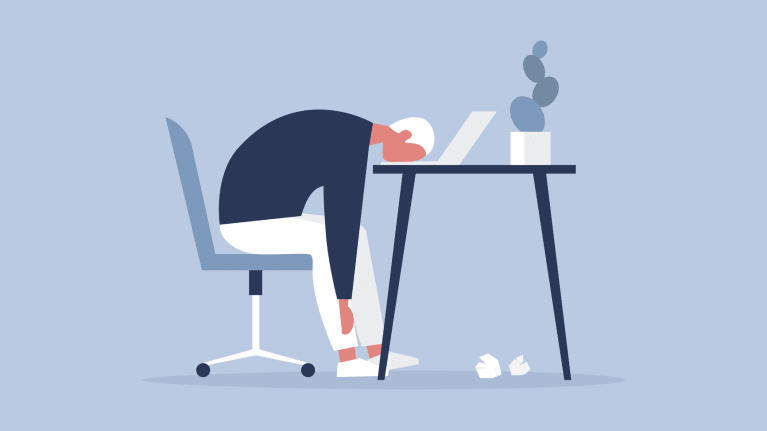ترجمة وتحرير نون بوست
في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 1973، أي بعد ستة أسابيع فقط من إعلان المملكة السعودية ومنظمة أوبك حظرا تصدير النفط نحو أوروبا والولايات المتحدة، انفجر مستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر غاضبا على السعوديين خلال اجتماع سري في البيت الأبيض. وقد كان في وقت سابق قد لوّح بفكرة إرسال قوات أمريكية للسيطرة على حقول النفط في المملكة وتقسيمها، منددا بما اعتبره “ابتزازا سعوديا”.
قال كيسنجر حينها غاضبا: “إنه من السخافة أن يبقى العالم المتحضر رهينة بين أيادي ثمانية ملايين من الهمج.”
بعد ثلاثة أشهر، كان كيسنجر داخل قصر الملك فيصل، يقدم فروض الطاعة ويعد بدعم أمريكي اقتصادي وتقني وعسكري حتى قبل رفع حظر تصدير النفط. حيث قال للملك: “إن هدفنا هو العمل مع سموكم لتعزيز صداقتنا على أسس طويلة المدى.”
تلك الأزمة التي دامت شهرا كامل حول حظر تصدير النفط، كانت فرصة نادرة لتسليط الضوء على العلاقات المتقلبة والقوية في آن واحد، بين السعودية والولايات المتحدة. إذ أنه في عدة مناسبات انهار التحالف بين الطرفين بسبب الخلاف حول الصراع العربي الإسرائيلي، ثم على خلفية هجمات 11 أيلول/ سبتمبر. إلا أن الصفقة التي عقدها الرئيس فرانكلين روزفلت والملك ابن سعود في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مكنت من الحفاظ على العلاقة بين واشنطن والرياض لمدة 75 عام.
لكن ربما قد تختلف الأمور الآن. إذ أنه في ربيع هذا العام، تماما كما حدث في أوائل السبعينات، استخدم السعوديون سلاحهم النفطي، ملحقين ضررا بالغا بالاقتصاد الأمريكي، وذلك من خلال تعمد خفض أسعار النفط في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي انهيارا بسبب فيروس كورونا. وحتى قبل هذه الأزمة كان المشرعون في واشنطن يشعرون بالقليل من الرضا عن السعوديين، بسبب تواصل انتهاكات حقوق الإنسان، والحرب الدموية التي تقودها المملكة في اليمن، وربما الأكثر إثارة للغضب، عملية القتل التي تعرض لها صحفي “واشنطن بوست” بأوامر من الدولة السعودية.
من خلال استخدام سلاح النفط، فإن السعوديين في النهاية يختبرون صبر الجمهوريين المتعطشين للذهب الأسود، والذين كانوا دائما من أكبر مساندي الرياض في الكونغرس. ورغم أن الولايات المتحدة والسعودية وروسيا وباقي الدول المنتجة للنفط توصلوا إلى اتفاق هذا الشهر لخفض الإنتاج وإصلاح الأضرار، فإن هذا الأمر لم ينفع، إذ أن أسعار النفط الخام الأمريكي وصلت إلى أدنى مستوى لها في القرن الواحد والعشرين، وهو ما يهدد بموجة من الإفلاس وتسريح العمال في الشركات الأمريكية. وفي 20 نيسان/ أبريل انهارت أسعار النفط الأمريكي بشكل كامل لتصل إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ.
الآن يوجّه المشرعون في الولايات المنتجة للنفط مثل تكساس ولويزيانا ونورث داكوتا وألاسكا اتهامات للسعودية بشن حرب اقتصادية، وقد قاموا بصياغة مسودة قرار لسحب القوات الأمريكية وإلغاء المظلة الأمنية التي كانت الولايات المتحدة منذ عقود تحمي بها الدولة السعودية الهشة.
في اتصال معه، قال كيفن كريمر، النائب الجمهوري عن نورث داكوتا، والذي يتزعم حملة الدفاع عن هذا المقترح: “ما هكذا يتصرف الأصدقاء تجاه أصدقائهم، لقد ارتكبوا خطأ فادحا في تقدير رد الفعل الأمريكي.”
على نطاق واسع بدأ الكثيرون في واشنطن بالتشكيك في الأسس التي قامت عليها العلاقات الثنائية الخاصة بين البلدين على مدى 75 عاما، وخاصة الحماية الأمريكية لضمان التدفق السلس للنفط السعودي ودعم الرياض لأصدقاء أمريكا في الشرق الأوسط.
حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان إلى وقت قريب يدافع عن هذه العلاقات، فإنه يتساءل الآن بشكل علني عما إذا كانت الولايات المتحدة تحتاج لحماية النفط السعودي. إذ أن أغلبه الآن يباع للصين وباقي المشترين الآسيويين، عوضا عن أوروبا والولايات المتحدة كما في السنوات السابقة. فالثورة الطاقية الأمريكية خلال العقد المنقضي خفضت من الاعتماد على نفط السعودية والشرق الأوسط، وهو ما دفع بالعديد من المتابعين للتساؤل حول جدوى صرف الأموال وخسارة أرواح الجنود الأمريكيين لحماية هذا النظام الملكي الديني الذي لا يتبنى الكثير من القيم الأمريكية.
هذه الزيجة التي صمدت أمام حظر تصدير النفط، ثم هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، وحرب العراق، تتعرض الآن لهزة بقوة الزلزال، وذلك بسبب تزايد الامتعاض لدى المشرعين الأمريكيين والإعلام والرأي العام.
يقول كريمر: “أنا أقضي وقتا عصيبا عندما أشرح للناخبين لماذا نصرف الأموال ونخاطر بحياة جنودنا للدفاع عن بلد يمتلك تاريخا سيئا معنا ويظهر الآن هذا النوع من السلوك. لقد أصبح من الصعب جدا الدفاع عن السعوديين”.
إلا أن الأوضاع قد تسوء بشكل أكبر خلال وقت قريب. حيث يقول بروس ريدل الخبير في الشأن السعودي والعميل المتقاعد من وكالة الاستخبارات الأمريكية: “الشيء الوحيد الذي يمنع انهيار العلاقات حاليا هو ترامب، إذ أن لديه ميلا خاصا للمملكة. ولكن هذا الأمر قد يتغير في انتخابات هذا العام، إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب، إذ أن بايدن نائب الرئيس السابق، كان قد وصف المملكة السعودية بأنها “منبوذة”، وأكد أنه سوف يوقف مبيعات الأسلحة إلى الرياض.
لكن كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟
يبدو أن التوترات القائمة اليوم تنبع في الأصل من الأسس التي قامت عليها هذه العلاقة الثنائية الغريبة، والتي تتمثل في مقايضة النفط مقابل الأمن والسعي دائما لتجاوز الهوة بين دولة ديمقراطية ليبرالية ونظام ملكي ديني محافظ.
يعتقد بعض الخبراء أن العلاقات الأمريكية السعودية سوف تتجاوز هذه العاصفة في النهاية، مثلما حدث في السابق، وذلك بسبب حاجة المصالح الأمريكية لحليف في الشرق الأوسط بمثل حجم المملكة وثرائها وعدائها لإيران.
يقول بلال صعب، المحلل في معهد الشرق الأوسط والمستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية: “إنه من الصعب جدا، وربما من غير المحتمل، التفكير في انهيار العلاقات أو حدوث طلاق.”
لكن محللين آخرين يرون احتمال حدوث قطيعة في الأفق، مثل بروس ريدل الذي يقول: “أعتقد أن اللحظة الحالية مهمة ومفصلية في تاريخ العلاقات، فقد كانت هناك في السابق هزات عديدة، ولكن العلاقات كانت دائما تستمر وتتعافى بسبب وجود تلك الصفقة الأولى. ولكننا لم نعد نحتاج للسعوديين اليوم، فهذه الأحداث تأتي في سياق جيوسياسي مختلف تماما عن الأزمات السابقة”.
الملك عبد العزيز آل سعود مع الرئيس فرانكلين روزفلت على متن البارجة يو إس إس كوينسي في 14 فبراير/ شباط 1945.
انطلقت العلاقات الأمريكية السعودية، برئيس واحد وملك واحد وثمانية رؤوس غنم على متن سفينة أمريكية مع اقتراب الحرب العالمية الثانية من نهايتها. إذ أن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، أثناء عودته من مؤتمر يالطا التاريخي، وقبل أسابيع من وفاته، عقد اجتماعا مصيريا في فبراير/ شباط 1945 مع الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمان آل سعود، المعروف بابن سعود، مؤسس المملكة السعودية الحديثة.
بالنسبة لابن سعود، فإن هذا اللقاء مثّل فرصة لاقتلاع مكان لدولته الناشئة كحليف أساسي لواشنطن، مع اقتراب خروجها من الحرب العالمية الثانية كمنتصر، وبداية تشكيل خارطة مرحلة ما بعد الحرب. وقد أثار ابن سعود إعجاب روزفيلت بجيش من الحاشية، وبالوجبات المترفة من الأغنام التي ذُبحت بالمناسبة، أملا في أن يقدم الرئيس الأمريكي للسعودية الدعم المالي الذي تحتاجه حتى تصبح قادرة على الاعتماد على صناعتها النفطية. وقد نجحت هذه العملية، إذ أن السعودية كانت واحدة من بين دول قليلة استمر حصولها على المساعدات الأمريكية بعد نهاية الحرب.
بالنسبة لروزفلت فإن السعودية تقدم للولايات المتحدة شيئين مهمين: أكبر خزان للنفط في العالم، وموقع جغرافي مركزي بين أوروبا وآسيا مع بداية تشكل ملامح الحرب الباردة. وأثناء هذا اللقاء، أقام روزفلت علاقة شخصية مع الملك السعودي، وهو ما شكّل أساس العلاقة التي دامت 75 عاما بين الرؤساء الأمريكيين والعائلة المالكة السعودية.
بعد سنوات قليلة من هذا اللقاء الأول، انتقلت الولايات المتحدة من تقديم بعض المعونات البسيطة للسعودية، إلى التكفل بأمن المملكة الصحراوية الغنية بالنفط، من أجل المحافظة على تدفق الذهب الأسود والإبقاء على السوفييت خارج المنطقة.
قال هاري ترومان لابن سعود في 1950: “ليس هناك من تهديد يمكن أن تتعرض له المملكة دون أن يتم اعتباره مصدر تهديد فوري للولايات المتحدة.”
بعد عام واحد، وقّع البلدان على اتفاقية للدفاع المشترك، ثم بعد عامين تم إنشاء البعثة الأمريكية للتدريب العسكري في المملكة. وبحلول 1957 كانت الولايات المتحدة تبيع للسعودية كميات ضخمة من الأسلحة لتمكينها من بناء قواتها البرية. واليوم تعد السعودية أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية، وقد كانت دائما تحت حماية واشنطن سواء في مواجهة الدكتاتور العراقي صدام حسين وتحركاته العسكرية العدائية في 1990، أو في السنوات الأخيرة في مواجهة تهديدات إيران.
لكن منذ البدايات كانت بذور الشقاق مزروعة في العلاقات بين البلدين وتهدد بإحداث شروخ فيها. إذ أن روزفلت حين التقى ابن سعود كان يأمل في الحصول على دعم السعوديين لإقامة الدولة اليهودية في الشرق الأوسط، وهو ما عارضه الملك بشدة، فتعهد الرئيس الأمريكي بعدم الضغط عليه في هذه المسألة. إلا أن ترومان الذي خلف روزفلت ساند إقامة دولة إسرائيل، وهو ما خلق حالة عدم ثقة وشعور بالغدر لدى السعوديين. وقد طفت هذه الخلافات حول الصراع العربي الإسرائيلي على السطح في عدة مناسبات، خاصة بعد حرب 1967، وهو ما أسفر في 1973 عن قرار حظر تصدير النفط، ثم في الأشهر التي تلت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، عندما كاد استياء السعوديين من مسار السلام في الشرق الأوسط أن يودي بالعلاقات المتأزمة حينها بفعل الهجمات التي كان أغلب منفذيها سعوديين.
هذه التوترات، خاصة بعد حرب 67 التي شهدت توسع الأراضي الإسرائيلية على حساب الجيران العرب، هددت بتسميم العلاقات الأمريكية السعودية مع بداية فترة نيكسون. وكانت إحدى وثائق مجلس الأمن القومي التي أُعدت لهنري كيسنجر في 1969، قد حذرت من تآكل الموقف الأمريكي في السعودية خلال العامين السابقين، وشدّدت على أن القضية الفلسطينية هي أبرز أسباب الخلاف الذي يمكن أن يلحق ضررا حقيقيا بالعلاقات بين الطرفين.
هذه التوترات تصاعدت خلال السنوات الثلاث الموالية إلى أن بدأ السعوديون بالتلويح بتهديد غير مسبوق، أي حظر تصدير النفط من أجل إجبار الولايات المتحدة على تغيير سياستها في الشرق الأوسط. وفي ذلك الوقت كانت واشنطن وحلفاؤها في أوروبا الغربية واليابان يعتمدون بشكل متزايد على النفط السعودي زهيد الثمن، وهو ما منح المملكة فرصة استثنائية للاستفادة من موقعها كأهم خزان للنفط في العالم من أجل إخضاع الغرب.
قد حذر مسؤولو مجلس الأمن القومي كيسنجر في صيف 1972 من “أن تزايد المخزون المالي لمنتجي النفط في الشرق الأوسط جعل هذه المادة بين أيديهم أداة للابتزاز والإكراه لم يعد بإمكاننا تجاهلها.”
بنهاية ذلك العام أرسلت واشنطن للرياض وفودا غير رسمية لتوجيه التحذيرات.
مستشار الأمن القومي هنري كيسنجر يلتقي الملك فيصل.
كتب كيسنجر إلى الرئيس نيكسون في 1972 يقول: “يبدو الأمر واضحا، إذ أن الملك فيصل يفكر في تسليط ضغط اقتصادي على الولايات المتحدة لفرض اتفاق سلام على إسرائيل يصب في مصلحة العرب”.
هذه المخاوف أصبحت حقيقة في أكتوبر/ تشرين الأول في 1973، أثناء الحرب بين إسرائيل ومصر، حين سارعت الولايات المتحدة لتقديم السلاح لإسرائيل من أجل صد التهديد السوفييتي ودعم حليفها في المنطقة. وكشفت مراسلة سرية من السفارة الأمريكية في جدة، أن الملك فيصل كان غاضبا بشكل غير مسبوق، وقد أمر هو بنفسه بفرض حظر على صادرات النفط إلى الولايات المتحدة. قبل ذلك، كان كيسنجر يستبعد دائما أن يتحول التهديد إلى أفعال، ولكن في تلك اللحظة، انتابه غضب شديد وتوعّد بعدم ترك السياسة الأمريكية رهينة للابتزاز الاقتصادي.
قال كيسنجر غاضبا أثناء أحد الاجتماعات في تلك الفترة: “أعرف ما كان يحدث في القرن التاسع عشر، وفكرة أن تتمكن مملكة البدو من إبتزاز أوروبا الغربية والولايات المتحدة كانت أمرا غير وارد على الإطلاق.”
بعد شهر واحد، كان كيسنجر يدرس فكرة القيام بخطوة عسكرية للتعامل مع حظر تصدير النفط والضغوط العربية، حيث قال أثناء تناوله الغداء في البيت الأبيض: “ألا يمكننا الإطاحة بأحد هؤلاء الشيوخ لنُظهر فقط ما الذي يمكننا فعله.”
من اليسار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ومستشار الأمن القومي هنري كيسنجر في زيارة إلى الملك فيصل في السعودية في 14 حزيران/ يونيو 1974. وقد تحدث نيكسون مع الملك فيصل حول التأثيرات العالمية لحظر تصدير النفط.
في النهاية تمكنت الولايات المتحدة والسعودية من فض الخلاف، وتم استئناف تصدير النفط في ربيع 1974. إلا أن الآثار التي خلفتها تلك الأزمة كانت عميقة وامتدت لفترة طويلة، وأضرّت بصورة السعودية لدى الرأي العام الأمريكي، وخلفت مخاوف كبيرة من احتمال أن يستخدم السعوديون النفط كسلاح ضد المصالح الأمريكية، وهي مخاوف بقيت قائمة رغم أن طبيعة التهديد النفطي السعودي كانت قد تغيّرت.
يقول الباحث في معهد بروكينغز بروس ريدل:” إن صورة شيوخ النفط الذين يفركون أيديهم بغبطة، بينما ننتظر نحن في طوابير للحصول على الوقود، جعلتهم شخصيات غير محبوبة بالمرّة.”
حتى قبل ثورة الطاقة الأمريكية التي مكّنت الولايات المتحدة من التخلص من تبعيّتها للواردات النفطية، وخاصة السعودية، فإن ذلك الحظر زرع فكرة في العقل الأمريكي مفادها أن المملكة ليست حليفا موثوقا.
قال جوزيف ويستفال الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في السعودية بين 2014 و2017: “إن ذلك الحظر كانت له آثار طويلة المدى على العلاقات وهي لا تزال جلية إلى اليوم. لقد جعلتنا على وعي بتبعيّتنا للنفط الأجنبي، وخلقت لدينا موقفا جديدا من السعوديين”.
الملك خالد يقف مع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر أثناء حفل استقبال في الرياض في كانون الثاني/ يناير 1978.
بعد سنوات قليلة من الحظر، وقع حدث آخر هزّ الشرق الأوسط، وكانت له ثلاثة تأثيرات طويلة الأمد على العلاقات الأمريكية السعودية، تواصلت إلى اليوم. ففي العام 1979 أطاحت الثورة الإيرانية بالشاه محمد رضا بهلوي الذي كان حليفا لواشنطن في المنطقة. تلك الثورة، إلى جانب حادثة الحرم المكي الدموية في العام ذاته، أرعبت القيادة السعودية التي اكتشفت حجم الأخطار التي يمكن أن تحدق بها.
كما أن تلك الثورة التي أطاحت بالشاه وخلقت حالة من العداء المستمر تجاه واشنطن، جعلت من السعودية الحليف الأهم لأمريكا في المنطقة، على الرغم من أزمة حظر تصدير النفط. وفي غضون عام واحد، أعلن الرئيس جيمي كارتر عن عقيدته السياسية تجاه المنطقة، والتي قامت بالأساس على مبدأ حماية نفط الخليج، وخاصة النفط السعودي.
وهكذا فإنه قبل عقد من نهاية الشيوعية، ظهر نظام ثائر في إيران قدّم للولايات المتحدة والسعودية عدوا مشتركا جديدا يحتاجان إليه، وأصبحت إيران منذ ذلك الحين وإلى اليوم، الركيزة الأساسية للتحالف الاستراتيجي الأمريكي السعودي. كما أن تراجع الصادرات النفطية الإيرانية في تلك الفترة، جعل من السعودية لاعبا أكثر أهمية في الأسواق العالمية، ورسّخ لدى الرياض تلك الدروس التي تعلمتها قبل خمس سنوات حين تجرأت على ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة.
كتب السفير الأمريكي في السعودية جون ويست في تقرير للرئيس كارتر في منتصف العام 1979، أن الرياض “بدأت تنظر إلى العلاقات الأمريكية السعودية القائمة أساسا على مبدأ النفط مقابل الحماية، باعتبارها أنها غير متوازنة إلى حد ما، ولذلك فإن السعوديين بدؤوا يتوقعون المزيد من التقدير والتنازلات من الطرف الأمريكي في مقابل النفط”.
لكنّ ذلك لم يكن في الواقع أخطر ما أفرزته الثورة الإيرانية. كان حكام السعودية يخشون من أن يطيح بهم بعض المتطرفين، لذلك نزعوا إلى سياسة أكثر محافظة وتحالفوا مع رجال الدين المتشددين في البلاد، ومثّل ذلك اللبنة الأولى لبرنامج تصدير الفكر الوهابي المستمر منذ عقود. وسرعان ما شرع الأثرياء السعوديون، ومن بينهم أسامة بن لادن، في تمويل المجاهدين لمواجهة الغزو السوفييتي لأفغانستان، والذي كان قد بدأ في العام الذي اندلعت فيه الثورة الإيرانية.
وبعد عقود، بدا أن ذلك التوجه السعودي نحو اعتماد نهج ديني أكثر تشددا، أدى في النهاية إلى خلق أكبر أزمة في تاريخ علاقات بين البلدين.
مثّلت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر أسوأ هجوم على الأراضي الأمريكية، حيث أوقع حوالي 3 ألاف قتيل، في سلسلة من العمليات الإنتحارية المنظمة عبر اختطاف طائرات تجارية والاصطدام بمركز التجارة العالمي. نفّذت ذلك الهجوم مجموعة أغلبها من حاملي الجنسية السعودية، وبالتحديد 15 من أصل 19 منفذا، وبعضهم كانت له علاقات مع المسؤولين السعوديين قبل ذلك. هذا الأمر خلق أخطر أزمة في العلاقات التي كانت تبدو في السابق غير قابلة للكسر. أصبح الرأي العام الأمريكي أكثر سخطا على المملكة، فيما شعرت القيادة السعودية بالامتعاض من ردة الفعل الأمريكية على ما اعتبرته الرياض عملا طائشا قامت به مجموعة من السعوديين المارقين الذين نددت بهم القيادة.
يذكر روبرت جوردن الذي كان مبعوث الولايات المتحدة للسعودية بعد أشهر من تلك الهجمات، أن “ذلك الوقت كان عصيبا وقويا جدا، حيث أن السعوديين صُدموا بردة فعل الرأي العام الأمريكي، ونظموا حملة مقاطعة للبضائع الأمريكية التي كانت مكدسة في رفوف المتاجر ومعارض السيارات. لقد كانت هناك حالة من الغليان بسبب المشاعر العدائية التي عبر عنها السياسيون ورجال الدين الأمريكيون.”
تلك الهجمات لم تؤد فقط إلى عقدين من الحملات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط الكبير، بل أيضا إلى الغضب مما يعتبره كثيرون تورط المسؤولين السعوديين في الهجمات. وعلى مدى سنوات، كان الجزء السري من تقرير 11 أيلول/ سبتمبر يغذي الشكوك لدى الرأي العام الأمريكي حول تورط السعودية، وقد جاء كشف النقاب عن تلك الصفحات في تموز/ يوليو 2016 كمحاولة لتبديد تلك الشكوك. ألمح ذلك الجزء من التقرير إلى إمكانية وجود اتصالات بين بعض الخاطفين وأشخاص مرتبطين بالحكومة السعودية، ولكن التحقيق لم يتمكن من توثيق أي علم مسبق لمسؤول سعودي أو أي مشاركة في الهجمات.
وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل يغادر بعد الحديث إلى المراسلين في البيت الأبيض في 29 تموز/ يوليو 2003 إثر لقاء مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. وقد أعلن الرئيس حينها أنه رفض الاستجابة للطلب السعودي برفع السرية عن أجزاء من تقرير الكونغرس حول هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.
رحبت الحكومة السعودية بقرار الكشف عن تلك الوثائق وقال عبد الله بن فيصل آل سعود الذي كان حينها سفيرا للسعودية في واشنطن: “نأمل أن يؤدي الكشف عن هذه الصفحات إلى وضع حد لأي أسئلة عالقة أو شكوك حول تصرفات السعودية أو نواياها، أو حول صداقتنا طويلة المدى مع الولايات المتحدة.”
وبعد مرور 15 عاما على تلك الهجمات، وافق الكونغرس بالإجماع على تشريع تحدّى الفيتو الذي رفعه الرئيس باراك أوباما وفتح الباب أمام رفع دعاوى قضائية لمطالبة السعودية بتعويضات لفائدة عائلات ضحايا تلك الهجمات.
حينها، قال جيرالد فيرشتاين، الدبلوماسي الذي عمل في عدة بلدان في الشرق الأوسط: “إن العلاقات بين البلدين لم تتعافى تماما منذ 11 أيلول/ سبتمبر.”
إلى اليوم تتواصل المعارك القانونية حول هذه المسألة، إذ أن عائلات ضحايا الهجمات، مدعومة بأعضاء متنفذين في الكونغرس، تدفع نحو إقامة دعاوى مدنية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات. وقد رفضت وزارة العدل الأمريكية عدة محاولات لرفع السرية عن ملفات تعود لمكتب التحقيقات الفدرالي تتضمن تقييما لمدى تورط المسؤولين السعوديين في الهجمات. وقد تم خلال هذا الشهر التقدم بطلب جديد أمام قاض فدرالي من أجل الاطلاع على هذه الوثائق.
بعد أيام من غزو الولايات المتحدة للعراق، دبابة للمارينز تحتل مكانا أمام لوحة لصدام حسين في مدينة الناصرية في 24 آذار/ مارس 2003.
إذا كانت تصرفات السعوديين قد سممت العلاقات في 2001، فإن الولايات المتحدة قامت بالشيء ذاته بعد عامين، عندما قررت إدارة الرئيس بوش غزو العراق والإطاحة بصدام حسين رغم المعارضة القوية من السعوديين الذين كانوا يخشون من أن هذا الأمر سوف يفتح الباب أمام اتساع دائرة النفوذ الإيراني بالقرب من حدودهم، وهو ما حدث بالفعل.
وكانت السعودية حينها تشعر بالارتياب تجاه تزايد الهيمنة الإيرانية على المنطقة منذ 1979، وقد ذكر جوردن الذي عمل سفيرا في الرياض حتى أواخر 2003، أن “المخاوف السعودية من إيران تزايدت بعد غزو العراق، حيث قال لي وزير الخارجية السعودي حينها “لقد قلبتم العراق رأسا على عقب وقدمتموه لإيران على طبق من فضة.”
ولكن مع مرور الوقت، منحت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر ذاتها، الولايات المتحدة والسعودية، الفرصة لإيجاد هدف مشترك، خاصة بعد ظهور تنظيمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة الذي نفذ تلك الهجمات ثم شرع في استهداف السعودية نفسها من خلال هجوم كبير في 2003. فقد أصبح تنسيق الجهود بين البلدين لمكافحة الإرهاب أقوى من أي وقت سابق، وهو مستمر إلى اليوم، ويمثل أحد أهم عوامل التقارب في العلاقات المتّسمة بالتوتر.
يقول جوردن إن ” بناء علاقة جديدة تقوم على مكافحة الإرهاب، مثّل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، بعد أن أيقن السعوديون أن تنظيم القاعدة كان يهددهم تماما مثل ما يهددنا.”
الرئيس الأمريكي جورج بوش يمسك يد ولي العهد السعودي عبد الله في مزرعة بوش في تكساس في 25 نيسان/ أبريل 2005.
يرى جوزيف وستفال، الذي عمل سفيرا في السعودية قبل جوردن، هو الآخر أن الحرب المشتركة ضد التطرف الديني ساعدت على رأب الصدع الذي خلفته هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، ومنح تلك العلاقات زخما جديدا. حيث يقول إن ” عبد الله الذي كان حينها وليا للعهد، ثم بعد ذلك ملكا، كان أكثر تشددا من الناحيتين الدينية والثقافية، ولكنه كان بكل تأكيد خصما للإرهاب، وأوضح أن هنالك حاجة للقضاء عليه.”
وقد قال وستفال حين كان سفيرا في السعودية: ” لم تكن علاقة البلدين قوية، ولا التعاون الاستخباراتي والأمني في مجال مكافحة الإرهاب عاليا، بمثل ما عليه الأمر الآن.”
هذه المعركة المشتركة ضد الإرهاب مثّلت رابطا ساعد بعد ذلك على الحفاظ على العلاقات رغم كل الهزات التي مرت بها، وقد كانت كثيرة في فترة أوباما.
الملك عبد الله يرافق الرئيس أوباما بجانب حرس الشرف أثناء استقباله في الرياض في 3 حزيران/ يونيو 2009.
من وجهة نظر السعودية، كانت بداية فترة أوباما مبهرة قبل أن يخفت بريقها بشكل كارثي، وذلك في ظل تباين الآراء حول الربيع العربي وحقوق الإنسان والحرب الأهلية في سوريا، وخاصة جهود أوباما للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران.
حيال هذا الشأن يقول علي الشهابي، الذي كان إلى حدود السنة الماضية يرأس خلية تفكير “مؤسسة العربية”، وهو من المدافعين عن المصالح السعودية في واشنطن: “لقد مرت المملكة العربية السعودية بستين عاما من خيبات الأمل مع حبيبتها (أمريكا)، ولكن أوباما كان أول رئيس منذ جيمي كارتر يقض مضجع السعوديين”.
ذكر دبلوماسيون أمريكيون في برقيات سرية في ذلك الوقت، أن النخب السعودية رحّبت بالخطاب الشهير الذي ألقاه أوباما في القاهرة سنة 2009 الذي دعا فيه إلى “بداية جديدة” للعلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي بحماس كبير. ولكن في غضون سنتين، هز اندلاع الربيع العربي أسس البلدان في جميع أنحاء المنطقة، وقد تلخّص الرد الأمريكي على هذا الاضطراب، في نظر السعودية، في التخلص من الشركاء الأمريكيين القدامى على غرار الرجل المصري القوي حسني مبارك. والأسوأ من ذلك، بالنسبة للقيادة السعودية، كان احتضان الولايات المتحدة الواضح لجماعة الإخوان المسلمين – التي تعتبرها الرياض شبيهة بجماعة إرهابية تهدد مكانتها في العالم الإسلامي – والتي مثلها الرئيس المصري الجديد آنذاك محمد مرسي.
حسب ريدل من مؤسسة “بروكينغز”، الذي قدم المشورة لإدارة أوباما بشأن قضايا السياسة الخارجية، فإن “الربيع العربي زعزع بلا شك العلاقات الأمريكية السعودية. بالنسبة لهم، كانت استجابة الولايات المتحدة إلى دعوات الإصلاح في العالم العربي متعاطفة بشكل كبير، مما أدى إلى فتور العلاقات بينهما”.
لكن ترحيب الولايات المتحدة الظاهري بحركات الإصلاح التي تشكل تهديدًا سياسيًا، تزامن مع ما بدا للسعوديين تقاعسا مخيبا للآمال في العمل على جبهات أخرى قريبة من حدودهم. عندما اندلعت الحرب الأهلية السورية، دعت إدارة أوباما إلى وقف العنف وتحدثت في النهاية عن ضرورة تنحية الزعيم السوري بشار الأسد – لكنها لم تتخذ خطوات مهمة للتدخل في صراع اعتبره السعوديون نواة قلقهم الأمني. في الوقت نفسه، بدا أن إدارة أوباما لا تواجه أي مشكلة تذكر مع حكومة العراق الموالية لإيران، بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي تسببت في زعزعة القيادة السعودية بسبب الخوف من تنامي النفوذ الإيراني في جارتها الشمالية.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأمريكي باراك أوباما يغادران حديقة الورود بعد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في 22 تموز/ يوليو 2009.
قال ويستفال، الذي كان حاضرا في ثلاث من أصل أربع زيارات مسجّلة لأوباما إلى المملكة العربية السعودية: “أعرب الملك عبد الله عن احترامه وأعجِب بأوباما شخصيا، ولكن كانت هناك أمور لا يمكنهم فهمها. فعلى سبيل المثال، لماذا تدعم المالكي الذي يُخضع بلاده بشكل أساسي لسيطرة الإيرانيين؟ كيف لا تستطيع عزل الأسد؟”
مع ذلك، جاء التهديد الأكبر للعلاقات الثنائية مع جهود إدارة أوباما لتطبيع العلاقات مع إيران وتأمين صفقة دبلوماسية من شأنها تقليل خطر برنامج الأسلحة النووية الإيراني. منذ سنة 1979، كان القادة السعوديون يعتبرون إيران أخطر تهديد للمنطقة وأمنهم الخاص، بينما أثارت جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع السماح لإيران بمواصلة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة، حفيظة السعوديين.
أشار ويستفال إلى أن القلق السعودي “لم يكن بسبب الاتفاقية النووية”. ففي محادثاته مع الملك وولي العهد ونائب ولي العهد، “فضلوا الجهود الرامية لوقف برنامج الأسلحة النووية الإيراني. لكنهم أرادوا المزيد؛ أرادوا أن نضغط على تحركات إيران في العراق وسوريا واليمن، ولكننا لم نفعل ذلك”.
واجهت الرياض صعوبات مع البيت الأبيض تحت إدارة أوباما، لكنها واجهت تحديات أكبر من الكونغرس، حتى قبل إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي فتح الباب لدعاوى قضائية تتعلق بالإرهاب ضد الرياض.
لقد تركزت أغلب الشكوك حول الحرب التي قادتها المملكة العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن. وفي وقت لاحق، قال أحد كبار المسؤولين السابقين في إدارة أوباما: “كنا نعلم أننا ربما نخاطر بالكثير”. لكن حذرا من استحواذ الحوثيين على السلطة، ونظرا لحساسية العلاقات الأمريكية السعودية التي أصبحت هشة بعد الاتفاق الإيراني، قدمت إدارة أوباما في نهاية المطاف الدعم العسكري والدبلوماسي لجهود المملكة العربية السعودية في اليمن.
جنود التحالف بقيادة السعودية ينتشرون في ضواحي عدن، اليمن، في الثالث من آب/ أغسطس 2015، خلال عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم.
مع استمرار الحرب في اليمن، اشتدت معارضة الكونغرس للدعم العسكري الأمريكي للحملة السعودية، إلى جانب تنامي الرقابة على مبيعات الأسلحة الأمريكية المقترحة إلى الرياض. حتى أن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، الديمقراطي إد ماركي، كان قد حذر في سنة 2015 من أن الشراكة الأمريكية السعودية قد تكون معرضة للخطر بسبب الحرب في اليمن.
بحلول موعد الانتخابات الأمريكية لسنة 2016، كانت المملكة العربية السعودية تكافح لاستعادة علاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة. ومع انتخاب دونالد ترامب، الجمهوري الذي شارك وجهات نظر الرياض المتشددة تجاه إيران ولم يثر ضجة حول حقوق الإنسان، حصلت المملكة العربية السعودية على شريان الحياة، ولكن أيضا على عبء محتملة.
من اليسار، يقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما يضع القادة أيديهم على كرة أرضية مضيئة أثناء حفل افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض في 21 أيار/ مايو 2017.
فوجئ القادة السعوديون، مثل أي شخص آخر تقريبا، بفوز ترامب المفاجئ في انتخابات سنة 2016، وانطلقوا بسرعة لبناء جسور التواصل مع الإدارة الجديدة وترسيخ الروابط الشخصية بين ولي العهد محمد بن سلمان وترامب، وخاصة إنشاء العلاقات مع صهر الرئيس جاريد كوشنر. لطالما كانت الزيارات الخارجية الأولى للرؤساء السابقين في الآونة الأخيرة إما إلى كندا أو المكسيك، وهما أقرب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وجيرانها. أما ترامب، فقد خالف التقاليد واختار التوجه إلى المملكة العربية السعودية.
بسط القادة السعوديون السجادة الحمراء لترامب وحضّروا الكرة المتوهجة استعدادا لأول رحلة خارجية له كرئيس. كان هذا الأمر بمثابة تغير جذري مفاجئ، خاصة بعد هجمات ترامب على المسلمين والهجمات المتكررة على المملكة العربية السعودية خلال الحملة الانتخابية، عندما اتهم ترامب المملكة بتنفيذ عملية 11/9، إضافة إلى انتقاده لإسقاط الحماية الأمريكية وتهديده بمقاطعة اقتصادية.
كان القادة السعوديون على استعداد لتجاهل تعليقات ترامب وكانوا حريصين على إقامة علاقات مع رئيس غير تقليدي ولم يقع اختباره، قبل أن يتمكن الزعماء الأجانب الآخرون من ذلك. وقال الشهابي: “كانت واشنطن مثل روما في الإمبراطورية الرومانية، ونحن مثل دولة تابعة عليها أن تحيي الإمبراطور. يمكنك وضع قرد في البيت الأبيض، وسنحييه”.
ساعدت هذه العلاقات الوثيقة مع البيت الأبيض على إبقاء العلاقات الأمريكية السعودية على المسار الصحيح حتى مع تكثيف الكونغرس لأبحاثه بشأن الحرب في اليمن ومضاعفة الجهود التشريعية لفك الروابط الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية خلال السنوات الأولى من تولي ترامب لمنصبه. ومن جهته، اعترض ترامب على جهود الكونغرس للحد من التعاون العسكري.
لم يشتد غضب الكونغرس على المملكة العربية السعودية إلا بعد القتل الوحشي لكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 من قبل عملاء سعوديين. وخلصت وكالة المخابرات المركزية لاحقا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الوريث الطموح للحكم السعودي، هو الذي أمر بقتل خاشقجي.
لكن مرة أخرى، تدخل ترامب لحماية السعوديين، مشيرا جزئيا إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين والمخاوف من تزايد نفوذ منافسي الولايات المتحدة الآخرين في الشرق الأوسط. وفي تصريح له لشبكة إن بي سي نيوز في مقابلة أجريت معه في حزيران/ يونيو سنة 2019، قال ترامب: “أنا لا أحب الأحمق الذي يقول ‘نحن لا نريد التعامل معهم'”.
لكن هذه العلاقات الرئاسية قد كلفت الرياض الكثير. يبدو أن الخطط التي عملت بشكل موثوق منذ سنة 1945 لترسيخ الروابط الثنائية في العلاقات الشخصية مع الرئيس، تأتي بنتائج عكسية. يُنظر إلى محمد بن سلمان، الذي انتقده الكثيرون في الكونغرس بحدة بسبب دوره المزعوم في قتل خاشقجي، وكذلك بسبب الانتهاكات الأخرى المستمرة لحقوق الإنسان داخل المملكة العربية السعودية واليمن، على أنه قريب بشكل استثنائي من كوشنر وترامب. ولكن لا شك أن الانتفاع من نجاحات رئيس لا يتمتع بشعبية تاريخيا ووقع توجيه تهم إليه لعزله ليس أفضل طريقة لتحسين صورة المملكة العربية السعودية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) يصلان لحضور اجتماع قمة مجموعة العشرين في أوساكا، اليابان، في 28 حزيران/ يونيو 2019.
أكد الشهابي أن الانفتاح على البيت الأبيض “ساهم في إقامة علاقة، ولكن على الجانب الآخر، خلق أوجه تشابه بين المملكة العربية السعودية وترامب”، وهو ما أضر بقضية السعودية في كابيتول هيل وفي الصحافة في وقت كانت فيه المشادات الحزبية على أوجها في واشنطن. وأضاف الشهابي قائلا: “إن احتضان ترامب كلف السعودية أكثر مما قدمته”.
رغم عقود من العلاقات الاقتصادية الوثيقة والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، يبدو أن المملكة العربية السعودية لم تزرع جذورًا عميقة في الولايات المتحدة من شأنها إضفاء الطابع المؤسسي على علاقتها بها بعيدا عن الملوك والجنرالات والرؤساء. وهذا يعني أنه عندما توترت العلاقات بين البلدين، لم يكن لدى الرياض العديد من الحلفاء الخارجيين للدفاع عنها في واشنطن. في هذا السياق، قال الدبلوماسي الأمريكي السابق فيرستين “لقد كانت علاقة عرضها ميل واحدًا وعمقها بوصة”.
بعد ذلك، جاءت تجاوزات محمد بن سلمان في السياسة الخارجية منها الحرب الكارثية في اليمن، والاختطاف الافتراضي لرئيس الوزراء اللبناني بهدف الضغط على إيران وحزب الله، والحظر المفروض على قطر جارتها الصغيرة وشريكها العسكري الرئيسي في الولايات المتحدة. أما على المستوى الداخلي، كانت هناك تقارير منتظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تركب في المملكة، بالإضافة إلى عملية الابتزاز لنيل حوالي 100 مليار دولار من الخصوم السياسيين الأثرياء لتعزيز السلطة تحت غطاء حملة مكافحة الفساد.
طغت تلك الخطوات على حملة محمد بن سلمان الطموحة لإصلاح بلاده وتنويع اقتصادها القائم على إيرادات النفط، مما دفع منتقدي الكونغرس إلى استنتاج أن الرياض كانت تخطو خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء. في سنة 2018، مثلا، منحت السعودية أخيرًا المرأة حق قيادة السيارة. لكن بعض أبرز الناشطين الذين ضغطوا من أجل هذه الإصلاحات سجنوا وتعرضوا للتعذيب، حسب بعض التقارير. علاوة على ذلك، أضحت المملكة العربية السعودية، أكثر من أي وقت مضى، تعتمد على تحالفها مع واشنطن لتعزيز شرعيتها الدولية في الوقت الذي تخلت فيه الدول الأوروبية والمجتمع الدولي الأوسع عن دعمها.
في هذا الإطار، أفادت المسؤولة السابقة عن تنظيم السياسات المتعلقة بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية، كيرستن فونتينروز، التي تعمل حاليا في المجلس الأطلسي بأنه: “طالما أنهم مجرد بلد – بلد يافع جدا – فهم حقًا لا يعرفون كيف ستكون مكانتهم في العالم دون دعم الولايات المتحدة”، مضيفةً أن محمد بن سلمان “يدرك أننا نضفي عليه بعض الشرعية، وأن العالم سيكون صارما أكثر معهم. لو لم نكن نساندهم لانتهى بهم الحال منبوذين، مثل إيران”.
كان موقف المملكة العربية السعودية في الكونغرس سلبيا بالفعل عندما فشلت روسيا والمملكة العربية السعودية في أوائل آذار/ مارس في التوصل إلى اتفاق للحد من إنتاج النفط، وحلا شراكة كانت قائمة منذ ما يقارب ثلاث سنوات والتي أسهمت في إبقاء أسعار النفط مرتفعة نسبيًا. بدأت روسيا حرب أسعار النفط، لكن المملكة العربية السعودية أنهتها من خلال الترفيع بشكل كبير في الإنتاج والتخفيض في سعر بيع صادراتها النفطية. بالاقتران مع الآثار الاقتصادية الكارثية لوباء فيروس كورونا، الذي شلّ الحركة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، أدت هذه الخطوة إلى هبوط أسعار النفط إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.
خلافًا لسنة 1973، عندما استخدمت المملكة العربية السعودية سلاح النفط لرفع الأسعار وإيذاء الولايات المتحدة، قامت أسعار النفط المتهاوية هذه المرة بالمطلوب. يحتاج منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى أن تكون أسعار النفط أعلى من 40 دولارًا للبرميل لتحقيق سعر التعادل. ولكن حرب الأسعار الروسية السعودية تسببت في هبوط سعر النفط إلى 25 دولارًا ثم إلى أرقام سلبية، مما انجر عنه موجة من الإفلاس وأضرار اقتصادية طالت الشركات من تكساس إلى داكوتا الشمالية.

الآن، ليس الديمقراطيون وحدهم من يركز على حقوق الإنسان في الكونغرس ويطالبون بالانتقام، بل بات الجمهوريون أيضا يُشككون بدورهم بالكامل في الأساس الذي تقوم عليه العلاقة الأمريكية السعودية. وفي أواخر نيسان/ أبريل، حث السيناتور الجمهوري القوي عن ولاية أوكلاهوما جيمس إنهوف إدارة ترامب على “معاقبة [المملكة العربية السعودية وروسيا] على سلوكهما العدواني”.
يقول ريدل إن “السعوديون لديهم مشكلة خطيرة مع الديمقراطيين، وهذا واضح منذ فترة طويلة… وفي الوقت الراهن أفسدوا علاقتهم بالجمهوريين”. ومن جهته، قال كيفن كريمر، السيناتور الجمهوري عن ولاية داكوتا الشمالية: “أعتقد أن التحالف الاستراتيجي الذي بيننا وبين السعودية قد تداعى، وسيستغرق إعادة بناء الثقة وقتا طويلا”.
لوحة إعلانية عملاقة تحمل صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان، معلقة على طريق رئيسي في الرياض في 19 أيار/ مايو من سنة 2017، وذلك قبل أول رحلة خارجية لترامب منذ توليه منصبه.
هل الزواج الذي بدأ على قناة السويس سنة 1945 على وشك الانتهاء بطلاق؟
من بعض النواحي، إن الأسس التي انبنت عليها العلاقات وخاصة منذ سنة 1980 وقع التخلي عليها في صمت. لسنوات، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن المملكة العربية السعودية وضمان التدفق الحر للنفط لصالح الاقتصاد العالمي. وبدخولها مرحلة المنافسة بين القوى العظمى، تسعى إدارة ترامب لانتزاع الثروات الأمريكية من الشرق الأوسط لمواجهة منافسيها العالميين روسيا والصين.
في صيف 2019، عندما هددت الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط بالقرب من الخليج الفارسي تدفق النفط، تمثل رد ترامب في أن يطلب من حلفائه مثل اليابان وكوريا الجنوبية حماية سفنهم، متسائلا عن سبب استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ هذه المهمة منذ عقود ما لم تكن دول أخرى تدفع مقابل ذلك. في ذلك الخريف، تعرضت منشآت نفط سعودية عديدة لهجوم إيراني حسب بعض المزاعم، ما تسبب في غضون دقائق في تراجع الإنتاج العالمي بحوالي 5 بالمئة. وقد كان رد الولايات المتحدة على ذلك عدم القيام بأي شيء، ما عدا نشر تغريدة من قبل ترامب.
وفقًا لخبير شؤون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية وكاتب العمود في مجلة “فورين بوليسي”، ستيفن كوك، “لطالما قيل لنا إن حدوث هجوم على المملكة العربية السعودية يتطلب ردًا من الولايات المتحدة، لكن تجاهل الجميع ذلك بكل بساطة. لم يكن لعقيدة كارتر أي استثناءات…”.
إن الاتهامات المريرة خلال حرب أسعار النفط، التي جاءت في أعقاب مقتل خاشقجي، وتواصل الحرب في اليمن وغيرها من الأخطاء السعودية، جعلت
العديد من الملاحظين يعتقدون أن العلاقات الأمريكية السعودية باتت في أمس الحاجة إلى إعادة النظر.
قال كوك إن العلاقة “قد تتطلب إعادة تقييم، أعتقد أن المشكلة تكمن في الطريقة المخيبة للآمال التي تعاملت بها السعودية مع هذا الوضع، وهذا لن يعيق إعادة تشكيل العلاقة فقط، بل سيمهد لبناء علاقة قائمة على عدم الثقة والانقسام”.
إن الشيء الوحيد الذي تغير خلال العقد الماضي هو تراجع اعتماد الولايات المتحدة على النفط السعودي ونفط الشرق الأوسط. وهذا من شأنه أن يضع العلاقات الأمريكية السعودية على أساس مختلف عما كانت عليه في البداية، أو في السبعينيات، أو خلال حرب الخليج.
في سياق متصل، أضاف كوك “لقد اختلفت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عما كانت عليه من قبل”. حتى لو خلقت طفرة الطاقة الأمريكية ما يسمى بـ “استقلالية الطاقة الأسطوري”، حيث لا يزال المنتجون الأمريكيون رهائن إلى حد كبير للنفط السعودي وضغوط السوق العالمية، فإن رؤية أمريكا حرة بعد كل هذه العقود من نفط الشرق الأوسط تجعل من السهل علينا تخيل إعادة صياغة شاملة للصفقة العشوائية التي أبرمها روزفلت مع بن سعود. كما يقلل الناس من شأن المناشدات السياسية لاستقلال الطاقة: التي تعتبر بمثابة وسيلة لإعادة تشكيل علاقاتنا في الشرق الأوسط”.
يعتقد خبراء آخرون أن أغلب الروابط التي عقدت بين البلدين لا تزال قائمة الذات. وقال صعب، المحلل في معهد الشرق الأوسط: “بعد النجاة من هجمات 11/9، لا يمكن أن نفكر عمليا في حصول أمر من شأنه أن يضع حدا للعلاقة أسوأ من هذه الحادثة”. وطالما أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار إيران مصدر تهديد كبير، فإن العلاقات الوثيقة مع المملكة العربية السعودية سيكون لها جاذبية قوية.
في هذا الشأن، أفاد كالي توماس، خبير الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن العلاقات الأمريكية السعودية الصاعدة “ليست إلا مجرد حل، وذلك بالنظر إلى الطبيعة التاريخية والتقليدية لتلك العلاقة. فمن الصعب أن تقسو على شريك أثبت أنه من الشركاء القلائل الذين يمكننا الاعتماد عليهم ضد إيران”.
لكن خلال هذه الأزمة الأخيرة، كانت علاقة السعودية الوثيقة مع ترامب هي العامل الوحيد الذي أنقذها من ردة فعل الكونغرس المعاكسة وحال دون انهيار العلاقة التي استمرت ثمانية عقود. لكن قد يتغير ذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال ريدل: “أعتقد أن هذه المرة مختلفة. إذا فاز بايدن، فمن المحتمل أن نرى إعادة تقييم جوهرية للعلاقات”.
المصدر: فورين بوليسي