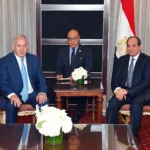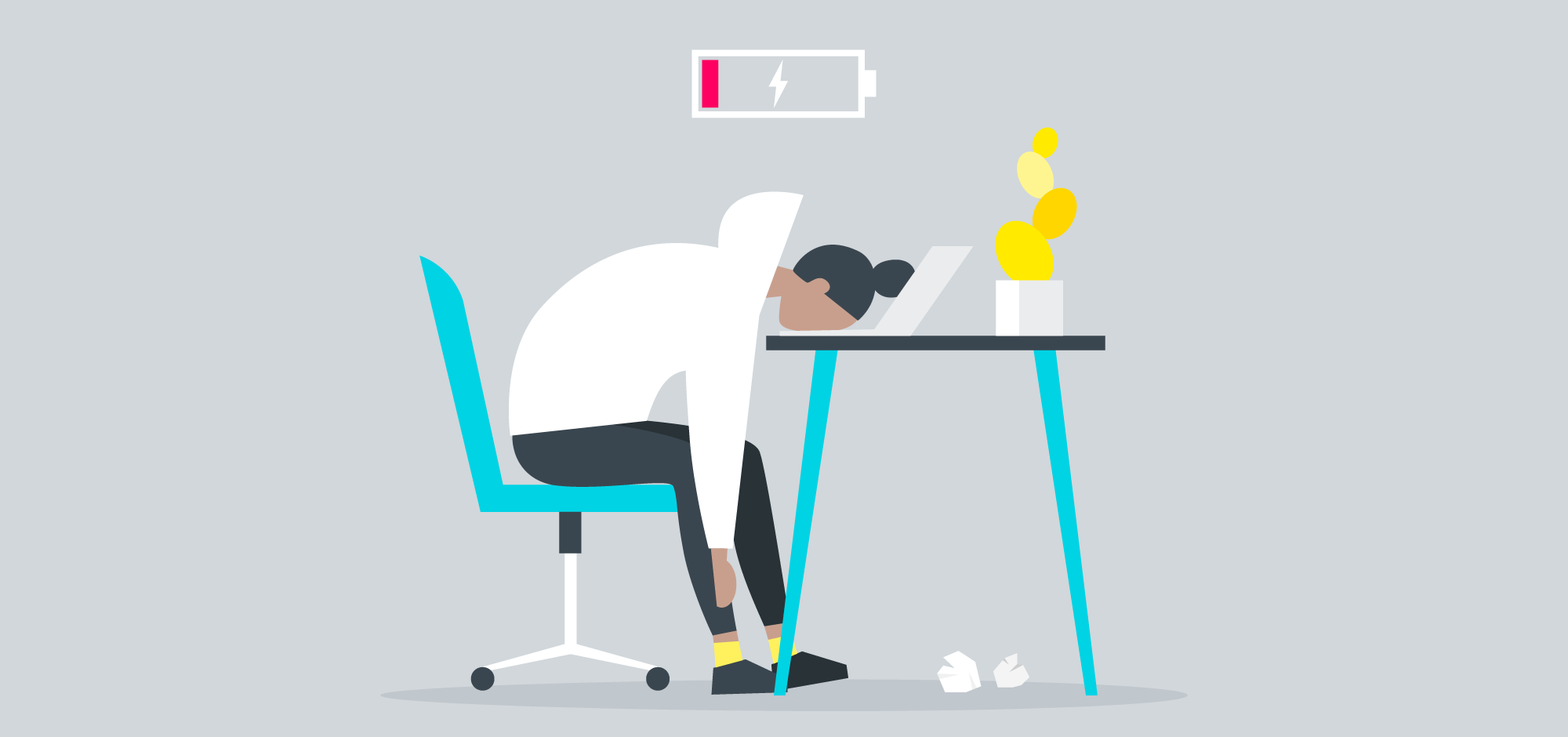منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحتى زيارة ماكرون الأخيرة إلى بيروت، لم تترك فرنسا أزمة في الشرق الأوسط أو في مناطق نفوذها السابقة – باستثناء بعض الفترات – إلا وتدخلت فيها وحاولت فرض نفوذها أو ممارسته – أو بمعنى أصح: التوهم بوجوده -، بل أحيانًا كانت تخترع بنفسها أدوارًا وأزمات لتلعب فيها دور الإمبراطورية!
المفارقة أنها كانت دائمًا تواجه نفس المشكلة التي تفضي بتدخلاتها للفشل: الولايات المتحدة الأمريكية! وبينما تعلمت شقيقتها، الإمبراطورية البريطانية الدرس مبكرًا، يبدو أن فرنسا لم تزل بعد تعي حقائق التاريخ، وحتى الجغرافيا!
إمبراطورية تسلم لإمبراطورية
حين انتهت الحرب العالمية الثانية بالتدخل الأمريكي الذي كسر قبضة هتلر على أوروبا – وكسر رأسه أيضًا -، وإذا أضفنا مشهد القنابل النووية التي انتهت عليها الحرب ثم لحاق الاتحاد السوفيتي بأمريكا في السباق النووي عام 1949، كان العالم يشهد تغيرًا كاملًا ليس في موازين القوى العظمى وحسب، وإنما في النظام الدولي كله، الذي تحول من إمبراطوريات متنافسة إلى قطبين عالميين، لكن هذه الحقائق ليست سهلة الفهم دائمًا خاصة على دول مثل بريطانيا وفرنسا اللتين تعودتا دور الإمبراطورية طوال قرون، وبالتي جاءت التصرفات مناقضة تمامًا للحقائق.
جاءت أولى الأزمات في الجزيرة الكورية، فأثبتت الأحداث بما لا يدع مجالًا للشك أن الإمبراطوريات الكبيرة لم يعد لها القدرة – بعد إنهاكها في حربين عالميتين – وبالتالي المكان في القيادة الدولية، لكن ذلك لم يكن كافيًا خاصة لأن الجزيرة الكورية لم تكن تاريخيًا مركز الصراع الإمبراطوري.
ثم نشأت أزمة السويس عقب تأميم مصر للقناة، كانت الفرصة مواتية للعب الدور الإمبراطوري، وهكذا شنت بريطانيا وفرنسا و”إسرائيل” عملية عسكرية ضد مصر بغرض احتلال القناة وإعادة الأمور لنصابها القديم، لكن المشكلة لم تكن في مصر، بقدر ما كانت في النصاب القديم الذي ولى بغير رجعة! وهنا بالضبط واجهت الدولتان حقائق الواقع التي لم يكن من مفر منها، تدخل الاتحاد السوفيتي وأمريكا إلى جانب مصر، الاتحاد السوفيتي بتوجيهه الإنذار النووي الشهير لدول العدوان، والولايات المتحدة بتوجيه عقوبات اقتصادية للدول الثلاثة في حال لم تتوقف الحملة!
لم يكن ما فعله الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حبًا في مصر ولا كرهًا في “إسرائيل”، وإنما كان إثباتًا لحقائق القوة الجديدة، خاصة أن فرنسا وبريطانيا تصرفتا دون إذن أمريكي، كما قال الرئيس الأمريكي أيزنهاور!
لم يكن الحال الفرنسي مماثلًا للحالة البريطانية، إذ بقيت فرنسا تبحث لها عن دور إمبراطوري وإن كان بالخفاء
بالمقابل، كانت الصدمة كبيرة في كلتا القوتين، ربما تعرضت الدولتان لهزائم وحتى غزو في الحرب العالمية، لكنهما لأول مرة تواجهان حقيقة دور جديد لهما في العالم.
كانت الاستجابة البريطانية سريعة لكنها ربما الأغرب في التاريخ من حيث كونها الأكثر براغماتية واعترافًا بالدور الجديد كتابع لا قائد، إذ وقعت بريطانيا في مارس عام 1957 “اتفاق برمودا” مع أمريكا، الذي يقضي بتسليم نفوذ الشرق الأوسط للولايات المتحدة مقابل 400 مليون دولار – ما يعادل الآن 3.6 مليار دولار -، وكأن الدول مجرد بضائع على متن السفن يسلمها تاجر لآخر!
حيث جاء الاتفاق كما يلي: “التزام على تخفيض الالتزامات البريطانية وراء البحار”
1. إن الرئيس الأمريكي يعبر لرئيس الوزراء عن فهمه للضرورات التي تدعو الحكومة البريطانية لتخفيف أعبائها في الشرق الأوسط، وهو يتعاطف مع رغبة هذه الحكومة في جعل التزاماتها في المنطقة متوازنة مع مواردها الاقتصادية.
2. إن الرئيس أخطر رئيس الوزراء البريطاني بأن الولايات المتحدة لن تستطيع تحمل كل الأعباء التي ترى الحكومة البريطانية أنها مضطرة للتخلي عنها، ولذلك فإن الولايات المتحدة تأمل في أن تستمر الحكومة البريطانية إخطارها بخططها في المستقبل.
3. إن الرئيس سوف يتخذ كل الترتيبات التي تكفل استمرار التشاور مع الحكومة البريطانية في المسائل والحالات التي يتعين فيها استطلاع رأي الحكومة البريطانية وسوف يكون ذلك موضع الاعتبار.
4. الرئيس يعرب عن أمله في أن الحكومة البريطانية سوف تقوم بتخفيضات تدريجية ومنتقاة بما يوافق المصالح الغربية بصورة عامة ويتفق مع مطالب الأمن الضرورية للسلامة المشتركة.
5. إن حكومة الولايات المتحدة الامريكية سوف تقدم دعمًا ماليًا فوريًا للحكومة البريطانية بقيمة 400 مليون دولار!
فتش عن برنارد ليفي
لم يكن الحال الفرنسي مماثلًا للحالة البريطانية، إذ بقيت فرنسا تبحث لها عن دور إمبراطوري وإن كان بالخفاء في مستعمراتها السابقة حتى بعد عام 1956، ورغم أنها واجهت تدخلًا أمريكيًا فيما يمكن أن تعتبره نطاق نفوذها، كما حصل في تونس حين زودت الرئيس التونسي بورقيبة بالسلاح! ورغم أن فترة الرئيس شارل ديغول شهدت تحولًا في السياسة الخارجية ببناء القوة الداخلية والحصول على القنبلة النووية – قوة الضرب – كما كان يسميها، فإن من أخلفوه عادوا لنفس السياسة القديمة، التي لا يمكن إنكار أن الكثير من الدول العربية استفادت منها في ظل الاستقطاب العالمي الثنائي الذي كان سائدًا وقتها.
فالعراق استفاد كثيرًا بعد تأميم النفط، وخلال الحرب العراقية الإيرانية، بل ويمكن تفسير تقديم فرنسا لمفاعل نووي “أوزيراك” إلى العراق، ضمن هذا السياق الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الكبار بعبور الخطوط الحمراء وتغيير موازين المنطقة العسكرية بأكملها، إذ لا تنحصر العملية بتقديم منشأة نووية بقدر ما تتخطاه نحو تقديم التكنولوجيا نفسها التي يمكن أن تجعل من العراق ندًا لـ”إسرائيل” لاحقًا.
غير بعيد عن تلك الفترة، حاولت فرنسا توسيع نفوذها – أو إعادة تأكيده مجددًا – من خلال عملية نادي السفاري، التي لعب فيها مدير الاستخبارات الفرنسية الكونت دي مارانش دورًا مهمًا لقيادة عمليات عسكرية في إفريقيا مولتها السعودية، وشاركت فيها مصر والمغرب وإيران، تحت ذريعة مكافحة التمدد الشيوعي، حيث نفذت عمليات في كل من الصومال وزائير وإثيوبيا، ووسع نشاطاته لاحقًا ليشمل المقاتلين الأفغان خلال الحرب مع الاتحاد السوفيتي.
نظرة الدولة لنفسها والتصرف بناءً على ذلك، لا يعني بأي حال من الأحوال تحوله إلى حقيقة واقعة حتى لو كانت تلك السياسة صادرة من إمبراطورية سابقة
في تحقيق لها، تقول صحيفة الإنترسبت، إن الكونت دي مارانش، حاول من خلال صلاته في عملية نادي السفاري، التأثير على الانتخابات الأمريكية التي فاز بها رونالد ريغان عام 1980، وتورد تحقيقًا للكونغرس مع الكونت دي مارانش، يظهر خلاله إقناعه بعض قيادات الثورة الإسلامية الجديدة في إيران للاحتفاظ بالرهائن الإيرانيين، وهو ما كان موضوعًا رئيسيًا في تلك الانتخابات.
بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أوائل التسعينيات، أصبحت الفرصة مواتية لفرنسا للعب دور أكبر، فالمظلة الأمريكية أو الستار الحديدي الذي كان يحمي أوروبا من إمبراطورية الخوف لم يعد لها نفس تلك الأهمية والحجم السابقين، وبالتالي فالمتغيرات الجديدة تفرض نفسها على الساحة، وهكذا حاولت لعب أدوار أكبر تخترق الرغبة الأمريكية في عدة ملفات – دون تحقيق نجاح يذكر- منها: حصار العراق وحرب عام 2003 وحرب أفغانستان والملف النووي الإيراني واللاجئين، والأهم الربيع العربي.
فقد شكل هذا الأخير منطلقًا للولوج إلى الشرق الأوسط، منطقة نفوذها السابقة، وعمق أمريكا الإستراتيجي، وكان الظهور رسميًا أحيانًا، مثل مشاركة فرنسا بقوة في إسقاط القذافي لحجز مقعد في مرحلة ما بعد سقوطه أو ملف استقلال إقليم كردستان في العراق الذي لعب فيه برنارد ليفي دورًا مهمًا، وكذلك الدور الفرنسي في لبنان من خلال إيصال الجنرال ميشال عون إلى الرئاسة، وأخيرًا دورها في مساندة حفتر المباشر بالسلاح والمستشارين.
الملاحظ، أنه ورغم التحركات الفرنسية الكبيرة، لم يكن تأثيرها فعالًا إلا في الحالات التي غضت أمريكا الطرف عنها أو شاركت فيها – مثل نادي السفاري والحرب الأهلية اللبنانية -، عدا عن ذلك لم يكن حجم التأثير الفرنسي يعدو حجم دولة إقليمية، لا أدل على ذلك من الأزمة الأخيرة في المتوسط، التي اكتفت فيها فرنسا بالشكوى الإعلامية مما دعته التوسع التركي ذي المنطلقات الإسلامية والقومية.
لكن السؤال الأهم: لماذا تستمر فرنسا في هذه السياسة عكس بريطانيا؟
في كتابه “أطلس الإمبراطورية البريطانية” يعزو الكاتب البريطاني تشارلز بايلي هذه السياسة إلى نوع الاستعمار الفرنسي السابق نفسه، إذ يقول: “كانت الإمبراطورية الفرنسية تختلف في كونها تربط المستعمرات بالمركز باريس، في حين كانت المستعمرات البريطانية تحصل على قدر أكبر من الاستقلالية، حتى قادة تلك المستعمرات العسكريين أنفسهم، كانوا يختلفون في صلاحياتهم بين الإمبراطورية الفرنسية والبريطانية”.
عالم الاجتماع البريطاني ورئيس قسمه في جامعة فرجينيا كريشان كومار يؤكد هذه النظرية، ويضيف إليها دلالة اللغة، حيث يقول: “مثل نشر اللغة الفرنسية دلالة مهمة في ربط المستعمرات بالمركز ربطًا ثقافيًا، فاللغة هوية قبل أن تكون وسيلة تواصل، وفي الوقت الذي انحسر فيه الاستعمار الفرنسي عن تلك البلدان، ظل الباب الثقافي مفتوحًا لفرنسا تدخل منه وقتما تشاء، وهو ما يمكن مشاهدته بوضوح في البلدان الإفريقية”.
إن نظرة الدولة لنفسها والتصرف بناءً على ذلك، لا يعني بأي حال من الأحوال تحوله إلى حقيقة واقعة حتى لو كانت تلك السياسة صادرة من إمبراطورية سابقة حكمت لعشرات السنين، ورغم أن الدور الفرنسي في كل فترات ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، كان ينجح تحت المظلة الأمريكية ويفشل فيما سواه، لا تزال الكثير من الدول العربية تمارس سياسة الانبطاح أمام فرنسا وكأنها ذلك العملاق الذي حكم المنطقة، في حين أن دولًا أخرى قد لا تملك موارد الدول العربية ولا موقعها الإستراتيجي، لا تعامل فرنسا إلا في المكان الذي تضعها إمكاناتها وقدرتها فيه: عضو عادي يستظل بمظلة الناتو الأمريكية.. واسألوا تركيا!