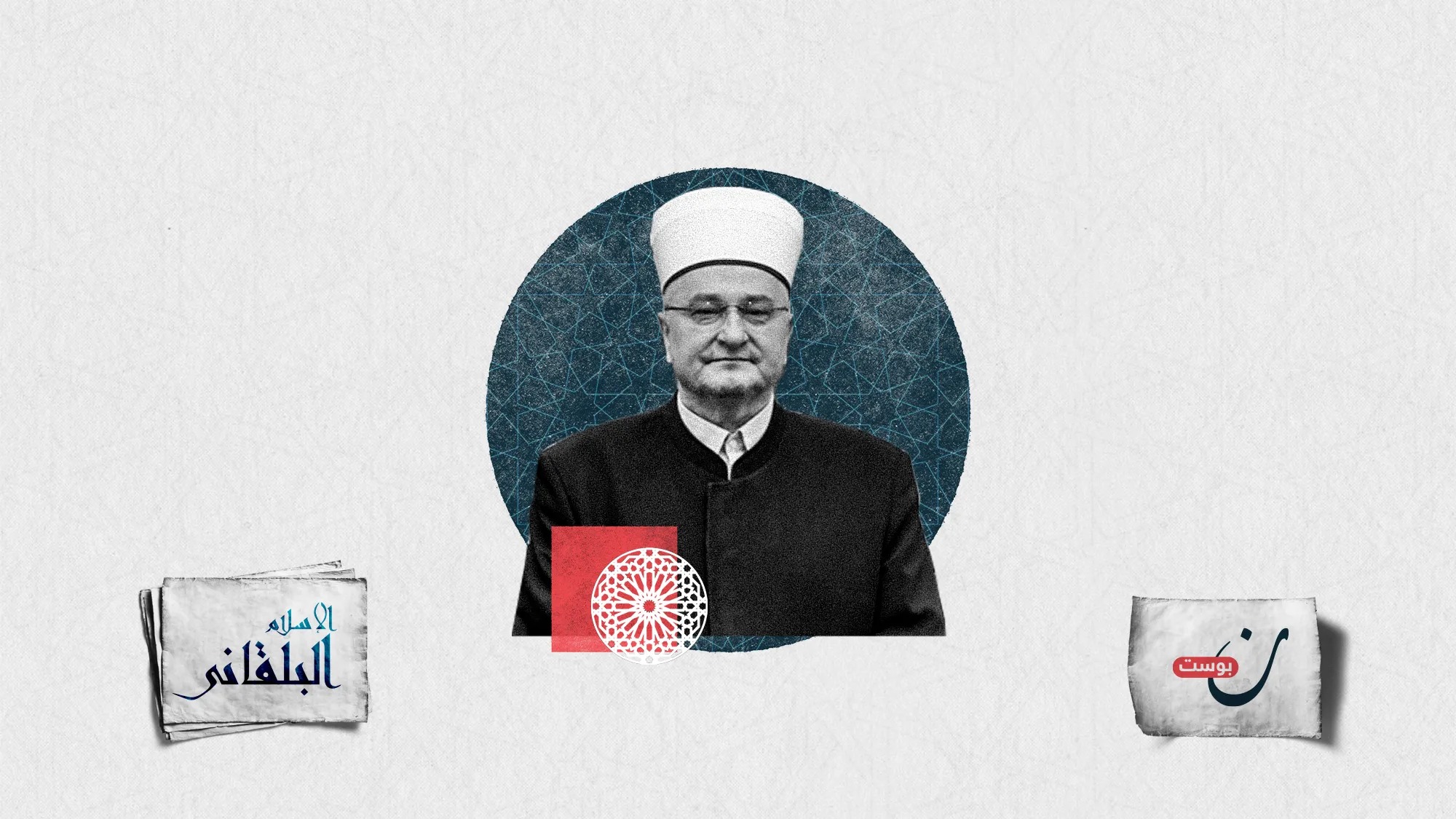ترجمة وتحرير: نون بوست
في الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مبادرة “تاريخية” تتمثل في إنشاء مجلس رسمي للأئمة لإضفاء الطابع الرسمي على دور رجال الدين. تعمل الدولة العلمانية الفرنسية، والتي بررت فرضها الرقابة على جميع المظاهر العامة للهوية الإسلامية باسم العلمانية، على إنشاء سجل رسمي للأئمة المسلمين.
سيعمل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إلى جانب وزارة الداخلية، على وضع المعايير القانونية للممارسات الدينية لحوالي خمسة ملايين مسلم في فرنسا. وسيتعين على الأئمة التوقيع على “ميثاق قيم جمهورية” يتضمن مادتين أساسيتين على الأقل تمنعان الإسلام السياسي و”التدخل الأجنبي”. بذلك، سينتهي التمويل الأجنبي الذي وفر حتى الآن، بموافقة الحكومة الفرنسية، الوسائل اللازمة لتمويل المساجد وموظفيها، لصالح نموذج جديد وهو الإسلام الفرنسي.
يأمل ماكرون أن يبلغ النجاح الذي فشل أسلافه في تحقيقه ويتمكن من إحياء هذا الحلم السياسي المتمثل في صياغة نسخة من الإسلام خاضعة سياسيًا ومتوافقة اجتماعيًا؛ إسلام دون قوة تُذكر، بإمكانه أن يدمج معتنقيه المحرومين في جمهورية تستحقر هويتهم الدينية بشكل منهجي، حيث يقول ثلثا المسلمين الفرنسيين إن دينهم يُنظر إليه بنظرة سلبية.
تسجيل الأئمة ما هو سوى جزء من حملة أوسع شنّها ماكرون لمواجهة “الانفصالية الإسلامية“. لكن لماذا قد يكون “الإسلام الفرنسي” أكثر مرونة من الأشكال الأخرى؟ ليس الإسلام دينًا مركزيًا يمكن التحكم فيه بكلمة زعيم واحد، كما ينبغي للمرء عدم افتراض أن تقاليد الثورة والمعارضة الفرنسية لا ولن تؤثر على الممارسة المحلية للشعائر الإسلامية، حيث يمنح كل من التاريخ الفرنسي والمبادئ الإسلامية الأولوية للعدالة الاجتماعية.
من بين حوالي 2500 مسجد في فرنسا، لم يصوت 1100 مسجد في آخر انتخابات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
فضلا عن ذلك، هناك نوع من المفارقة في هذا المقترح الأخير. فالأئمة مسؤولون عن إقامة الصلاة. بينما يقدم علماء الدين الإسلامي أو الفقهاء المضمون الأخلاقي للدين، إلا أنه لا وجود لخطط “لإضفاء الطابع الرسمي” عليهم.
كما أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بحد ذاته يتكون من اتحادات تتلقى تمويلًا أجنبيًا، وعلى الرغم من أنه قد شُكل من قبل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في سنة 2003 ليكون وسيطًا بين المجتمعات المسلمة في فرنسا والحكومة، إلا أن المجلس سُئل عن شرعيته.
من بين حوالي 2500 مسجد في فرنسا، لم يصوت 1100 مسجد في آخر انتخابات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وبغض النظر عن سعي ماكرون لممارسة السيطرة على هذا المجال، إلا أن المسلمين الذين يرغبون في طلب الإرشاد الديني خارج نطاق المجلس سيكونون قادرين على القيام بذلك تماما.
مشهد استعراضي
كما يشير الإمام الفرنسي طارق أوبرو، فإن الاتحادات التي يتألف منها المجلس منظمات علمانية وليست دينية؛ ما مؤهلاتهم لتكوين الأئمة في علم أصول الدين؟ والأسوأ من ذلك، ما هي نسخة الإسلام التي سيعملون على إضفاء الطابع الرسمي عليها؟ هل ستكون تلك التي حصلوا عليها من الحكومات الأجنبية الاستبدادية التي تمولهم؟ كيف لذلك أن يكون إسلاما فرنسيا؟
هل سنشهد تكرارًا لمبادرة الرئيس السابق فرانسوا أولاند لسنة 2015، عندما أرسل أئمة فرنسيين للتدريب في المغرب لإعادة “الإسلام الفرنسي” إلى الوطن؟ تتخذ معظم جوانب هذا المشهد طابعا استعراضيًا، قد تم تصميمه لطمأنة الناخبين بأن ماكرون مسيطر على الوضع. ولكن ما هي المشكلة بوجهة نظره بالضبط؟
صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس في السابع من شهر كانون الأول/ديسمبر.
إذا كان الرئيس يريد حقيقة تطوير “إسلام فرنسي”، وهو أمر يرحب به العديد من المسلمين الفرنسيين بلا شك، أليس من الأجدر إشراك المسلمين الفرنسيين، بدلاً من تنفيرهم من خلال التعامل مع منظماتهم الدينية كما لو أنها خطرََا أمنيََا؟
إن فكرة جمهورية فرنسية معرضة لهجوم أيديولوجي من أقلية مسلمة عنيفة هي من نسج خيال اليمين المتطرف، ومع ذلك فقد استسلم ماكرون لهذه الرؤية. وأصبحت أسطورة صراع الحضارات، التي طالما روجت لها الجبهة الوطنية، سياسة بعد أن تبناها “ليبراليون” يتنافسون على الأصوات.
تذكرنا نظرية “الانفصالية الإسلامية” بالسياسة المحافظة الجديدة المناهضة للإرهاب والتي تم طرحها في المملكة المتحدة في سنة 2010. وتعتبر نظرية “الحزام الناقل” أن الأيديولوجيا هي”النذير الرئيسي للتطرف العنيف”. ودحضت مذكرة لجنة مجلس الوزراء التي تم تسريبها في ذلك الوقت هذه النظرية، وأشارت إلى أنها تمنح “وزنًا مبالغ فيه للعوامل الأيديولوجية“، ومع ذلك، لم يتم فقط تكريس هذه النظرية في إستراتيجية “المنع” المتنازع عليها بشدة في المملكة المتحدة، ولكن هناك نموذج فرنسي لهذه النظرية المنقوصة يظهر أنها تدعم أحدث مشروع قانون لماكرون بشأن “الانفصالية الإسلامية”.
تمجيد الإرهاب
إن أحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق في مشروع القانون، والذي يهدف إلى تحرير الإسلام في فرنسا من “التأثيرات الخارجية”، إدراج الأفراد المدانين بتهمة “تمجيد الإرهاب” إلى قائمة رصد الإرهاب، آليا. وبما أنه تم التحقيق مع مئات الأشخاص، بما في ذلك أطفال لم تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، بتهمة “تمجيد الإرهاب”، فإن مشروع القانون يخاطر بتجريم جيل من المسلمين وذلك لسلوكاتهم المعارضة. وأحيانا قد يكون لأعمال تهور يقوم بها بعض المراهقين الذين يرفضون مثلا إزالة القبعة والسماعات خلال دقيقة صمت، مضاعفات قد تغير حياتهم.
هل نصدق أن هذه السياسة يمكن أن تقلل من الاستياء إزاء الدولة وأن تحسن الأمن؟
ستخضع مؤسسات المجتمع المدني الفرنسي، من مساجد ومنظمات رياضية، بدورها وبحسب مشروع القانون، لرقابة حكومية أكثر صرامة، مع منح السلطات المحلية حرية أكبر لإغلاقها على أساس تصرفات أحد أتباعها، بقطع النظر عما إذا كان هذا الشخص يشغل مناصب قيادية داخل هياكل الجمعية.
بدأت الحكومة الفرنسية بحلّ بعض منظمات المجتمع المدني بموجب مرسوم بما في ذلك جمعية خيرية إسلامية بارزة، وهي جمعية “بركة سيتي“، وجمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” وهي كذلك جمعية بارزة في مجال حقوق الإنسان وصفها وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأنها “عدو للجمهورية“. وقد قام بذلك دون أي دليل عن وجود سلوك غير قانوني، وهو بمثابة تحذير شديد اللهجة للمسلمين الفرنسيين الساعين إلى تأكيد حقوقهم. ومن جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية عمليات الإغلاق بأنها “نيلا من حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
دعامة الهوية الفرنسية
ينبني المبدأ الدستوري الفرنسي للعلمانية على الحياد الديني الصارم للدولة والمؤسسات العمومية، ويمثل أحد أعمدة الهوية الفرنسية. لكن هذا القانون الجديد يقترح تعديل هذه الركيزة التاريخية من خلال تحويلها من شكل من أشكال الحماية القانونية للدولة إلى نوع من الإكراه السياسي.
تواجه فرنسا بلا شك تهديدًا إرهابيا، لكن الإجراءات الحالية تهدد بتعريض أسس الجمهورية ذاتها للخطر، مع “تشريع” العداء الكامن تجاه المسلمين. وقد يكون إرث ماكرون مكرسَا في القانون.
المصدر: ميدل إيست آي