ترددت كثيرًا قبل أن أدون هذه الكلمات، فالثورة ليست مجرد حدث مرت عليه عشر سنوات، لكنه تحول كامل في تاريخ شعب، ما زالت المحاولات مستمرة لتشويهه، لكنه محفوظ في قلوب وعقول ثواره.
بالنسبة لي لم تبدأ الثورة إلا يوم 28 يناير، فهو اليوم الفاصل وما جاء بعده ليس كما كان قبله، كأم لطفلة عمرها 9 أشهر في ذلك الوقت، لم يكن متاحًا لي التظاهر في الشوارع والتعرض للغاز المسيل للدموع فضلًا عن الركض هربًا من البلطجية.
لم يكن أمامي إلا متابعة الأحداث والأخبار على التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالطبع ما يحكيه زوجي عندها أهاتفه، كانت مشاعري متناقضة في ذلك الوقت ما بين فخر بما يحدث وقلق شديد عليه.
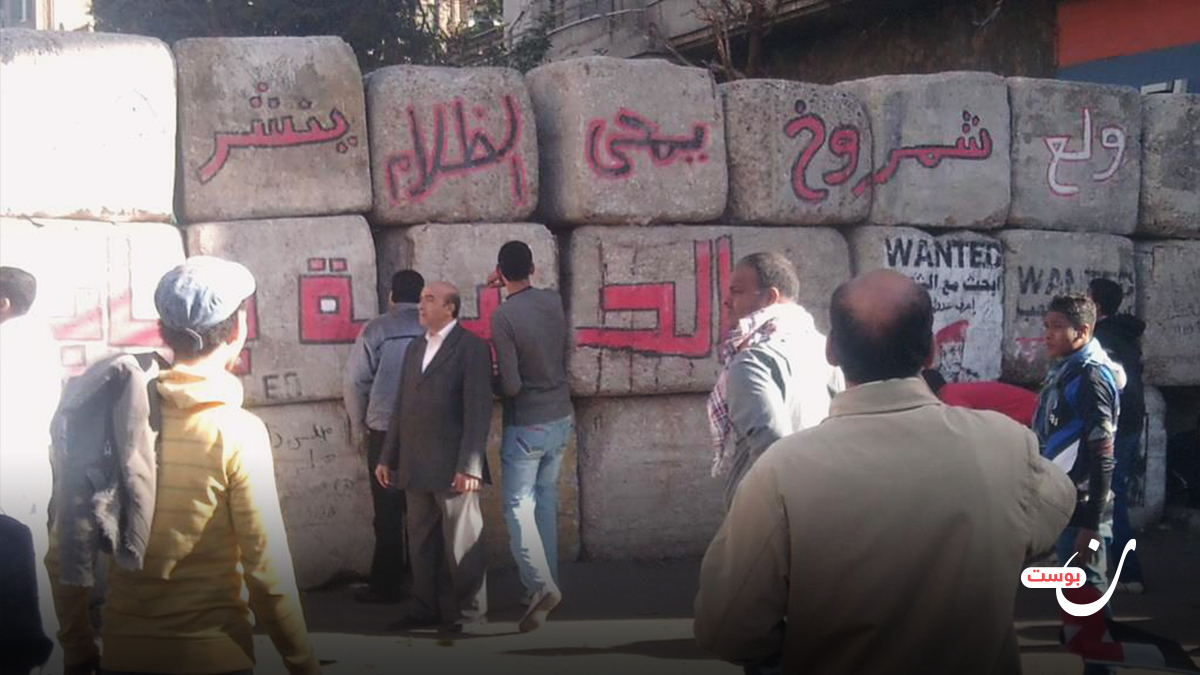
في صبيحة جمعة الغضب يوم 28 يناير، انقطعت شبكات الهاتف المحمول وكذلك الإنترنت وانقطعت معهم أي أخبار، ولم يكن أمامنا إلا مشاهدة الأخبار والمقاطع التي تبثها القنوات الفضائية، كان القلق سيد الموقف خاصة مع انتشار الأخبار عن الصدام القوي بين قوات الشرطة والمتظاهرين ووقوع الكثير من الإصابات في صفوف المتظاهرين، فقد جن جنون الشرطة من استمرار التظاهرات لليوم الرابع على التوالي دون انقطاع.
كنت أشعر ببعض السكينة طوال اليوم حتى أذان العشاء إذ شعرت بوخزة في قلبي وبدأت في البكاء، لم أدر ما أصابني ولم أتمكن من التوقف عن البكاء، هاتفتني صديقتي لتخبرني أن زوجها هاتفها من أحد الخطوط الأرضية ليخبرها أنه بخير وأنه رأى زوجي قبلها بساعة وكان بخير.
شكرتها كثيرًا لكن الخبر لم يفلح في تهدئتي، استمر قلقي طوال الليل حتى إنني كنت أمسك الهاتف كل نصف ساعة محاولة الاتصال به أملًا في عودة شبكات الاتصال للعمل، لكنها ظلت مقطوعة حتى الساعة العاشرة من صباح 29 يناير عندما رن جرس الهاتف بعد صمت طويل ومؤلم.
أسرعت بالرد لأجد صوته عبر الهاتف يخبرني أنه فقد عينه، لم أصدقه وأخبرته أن يكف عن المزاح فأنا قلقة عليه منذ الأمس، لكن صوته أكد لي مرة أخرى أنه لا يمزح، فهو في مستشفى القصر العيني منتظرًا دوره لدخول غرفة العمليات، كما لم يكن وحده هناك، فثمة أكثر من 150 إصابة في قسم العيون وحده ذاك اليوم.
خرجنا من المستشفى لتبدأ رحلة من العلاج استمرت لأكثر من 5 سنوات، لكن أثر الثورة يأبى مغادرته ليستقر في عينه اليمنى إلى الأبد وسامًا وفخرًا
ونظرًا لأننا نسكن في مدينة أخرى بعيدًا عن القاهرة، فقد وصلت إلى المستشفى وأنا أحمل ابنتي بعد خروجه من غرفة العمليات، أسرعت لرؤيته في عنبر العيون ولم يكن قد استيقظ من المخدر بعد، لكن مجرد رؤيته منحتني الطمأنينة والثقة.
كان جل ما أخشاه أن يكون قد أصابه اليأس أو أن تتحطم معنوياته جراء الإصابة، لكنه كان صلبًا وواثقًا كعادته، ما منحني الكثير من الراحة والفخر، وحينما سألته عن وقت إصابته أخبرني أنها كانت عند صلاة العشاء.
أمضينا الليلة في القصر العيني وعند منتصف الليل حاول البلطجية دخول المستشفى وتحطيم المكان، ما زالوا يبحثون عن الثوار رغبة في إيذائهم، لكن الممرضات وكل مرافقي المرضى أمسكوا بكل ما تطاله أيديهم لصد العدوان وحماية المرضى حتى تمر الليلة بسلام.
كان العنبر الواحد يضم أكثر من 15 مصابًا ممدين على الأسرة، بينما يجلس مرافقوهم على الأرض بجوارهم لازدحام المكان، وعندما شعرت إحدى الأمهات بالأسى على ابنها ذي الـ17 عامًا الذي فقد عينه، أخبرتها الأخرى أن ابنها بطل ويجب أن تفخر به، كانت هناك حالة من التكاتف والتراحم تملأ المكان.
في اليوم التالي خرجنا من المستشفى لتبدأ رحلة من العلاج استمرت لأكثر من 5 سنوات، لكن أثر الثورة يأبى مغادرته ليستقر في عينه اليمنى إلى الأبد وسامًا وفخرًا.
ربما لم أتمكن من المشاركة في الثورة بجسدي، لكن بعضًا مني كان هناك، وقلبي كان مؤمنًا بها منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا، ربما لم أذهب إلى ميدان التحرير وأجري مع المتظاهرين وأستنشق الغاز المسيل للدموع، لكن روحي كانت تطوف هناك كأنني بينهم.
بعد عشر سنوات من الحلم، ربما لم يبق لنا إلا الألم والمرارة، وربما بعض الغضب واليأس، والكثير من الجراح غير المندملة والظروف العصيبة، لكننا لم نفقد إيماننا بالثورة، لقد كانت الثورة هي الحقيقة الوحيدة، كانت أصدق ما عاشه جيلنا وستظل البوصلة دائمًا حتى يؤمن بها الجميع ويتوجهون إليها.
يقولون إن التاريخ يكتبه المنتصر، لو كانت المقولة على حق فقد انتصرنا بالفعل وكتبنا التاريخ بأحرف تتلون بدماء الشهداء، سيظل هذا التاريخ راسخًا ما حيينا وسنورثه لأبنائنا حتى يأتي اليوم الذي يتحقق فيه الحلم كاملًا.









