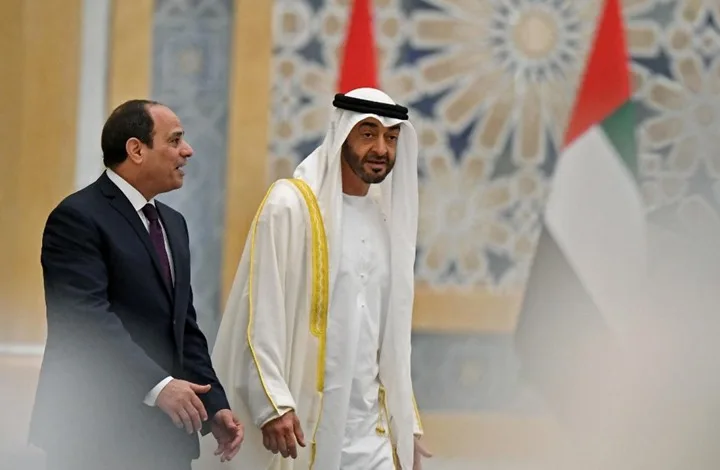في العام الماضي، لم يتوقع أي من النقاد أو الجماهير الاكتساح الذي أحدثه فيلم “طفيلي” لجوائز الأوسكار، ليس لأن جوائز الأوسكار تحمل منهجية معينة في التعامل مع الأفلام – رغم أنها تفعل ذلك – خاصة الأجنبية منها، بل لأن فوز فيلم من إنتاج كوريا أو أي دولة أخرى، يحمل في داخله أمارات انهيار ويشي بانحلال أنظمة إنتاجية كاملة وآمنة.
هذا التهديد ليس كافيًا ليخفض معدل شباك التذاكر، رغم أنه تلميح لكارثة انخفاض مستوى السينما الأمريكية لدرجة تسمح لفيلم من شرق آسيا أن يفوز بأربع جوائز في حفل المواطن الأمريكي المفضل، وعليه فهي رسالة شديدة اللهجة أن صناعة السينما الأمريكية في خطر على المستوى الإبداعي، إذ ثمة خلل في الطاقات المحلية التي تنتجها مدارس السينما أو حتى الطاقات اللاجئة لهوليوود بقيمتها المهنية الكبيرة، فجوائز الأوسكار تعطي قيمةً فنيةً بالإضافة لرفع إيرادات شباك التذاكر بشكل يجعل بعض شركات الإنتاج تضع الجائزة في الحسبان قبل بداية عملية صناعة الفيلم نفسها.
هذا الفيلم – الطفيلي – وبضعة أفلام أخرى شيدت جسورًا بين السينما الأمريكية – أو كما يمكننا أن نقول بين الجمهور الأمريكي الذي يكره شريط الترجمة – وأفلام بلغات مختلفة، ويقول المخرج بونج جون هو عن تلك النقطة: “كسر الناس حائل شريط الترجمة بالفعل من خلال خدمات البث ومنصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو التي تبث عليها. أعتقد أننا جميعًا متصلون، في البيئة التي نعيش بها حاليًّا”.
عمم الوضع وتكشفت الأمور بعض الشيء، ما دفع بعض شركات الإنتاج أن تضع ثقتها بمخرجين أجانب ليس لهم الرصيد الكافي عند الجمهور، ليس هذا فقط، بل الخطوة الأهم هي إنتاج أفلام بلغات أخرى، تمولها شركات إنتاج أمريكية بشكل كامل، وهذا ما حدث مع فيلم Minari الذي تم إنتاجه بأموال أمريكية لكن بجهود كورية أو أجنبية كاملة، ليشارك في موسم الجوائز ويحصد عدد ترشيحات لا بأس بها من جوائز أمريكية عريقة.
بل يمكننا القول إنه كان مفاجأة سعيدة في موسم الجوائز بعد حصوله على ستة ترشيحات كاملة للأوسكار ومثلهم من البافتا، هذا تحت تأثير مفعول فيلم Parasite بجانب استفحال الموجة الملونة، حاملةً هذا النوع من الأفلام من الأعماق نحو السطح، ليس لأنه ذا جودة ممتازة في صناعته، بل لأنه مفيد للقضية – نبذ العنصرية – بشكل عام، ويمكن رؤية تأثير هذه الموجة في السيل العارم من الانتقادات التي وجهت لجائزة الغولدن غلوب لعدم ترشح الفيلم في أي فئة – رغم أحقيته في رأيهم – إلا فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية، رغم فوزه بالأخيرة.
صنع المخرج لي آيزيك تشونغ فيلم Minari بميزانية ضئيلة تقدر بنحو مليوني دولار فقط، يقول المخرج إنهم كانوا يملكون القليل من المال، لذلك لم يستطيعوا تصوير المشاهد بترتيبها الطبيعي في السيناريو، وكان عليهم أن يتكيفوا مع الوضع.
لكن رغم ذلك تم تصوير الفيلم في 25 يومًا فقط، والجدير بالذكر أن جميع المشاهد التي تضمنت جدول المياه، تم تصويرها في يوم واحد، وهذا ما أقصده بكلمة ميزانية ضئيلة، وما تتضمنه من ظروف يجب أن يتعامل معها المخرج، لكن من النظرة الأولي للفيلم، يمكننا تذكر فيلم “طفيلي” بشكل مشوه، بيد أنه يمكننا تذكر سينما مخرجين يابانيين هما: هيروكازو كوري إيدا والرائع ياسوجيرو أوزو بسهولة كبيرة.
جميعهم ينزعون للواقعية السردية والإحاطة الكاملة بدراما العائلة/الأسرة داخل الفيلم والمشاكل الاجتماعية التي تفككها الصور بطريقة ممتازة، ويحاولون إقحام شخصياتهم في اختيارات أخلاقية، ويتشارك مع أوزو في اختفاء مركزية الجنس في أفلامه بشكل واضح – أقصد في فيلم Minari خصوصًا – ويلعب على العاطفة والشعور بالمسؤولية كمشرع للأفعال، بجانب الميزانية الضئيلة التي تلاحق هذا النوع من الأفلام لتضفي عليه رونقًا بسيطًا وخفةً محببةً.
والحق أن بعض من الجيل السينمائي الجديد ذو الجذور الآسيوية في الولايات المتحدة، لا يزال يحتفظ بنصف هويته الشرق آسيوية، ويتضح ذلك من خلال تجاربهم الفيلمية وطريقة أفلمة أفكارهم، آخر هذه التجارب فيلم The Farewell للمخرجة لولو وانغ، الذي يتسم بنفس الظروف الإنتاجية تقريبًا ويحمل نفس ثيمة القصة التي تدور حول الأسرة، ونفس الأجواء الخفيفة لكن الموترة والكوميديا السوداء.
ذاتية الفيلم
لكن هذا ليس ما دفع لي آيزيك تشونغ لكتابة فيلم Minari، بل بعض من النوستالجيا، فقد تعرض المخرج تقريبًا لنفس الظروف، هاجرت عائلته من كوريا نحو الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، بدأ لي كتابة الفيلم في بضعة أشهر قبل أن يبدأ عملًا بدوام كامل، حاول أن يستلهم الحكايات، ووجد نفسه لا إراديًا ينغمس في ذاته، في ذكريات لم يجدها من قبل في رأسه، بيد أنه توغل أكثر وابتغى من نفسه أكثر من مجرد صور عابرة، حتى بلغ أعمق الذكريات، أشياء مشوهة في رأسه، نصف حكايات، يذكر جدته ووالديه، وجدول المياه.
لذلك فالفيلم مثل كثير من أفلام السيرة الذاتية غارق في الذاتية، إنما حاول المخرج أن يعزل نفسه بعض الشيء عن ذكرياته في الحكي، أن يتصرف بمعزل عن وجهة نظره، ويطور حكاية تحمل وجهة نظر جماعية، يتشارك فيها البعض.
وهذا ما قاله المخرج في لقاء مع المخرج الكوري بونج جون هو، عندما أخبره الأخير بإعجابه بالفيلم، ووضح له نقطة قوة، أنه لم يذب بين أذرع الحنين للماضي، لم يفقد نفسه داخل شخصيته الحقيقية، التي مثلها الطفل آلان كيم بسحر ولطافة، فكان من الممكن أن تقص الحكاية من وجهة نظر الطفل الذي يمثل المخرج، بيد أنه تخلى عن تلك الفكرة في مقابل إعطاء نوع من الشمولية في حكايته، أن يقص حكاية عائلة كاملة، مديرًا الكاميرا ليلتقط خيبات أملها وأفراحها، لهذا ضمن المخرج جميع أفراد أسرته في الفيلم، ولخص تجربة كاملة متكررة، عاشتها العديد من العائلات وقتها.
الحلم الأمريكي
في ثلاثينيات القرن الماضي، عقب إعلان الاستقلال الأمريكي، ظهرت موجة من الأقاويل التي تصف مدى رحابة الولايات المتحدة وتشدد على نظام أخلاقي صارم يسوده العدل والمساواة بين الخلق، وعليه تردد صدى جملة كانت تختزل كمية هائلة من الأماني والطموحات، وتفشى صداها في أجواز الفضاء العالمي، إنها “الحلم الأمريكي”.
تحورت الكلمة لتنقلب رمزًا لكل ما هو جميل، وأضحت محفزًا لطموحات وأحلام الكثير من الشباب في العالم، لتصبح أمريكا بما تمتلكه من إمكانات هائلة ومساحات شاسعة وخلق متباينة، مدينة الأحلام، إلا أن الكلام سهل، والحقيقة لم تكن كذلك، لكن هذا ليس موضوعنا الرئيسي، لكن وجب ذكره، لأن بعد ذلك استفحل مصطلح الحلم الأمريكي ليصور للبعض على أنه جنة على الأرض.
وهذا ما دفع الكثير من الأسر للهجرة إلى الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، إنها بلد الفرص، ومنهم عائلة المخرج التي هاجرت في أواخر السبعينيات تقريبًا، ويكبر الفتى على أرض أمريكا مقدرًا له أن يكتب فيلمًا عن حياته.
تناول الفيلم مصطلح الحلم الأمريكي بشكل مبطن، فالمهاجرون يرغبون في حياة أفضل، وهذا ما حدث في الفيلم، لكن من الوهلة الأولى نرى الخلاف الواضح بين شخصيتي الأب جاكوب الذي يؤدي دوره ستيفن يون، والأم مونيكا التي تؤدي دورها هان يي ري.
تسعى الأم لحياة أفضل في حدودٍ مريحة، تسعى للمكوث في المنطقة الدافئة، لا تريد أن تغامر بالمال والجهد في مكانٍ ربما تخسر فيه كل شيء، لذلك في اللقطة الأولي، تبدو الأم عابثةً وتفتح مجالًا للتفكك الأسري وتعطي انطباعًا أوليًا لمسيرة الحكاية، أما الأب فهو مغامر من الدرجة الأولى، يمثل إيمانًا جارفًا بالحلم الأمريكي، بشكل يسيطر على أفعال شخصية جاكوب، ويجعله يتصرف بمعزل عن إرادته.
الطموح الجائح الذي يستقوي به جاكوب على الحياة، يسطو على قداسة العائلة التي كانت تتسم بها المجتمعات الشرق آسيوية في ذلك الوقت، تنبئ الميلودراما بين الزوجين بتفكيك المقدس، طموح هائل وأحلام مستباحة تدفع الأب للعمل في المزرعة مخاطرًا بماله وبابنه الذي – خلال أحداث الفيلم – يتكشف لنا أنه يعاني من ثقب في القلب، والمزرعة التي يعيشون فيها تبعد عن أقرب مشفى مسافة ساعة كاملة، وهذه فرصة ضئيلة للنجاة إذا حدث شيء للابن الصغير.
يصطحب جاكوب عائلته من كاليفورنيا نحو الجنوب الأمريكي، لولاية “آركانسا” على وجه الخصوص، منطقة شبه نائية يرى فيها جاكوب أحلامه وهي تتراقص أمامه، لون التربة ينبئ بمحصول وفير، يستغل جاكوب أن ثلاثين ألف مواطن كوري يهاجرون إلى أمريكا كل عام، معتمدًا على حدسه ومعاشرته لأهل بلدته، يرى أن مواطنيه يحبون المحاصيل المزروعة على الطريقة الكورية، لذا سيزرع بالطريقة التقليدية، ويبيع للناس التقليديين.
يشترى منزلًا من الخشب، يشبه كابينة سيارة، يعيش فيه مع أولاده وزوجته، ويباشر مشروعه من اللحظة الأولى، بحماس متوهج وقلب مفتوح على الحياة الجديدة، يتمكن هو وزوجته من الحصول على وظيفة في مصنع فرز دجاج، حيث يفرزون الفراخ الصغيرة، يحتفظون بالإناث ويتخلصون من الذكور.
وهذه النقطة تلميحًا بتهديد واضح لرب العائلة، حيث إن – في أغلب الأحيان – العائل ورب الأسرة يكون ذكرًا مسؤولًا، وتنذر تلك التلميحات بخطرٍ يداهم المرء إذا فشل في الوصول إلى القيمة المطلوبة، من الممكن أن تتلاشي فيه ذاته وقيمته، يشي ذلك الإنذار بانفراط عقد العائلة، المتمثل في الأب.
يشعر جاكوب بالخطر يداهمه دائمًا، مجرد التفكير في احتمالات الفشل يزعجه، وزوجته دائمة التذكير بخطر الفشل، لا تملك نفس روح المثابرة، تبطن حديثها بواقعية روتينية معهودة، لماذا لا نبقى مثل بقية البشر؟ طموحٌ خطيرٌ يداهمنا، لكن الحق يبدو كله معها.
يتضح بعد ذلك أن جاكوب صرف الكثير من المال على أسرته في كوريا – والده ووالدته وأخوته – لكي يؤمن لهم مستقبلهم، وذهب إلى أرض الأحلام وهو متحرر من كل مسؤولية حولهم، يتعارك الاثنان بالكلمات، يلقيان بعضهما بكلمات جارحة، لكن لا يأبه جاكوب لزوجته، يبدأ العمل، يحضر جرارًا زراعيًا مستعملًا، ويستأجر بول الفلاح المطارد بخيالاته.
بعدها تستدعي مونيكا أمها/الجدة التي يقول عنها المخرج إنها لا تشبه جدته في أغلب الصفات، لا في طريقة الكلام أو الشكل، لكن بحضور الجدة تنتقل مسؤولية العائلة من الأب – الذي ينشغل بأرضه وعمله – إلى الجدة، التي تهتم بالأولاد وتحاول إبقاء العائلة مترابطة بأكثر من طريقة.
تزرع الجدة نبات يسمى ميناري – نفس اسم الفيلم – وهو نبات يشبه الجرجير أو الكرفس، وتتركه ينمو في الجدول، له قدرة سحرية على التأقلم وإعادة دورة حياته، نجد أن هذه النباتات تعطي الجدة نوعًا من الطمأنينة، كأنها أحاطت نفسها بجزء مهم من ثقافتها يذكرها ببلدها، لن تشعر بالاغتراب بعد الآن، بجانب أن النبات ينمو وحده في جدول المياه، فكانت تصحب الصغير معها لتذكره بضرورة ذلك النبات لتؤكد أن هذا الصغير انعكاسًا للنبات، سينمو وحده من خلال التجارب، وأن الزوج سينجح عاجلًا أو آجلًا بقليل من الصبر.
الدين والخرافة
عند معرفة جاكوب بالفلاح بول يعرض عليه العمل معه ويعطيه ورقة نقدية كورية من أيام الحرب العالمية الثانية، وهنا تبدأ شخصية بول بالظهور، شخصية مهزوزة، تتلعثم بالكلام، ترطم دائمًا بما يشبه التواشيح الدينية، للوهلة الأولي يشعر المشاهد أن هذه الشخصية مرت بالكثير من الصعوبات والمخاطر، انعكس ذلك بشكل واضح على أفكارها وأفعالها، بجانب حضور الخرافة في حياتها، لكن هذا منطقي، الإيمان بالإله يلزم بالضرورة الإيمان بالشيطان.
يفرض بول على نفسه أعمالًا شاقةً، فيذهب كل يوم أحد، ويحمل عرق خشب على هيئة صليب، ويجره على طول الطريق حتى النهاية، كأنه يفرض على نفسه عقوبة ليكفر عن ذنب اقترفه من قبل، سواء في الحرب أم في مكان آخر، فعندما مكث الصغير دافيد مع صديقه، قال له والد صديقه إن المزرعة شبه مسكونة، تجلب سوء الحظ، فآخر مالك لها قتل نفسه، وهذه الظروف كلها تكثف لحدث، وآخرها الجلطة التي أصابت الجدة وأصبحت ترى أشباحًا في الغرفة، وجاء بول ليفعل ما يشبه طرد الأشباح من الغرفة.
هذا حضور واضح للخرافة يشي بذروة تهبط من السماء مثل عقاب لمالكي أرض ملعونة، يفرش المخرج لحدث أعظم في النهاية، فالإشارة للكنيسة في الفيلم توحي بأهمية الحياة الدينية في ذلك الوقت، وردود الفعل هناك توحي بتعلق الأم بالشخصية المسيحية كشيء مخلص من كل الآلام، بينما يظهر الأب بمظهر الشخص العملي معظم الوقت.
ثيمة الوطن والعائلة
طور المخرج علاقة مهمة بين العائلة والمكان، خصوصًا الأب الذي تظهره الكاميرا في بعض من المشاهد وحيدًا في الخلاء يفلح في الأرض، لدرجة تشعر المشاهد بمدى أهمية الأرض، هناك بعض الجمل الثقيلة جدًا، التي من الصعب أن يقولها إنسان، وتشير بماهية العلاقة بين أرضٍ يعتبرها وطنًا يعانقه، لقد تم تصفيده بالمزرعة، إنه محبوس داخل أفكاره واحتمالات خسارته، يقول لزوجته في مرة، إن هذه الأرض ما بحثا عنه، هي فرصتهم، وإذا فشل سيتركها تفعل ما تشاء، وإذا أرادت أن تأخذ الأولاد معها سيوافق.
كل شيء مرهون باحتمالات الفشل والنجاح، إنه يخاطر بكل شيء، يلعب الكل في الكل، وفي نهاية الفيلم تسأله سؤال يستدعي كمًا هائلًا من الواجبات الأخلاقية:
“مونيكا: هل الأرض أهم من بقائنا معًا؟
جاكوب: افعلي ما تريدين، حتى إذا فشلت، عليّ أن أنهي ما بدأت”.
هذا الخضوع التام لسطوة الحلم وترك النفس لطموحٍ يبدو محرمًا، يغير طريقة تفكير جاكوب، ليصبح صاحب فكر برغماتي بحت، يقدر فائدته بالمنفعة التي يقدمها للأسرة التي تمثل العالم بالنسبة له، ليلقي بنفسه في أحضان الصدف من أجل إعطاء حياته معنى، ولا يسمح لعاطفته أن تأخذه ليسافر إلى كاليفورنيا ليعيش حياة شخص عادي.
من أول الفيلم تظهر المشاحنات بين الطرفين، العقد الصغيرة تصنع مشكلة كبيرة في آخر الأمر هذا ما انتهجه المخرج، فغياب الجنس له دور معين، والخوف من الإنجاب في مستقبل مظلم، والتنافر التام وغياب التفهم لفكرة الوطن التي يختلف معناها من شخص لآخر.
وخلال تلك المشاحنات، يؤسس المخرج لعلاقة في غاية الجمال والخفة، بين الابن الصغير والجدة، علاقة ترتبط بالتجول والمناكفة واللعب والمحاولة لتقبل وفهم الآخر، وهي العلاقة الأفضل والأقوى في محيط الأسرة، وهذا بفضل فارق السن الذي يدفع الاثنين لاستكشاف عوالم مختلفة.
يصدمنا المخرج بنهاية غير متوقعة لحريق هائل، يتبعها لحظات من الانكسار بعد تفكك تام للأسرة في المدينة، بيد أن هذه الكارثة تسببت في تأثير عكسي على العائلة، فأضحت تعالج المشكلة الرئيسية بدلًا من إشاحة النظر عنها أو تصبير النفس بظروف وعلامات ستتلاشى مع الوقت، ليتضح كل شيء، ويرى جاكوب الصورة من الخارج، ويتغلب على حمى الأنانية، ويكسر حائل الطموح المزيف بعد خسارة محصوله، ويظفر دافيد بقلبٍ سليم، يجري نحو من يحبه، لا يوجد شيء يقوي القلب مثل الحب والشعور بالمسؤولية اتجاه الآخر.
استعمل المخرج لغة هجين بين الإنجليزية والكورية، ليصدر شعورًا بالاغتراب عن أي من البلدين، سواء الولايات المتحدة أم كوريا، ويظهر تأثير الهوية الثقافية والفارق العمري في اللغة، فالأبناء يتحدثون الإنجليزية بطلاقة، أما الآباء يتحدثون الكورية في أغلب الأوقات.
الطبيعة “الماء والنار”
استخدام عناصر الطبيعة شيء في غاية الأهمية لبناء مناخ يخدم الفيلم، واتحاد تلك العناصر تحفز القصة وتؤسس لحيوية مطلوبة في هذا النوع من الأفلام الذي يعتمد على التصوير الخارجي في أغلب مشاهده، وهذا رأيناه في كثير من أفلام مخرجين عظماء، أهمهم آندريا تاركوفيسكي في فيلمين مهمين هما “المرآة” و”التضحية”.
ويظهر المخرج الروسي مهارة بالتلاعب بظاهرتي النار والماء، كعلامات للتطهير أو العقاب، وهناك مخرجون من شرق آسيا يقدسون المياه بشكل كبير، مثل تساي مينغ ليانغ الذي يصنع من المياه بشكل عام ثيمة مهمة في أفلامه، سواء الأمطار أم تسريبات المياه داخل الشقق أم الحوائط التي تنضح بمياه الأمطار الهائلة أم الأسقف التي تنسكب منها قطرات الماء، فالمياه في أفلام تساي تمثل مشاعر مكبوتة وأفكار مخفية تنفجر للسطح منفلته عن السيطرة.
يظهر التعاطي مع الماء والنار بفيلم ميناري في كثير من اللقطات أهمها مشهد البداية والنهاية، أولها فيضان من المياه، يهدد حياتهم وأمطار غزيرة تحاول أن تطيح بهم من الأرض، بعدها يسير الخط الدرامي بشكل متقاطع مع المياه، تظهر طبيعة الأرض الخصبة، ويكتشف المشاهد مدى أهمية المياه، لكن هذه المرة مقابل المال، وتنقطع المياه عن المنزل ليروي بها الأرض.
وتتشكل رمزية للماء في الفيلم أشبه بمخلص من شرٍ ما، ليأتي مشهد النهاية، الذروة العظمى التي تعيد تشكيل الفيلم، يطهر الحريق الأرض من لعنة غير مرأية، ذنب مقترف في المزرعة يجعل الحظ السيء ينبش في قواعد العائلة، لترجع العائلة وترى الأشياء بوضوح أكبر.