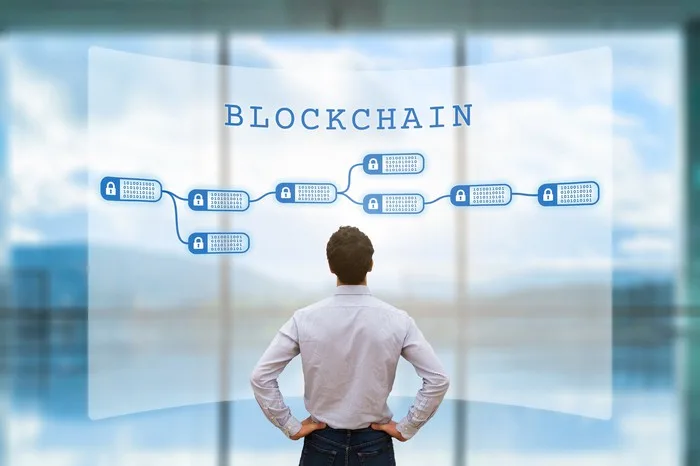قضية العنف في كولومبيا تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، إذ سجلت البلاد ما يقرب من 10 حروب أهلية، بدأت عام 1830 وخلفت أكثر من 400 ألف قتيل و80 ألفًا في عداد المفقودين ـ وفقًا للأرقام الرسمية ـ ما ترك انطباعًا عالميًا عن تميز البلاد بثقافة عنف فريدة من نوعها، تلجأ إليها في حل الخلافات بالصراع وليس الحوار.
كان الصراع يشتعل دائمًا على أجندة النظام الاجتماعي والسياسي، بين فريق يميني يريد تطبيق أشد الأنظمة الرأسمالية تطرفًا بغض النظر عن وضع المجتمع، وإن كان يصلح لهذا النمط أم لا، بما يحمي مصالح الطبقة الثرية وحدها، وفريق آخر يقدم بديلًا إصلاحيًا يدافع من خلاله عن تكافؤ الفرص للفرد الكولومبي ومصالح التجار والفئات الأقل تفضيلًا في المجتمع.
كولومبيا ..تصاعد العنف
اندلع الصراع بين هذه القوى المختلفة وتصاعدت الاغتيالات والاعتداءات، عزز من ذلك السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي وجدت فيه الدولة نفسها، من تضخم وأزمات اقتصادية لا حصر لها، إلى الضعف الشديد للدولة في إعالة المواطنين خاصة في المناطق الريفية والنائية.
مع الوقت تحول الصراع على الأجندة الاجتماعية إلى صراع أيديولوجيات بين اليمين الرأسمالي المتطرف الرافض حتى لأفكار المجموعات الليبرالية المعتدلة، والجناح اليساري الشيوعي، والأخير كان أول من تحول إلى العمل المسلح الكامل عبر إنشاء القوات المسلحة الثورية لكولومبيا.
زاد الصراع في البلاد بعد اغتيال المرشح الرئاسي الليبرالي خورخي غايتان في أبريل/نيسان 1948، فخلق رحيله موجة غير مسبوقة من العنف في البلاد، من إحراق مبان عامة إلى إتلاف مبان حكومية واغتيال مسؤولين وسطو على محلات تجارية وكنائس.
ولم يكن مستغربًا أن الجهات التي غذت الصراع المسلح في معظمها كانت أحزابًا سياسيةً تقليديةً، لكن ما أشعل الموقف وجعله غير قابل للحل، ظهور مجموعات ثورية وقوات شبه عسكرية، جميعها كانت تعبر عن الفجوة الاجتماعية بين النخبة السياسية وتآكل العقد الاجتماعي وحاجة البلاد إلى عقد جديد يعبر عن مصالح الجميع وخاصة الأقليات، سواء السكان الأصليين أم المنحدرين من أصل إفريقي والفلاحين الذين لم يكن لديهم نفس فرص الوصول إلى حقوق الملكية وخدمات الدولة.
وضع الجميع ـ حسب مرجعيته ـ المساواة والعدالة الاجتماعية شعارًا له، لكن قوى مثل القوات المسلحة الثورية وجيش التحرير الوطني، وضعا هدفًا آخر وهو تطبيق الشيوعية في البلاد، ودعم هذا التوجه المناطق الفقيرة وشرائح السكان منخفضة الدخل.
ذروة الصراع
خلال خمسينيات القرن الماضي، بدأ الفلاحون ينظمون أنفسهم بجنوب البلاد وسط عناد وإصرار من النخب المالكة للأراضي، التي استمرت هي الأخرى في مواصلة توسعها وضغطها الشرس على الحكومة لاتخاذ إجراءات ضد المناطق المتمردة التي أصبحت تسمى بالجمهوريات المستقلة.
مع مطلع عام 1964، أطلقت الحكومة عملية ماركيتاليا لتأديب مناطق الحكم الذاتي، وانتصرت في بداية الأمر، لكن المقاتلين اعتمدوا تكتيك حرب العصابات ونجحوا في إنشاء جيش سمي رسميًا “القوات المسلحة الثورية لكولومبيا ـ فارك ـ”.
استلهم الجيش الثوري تعريفاته من أدبيات الثورة الكوبية وفلسفة تشي جيفارا الثورية، وحاولا معًا جذب المزيد من الجماهير المحافظة والليبرالية الرافضة للأوضاع في البلاد، وطالبوهم بالانضمام معهم لهزيمة الأوليغارشية من كلا الحزبين.
تطورت الحمية الثورية ودفعت المجموعات المختلفة نفسها للاتحاد في كيان شبه عسكري داخل هيكل واحد سمى بقوات الدفاع الذاتي الكولومبية (AUC)، وكانت هذه الفترة هي الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان مع توسع القوات شبه العسكرية في جميع أنحاء البلاد.
في الثمانينيات ازداد مستوى العنف وشمل أغلب مناطق البلاد نتيجة لشيوع تهريب المخدرات والاتجار بها الذي روّج على نطاق واسع في الستينيات والسبعينيات، لكن مع حلول عام 2002 وتولي ألفارو أوريبي رئاسة كولومبيا، بدأت مرحلة أخرى في المواجهة، إذ اتبع الرجل منهجًا قوميًا يضرب بيد من حديد لتغيير الواقع بشكل قسرى، فحارب المتمردين وقاد هجومًا عسكريًا شاملًا ضد الهياكل اليسارية المسلحة.
استغل أوريبي الدعم الهائل من إدارتي كلينتون وبوش الذي تجاوز 2.8 مليار دولار تحت مسمى “خطة كولومبيا” وهو اتفاق ثنائي أبُرم بين حكومتي كولومبيا والولايات المتحدة عام 1999 لأهداف محددة تتمثل في توليد الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي وإنهاء النزاع المسلح في كولومبيا ومساعدة البلاد على تعزيز السلام والتنمية الاقتصادية والحرب الصارمة على المخدرات، على أن تضم في طياتها “حربًا على الإرهاب” .
هذه التفاصيل التي تبدو فضفاضة في التفويض الأمريكي استغلها ألفارو في قيادة حرب شاملة ضد الجميع، فأعاد الانضباط الأمني جزئيًا، لكن على حساب حرية وإنسانية الملايين من الشعب الكولومبي، إذ اتبع عمليات قتل ممنهجة لآلاف المدنيين المعارضين له، وأجبر مثلهم على التهجير القسري، وأصبحت كولومبيا في عهده نموذجًا للعسكرة المكثفة التي يصاحبها دائمًا انتهاكات مفزعة في حقوق الإنسان.
بداية الحل
حاولت كولومبيا منذ عام 1974 تقديم العديد من الإصلاحات الدستورية وتفنيد أهم المشكلات التي تؤجج الصراعات الأهلية، فقدمت قانونًا للإصلاح الزراعي عام 1978 يهدف إلى تمكين جميع الكولومبيين من حق تملك الأراضي دون خلفيات طبقية.
أجريت أيضًا تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية طوال السبعينيات، بهدف تقليل تدخل الدولة وتحرير الاقتصاد، وضم المزيد من الفئات المختلفة إلى المجال السياسي بعد أن كانت فئات بعينها محرومة من العمل السياسي.
لجأت الدولة إلى تدويل الصراع في كولومبيا للحصول على الشرعية والمساعدات العسكرية من الدول الأخرى، وكان تدويل الصراع يعني عدم إنكار وجود نزاع مسلح أولًا والاعتراف به، الأمر الذي تسبب في تعقد الموقف الإقليمي والدولي من النزاع.
مع التدويل أصبح هناك ثلاثة اتجاهات من القضية: الأول يعتبر صراحة الحركات المسلحة الموازية مجموعات متحاربة مثل فنزويلا، الثاني صنفهم على أنهم جماعات إرهابية مثل الولايات المتحدة وكندا وتشيلي وبيرو وكوستاريكا وهندوراس ودول أخرى، والثالث لأولئك الذين أدانوا الأعمال العنيفة، لكنهم امتنعوا عن اعتبار الكيانات الموازية حركات إرهابية، مثل الإكوادور والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل والمكسيك.
ظل الموقف معقدًا في البلاد، حتى تولى السياسي خوان مانويل سانتوس السلطة من عام 2010 وحتى 2018، واتباعه سياسات تقدمية وأساليب جديدة في مواجهة الأزمات المستعصية على الحل، وقاد الرجل لأول مرة مناقشات مجتمعية لإيجاد حل جماعي قانوني لمكافحة المخدرات.
نجح سانتوس بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2016 في التفاوض على معاهدة سلام، ووقعت الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية اتفاقية سلام، الأمر الذي أوقف الصراع، ونال خوان مانويل عن هذه الجهود جائزة نوبل في السلام، وتم اختياره واحدًا من أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجلة تايم.
ترك خوان منصبه في 2018 وسط محاولات شرسة لتقويض جهوده وإضعاف شعبيته من الرئيس الذي سبقه ألفارو أوريبي بعد أن تحول إلى خصم ومعارض شرس له، وتولى محامي أوريبي منصب الرئاسة وهو إيفان دوكي ماركيز.
لكن فترة رئاسة سانتوس تركت بصماتها على البلاد، إذ تم الربط بعدها بين المساعدات الخارجية وفق الخطة الجديدة التي أسماها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما “باز كولومبيا”، باعتبار بلاده أحد الشركاء الرئيسيين من أجل السلام في البلاد والتقدم بأربعة مجالات رئيسية، هي: الأمن ومكافحة المخدرات والتنمية الريفية والضحايا والعدالة وإزالة الألغام.
كما أسس سانتوس محكمة ذات حيثية مستقلة ـ بموجب اتفاقيات السلام ـ تتولى الحكم في انتهاكات حقوق الإنسان، على أن تكون لها كل الصلاحيات في فرض العقوبات الحصرية وإجراءات التعويض وكل ذلك كضمانة لعدم تكرارها، على أن يحق لها توقيف الضباط العسكريين المسؤولين عن الانتهاكات من هذا النوع بعد التحقيق معهم ومعاقبتهم وإبعادهم عن مناصبهم.
خلاصة التجربة
ما يمكن فهمه من التجربة الكولومبية، أن عوامل إطالة هذا الصراع المرير، كان يعود في المقام الأول لعدم وجود شخصية في الحكم تريد الحوار والسلام، بجانب تدخلات البلدان المجاورة، التي أججت الصراع الكولومبي في المنطقة وجعلته مشكلةً إقليميةً وعالميةً.
تسببت مواقف دول الجوار في إبقاء الصراع مشتعلًا، وكان يتزايد ويتراجع حسب خلفية رأس السلطة وأيدلوجيته السياسية، فخوان مانويل سانتوس على سبيل المثال، الذي ساهم بقوة في وقف حرب العصابات، كانت علاقته متوترة للغاية مع فنزويلا التي تتبنى خطابًا معاديًا لأفكاره، لكن صلابة السلطة ودعمها دوليًا جعل الجارة تتغلب على منطلقاتها الأيدلوجية ودعمت سانتوس بل وساهمت في جهود السلام، لكن دون إلقاء حلفائها في الداخل إلى الجحيم.
على العكس كانت علاقات سانتوس مع دولة الأكوادور في أغلب الأوقات ودية، إذ كانت داعمة لسياساته التقدمية في الأمن والدفاع وحقوق الإنسان، ولهذا لعبت كل من فنزويلا والإكوادور دورًا كبيرًا في حل النزاع المسلح الكولومبي، وساهم الحزام الإقليمي في دعم عملية بناء الثقة بين الأطراف، فضمنت فنزويلا اتفاق السلام مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، كما ضمنت الإكوادور السلام مع جيش التحرير الوطني.
تقول التقارير الدولية التي صدرت مؤخرًا، إن قضايا تعويض الضحايا تحتاج من الدولة الكولومبية ما يقرب من خمسة عقود لتعويض جميع ضحايا النزاع، ولهذا ما زال هناك توترات مستمرة بين مكونات المجتمع المختلفة، لكن ما يحمد للدولة إيقاف أقدم حرب عصابات في العالم، ووضع حجر الأساس لإجراء التحولات الاجتماعية التي احتاجتها كولومبيا لعقود من الزمن، ومن خلالها سيعود الاستقرار عاجلًا أم آجلًا للبلاد وأهلها.