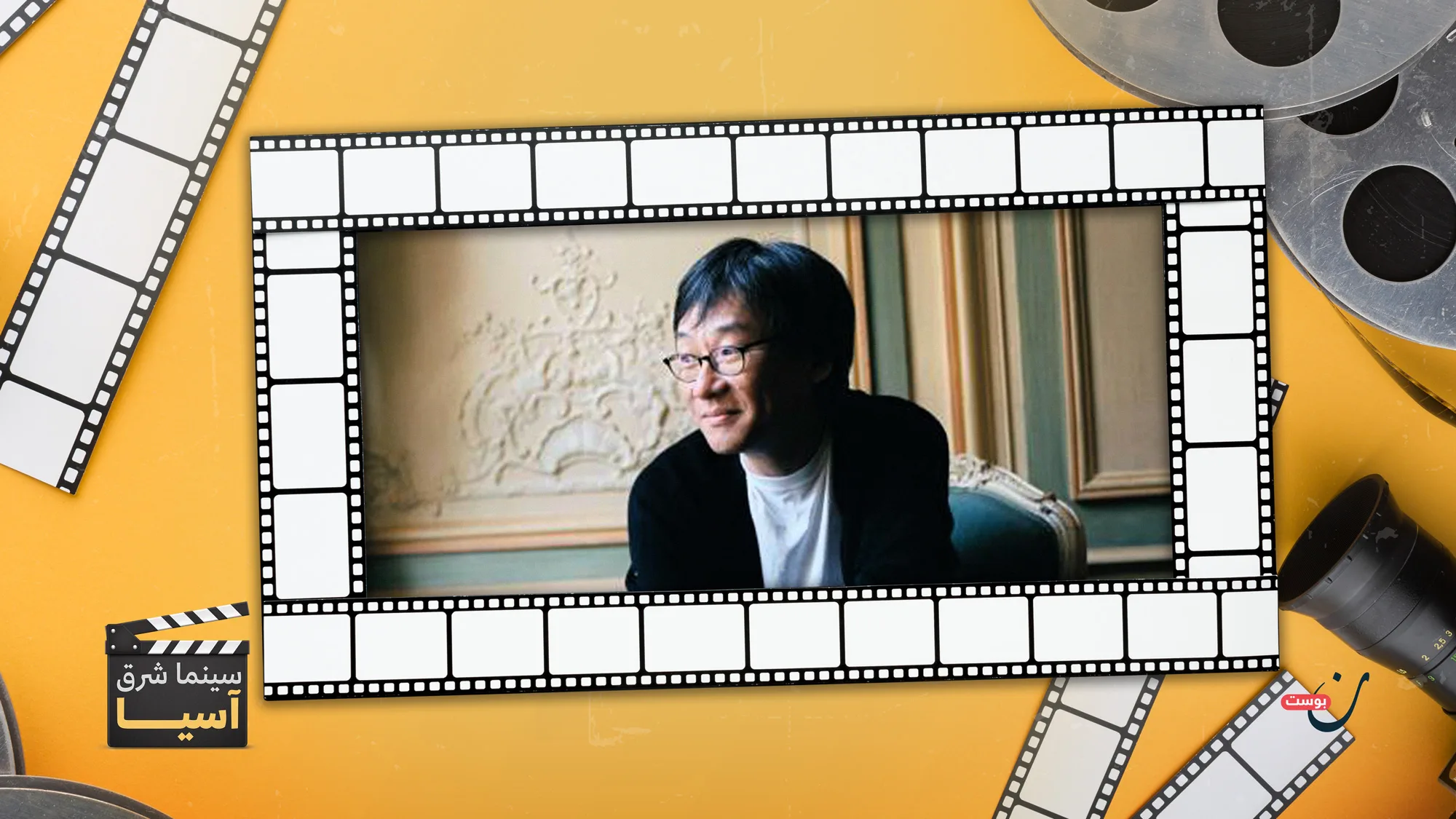ضحكاته كانت تملأ أروقة مدرج كلية الإعلام جامعة القاهرة، مزاحه المستمر مع أستاذ مادة الإعلام الدولي التي كنا ندرسها ضمن منهج الدراسات العليا بالكلية، كانت السمة الطاغية على أجواء المحاضرة، لم أتردد كثيرًا في الجلوس بجانبه، وقبل أن أستقر في مكاني بادرني: مرحبًا بك أخي؟ منذ الوهلة الأولى اعتقدت أنه مصري، مظهره وطريقة كلامه يشيران لذلك، لكنه داهمني قبل أن أرد عليه: معك أخوك خالد من فلسطين.
وما إن انتهت المحاضرة حتى اقترب مني أكثر وبدأ يحكي عن خمس سنوات كاملة قضاها في مصر، كأنه مصري حتى النخاع، إذ يعرف عن المحروسة ما لم أعرفه أنا، عشوائياتها، أشهر المطاعم والكافيهات، السير الذاتية لكل أساتذة الكلية التي تخرجت أنا منها ولا أعلم عنهم عُشر ما يعرف هو.
لفت نظري انصهاره الشديد داخل المجتمع المصري، حتى بات أحد مكوناته، وبدأنا نتبادل أطراف الحديث عن غزة ورام الله والهرم والجيزة والسيدة عائشة والأزهر والحسين ووسط البلد ومقهى الفيشاوي وكافيه ريش، قاربنا على الساعتين ونحن نتناقش في سمات التقارب بين الشعبين، المصري والفلسطيني، الذي أصر هو أن يسميهم شعب واحد وإن كانا في بلدين.
الجالية الفلسطينية في مصر، واحدة من أقدم الجاليات التي استقرت في المحروسة، وعلى مدار العقود الطويلة الماضية تعرضت لموجات من المد والجزر وفقًا لمستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين من جانب، والقاهرة وتل أبيب من جانب آخر، دفع خلالها الفلسطينيون الثمن الذي كان في بعض الأحيان غاليًا جدًا.
لا يوجد إحصاء رسمي لعدد الفلسطينيين المقيمين في مصر، لكن الأرقام التقريبية تشير إلى أن العدد يتأرجح حول المئة ألف فلسطيني، يزيد وينقص بين الحين والآخر، ورغم أي تحديات يمكن أن تواجه أبناء القضية العربية الأم، فإنهم من أوائل الشعوب التي تأقلمت بشكل كبير مع المصريين، فباتوا أحد الروافد الثقافية التي أغنت النسيج الاجتماعي المصري.
بورسعيد في استقبال الأشقاء
الحكاية تعود إلى بدايات 1948، حين شنت العصابات الصهيونية هجماتها المدفعية ضد أهالي مدينة يافا، ما دفعهم إلى الهرولة نحو البحر هربًا من القذائف التي حطمت أسوار المدينة العريقة، فتوجهوا جنوبًا حيث غزة ومصر، بضعة آلاف استقروا في المدينة الفلسطينية الحدودية فيما توجه آخرون عبر المياه إلى مدينة بورسعيد.
استقبل أهالي بورسعيد اللاجئين الفلسطينيين أحسن استقبال، حيث أقامت لهم الدولة المصرية مبنى مخصص لهم تابع لشركة قناة السويس، فيما توجه جزء آخر من الأشقاء إلى معسكر العباسية بالقاهرة، ومع توافد الأعداد الكبيرة أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية معسكرًا كبيرًا في منطقة “قنطرة شرق” في مايو/أيار 1948.
العدد حينها قارب على 12 ألف فلسطيني، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه الأعداد ومباشرة خدماتهم تحت اسم “اللجنة العليا لشؤون مهاجري فلسطين”، وتألفت في البداية من قرابة عشرين عضوًا يمثلون مختلف الوزارات والمصالح الرسمية المعنية.
نجحت اللجنة في توفير مختلف الخدمات للمعسكر، من تعليم وصحة وطرق ونوادي، حتى سمي بـ”مدينة اللاجئين” فيما بدأت الجامعة العربية في توفير التمويل المناسب للإنفاق على الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم، إلا أنه وبعد توقيع اتفاقية الهدنة في فبراير/شباط 1949 أمرت الحكومة المصرية بترحيل اللاجئين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وكان لهذا القرار أبعاده السياسية في المقام الأول.
القرار كان اختياريًا بصورة كبيرة ولم يكن ملزمًا، وعليه آثر البعض البقاء في مصر، فقد غادرت الأغلبية معسكر القنطرة باتجاه غزة، ولم يبق في الجانب المصري إلا 4 آلاف لاجئ فلسطيني فقط، شكلوا نواة الجالية الفلسطينية في مصر، لتبدأ رحلة جديدة من التعايش والمعاناة معًا داخل المجتمع المصري.
في عهد الجمهورية
مر الفلسطينيون بعد انتهاء الملكية ودخول عصر الجمهورية منذ يوليو/تموز 1953 بمرحلتين أساسيتين، الأولى خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر (1954 – 1970)، وحينها تعاظم الشعور القومي العربي بصورة كبيرة لدى الرئيس المصري، الذي أصدر عددًا من القوانين التي تنظم الوجود الفلسطيني في مصر.
معظم تلك القوانين أعطت الفلسطينيين نفس حقوق المصريين، فباتوا شركاء في الوطن لا فرق بين فلسطيني ومصري، دون أن يكون لذلك تأثير على هويتهم الوطنية، فكان لهم الحق في العمل بالوظائف العامة، وتملك الأراضي الزراعية والتعليم المجاني في المدارس الحكومية والجامعات.
وخلال مرحلة عبد الناصر تأسست العديد من الكيانات الفلسطينية المدنية التي تعكس حجم الاندماج الواضح في المجتمع، كان أبرزها الاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد طلاب فلسطين واتحاد الكتاب الفلسطينيين واتحاد المرأة الفلسطينية، فكانت الأداة التي استعان بها اللاجئون للدفاع عن قضيتهم وتوحيد كلمتهم، ما سهل الطريق أمامهم بعد ذلك للارتباط بمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومع نشوب حرب عام 1967 واحتلال ما تبقى من فلسطين، اضطر الكثير من سكان غزة ورام الله للهرب إلى مصر، فزادت أعداد الجالية الفلسطينية من 4 آلاف عام 1948 إلى أكثر من 35 ألف عام 1967، فيما انفصل الفلسطينيون المقيمون في مصر عن وطنهم بصورة شبه كاملة خلال هذه الفترة.
اليوم لم يعد الفلسطينيون في مناطق معزولة أو مخيمات وقواعد خاصة بهم، كما كان في السابق، بل انصهروا بصورة كبيرة داخل النسيج المصري
البعض كان يأخذ على القاهرة وقتها أنها منعت التجنيس، رغم سياسات الاندماج التي اتبعها ناصر مع الفلسطينيين، غير أن هذا الموقف جاء استنادًا إلى قرار الجامعة العربية عام 1952، الذي أكد عدم تجنيس اللاجئين حفاظًا على الهوية الفلسطينية واستعادة الحقوق الأساسية للاجئ الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والحصول على تعويضات.
أما المرحلة الثانية فتنقسم إلى عهدين: الأول خلال ولاية محمد أنور السادات (1918-1981) والثاني خلال فترة محمد حسني مبارك (1928-2020)، ففي الأولى دفع الفلسطينيون ثمن التجاذبات السياسية بين حكومة القاهرة ومنظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1978، وما تلاها من مقاطعة عربية لمصر، وما سبق ذلك من اغتيال وزير الثقافة المصري يوسف السباعي في قبرص في فبراير/شباط من نفس العام من منظمة “أبو نضال” الفلسطينية.
في تلك السنوات جرد الفلسطينيون من الكثير من حقوقهم، على رأسها الإقامة التي باتت مشروطة بمن كان متزوجًا بمصرية منذ أكثر من خمسة أعوام أو ملتحقًا بمدرسة أو جامعة، ودافعًا لرسومها، أو متعاقدًا مع القطاع الخاص، أو من كانت لديه مصلحة تجارية أو استثمارات داخل البلد، هذا بخلاف إلغاء مجانية التعليم للفلسطينيين وبات عليهم دفع الرسوم بالعملات الأجنبية، وهو القرار المستمر حتى اليوم.
وفي عهد مبارك، لم يتغير الوضع كثيرًا، لا سيما بعد تفعيل قانون الطوارئ، ما كان له أسوأ الأثر على القبضة الأمنية المشددة على كل الجاليات الموجودة في مصر وعلى رأسها الجالية الفلسطينية، فتوسعت دائرة الاشتباه والاعتقال، لا سيما بعد اعتراض الفلسطينيين على مشاركة الجانب المصري ضمن قوات التحالف المشاركة في حرب الخليج الثانية.
بعد ثورة يناير
شهدت ثورة يناير 2011 دخول الأجواء المصرية الفلسطينية مزيدًا من التناغم، وهو ما كان له أثره على أعداد الفلسطينيين الموجودين فوق التراب المصري، الذي زاد عددهم على المئة ألف فلسطيني، فيما شهدت خريطة اللوائح والقوانين الخاصة بهم بعض المرونة النسبية مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك.
واليوم لم يعد الفلسطينيون في مناطق معزولة أو مخيمات وقواعد خاصة بهم، كما كان في السابق، بل انصهروا بصورة كبيرة داخل النسيج المصري، فتجد الأسرة الفلسطينية إلى جوار المصرية والسورية والأردنية والعراقية، بل تجد الشاب الفلسطيني يسكن في الغرفة المجاورة لشقيقه المصري في ذات الوحدة العقارية.
أبو خليل، أربعيني فلسطيني يدرس الدكتواره في إحدى الجامعات المصرية، يقول إنه أتى إلى القاهرة منذ أكثر من 12 عامًا، وتعددت الزيارات بين الاستشفاء والعلاج في المستشفيات المصرية أو الدراسة، سواء كان ماجستير أم دكتوراه، لافتًا أنه لم يشعر يومًا واحدًا أنه أجنبي أو غريب في هذا البلد.
وأضاف الشاب الفلسطيني الذي يعمل صحفيًا، أن الشعب – وليست الأنظمة – هو المرآة الحقيقية التي يمكن من خلالها رؤية مواقف الدول تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المصريين من أكثر شعوب العالم حبًا وتقديرًا للفلسطينيين، فهم يرون أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم التي يجب أن تحظى بالدعم الكامل.
الموقف ذاته أشارت إليه “حسناء” الشابة الفلسطينية التي تدير أحد المشروعات الصغيرة في منطقة فيصل بالجيزة، فقد أوضحت أن الشارع الذي تقيم فيه لا يختلف كثيرًا عن شارع الوحدة أو عمر المختار في غزة، لافتة إلى أنها وجدت حبًا ودعمًا من المصريين ربما يفوق بعض الفلسطينيين لا سيما أبناء الانتماءات السياسية المختلفة.
وعن انخراطها في العمل داخل المجتمع المصري، لفتت أنها وجميع أفراد الجالية الفلسطينية مطالبون بالإنفاق على أنفسهم، فهم – على عكس غيرهم من الجاليات الأخرى – غير مشمولين بخدمات وكالة “الأونروا”، ويعود ذلك إلى معاملة عبد الناصر لهم معاملة المصريين هذا بخلاف صعوبة التوصل إليهم بعد حالة الانصهار داخل النسيج المجتمعي المصري.
الحفاظ على الهوية
“رغم مغادرة أوطاننا، فإننا جميعًا هنا أسرة واحدة، نحيي وطننا أينما رحلنا أو نزلنا”، بهذه الكلمات كشف “ملهم” الخمسيني الفلسطيني المقيم بمدينة السادس من أكتوبر طبيعة حياة الجالية الفلسطينية في مصر، لافتًا إلى أن الطقوس التي كانوا يحيوها في غزة ويافا ورام الله هي ذاتها التي يحيوها في أكتوبر والهرم والجيزة والسيدة عائشة ووسط القاهرة.
وألمح إلى أنه في نهاية الأسبوع يجتمع أفراد العائلة والأقارب عند أحد الأصدقاء بالتناوب، فيتناولون العشاء ويسهرون طيلة الليل على أوتار العادات الفلسطينية الخالصة، طعام وشراب وأهازيج وألحان وأغاني وأشعار كلها على الطريقة الفلسطينية، وكأننا لم نكن ببلد آخر له طقوسه وعاداته المختلفة.
ويضيف “بينما نحن خارج وطننا، نجحنا في الحفاظ على هويتنا الوطنية والتراثية، حتى إننا علمنا المصريين عاداتنا وتقاليدنا فباتوا يقومون بها كأنهم فلسطينيون”، وتابع “ينبهر المصريون حين ندعوهم للجلوس عندنا لا سيما أوقات رمضان والمناسبات الوطنية الخاصة بنا، انبهارهم دفعهم أكثر من مرة لتقليد تراثنا في أكثر من مجال، إنما ذلك بحب وعشق للقضية الفلسطينية أكثر منه تقليد بالمعنى المعتاد” هكذا اختتم حديثه.
وينقسم الفلسطينيون المقيمون في مصر إلى ثلاثة أصناف، الأول: الشريحة الشبابية وهي من الطلاب الدارسين في الجامعات المصرية والساعين للحصول على الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) للعودة بها إلى وطنهم الأم من أجل الترقي، وهم يشكلون الغالبية العظمى، أما القسم الثاني فمن كبار السن وهم من يتلقون العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات المصرية، وكلا القسمين في الغالب يكون وجوده بصورة مؤقتة.
أما القسم الثالث الذي ازدادت أعداده مؤخرًا فهم المستثمرون ورجال الأعمال والموظفون، الذين حققوا نجاحات كبيرة في مجال الاستثمار والقطاع المالي، وتتركز معظم الأنشطة حول التجارة والاستيراد والاستثمارات العقارية، فيما يبقى جزء كبير منهم في مجالات الاتصالات والإعلام والتسويق الشبكي.
المعاناة مستمرة
رغم حالة الاندماج الكبير داخل المجتمع المصري، فإن معاناة الفلسطينيين في الإقامة بمصر لا تزال مستمرة، وبحسب شهادة العشرات منهم يمكن تقسيم الصعوبات والتحديات التي تواجههم إلى ثلاثة أقسام: الأول يتعلق بالبعد الاقتصادي، حيث ارتفاع الرسوم الخاصة بإنهاء إجراءات وأوراق الأجانب بصفة عامة التي ربما في بعضها تفوق قدرات الكثير منهم، وهو ما يمكن ملاحظته مثلًا على رسوم الدراسة، إذ تبلغ أكثر من 4 أضعاف رسوم المصريين في بعض الأماكن.
العديد من المناشدات قدمها فلسطينيون للسلطات المصرية من أجل إعادة النظر في هذه اللوائح واستثنائهم من المعمول به مع بقية الجاليات الأجنبية الأخرى التي تحصل معظمها على دعم وتمويل ثابت من المنظمات الدولية، وقد تلقوا وعودًا بهذا لكن دون إنجاز على أرض الواقع حتى اليوم.
القسم الثاني يتعلق بالصعوبات التي تواجه وثائق السفر، إذ تمنح تأشيرات الدخول لمرة واحدة فقط، أما من أراد الدخول لمصر مرة أخرى عليه العودة إلى القاهرة كل 6 أشهر لتجديد الإقامة أو تزويد السلطات المصرية مقدمًا ما يُثبت عمله أو التحاقه بمؤسسة تعليمية، بحيث يحصل على تأشيرة للعودة مدتها عام واحد، وهي مسألة مرهقة جدًا.
معاناة الفلسطينيين بصفة عامة معاناة متعددة الأوجه، معاناة من الداخل، فكل الأطراف الفلسطينية المتصارعة باتت مشغولة بنفوذها ومكاسبها أكثر من هموم الشعب، داخليًا كان أو خارجيًا، ومعاناة الخارج سواء من المجتمع الدولي أم الهيئات الخيرية العالمية، هذا بجانب معاناة المنفى، حيث التضييقات التي يتعرضون لها بين الحين والآخر
هذا بخلاف التعقيدات التي يواجهونها عند معبر رفح الحدودي، فكثيرًا ما يتعرض للغلق بين الحين والآخر، وهو ما يعرض حياة ومستقبل العالقين في الجانب الفلسطيني للخطر، خاصة أن بعضهم قد يكون مرتبطًا بمواقيت للعلاج وإجراء عمليات جراحية، وآخرين لديهم ارتباطات دراسية عقد امتحانات أو خلافه، ورغم التسهيلات التي تمنح للحالات الطارئة، فإن تلك الإشكالية في المجمل تمثل صداعًا وقلقًا لدى الفلسطينيين.
فيما يتمحور القسم الثالث من الصعوبات حول التضييقات الأمنية المشددة التي يواجهها الفلسطينيون، إذ ينظر إليهم في الغالب على أنهم موضع اتهام، خاصة أبناء غزة بسبب علاقاتهم بحركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تشوب العلاقات بينها وبين النظام المصري توترات بين الحين والآخر، ما ينعكس بالطبع على الجالية الفلسطينية في مصر.
كثير من الشهادات أفادت بتعرض وحدات عقارية يقطنها فلسطينيون وعرب للمداهمة من الأمن الوطني المصري لا سيما أوقات حدوث أي أعمال إرهابية في البلاد، ورغم تفهم الفلسطينيين لهذا الأمر، فإن النظرة الرسمية لهم باعتبارهم محل شك واتهام باتت مسألة مقلقة بالنسبة لهم، رغم المعاملة الجيدة التي يعاملون بها في الغالب.
وفي الأخير، فإن معاناة الفلسطينيين بصفة عامة معاناة متعددة الأوجه، معاناة من الداخل، فكل الأطراف الفلسطينية المتصارعة التي باتت مشغولة بنفوذها ومكاسبها أكثر من هموم الشعب، داخليًا كان أو خارجيًا، ومعاناة الخارج سواء من المجتمع الدولي أم الهيئات الخيرية العالمية، هذا بجانب معاناة المنفى، حيث التضييقات التي يتعرضون لها بين الحين والآخر، مكتوب عليهم أن يدفعوا ثمن أي توتر قد ينشب في العلاقات بين حكومة بلادهم والدولة المضيفة لهم.