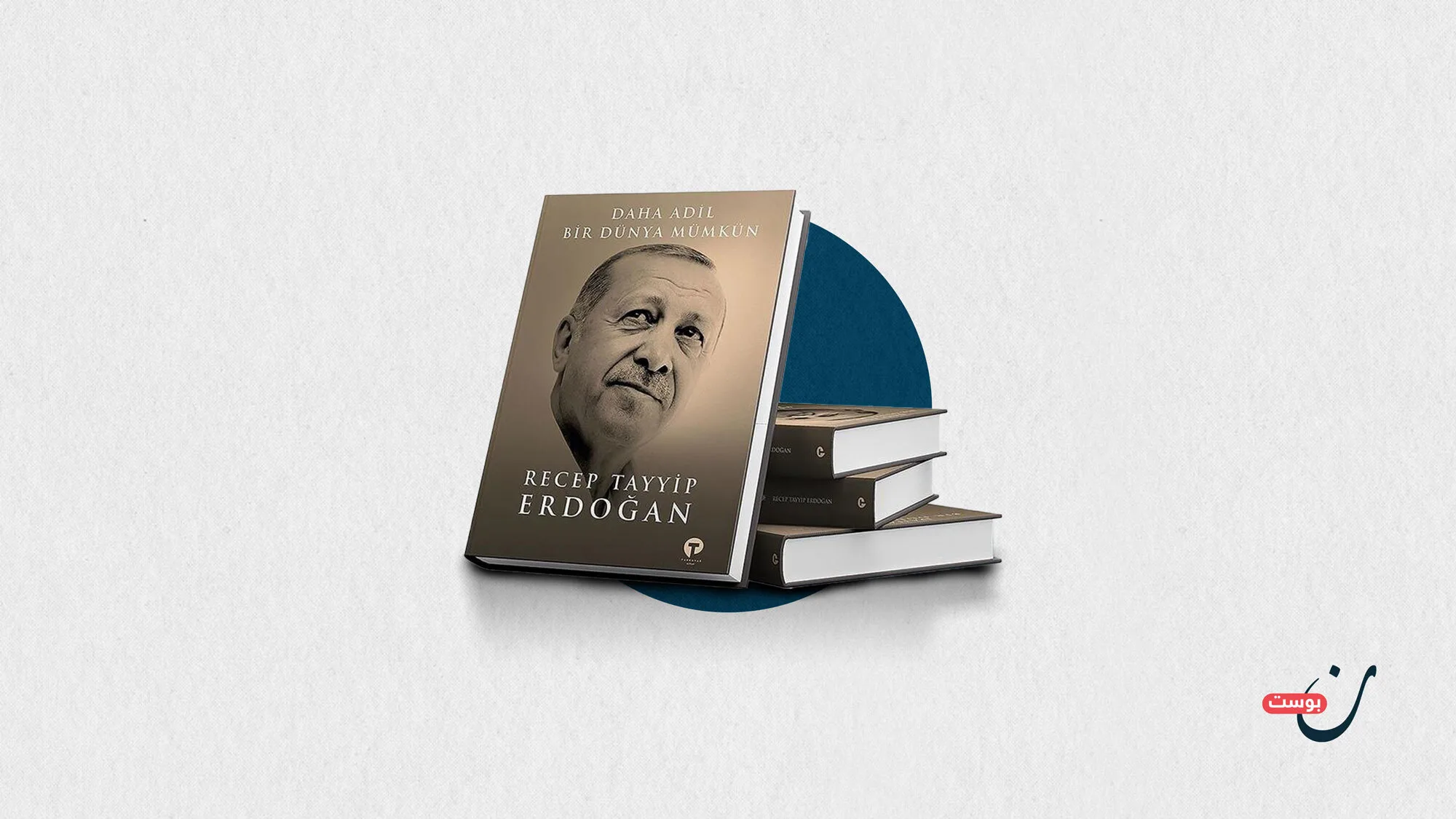زعيمة الاستئصال السياسي الجديدة تعود إلى الظهور في المشهد، بعد أن طردها الانقلاب من حماه، وعودتها جاءت لتحفر الأخاديد بين الحراك الدستوري المواطني والإسلاميين أو من بقيَ منهم حيًّا متماسكًا بعد الانقلاب. لقد خيّب الانقلاب رجاءها حتى الآن، فتابت عن مساندته لكنها لم تَتُبْ عن غريزتها الاستئصالية، لذلك قادت تفريق الصفوف يوم 26 تحت عنوان “الديمقراطيون لا يشاركون الإسلاميين في الاحتجاج الشعبي”.
وإلى ذلك هناك تحركات مشابهة لأحزاب مجهرية تتجمّع في مكاتب النقابة تحت عنوان رفض الانقلاب، لكن دون التنسيق مع الشارع الذي وُصِمَ بأنه شارع النهضة رغم وجود الآلاف في الشارع لا ينتمون إلى النهضة، بل يختلفون معها سياسيًّا وبشكل جذري. وأرى في هذا عودة للاستقطاب السياسي التقليدي في أفق ما بعد الانقلاب.
ما بعد الانقلاب صار ممكنًا.. لكن بمن ومع من؟
انطلق حراك 18 سبتمبر/ أيلول دون حزب النهضة، فكان شارعًا شعبيًّا متمسّكًا بالمؤسسات وبالدستور، وفي اليوم الثاني (26) ظهر جمهور من النهضة بين الصفوف، بعد أن أصدر الحزب بيانًا يحرِّر فيه إرادة منتسبيه للمشاركة والدعم. لكن غالبية الحضور لم تكن من الحزب ولم تتصدر قيادات من الحزب الخطابة أو الحديث باسم الحراك.
البعض توقّع أن هذا بداية التحاق متدرِّج بالحراك، خاصة أنه الحزب الوحيد المنظَّم القادر على الرفد والمثابرة. ولكن قبل تجلّي حقيقة الحضور وحجمه، برز موقف موازٍ للحراك عنوانه أحزاب مجهرية شرعت في تنسيق موقفها مع النقابة المساندة عمليًّا للانقلاب، ولا تقول بعودة المؤسسات للعمل وخاصة رفض عودة البرلمان مع تخصيص على رئيسه.
الذي أثار استغراب المتابعين هو حضور الحزب الجمهوري، ذي النزعة الاستقلالية، مع حزب آفاق تونس المعروف أنه صنيعة فرنسية منذ ظهوره، وهو لقاء غريب يوسِّع الشكوك حول الحزب الجمهوري نفسه، وعصام الشابي رئيسه الذي كان له موقف مبدئي من الانقلاب منذ اليوم الأول.
نحن إذًا أمام رأسَين أو لسانَين لحراك واحد في الظاهر، الشارع المستقل عن الأحزاب والمنظمة النقابية وفيهما جمهور نهضوي، وكتل حزبية صغيرة ولكنها منفوخة بالإعلام تعارض الانقلاب لكن تحت مظلة النقابة المساندة للانقلاب.
أعقب ذلك تغيُّر جذري في موقف الصحافة الفرنسية، يمينها ويسارها، من الانقلاب ومن المنقلب نفسه، بما يوحي أن فرنسا تخلت عن دعم الانقلاب المسمّى سابقًا عندها بالإجراءات التصحيحية. لكن العارفين بالسياسات الفرنسية يتوجّسون أن تكون فرنسا قد غيّرت مركوبها السياسي في الداخل، وما هذه الاجتماعات إلا تمهيد لإبراز رأس موازٍ للحراك الشعبي ليفاوض على ما بعد الانقلاب. ويؤكد هذه الظنون التحاق حزب تحيا تونس (يوسف الشاهد) بمشهد معارضي الانقلاب قريبًا من النقابة بعيدًا عن حراك الشارع.
لم يصدر عن هذه الاجتماعات ما يفيد خصومة مع حراك الشارع، ولكن المسكوت عنه عبّرت عنه سامية عبو (المالك الفعلي لحزب التيار) بدعوتها إلى عدم مشاركة الشارع في تحركاته لأنه ملوَّث بحزب النهضة، ثم تلقف الإعلام الموالي للانقلاب موقفها ليقدم موقف التفتيت على موقف التجميع.
نحن إذًا أمام رأسَين أو لسانَين لحراك واحد في الظاهر، الشارع المستقل عن الأحزاب والمنظمة النقابية وفيهما جمهور نهضوي، وكتل حزبية صغيرة ولكنها منفوخة بالإعلام تعارض الانقلاب لكن تحت مظلة النقابة المساندة للانقلاب.
ويبدو لنا الهدف واضحًا؛ في أفق ما بعد الانقلاب لا يجب فسح مجال لحزب النهضة لينال مكاسب سياسية مهما كان حجم معارضته للانقلاب، وهي عودة إلى المشهد المنقسم نفسه قبل الانقلاب.
مقاولات فرنسية في الساحة المضطربة
إن أي تحرك احتجاجي يفضي إلى عودة البرلمان برئيسه، يعني نجاة حزب النهضة من استئصال مبرمَج، أي بقاء الحزب ضمن المشهد القادم بغضّ النظر عن تأثير مشاكله الداخلية التي أفضت إلى انقسام واستقالات.
عودة البرلمان تعني نجاة الدستور من قبضة الرئيس وبقاء “جرثومة” النظام البرلماني حية، وهو الأمر الذي يزعج فرنسا ويحرمها من مفاوض وحيد يقبّل أكتاف رؤسائها. ولا نظن فرنسا عَميت عن الشعارات التي رُفعت ضدها في التحرك، ولولا الأمن المكثَّف حول السفارة لشهدت حقيقة الموقف الشعبي عند سفارتها التي تحتل مقرَّ المقيم العام منذ دخولها محتلة للبلد.
لقد تبيّن للحراك وجه عدوه الحقيقي، وسيكتمل وعيه بأن مقاومة هذا الخصم ستمرُّ حتمًا باستعادة الدستور والنظام البرلماني ولو بعد حين، فيكون الانقلاب مناورتها الأخيرة التي انتهت بخروجها من تونس بلا مكاسب تذكر. في هذا الأفق بدأت بتحريك جماعات تشترك معها في معاداة حزب النهضة، ومركّزة نشاطهم وتحركاتهم تحت مظلة النقابة وهو بعض ثمن جائزة نوبل للسلام. ولا بأس بحرق ورقة الرئيس التي ولدت رمادًا. لقد سمينا هذا بتغيير المركوب لكن دون تغيير المقصد. قسمة الساحة السياسية على أُسُس أيديولوجية ودفع الاستقطاب إلى مداه كما فعلت منذ أول الثورة.
عجز الرئيس منذ انقلابه وحتى الآن عن الدخول في معركة استئصال النهضة بواسطة الأجهزة على طريقة بن علي، كما نصحه المحيطون به، وهو ما يكشف خيبتهم وانفضاضهم عنه.
وهذا مؤشر قد يجعل ما بعد الانقلاب مشابهًا في تفاصيله اليومية لما قبله، وتغرق تونس في صراع بلا نهاية، كما تحسنُ فرنسا وجماعاتها الثقافية تزويده بالحطب الأيديولوجي.
إننا نرى آلية الوصم بـ”الخوانجية” تسيطر على الخطاب الإعلامي المساند للانقلاب، والمساند في الوقت ذاته لمعارضيه المعادين للنهضة وحضورها في المشهد، دون أي شعور بالتناقض فالهدف واحد.
لقد عجز الرئيس منذ انقلابه وحتى الآن عن الدخول في معركة استئصال النهضة بواسطة الأجهزة على طريقة بن علي، كما نصحه المحيطون به، وهو ما يكشف خيبتهم وانفضاضهم عنه. وقد يفكّر في استعادتهم بدخول هذه المعركة، لكن انطلاقة الحراك وبقوة فوّتت عليه الكثير من الفرص وجعلت هذه المهمة عسيرة إن لم نقل مستحيلة. وترجمة ذلك ترسيخ أقدام حزب النهضة في المشهد القادم بقطع النظر عن الحجم الباقي بعد الانقسام الذي شقّها.
إذا عاد الصندوق الانتخابي سيكون المشهد مختلفًا
عودة البرلمان تعني إغلاق قوس الانقلاب نهائيًّا والدخول في مرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي تحت ظل الدستور، ويُترجَم ذلك ببقاء هيئة الانتخابات المستقلة وتغيير القانون الانتخابي بوضع عتبة، كما هو مقترح في نص رفض الرئيس المصادق عليه منذ يوم توليه.
في المشهد الجديد لن تغيب النهضة وستظهر وجوه جديدة نراها الآن تتحرك في الشارع وإن لم تنتظم حزبيًّا، وهو ليس شرطًا للترشح. وفي غياب الاستئصاليين لا نرى حزب النهضة يصرُّ على الحكم، وقد يمكث في المعارضة وينسى خطاب المظلومية الذي أفرط فيه حتى فقدَ مراجعه الأساسية.
ستغيب الحزبيات الموصومة بالصفر فاصل ولو ظللتها النقابة وضللتها. فرنسا ترى هذا الخطر وتحتاط له لذلك تستعيد جهدها في تقسيم الساحة على قاعدة حرب الأيديولوجيا التي يبدع أنصارها في إشعالها بقضايا ليس أسخفها المثلية الجنسية. وهذا يدفعنا إلى جملة خاتمة، إذا لم يتجه الحراك الدستوري إلى قطع دابر فرنسا من تونس، فكل الجهد سيكون استعادة الوضع الصفري الذي كان قبل الانقلاب.