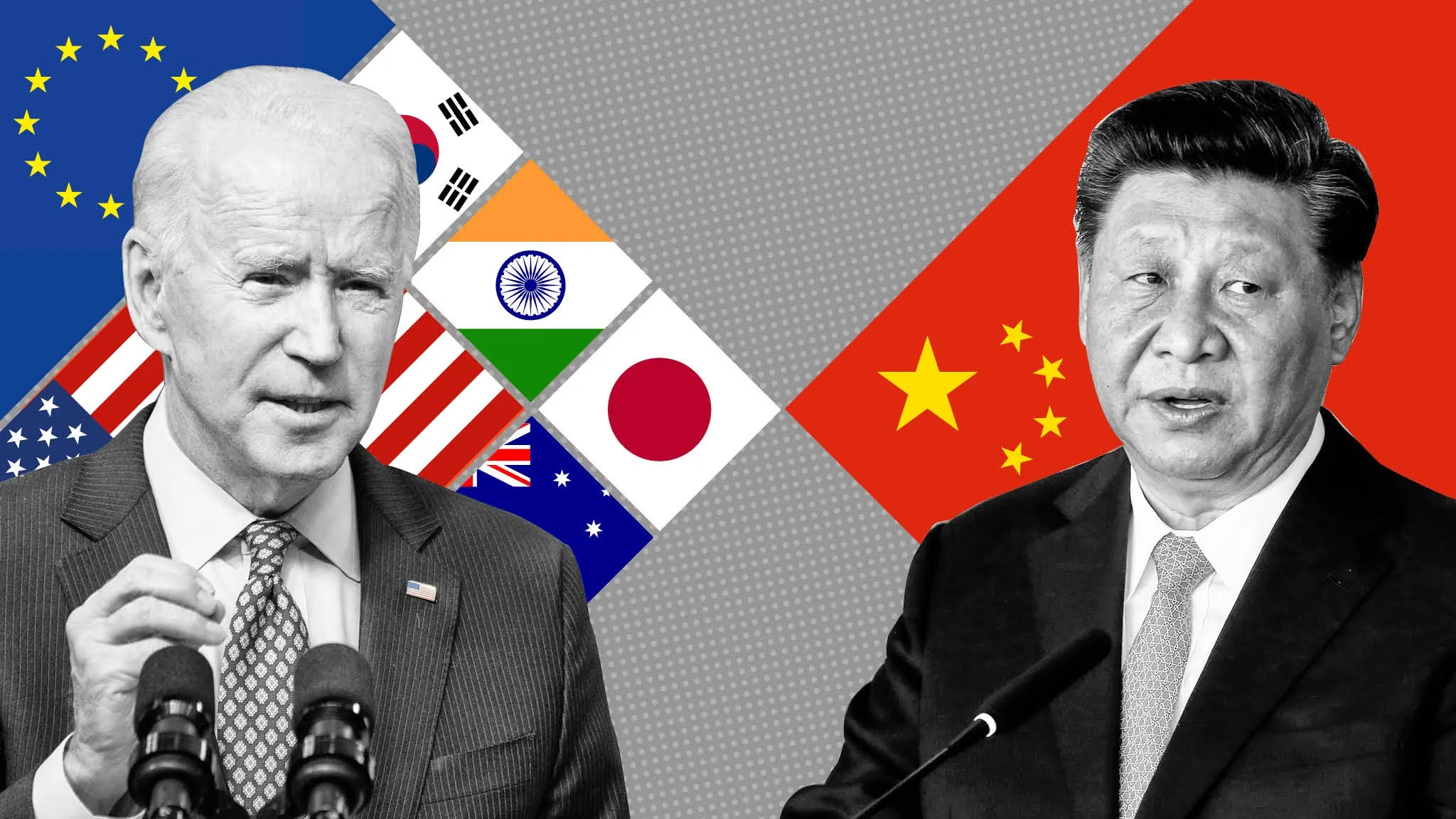تقع سينما فلسطين، بالنسبة إلى الجمهور الخارجي، موقع المُكاشفة، تسمح لهم بالتلصُّص على الداخلي، الرؤية بنصف عين والحكم بنصف معرفة، وبغضّ النظر عن الانتقادات التي تصف مخرجي الموجة الفلسطينية الجديدة بالرخاوة والبقاء في المنطقة الآمنة، لأنهم طوّروا سرديةً تبتعد عن النمط السائد في الفترة الأولى والثانية من السينما الفلسطينية، تركّز على اليومي كثيمة تقود المشاهد لمتوالية من الوقائع وتتلامس مع حياة الأفراد بواقعية تساهم في تشريح المواطن الفلسطيني من الداخل، ورصد وقائعه وحوادثه بصيغة معنيّة بحقوق المواطن الفردية في الحياة كإنسان طبيعي.
ويتمُّ هذا من خلال التعاطي مع ثنائية القمع الجمعي والمحاولات الفردية، تتسرّب المعاناة الحقيقية للشعب الفلسطيني من خلال العين الفردية والأحلام المؤقتة التي تتلاشى مع انقضاء اليومي وتتجدد بمواصلته، ويتبدّى الضيق المعيشي للفرد في محاولاته التي لا تنتهي من أجل تفكيك الحصار الاقتصادي والمعرفي قبل السياسي، وإرادته في تحقيق أكبر قدر من الأهداف اليومية قصيرة المدى التي تتقاطع بشكل يومي مع المكان كمِحبَس حائل بين الفرد وهدفه.
فيلم “200 متر” يكمل مسيرة مخرجين مثل هاني أبو أسعد وإيليا سليمان في إعطاء المواطن الفلسطيني الحق في أن يكون عاديًّا، بغضّ النظر عن لغتهم السينمائية التي تختلف عن مخرج فيلم “200 متر” أمين نايفة، ولكنهم جميعًا يسعون في الاتجاه نفسه بعيدًا عن الانشغال بالرواية التاريخية، يحاولون رصد ظواهر قمع المواطن في شتى أنماطها، يمنحونه الحق في العيش، ومن هنا تبدأ السردية بالتوهُّج، من أحقية الفرد بالعيش، ومن صدق نيته في إثبات تلك الحقيقة الغائبة عن الفرد الفلسطيني بشكل خاص.
يتحرك فيلم “200 متر” من كونه فيلمًا مكانيًّا من الدرجة الأولى، بدايةً من العنوان الذي يطرح نفسه كمسافة مادّية يمكن قياسها -فالاسم وحده يولِّد صورًا، ويرسِّخ للغة بصرية تصبح في بعض الأحيان مفتاحًا لفهم منهجية الفيلم-، ويهيّئ للمُشاهد أن يقرن تلك القيمة القياسية الضئيلة من المكان -إذا تمّت مقارنتها ببلدٍ كامل أو حتى حي صغير- بصعوبة الوصول.
فـ 200 متر يمكن أن تكون المسافة التي تفصل المشاهد عن أقرب بقّال، ولكن الأمور تختلف داخل الجانب الفلسطيني، فقياسات المكاني بالنسبة إليهم لا يمكن تقديرها بوحدات قياس مكانية، ولكن بوحدات زمانية، أي يوم أو يومَين وهكذا؛ لأن المكان يتخلّى عن كونه مساحة واسعة من الأرض يمكن اجتيازها بالمشي، ويستحيل إلى رحلة طويلة يمكن أن تستغرق أيامًا، لأن الفلسطيني ببساطة يفتقد لما يُسمّى العبور للجهة الأخرى، فكل الأبواب مغلقة أمامه، ووسائل العبور شرطية وتتقيد بأوقات معيّنة.
ولذلك يتحرّك الفيلم ممّا هو مكاني ومادي، وهذا يرسّخ لفرضية المكان ويؤسِّس لإشكالية الاحتجاز التي تناولتها السينما الفلسطينية بشكل متكرر في الموجة الجديدة، خصوصًا المخرج العظيم ميشيل خليفي، وهي إشكالية قمعيّة يتعاطى معها المواطن الفلسطيني بشكل يومي، ومن المادي والمكاني يأخذ الفيلم هذا المنحى بشكل كبير، فللأشياء المادية نوع من الشاعرية تقرّب المسافات، واستخدام المخرج لأدواته ليحاول تقريب المسافات حتى لو بشكل ظاهري يعطي الفيلم انطباعًا شاعريًّا.
فالحكاية تدور حول الأب مصطفى (الممثل علي سليمان) الذي تجبره الحياة على العيش في الضفة الغربية المحتلة، فيما تعيش زوجته سلوى (لنا زريق) وأولاده على الجانب الآخر من جدار الفصل العنصري في الجانب الإسرائيلي، ومن هنا تبدأ الحكاية كأقصوصة اجتماعية، يحاول فيها الأب بالعمل تحت ظروف مرض ظهره، الذي من المفترض أن يمنعه من العمل في الأساس كحرفي بنّاء يعمل في صبِّ المنازل وتأسيسها، والأم تحاول هي الأخرى من خلال قيامها بعملَين أن تربّي أبناءها على الجانب الآخر من الجدار.
والجدير بالذكر أن مصطفى رفض أن يأخذ الهوية الإسرائيلية، وفضّل المكوث في الضفة الغربية المحتلة على أن يتمَّ محي هويته الفلسطينية بشكل شبه كامل، وهذا يستدعي إشكالية الاضطراب الهوياتي الذي يعانيه المواطن الفلسطيني والذي يتمُّ طرحه بشكل جانبي، ولكنه يفرض نفسه بضرورة يجب التمسُّك بها.
ويقول المخرج أمين نايفة في لقاء له مع منصة “ثمانية”:
“جزء من القصة هو قصتي الشخصية. فوالدتي من قرية فلسطينية توجد اليوم على الجهة الأخرى من الجدار. جدار الفصل العنصري هذا غير قديم، غير موجود منذ الأزل مثلما يعتقد الكثيرون، فعمره 16 سنة فقط. ترعرعنا، إخوتي وأنا، في تعلّقٍ كبيرٍ بأهل والدتي، سيدي وستي وأخوالي. وفجأة، صرنا ممنوعين من رؤية جزء من عائلتي… آنذاك جلست رفقة صديقي الذي يسكن بقرية تشبه قرية الفيلم، قرية فصلها الجدار عن القرية المجاورة، على سطح منزلهم، نراقب المشهد أمامنا. انضمَّ إلينا زوج أخته الذي يشتغل عامل بناء في الأراضي المحتلة. حكى لنا أنه قبل الجدار، كان يشعل سيجارته هنا، ويطفئها هناك، والمسافة كلها لا تتجاوز الـ 200 متر”.
عاش أمين نايفة تلك الظروف، واستغرقت محاولته لأفلمتها والبحث عن منتج لها مدة 7 سنوات، ليُخرِجَ بعدها تجربته الروائية الطويلة الأولى، والتي حققت نجاحًا في العديد من المهرجانات. ويحاول نايفة من خلال فيلمه صنع عمل سينمائي شديد الخصوصية بالنسبة إليه هو المواطن الفلسطيني، ونتج عن تلك الأفلمة تجربة فيها الكثير من الشاعرية.
والشاعرية هنا ليست في صنع أجواء حميمية أو رصد بنى طبيعية جمالية، ولكن عن طريق محاولة التواصل في أحلك الظروف، شاعرية الارتباط هي من ترقّى بفعل الإشارات الضوئية -التي يطمأنُّ من خلالها الأب على أسرته- من مجرد محاولة إلى حشد هائل من المشاعر تجلب معها الكثير من الحزن، وتؤرِّخ لصور معاناة مكسورة بنشوة الوصول للآخر.
يحاول نايفة تأطير العمومي، والتعبير عن معاناة جمعيّة للشعب الفلسطيني في أقصوصة فردية، واختار الجدار ليمثّل عقبته الممتدة التي لا سبيل لهزيمتها ظاهريًّا، كحاجز رادع للأشخاص والأحلام وحتى المشاعر، وتطويع ذلك المخلوق الإسمنتي الوغد في فيلم امتدَّ ليتحوّر ويتحول إلى فيلم طريق (Road Movie)، ويكتسب ديناميكية وحيوية أكثر سواء في تقاطعه مع شخصيات عارضة على طول الطريق، أو محاولاته في تجاوز ذلك المأزق الذي يمتدُّ لمئات الكيلومترات.
وإذا لاحظنا فقد اقتصرَ وجود جنود الاحتلال داخل الفيلم على عدة مشاهد ضئيلة، ظهروا كأشياء عارضة، بَيدَ أنهم حاضرون من دون وجودهم، يتمثّلون في ذلك الجدار الرادع، الذي يلوح ضخمًا على امتداده المترامي، لا يمكن النفاذ منه، لذلك هو عنصر وجود الجانب المحتل في كل مكان، أشبه بمراقب له عيون في كل مكان، لا يمكن رؤيتها بَيدَ أن وجودها يحمل في داخله ازدراء واحتقارًا لا نهائيًّا من قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهذا الازدراء لا يمكن تصويره في إشكالية أخرى أكثر من إشكالية جدار الفصل.
وقد تمَّ استغلال ذلك العنصر بشكل جيد لتوضيح تلك النقطة داخل الفيلم، فمسافة 200 متر يقطعها العدّاء يوسين بولت في زمن 19.19 ثانية؛ ولكن في فلسطين المحتلة يمكن أن يستغرق الأمر أيامًا حتى يستطيع المرء أن يدلف فيما خلف الأسوار، يدخلون تهريبًا مثل بضائع تنسلّ بين أيادي موظفي الجمارك، وبهذا القدر من الجسارة والازدراء يتحول ما يستغرق الـ 20 ثانية إلى مدة أيام، وهذا هو مربط الفرس: الرحلة.
يضطر مصطفى أن يلقي بنفسه في أحضان المخاطرة، ليرى ابنه الذي في المستشفى على الجانب الآخر من الجدار، ويركب مع أحد المهرّبين، ليقابلَ شابًّا صغيرًا يُدعى رامي (الممثل محمود أبو عيطة)، ورامي ليس شابًّا ضئيلًا فقط، بل هو رمز للمحدودية الفلسطينية والتضييق الشديد على المجتمع الفلسطيني، فهو شاب لم يكمل الـ 18 عامًا بعد، يحاول أن يعبر الجدار ليجدَ عملًا في أي ورشة أو حرفة، هذه هي أحلامه، مجرد عمل يكتسب منه المال، وحيث يعمل سيقضي يومه وينام حتى اليوم التالي.
تظهر على رامي أمارات الطِّيبة والبلاهة، يعشق اللاعب محمد صلاح ويرتدي سوارًا حُفر عليه اسمه، لا يوجد شيء استثنائي في رامي، ولكنه وُلد في بيئة استثنائية لا يمكن مجابهتها بسذاجة، وهذه هي خطيئته الكبرى، فالأشخاص في فلسطين المحتلة ليس لديهم رفاهية الخطأ والسذاجة، من يخطئ سيموت بلا شك.
يلتقي مصطفى شابًّا آخر يدعى كفاح (الممثل معتز ملحيس) ومعه فتاة شقراء اسمها آن (الممثلة آنا أونتربيرغر) تدّعي أنها صانعة أفلام ألمانية، جاءت لتصوِّر فيلمًا وثائقيًّا أو تسجيليًّا عن رحلة كفاح فيما يدلف طريق التهريب من أجل حضور عرس قريبه.
كفاح هو شاب فلسطيني عادي، وطنه يقع في المرتبة الأولى، يجيد الإنجليزية عكس أغلب أفراد الرحلة، وهذا يعطيه ميزة إضافية بحيث يمكن أن يلفّق أي من الأقاصيص المزيَّفة حتى يتقبّل راكبو السيارة مواطنة أجنبية، دخيلة على بيئتهم ولغتهم.
أما شخصية آن التي لم يُفرد لها مساحة جيدة للتطور، أو يُفرش لها الأرضية لتصنع دوافعًا منطقية تتوافق مع سياق الفيلم، تبدو كشخصية مقتطَعة، كأحجية ناقصة، هذا لأن تضمينها داخل الحكي يمثّل إشكالية شائكة، من الضرورة محاولة فهمها، فهي شخصية نهمة لمعرفة شيء ما، تريد أن تؤكد صورة معينة أو أن تستبدلها، لا أحد يعرف، بيد أن الكشف عن حقيقة كونها إسرائيلية، يفرض سؤالًا يمكن تأويله بالكثير من الطرق.
ولكن هذا بالطبع ليس محاولة تطبيع أو غيره من دسّ لوثة ثقافية، بل محاولة استكشاف نفس بشرية تمثّل الضد بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني، عن طريق محاولة إقحامها داخل البيئة المحاذية لها، والتي بالطبع لم ترَها إلا في صورة تلفازية مزيَّفة، وهذا شيء جيّد، لأنه يفرض على الشخصية استخدام كل أدواتها المعرفية لفهم المجتمع والوصول إلى الصواب، بجانب إجبارها على مشاركة المعاناة نفسها كفرد داخل المنظومة يرى الأشياء كما يراها السكّان الأصليون، وهذا بالضرورة يترك أثرًا واضحًا في تكوين رأي عن القضية.
إنها محاولة للمكاشفة، ربما أخذت الكثير من الانتقاد بسبب المشهد الذي التقط فيه كفاح الكاميرا بغضب، وأمرَ آن بمسح الصور، ليتدخّل مصطفى ويردّ الكاميرا للفتاة. هذا المشهد لم يعطِ لشخصية كفاح المساحة الكافية لكي يكره، وهو مُحتَلّ ومحمّل بكمٍّ هائل من الصور والكتابات والتاريخ والوقائع.
لماذا لم يُسمَح لكفاح أن يغضب غضبًا هائلًا، أن يحزن بالشكل الكافي عندما اكتشف أنها تخدعه، وهو ابن شعب فلسطيني شعرَ في كل لحظة أنه يقع -دون إرادته- فريسة لبروباغندا يروِّج لها الجانب الصهيوني على أنها حقيقة كونيّة؟ لهذا كان يبدو خائفًا من أن تلفِّقَ هي الأخرى قصصًا غير حقيقية، وهذا حقّه في الأساس، لقد احتالت عليه منذ البداية، ولم نعرف -نحن المشاهدين- غرضها، وهذا كفيل بالتأكيد على هذه الرؤية.