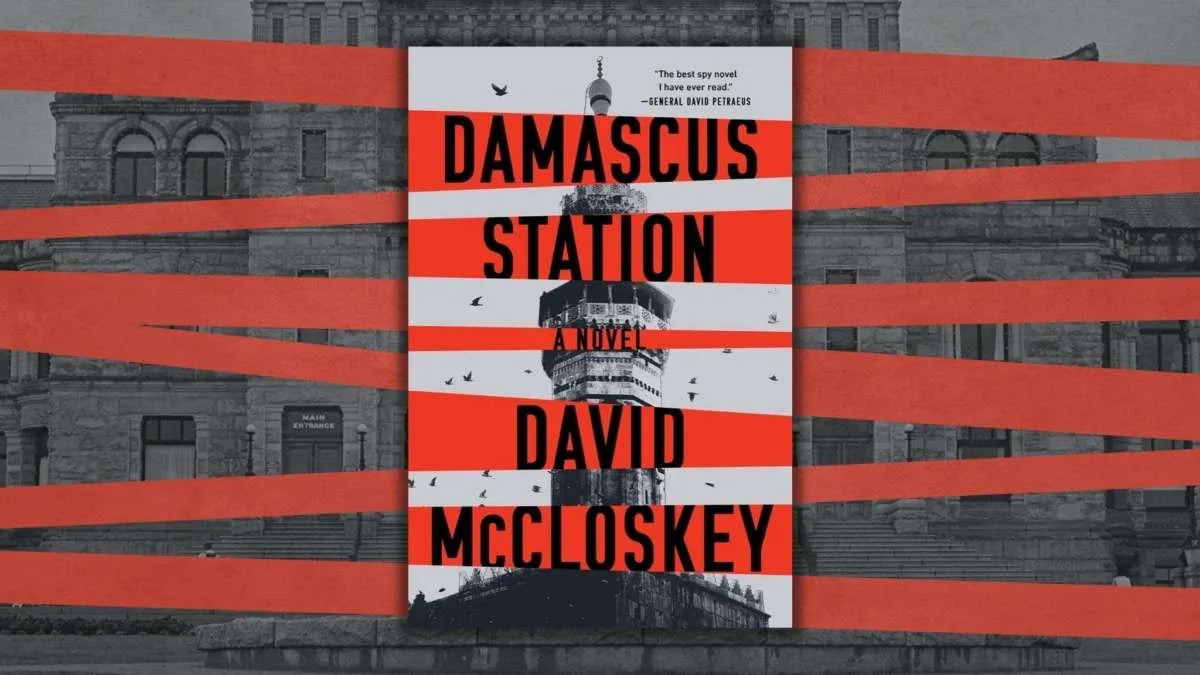لم تكن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية السودانية ممثلة في رئيس مجلس السيادة (قبل أن يُحل) عبد الفتاح البرهان، مفاجئة بالنسبة لكثير من المتابعين، كونها كانت نتيجة منطقية ومتوقعة لصراع النفوذ المحتدم بين المكونين المدني والعسكري منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
وبعيدًا عن التصريحات الإعلامية والشعارات الشعبوية التي كان يخاطب بها كل مكون الشارع الثائر، الحالم بدولة مدنية ديمقراطية، تلبي طموحاته في حياة كريمة، كان التوتر المكتوم شعار المرحلة، فمنذ الوهلة الأولى نجح العسكر خطوة تلو الأخرى في توسعة رقعة نفوذهم على حساب المدنيين الذين فشلوا في تحقيق التوازن في تلك المعادلة الصعبة، متوهمين أن الأمور باتت في قبضتهم وأن عقارب الزمن لن تعود للوراء مجددًا.
في هذه الإطلالة نلقي الضوء على أبرز المحطات في تلك العلاقة المعقدة بين العسكر والمدنيين، بدءًا بحالة الاحتفاء الشعبي عقب إعلان خبر تعيين البرهان رئيسًا للمجلس العسكري السوداني في أبريل/نيسان 2019، وصولًا إلى الانقلاب الذي نفذه أمس 25 أكتوبر/تشرين الثاني 2021، وهو التحرك الذي توقعه الجميع إلا القوى المدنية الحاكمة.
كلنا شركاء في الثورة
منذ انطلاق المظاهرات المناهضة للبشير في مدينة “عطبرة” بولاية نهر النيل في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، تجنب العسكر التصعيد الدموي مع المحتجين رغم سقوط البعض، فيما خرجت تصريحات بين الحين والآخر تشير إلى تأييد بعض الجنرالات لمطالب الغاضبين وعلى رأسها توفير الوقود والخبز.
ولم يستجب الكثير من قادة الجيش لأوامر البشير وقتها بالتصدي لتلك التظاهرات بالقوة، رغم انصياع البعض، الأمر الذي قاد في النهاية إلى إعلان وزير الدفاع – آنذاك – عوض بن عوف، اعتقال البشير في 11 أبريل/نيسان 2018، بعدما استقر في يقين المؤسسة العسكرية أن المتظاهرين لن يعودوا لمنازلهم إلا بعد تحقيق مطالبهم التي كان على رأسها إسقاط النظام.
ضرب العسكر عصفورين بحجر واحد، قدموا أوراق اعتمادهم لدى الشعب السوداني من خلال الاصطفاف مع مطالبهم واعتقال الرئيس، والتخلص من النظام سيئ السمعة وتقديم صورة مغايرة وفق أبجديات مختلفة تحفظ لهم مكانهم وسلطتهم فيما هو قادم، وبالفعل كان ما قد تم التخطيط له.
رفض المحتجون تولي بن عوف السلطة، كونه امتدادًا لنظام الإنقاذ، ما دفعه لتقديم استقالته، ليأتي عبد الفتاح البرهان، ذلك الوجه غير المألوف للشارع نسبيًا، وغير المحسوب بصورة كاملة من رجالات البشير، متصدرًا المشهد، متوليًا رئاسة المجلس العسكري المؤقت لإدارة شؤون البلاد في تلك المرحلة الحرجة.
عشرات آلاف السودانيين خرجوا في الشوارع والميادين احتفاءً بالبرهان، ذلك الرجل المستقل، القادم من رحم الثورة والاحتجاجات، تزامن ذلك مع موجة تصريحات تفاؤلية أصدرها الجنرال الذي وجد نفسه بين غمضة عين وانتباهتها حاكمًا للبلاد، دون أي مؤشرات.
بداية التوتر.. الانتخابات ومذبحة القيادة
بدأ التوتر بين المكونين بعد أقل من شهر على تدشين المجلس العسكري، الذي طالب وقتها بإجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي رفضه المحتجون، بزعم أنها محاولة لشرعنة النظام القديم مرة أخرى، في ظل عدم اكتمال الصورة بأركانها المختلفة، وعدم قدرة القوى الثورية على لململة شتاتها وترتيب أوراقها لخوض المرحلة الجديدة، وهنا هدد قادة الاحتجاج بتنظيم “عصيان مدني” في أرجاء البلاد ردًا على ما وصفوه بـ”تعطيل” نقل الجيش السلطة لحكومة مدنية.
وفي يونيو/حزيران وصل الصدام بين المكونين مداه مبكرًا، حين ارتكبت المؤسسة العسكرية ما عرف باسم “مذبحة القيادة العامة”، عندما شن نحو ألفي جندي تابعين للجيش وقوات الدعم السريع والشرطة هجومًا عنيفًا على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة اعتراضًا على مماطلة المجلس في تسليم السلطة للمدنيين، ما خلّف نحو 150 قتيلًا، وفقًا لبعض التقديرات، ورميت 40 جثة منهم في نهر النيل.
في تلك الأثناء خرج البرهان معلنًا توقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير والإعلان عن إجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، متهمًا القوى المدنية بالعمل على احتكار السلطة، فيما قطع المجلس العسكري الإنترنت عن معظم أرجاء البلاد التي دخلت في عصيان مدني شامل بدعوة من “تجمع المهنيين السودانيين”.
الوضع المتأزم دفع بعض الوسطاء للتدخل لتقريب وجهات النظر بين المكونين، كان على رأسهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي زار الخرطوم لتخفيف التوتر بين طرفي المجلس والمعارضة، هذا بخلاف الجهود الدبلوماسية التي قام بها الاتحاد الإفريقي، وأسفرت في النهاية عن وثيقة تقسيم السلطة.
تقسيم السلطة دون انتخابات
في يوليو/تموز 2019 وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الوثيقة الأولى لاتفاق تسليم السلطة، شملت بنودًا عامة عن إدارة المرحلة وتقاسم الحكم بين المكونين، وفي الشهر التالي مباشرة أقيمت مراسم توقيع الوثيقة بحضور رؤساء دول وحكومات، التي أقرت فترة انتقالية تقدر بنحو 3 سنوات، وتشكيل مجلس سيادة من 11 عضو (5 مدنيين يختارهم الحرية والتغيير و5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين الطرفين).
بحسب الوثيقة يرأس مجلس السيادة المشكل شخص عسكري في الـ21 شهرًا الأولى وتنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أما الـ18 شهرًا المتبقية فيرأسها عضو مدني، أما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة فتشير الوثيقة إلى أنها تتكون من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز عددهم العشرين، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.
مع اقتراب موعد تسليم السلطة للمدنيين، بدأ العسكر في نصب فخاخهم للمدنيين، البداية كانت بتوقيع اتفاق سلام مع بعض الجماعات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهو الاتفاق الذي عدل موعد تسليم السلطة
كان عبد الله حمدوك، ذلك الاقتصادي الأممي، صاحب الخبرة التي تزيد على 30 عامًا في مجالات التنمية الاقتصادية في إفريقيا، على رأس المرشحين لتولي المسؤولية كأول رئيس حكومة في المرحلة الانتقالية، إذ قام بداية بدور الوساطة بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، ليتم اختياره رئيسًا للحكومة، وبالفعل أدي اليمين الدستورية في منتصف أغسطس/آب 2019 كرئيس وزراء السودان الجديد.
الرغبة في الحصول على حصة من تورتة الحكم دفعت المكونين لقبول الوثيقة بوضعيتها تلك رغم تباين الآراء بشأن مضمونها وقراءتها قراءة صحيحة، فيما تم إقصاء بقية القوى والتيارات، وهو المسمار الأول الذي دقه العسكر في نعش المدنيين الذين انغمسوا في عسل السلطة والحكم دون قدرة على استقراء المشهد من زواياه الجانبية.
الخلافات تخرج للعلن
لم يستمر شهر العسل طويلًا بين المكونين، ففي أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، أصدر حمدوك قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت في مذبحة فض الاعتصام، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة العسكر بصورة دفعتهم لعرقلة أي إجراءات تتم في هذا المسار، وهو ما كان له تبعاته السلبية على جماهيرية الحكومة وكشفت بشكل كبير نوايا الجنرالات الحقيقية.
ثم جاء التحرك المنفرد من العسكر بالتطبيع مع “إسرائيل” لتزيد الخلافات، حتى إن قبل بعض أعضاء الحرية والتغيير بهذه الخطوة، ففي فبراير/شباط 2020، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أنه التقى البرهان في عنتيبي بأوغندا، وأنهما اتفقا على بدء حوار من أجل “تطبيع العلاقات” بين البلدين، وهو اللقاء الذي نفت الحكومة علمها به.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، أعلن ترامب تطبيعًا رسميًا بين “إسرائيل” والسودان، وهو الإعلان الذي كشف التوترات بين أجنحة السلطة في البلاد، بين الذين يؤيدون تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” وغالبية المواطنين الذين يرفضون إضفاء طابع رسمي على العلاقات.
وكان وزير الخارجية المكلف في الحكومة الأولى لحمدوك، عمر قمر الدين، قد ألمح إلى أن المكون العسكري في الحكومة هو الذي اتخذ قرار الانضمام إلى الإمارات والبحرين لبدء العلاقات مع “إسرائيل”، وما كان لرئيس الحكومة إلا التماشي مع هذا التوجه على مضض، وهو ما لم يقنع الشارع وزاد من الاحتقان بين العسكر والمدنيين في الوقت ذاته.
فخاخ العسكر
مع اقتراب موعد تسليم السلطة للمدنيين، بدأ العسكر في نصب فخاخهم للمدنيين، البداية كانت بتوقيع اتفاق سلام مع بعض الجماعات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهو الاتفاق الذي عدل موعد تسليم السلطة بعدما أدخل عليها بعض الإضافات المتعلقة بالأطراف المشاركة في الحكم وحصصها السلطوية.
في تلك الأثناء، لعب المكون العسكري على أوتار فشل الحكومة في التعاطي مع ملفات المواطنين الحياتية، وهو ما تسبب بشكل أو بآخر في زيادة وتيرة الانقسامات داخل الجسم المدني، فبدأت الانشقاقات تتوالي، أولها كان وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وهم أعضاء في الحكومة، متهمين قوى الحرية والتغيير بصفتها الحاضنة السياسية للحكومة، بإقصائهم واختطاف الثورة من الثوار.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت المؤسسة العسكرية عن إجهاض محاولة انقلابية فاشلة كانت تهدف للسيطرة على الحكم، وسط اتهامات للعسكر بافتعال تلك الأزمات لإضعاف الحكومة، تزامن ذلك مع احتجاجات متصاعدة في الشرق تطالب بإقالة حكومة حمدوك وسط تأييد ضمني للجنرالات وصمت مطبق مثير للجدل من المؤسسات العسكرية والشرطية رغم ما تمثله تلك المنطقة من أهمية إستراتيجية للبلاد.
ثم جاءت دعوة الفصيل العسكري في الحكومة ومجلس السيادة بتوسيع الحاضنة السياسية للسلطة، ودعم وتأييد الانشقاقات بداخل التحالف المدني، ممثلًا في “مجموعة الميثاق” التي تضم كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحاليّ، التي دعت للخروج في “مواكب” للمطالبة بإقالة حكومة حمدوك.
وفي أريحية كاملة ودعم غير مسبوق، مهد العسكر الطريق أمام المنشقين لتدشين اعتصام بالقرب من القصر الرئاسي، ضم العديد من التيارات الدينية والسياسية، مطالبين بالإطاحة بحكومة حمدوك وتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط بإشراف ودعم عسكري، وهي المطالب التي تناغمت مع تصريحات بعض الجنرالات بأن الجيش لن يترك المشهد ولن يتخلى عن السلطة للمدنيين، متهمًا إياهم بالمسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الراهنة.
انقلاب كامل الدسم
بعد ساعات قليلة من انتهاء المباحثات التي أجراها المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان، مع أطراف المكونين العسكري والمدني في البلاد وتقديم حزمة من المقترحات التي اتفق البرهان وحمدوك التشاور بشأنها، استيقظ السودانيون فجر 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على موجة اعتقالات غير مسبوقة، شملت رئيس الحكومة ومعظم الوزراء وقيادات سياسية ورؤساء أحزاب، بجانب السيطرة على مبني الإذاعة والتليفزيون وانتشار كثيف في الشوارع والطرقات.
وفي منتصف اليوم ذاته خرج البرهان في بيان متلفز له معلنًا حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وتجميد عمل لجنة التمكين وإعفاء وكالات الوزارات والمديرين، وتكليف المؤسسة العسكرية بإدارة المرحلة الحاليّة لحين إجراء انتخابات.
المؤشرات التي تقود لهذا الانقلاب كانت واضحة منذ البداية، انقلاب يراه الجميع إلا شركاء السلطة من المدنيين الذين استقووا بالجيش حتى استقوى عليهم
وبعيدًا عن توصيف ما حدث، سواء كان “انقلابًا كامل الدسم” كما تصفه وزارة الإعلام والثقافة – التي قيل إن وزيرها اعتقل من منزله بالملابس الداخلية -، أو “تصحيح مسار الثورة” كما يسميها البرهان، فإن النتيجة واحدة، سيطرة العسكر على المشهد والإطاحة بالمدنيين، والانقلاب على الوثيقة الدستورية ومنحهم السلطة المطلقة في إدارة المرحلة دون منافس أو شريك.
وردًا على هذا التحرك دعت القوى الثورية لحشود ضخمة لاسترداد البلاد من قبضة العسكر فيما أعلنت العديد من الكيانات والمنظمات العمالية والمهنية إضرابها عن العمل، وسط ردود فعل دولية وإقليمية منددة بما حدث، مطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي وتفعيل بنود الوثيقة الدستورية والالتزام بما جاء في بنودها التي تشير إلى تسليم السلطة للمدنيين الشهر القادم.
مسؤولية مشتركة
ما كان للعسكر أن ينقلبوا على الوثيقة الدستورية والمسار الديمقراطي دون مساعدة القوى المدينة التي قدمت له هدية على طبق من ذهب، من خلال فشلها الواضح في إدارة المشهد وتعميق حالة الاحتقان ضدها بجانب الشروخات التي ضُربت بها جدرانها فباتت من الهشاشة ما لا يمكنها الصمود أمام أقل تيارات الاستهداف السياسي والأمني.
قوى الحرية والتغيير، بصفتها الحاضنة السياسية للتيار المدني، ارتأت منذ الوهلة الأولى الارتماء في أحضان العسكر، والاحتماء بهم من التيار الإسلامي المغضوب عليه، وبعض القوى المدنية الأخرى، فضلًا عن عدد من الجماعات المسلحة، (رغم تجارب التاريخ التي تؤكد أن العسكر لا أمان ولا عهد لهم) ما أوقعها في شرك الإقصاء، فباتت في مرمى الانتقادات والهجوم من ضحاياها، كيانات كانوا أو أفراد.
ومنذ الإطاحة بالبشير توالت التحذيرات من التحالف مع العسكر، الذي وصفه البعض بـ”شراكة الدم”، غير أن التحالف المدني رأي في الاصطفاف مع ما يمكن تسميته “التيار غير المؤدلج” في الجيش، سبيلًا نحو تحقيق أحلامه السياسية في بناء دولة مدنية ديمقراطية، مستندًا في ذلك إلى الشارع الذي بدأ يُسحب البساط من تحت أقدامه رويدًا رويدًا.
المؤشرات التي تقود لهذا الانقلاب كانت واضحة منذ البداية، انقلاب يراه الجميع إلا شركاء السلطة من المدنيين الذين استقووا بالجيش حتى استقوى عليهم، ظنًا أن الذئب الذي وضعوه في فناء البيت لا يمكن أن يلتهم أصحابه ممن أنزلوه منزل كرم وأغدقوا عليه العطايا حتى كانوا أول ضحاياه.
اليوم تدفع القوى المدنية ثمن ما قدموه من تنازلات للعسكر باهظًا للغاية، ربما يكلفها حياة قادتها وحريتهم، كما أنه قد يجهض تجربتهم الثورية الديمقراطية، غير أن الستار لم يسدل بعد عن المشهد الأخير في تلك المسرحية التراجيدية، فالحشود التي خرجت احتجاجًا على انقلاب العسكر ورفضًا لعودة البلاد لعصور الظلام الديكتاتورية مرة أخرى ربما تصحح مسار الثورة من جديد، بعدما سقطت كل الأقنعة، وانجلت الصورة تمامًا حتى يستطيع السودانيون – استفادة من دروس التاريخ وتجارب الدول المجاورة – بناء دولتهم، على أسس نظيفة، انطلاقًا من القاعدة الفقهية “التخلية قبل التحلية”.