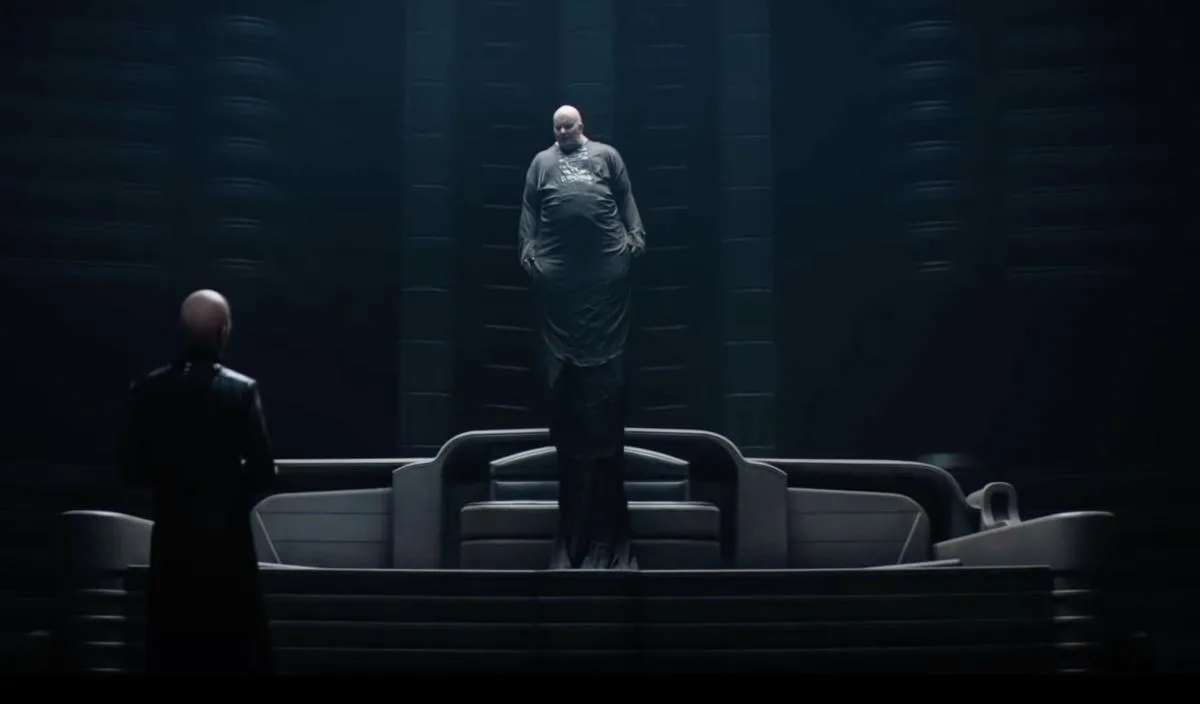أطلقت 3 منظمات كبرى معنية بحماية الصحفيين والدفاع عنهم ما أسمته بـ”المحكمة الشعبية للتحقيق في قتل الصحفيين” في لاهاي، بهدف تسليط الضوء على الجرائم بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة من خلال محكمة العدل الدولية.
وتسعى المنظمات الثلاثة المشكلة لهذا الكيان: “لجنة حماية الصحفيين” و”مراسلون بلا حدود” و”فري بريس أنليميتيد”، من وراء المحاكم الشعبية إلى مساءلة الدول عن انتهاكات القانون الدولي من خلال العمل على تشكيل الوعي العام وإعداد سجل قانوني بالأدلة وأداء دور مهم على صعيد تمكين الضحايا وتسجيل قصصهم.
ومن المقرر أن تتخذ تلك المحكمة طابع العدالة الشعبية وتعتمد على تحقيقات وتحليلات قانونية عالية الجودة تتناول حالات قتل محددة في ثلاث بلدان كمرحلة أولى، المكسيك وسوريا وسريلانكا، وستعقد جلساتها حتى اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو/أيار 2022.
ورغم أن دائرة الاتهام تقتصر على 3 دول فقط، كنقطة انطلاق مبدأية لتعميم التجربة، فإن المحكمة في حد ذاتها تمثل تحذيرًا أوسع للبلدان التي ترتكب انتهاكات بحق الصحفيين خاصة الدول القمعية في الشرق الأوسط، الأمر الذي ربما يضع السعودية والإمارات ومصر وسوريا تحديدًا في مرمى الاتهام خلال المرحلة القادمة.
إنصاف الصحفيين
تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع تزايد معدلات العنف ضد الصحفيين خلال الآونة الأخيرة، فوفقا لـ”لجنة حماية الصحفيين”، فقد قُتل 278 صحفيًا خلال العقد الماضي بين عامي 2010 و2020، فيما قُتل أكثر من 1400 صحفي في مختلف أنحاء العالم منذ عام 1992 وحتى اليوم، هذا في الوقت الذي ظل فيه القتلة أحرارًا، فمن بين كل عشرة جرائم قتل للصحفيين هناك 8 من المتورطين فيها لم تطلهم يد العدالة والمحاكمة.
ربما لا تملك المحكمة قرارات إلزامية لإدانة القتلة، أنظمة كانوا أو كيانات أو أفراد، وهو ما يقلل من ثقلها القانوني الرسمي، لكنها من جانب آخر ستؤدي حتمًا إلى فرض طوق من الضغط المستمر على أعناق الحكومات السلطوية وفضح جرائمها أمام العالم بما يمهد الطريق لفتح طرق عقابية أخرى أكثر تأثيرًا من مجرد المحاكمة الصورية.
وعقدت الجلسة الافتتاحية للمحكمة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، برئاسة محامي حقوق الإنسان البارز المودينا برنابيو، فيما شارك آخرون بشهاداتهم بشأن وقائع انتهاكات بحق صحفيين، أبرزهم الصحفية الفلبينية المعروفة ماريا ريسا، والأكاديمية خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل عام 2018، والصحفي ماثيو كاراوانا غاليزيا، وهو نجل الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا التي قُتلت عام 2017، والصحفية الاستقصائية بافلا هولوكوفا، وهي زميلة الصحفي السلوفاكي يان كوتشياك الذي قُتل عام 2018.
من جانبه علق مدير السياسات والبرامج بمنظمة صحافة حرة بلا حدود، ليون ويلمز، على تشكيل المحكمة قائلًا “لقد قُتل عدد كبير جدًا من الصحفيين الشجعان بسبب قيامهم بعملهم الحيوي: وهو نقل الحقيقة. تطالب المحكمة الشعبية بتحقيق العدالة في هذه الجرائم البشعة وتخلق الحافز من أجل تعبئة جهود الدول لمواجهة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. يمكننا، بل ويتوجب علينا، القيام بالمزيد من أجل جلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. يشكل ذلك عامل إلهام بالنسبة لمشروع “عالم أكثر أمانًا من أجل الحقيقة””.
خلال عام 2020 هناك 89 صحفياً سجيناً في 10 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أعلى رقم تسجله المنطقة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بإحصاء أعداد الصحفيين السجناء سنة 1992
أما المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سيمون، فأوضح أن المحكمة ” تودي دورًا مهمًا على صعيد إنصاف هؤلاء الصحفيين الشجعان، كما أنها تمنح أفراد عائلاتهم وزملائهم فرصة ليوصلوا أصواتهم ويشاركوا الآخرين قصصهم الخاصة وليتحدثوا عن الأثر الذي تركته هذه الجرائم الوحشية. وقد عمل أقارب الضحايا بلا كلل كي تبقى قصص هؤلاء الصحفيين حية، وذلك رغم ما لاقوه من تهديدات ومضايقات في أغلب الأحيان. وقد كان صوتهم عاملًا حاسمًا في مواصلة الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب”.
فيما صرح الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوير، بالقول: “يصادف موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية في 2 نوفمبر/تشرين الثاني اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. ولا تقف هذه المبادرة عند مجرد تسمية السلطات التي تسمح بمثل هذا المستوى المفزع من الإفلات من العقاب وفضحها، بل تتخطى ذلك إلى ضرب مثال مادي ملموس ومفيد لما يتوجب على القضاء القيام به”.
وقد اختتم ممثل الادعاء في المحكمة، ورئيس الجلسة الافتتاحية، المودينا برنابيو، قائلًا: “حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن وتيرة الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الصحفيين وما يصاحبها من مستويات عالية وشائعة للإفلات من العقاب تقرع ناقوس الخطر. لقد حان الوقت لمساءلة الدول عن ذلك”.
الصحفيون العرب.. انتهاكات مستمرة
خلال العقد الأخير شهدت الأسرة الصحفية العربية موجات من التنكيل والاستهداف والقتل والاعتقال والمصادرة وتضييق الخناق، فقد كشفت ثورات الربيع العربي أهمية وتأثير الدور الذي تقوم به الصحافة في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية وهو ما دفعها للانتقام بعد إجهاض تلك الثورات.
لجنة حماية الصحفيين وثقت العديد من الاتجاهات التي استخدمتها النظم العربية لإسكات التغطية المستقلة واستهداف الصحفيين بصفة فردية خلال السنوات العشرة الماضية التي تلت انطلاقة الربيع العربي، وأوقعت تلك الدول في مرمى الانتقادات الدولية وتراجع ترتيبها في مؤشرات حرية الصحافة بصفة عامة.
الاتجاه الأول التي وثقته اللجنة “سجن الصحفيين”، فخلال عام 2020 هناك 89 صحفيًا سجينًا في 10 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أعلى رقم تسجله المنطقة منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بإحصاء أعداد الصحفيين السجناء سنة 1992، لافتة إلى أن الأنظمة الديكتاتورية تستخدم هذا الأسلوب لمنع تغطية القضايا السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان ولإسكات صوت تلك التغطية وتكميم الأفواه المعارضة.
التوثيق كشف أن مصر والسعودية تحديدًا كانتا على رأس الدول العربية الأكثر سجنًا للصحفيين خلال العقد الأخير، ففي الرياض على سبيل المثال لم يكن هناك صحفي واحد داخل السجن عام 2011 لكن سرعان ما تغير الأمر في العام التالي، الأمر ذاته مع السلطات المصرية، إذ يقبع داخل السجون الأن أكثر من 27 صحفيًا بتهم تتعلق بآرائها ومواقفها السياسية.
يبقى رد الفعل الدولي إزاء نشاط المحكمة وتوصياتها وما إذا كانت ستتمكن من ممارسة ضغوط ذات مغزى على المجتمع الدولي لكي يتخذ إجراءات رسمية، هو الفيصل في التقييم
كما لجأت السلطات القمعية في الدول العربية إلى الرقابة على الإعلام الإلكتروني من خلال حزمة من القوانين والتشريعات، التي مهدت الطريق نحو فرض عقوبات بحق عشرات المواقع ومحاكمة مسؤوليها، غرامة وسجنًا، هذا بجانب حجب المواقع بزعم نشر أخبار كاذبة، وهو ما حدث في مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
ومن أكثر الإستراتيجيات التي استخدمتها تلك الأنظمة الكارهة للحريات الإعلامية، تجريم العمل الصحفي، فخلال العقد الأخير لجأت حكومات المنطقة وعلى نحو متزايد إلى استخدام القوانين المتعلقة بمناهضة الدولة وممارسة الإرهاب، بدلاً من قوانين النشر والإعلام، وتتصدر مصر قائمة دول العالم في سجن الصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة.
هذا بجانب جرائم القتل المستهدفة والإفلات من العقاب، فقد شهدت المنطقة خلال العقد الماضي مقتل 50 صحفيًا، بما في ذلك جريمتا قتل دُبرتا على مستوى رسمي رفيع لم تتم مساءلة مرتكبيهما، تزامنًا مع مراقبة الصحفيين والقنوات الإعلامية، ففي أعقاب تظاهرات عام 2011 التي هزّت المنطقة، ضاعفت السلطات من جهودها لمراقبة أنشطة الصحفيين وغيرهم ممن ترى أنهم يشكلون تهديدًا محتملًا لسلطتها.
كل تلك الاتجاهات والإستراتيجيات المتبعة أفرزت بيئة فتاكة للعمل الصحفي، فمنذ انطلاق ثورات الربيع العربي، باتت الممارسات الإعلامية برمتها مغامرة ربما تكلف صاحبها حياته وحريته ثمنًا لها، وهو ما تترجمه أرقام الضحايا من العاملين في الحقل الإعلامي لا سيما في الدول ذات النزاعات وعلى رأسها سوريا واليمن والعراق.
خطوة على الطريق الصحيح
قد يكون هذا التحرك خطوة جيدة في الطريق الصحيح نحو حماية الصحفيين، لكن من المبكر لأوانه تقييم أداء تلك المحكمة وما يمكن أن يصدر عنها من قرارات، بعيدًا عن مدى إلزامية تنفيذها وإجبار السلطات بها، خاصة أنها تفتقد للقوة القانونية النافذة.
ويبقى رد الفعل الدولي إزاء نشاط المحكمة وتوصياتها وما إذا كانت ستتمكن من ممارسة ضغوط ذات مغزى على المجتمع الدولي لكي يتخذ إجراءات رسمية، هو الفيصل في التقييم، فلطالما أفلتت الدول القوية ورؤساء الدول من العقاب على جرائمها بحق الصحفيين.
ووفق التجارب الأخيرة فقد نجحت مثل تلك الإستراتيجيات الضاغطة في فضح انتهاكات بعض النظم السلطوية العربية، ولعل الانتقادات التي تعرضت لها السعودية عقب مقتل جمال خاشقجي واحدة من أكثر التجارب العملية على إمكانية تأثير أدوات الضغط الحقوقية رغم ضعف ثقلها القانوني، الوضع كذلك إزاء نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يعاني جدار الحريات الصحفية في عهده من ثقوب عارية.
وفي الأخير تأتي “المحكمة الشعبية للتحقيق في قتل الصحفيين” كجزء من منظومة أكبر من الضغوط التي يجب أن تمارس على الأنظمة الاستبدادية، في مقدمتها الحكومات العربية الديكتاتورية، لدفعها نحو التغيير وفق أبجديات أكثر مرونة وحرية، مع الوضع في الاعتبار أن المحكمة وحدها لن تكون كافية دون زخم سياسي وإعلامي وحقوقي يجبر كل القوى الدولية التي ترفع شعارات الحريات والحقوق على اتخاذ إجراءات أكثر قسوة بحق تلك السلطات المتورطة في هذه الجرائم.. كرة جديدة تلقى في ملعب المجتمع الدولي.. فهل يسجل هدفًا هذه المرة أم ستكون الغلبة – كالعادة – للغة المصالح وتحالفاتها؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة.