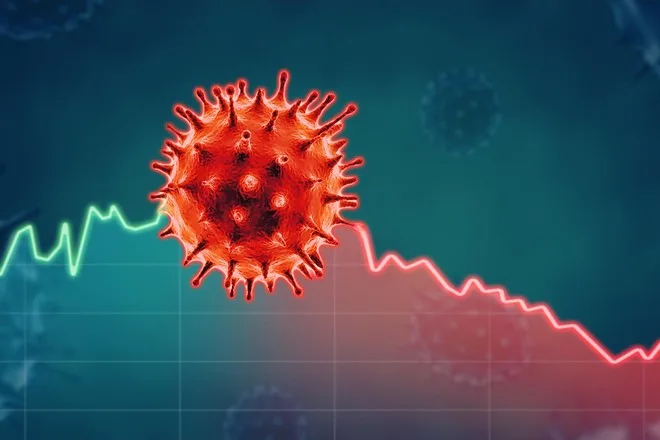ترجمة وتحرير: نون بوست
ما هي القوى التي تدافع عن الديمقراطية الليبرالية؟ ما هي القوى التي يمكن أن تمزق الديمقراطية الليبرالية؟ كانت هذه بعض من الأسئلة التي تدور في ذهني عندما استمعت في وقت سابق من هذه السنة إلى خطاب وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، دافع فيه عن مشروع قانون طُرح للتصويت.
عُقد الاجتماع في مجلس الشيوخ الفرنسي، وهو عبارة عن مكان أنيق يشبه دار الأوبرا، وكان مشروع القانون الذي طرحه بلانكير يبدو عظيما، وأطلق عليه اسم “مبادئ الجمهورية ومحاربة الانفصالية”.
ألقى بلانكير خطابه على الأرضية الرخامية، وخلفه تمثال جان بابتيست كولبير، مهندس فرنسا الشهير في القرن السابع عشر. صُممت ضفائر كولبير على طول الكتفين لتتباين مع التاج المصقول. أصبح مشروع قانون مناهضة الانفصالية، الذي تحوّل إلى نص قانوني، أحدث فصول المعركة المستمرة منذ قرون بين الدولة الفرنسية والأديان.
صُمم هذا القانون الذي أيدته حكومة إيمانويل ماكرون لتعزيز نفوذ العلمانية، وهو مصطلح يُترجم بشكل غير دقيق، وقد أصبح مشحونا سياسيا وأكثر تعقيدا من السابق.
الكل يسمع عن “الحرية، المساواة، الأخوة“، لكن العلمانية هي التي تحدد معالم تطبيق هذه المبادئ في المعركة الشرسة التي تخوضها فرنسا المعاصرة. ظهر المصطلح للتعبير عن إصرار فرنسي فريد على أن الدين، إلى جانب الرموز الدينية ومنها اللباس، يجب أن لا يظهر في المجال العام. لم تتبع أي دولة أخرى في أوروبا هذا المسار.
تنحدر الكلمة نفسها من المصطلح اليوناني القديم “الشعب” أو “العلمانيين”، لتمييز هذه الطبقة عن الكهنوت. لا تعني العلمانية الحرية الدينية (يضمن الدستور الفرنسي حرية ممارسة الدين)، ولكن ما تعنيه أحيانًا هو التحرر من الدين. في الوقت الذي تستمر فيه الهجمات الإرهابية التي تستند إلى الدين في إلحاق الأذى بفرنسا، أصبحت العلمانية متشابكة بشكل وثيق مع قضايا الهوية الوطنية والأمن القومي.
من المرجح أن يصطدم ماكرون مرة أخرى مع منافسته مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني، وهو الحزب الذي يقوم على بث الخوف من المهاجرين والإسلام، في بلد يشكل فيه المسلمون حاليا 8 بالمئة من عدد السكان.
يمثل مشروع القانون الذي ناقشه بلانكير في مجلس الشيوخ الفرنسي مناورة سياسية متعددة الجبهات، وهو مثال كلاسيكي على نهج التثليث الذي سنّه ماكرون، السياسي الوسطي الذي أسس حزبا جديدا لاستقطاب الأصوات من اليمين.
كان ذلك في المقام الأول جزءًا من جهود فرنسا لمحاربة الأصولية الإسلامية بعد سنوات من العنف. كما كانت صدّا ضمنيا لتركيا، الداعم الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي تمتلك نفوذا في بعض المساجد الفرنسية. ونظرا لأنه يساند المبدأ الأعلى “للقيم الجمهورية”، فقد كان أيضا وسيلة لحرمان اليمين واليمين المتطرف من حشد مؤيديه قبل انتخابات الربيع المقبل.
ومن المرجح أن يصطدم ماكرون مرة أخرى مع منافسته مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني، وهو الحزب الذي يقوم على بث الخوف من المهاجرين والإسلام، في بلد يشكل فيه المسلمون حاليا 8 بالمئة من عدد السكان.
في شهر أيلول/ سبتمبر، مثل عدد من الجهاديين أمام المحكمة بتهم تتعلق بهجمات 2015 في باريس، التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا، من بينهم 90 شخصا كانوا داخل قاعة باتاكلان. وقعت تلك الهجمات بعد أشهر فقط من المجزرة التي ارتكبها متشددان في صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة.
بالنسبة لأولئك الذين عاشوا ذلك الوقت العصيب في باريس، كما حدث معي، أحيت المحاكمة ذكريات قاتمة. كانت أكبر محاكمة في تاريخ فرنسا، بحضور أكثر من 1000 مدعٍ، ومن المتوقع أن تستمر لمدة تسعة أشهر.
كما أدت حادثة إلى تعميق الانقسامات، حيث قُطع رأس المدرس صامويل باتي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 قريبا من باريس. يُذكر أن باتي نشر رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد لشرح مبدأ حرية التعبير، وقد فعل ذلك بعد أن حث أي طالب منزعج من الصور على مغادرة المكان، كما أفادت التقارير.
قُتل باتي على يد متشدد يبلغ من العمر 18 سنة، وهو مهاجر من الشيشان سرعان ما حاصرته الشرطة وقتلته. لم تُعجّل جريمة القتل التي أثارها دفاع باتي عن القيمة الأسمى للجمهورية، وهي حرية التعبير، بتمرير مشروع قانون مناهضة الانفصالية، لكنها سببت ضغوطا هائلة على الحكومة. قال ماكرون عن القاتل “لقد أراد ضرب الجمهورية وقيمها. هذه هي معركتنا، وهي معركة وجودية”.
تم تمرير مشروع قانون مناهضة الانفصالية في شهر تموز/ يوليو تحت شعار تأكيد احترام مبادئ الجمهورية، وهو يفرض قيودا أكثر صرامة على المنظمات والجمعيات الدينية (يتم تمويل العديد من المساجد في فرنسا من الخارج)، ويمنح الدولة سلطة واسعة لإغلاق أي دور عبادة مؤقتًا إذا كانت هناك شكوك في التحريض على الكراهية أو العنف.
كما يفرض القانون قيودا أكثر صرامة على طالبي اللجوء، ويرفض منح تصاريح إقامة للرجال متعددي الزوجات، ويمنح الدولة مزيدا من الصلاحيات لمنع الزواج إذا تم إكراه المرأة على ذلك.
علاوة على ذلك، يحظر القانون على الأطباء منح النساء شهادات العذرية، وهي ممارسة مرتبطة ببعض الزيجات الدينية. كما اقترح مجلس الشيوخ، بأغلبية يمينية، تعديلات أخرى تم إلغاؤها لاحقا، من شأنها أن تمنع النساء من ارتداء البوركيني (وهو لباس محتشم ترتديه المرأة المسلمة أثناء السباحة) في حمامات السباحة العامة، أو ارتداء الحجاب عند مرافقة الطلاب في الرحلات المدرسية. الجدير بالذكر أن القانون الفرنسي يحظر ارتداء كل ما يرمز للمعتقدات الدينية في المدارس الابتدائية والثانوية العامة، بما في ذلك الحجاب والكيباه والصلبان الكبيرة.
وقد شجب رجال دين مسلمون وكاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس القانون الجديد، قائلين إنه يقيد حرية تأسيس الجمعيات (تجنبت الجالية اليهودية في فرنسا، التي صُدمت من جرائم الكراهية ومعاداة السامية، الإدلاء برأيها، على الرغم من أن بعض القيادات المنظمة أيدت القانون). وأدان علماء ومؤرخون هذا القانون باعتباره إجراء لا يضيف شيئا للقوانين القائمة، وتكريسا لسلطة الدولة في الشؤون الدينية.
في عصر ذلك اليوم في مجلس الشيوخ، انتقد بلانكير التعليم المنزلي، وهو شكل من أشكال التعليم الذي تتبناه الأقليات الدينية في بعض الأحيان، كما أنه شائع لدى عائلات الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية أو احتياجات خاصة.
سعت الولايات المتحدة، التي تضمن حرية الدين، إلى حماية الدين من تدخل الدولة، في حين سعت فرنسا، من خلال ضمان حرية الدين، إلى حماية الدولة من التدخل الديني. كان لهذا الاختلاف الكثير من التداعيات
قال بلانكير لأعضاء مجلس الشيوخ إن استغلال مثل هذه “المساحات الموازية” يمثل “إلغاء للتعليم المشترك”، وهي مساحة يتم فيها التعرف على “قيم الجمهورية”. يقتضي القانون الجديد الحصول على تصريح خاص من الحكومة لتلقي دروس في المنزل، ولا تتعلق أي من الظروف المسموح بها بالدين.
هكذا يتضح جوهر الفلسفة الفرنسية. في حين يعتبر مفهوم “واحد من المجموعة” نموذجا أساسيا في الولايات المتحدة، حيث يمكن للوحدة -على الأقل من الناحية النظرية- أن تستوعب الاختلاف، فإنه يُنظر إلى الاختلاف في فرنسا على أنه تصدع.
يبدو التناقض بين فرنسا والولايات المتحدة واضحا، إلا أنه يخفي في طياته تحديا مشتركا. سواء كانت القضية تتعلق بالدين أو العرق أو المكان، تحاول الدولتان وضع القواعد التي توحد بها مجموعات متنوعة وتعمل ضمن كيان واحد، وهي ليست ممارسة أكاديمية. لن تنجو الدول الديمقراطية الليبرالية إذا لم تتمكن من تحقيق التوازن.
تاريخ بعض البلدان متشابك بعمق، مثل تاريخ فرنسا والولايات المتحدة. تعتبر هاتان الدولتان نتاج عصر التنوير، ويرى كل منهما نفسه منارة بين الأمم. كلاهما يجسد الفصل الواضح بين الكنيسة والدولة. ففي الولايات المتحدة، يتم تحديد الفصل من خلال التعديل الأول، والذي يحظر على الحكومة سن أي قانون “يتعلق بتأسيس ديانة” أو يعيق الممارسة الحرة للدين.
يعتبر التعديل الأول مستوحى من قانون فيرجينيا للحرية الدينية، وتم تبنيه سنة 1786، وقد صاغه توماس جيفرسون. كان جيفرسون سفيرا في فرنسا عندما اندلعت الثورة الفرنسية، واستشاره الماركيز دي لافاييت عند صياغة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789. تنص المادة 10 من تلك الوثيقة على أنه لا يجوز قمع الآراء، حتى الدينية منها، بشرط ألا يؤثر إظهارها على النظام العام.
في الوقت الراهن، يتم تعريف الفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا من خلال قانون 1905 الذي انبثق من معركة حامية الوطيس لإنهاء سلطة الكنيسة الكاثوليكية. ينص القانون على أن “الجمهورية تضمن حرية المعتقد” وكذلك الحرية الدينية، وينص على أن الدولة لن تميز بين الأديان. وقد حدد قانون 1905 المبادئ الأولية للعلمانية، وتم إدراج الكلمة نفسها في الدستور الفرنسي سنة 1958.
تبدو نوايا فرنسا والولايات المتحدة متشابهة، لكنها مختلفة على أرض الواقع. سعت الولايات المتحدة، التي تضمن حرية الدين، إلى حماية الدين من تدخل الدولة، في حين سعت فرنسا، من خلال ضمان حرية الدين، إلى حماية الدولة من التدخل الديني. كان لهذا الاختلاف الكثير من التداعيات.
بصفتي أمريكيا يعيش ويعمل في باريس، أصبحت مواطنا غريبا في كلا البلدين. في كل مرة أعود فيها إلى أمريكا، أذهل لسماع مقدمي البرامج في التلفزيون يرددون عبارة “باركك الرب”، وسماع الرؤساء يذكرون اقتباسات من الكتاب المقدس، أو يطلبون من الرب حماية الولايات المتحدة وقواتها.
في سن مبكر، يتم ترسيخ مبدأ العلمانية في أذهان الفرنسيين. يتم تدريس كل الطلاب في المدارس العمومية منهجا موحدا من الصف الأول حتى المرحلة الثانوية.
في الولايات المتحدة، من غير المعتاد – وربما من المستحيل – أن يعلن مرشح ترشحه للرئاسة دون أن يذكر الرب. في فرنسا، يُنظر إلى إدخال المعتقدات الخاصة في المجال العام على أنه انتهاك للعلمانية، وسلوك ذو صبغة يسارية متطرفة.
في الولايات المتحدة، تستطيع النائبة إلهان عمر ارتداء الحجاب بفخر داخل الكونغرس. أما في فرنسا، يُحظر على أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية أو مجلس الشيوخ ارتداء الملابس الدينية في المباني الحكومية، ناهيك عن الأماكن العامة.
مؤخرا، قام حزب ماكرون بتوبيخ مرشحة مسلمة لارتدائها الحجاب في ملصقات حملتها الانتخابية – على الرغم من الإقرار أنها لم تخالف القوانين الفرنسية- ، وقد تم منعها من الترشح في الانتخابات المحلية. تتشكل معالم كل دولة من مآسي الماضي، فبينما خاضت أمريكا حربًا أهلية لمناهضة العبودية، كانت فرنسا تعيش حروبا أهلية بسبب الدين.
في سن مبكر، يتم ترسيخ مبدأ العلمانية في أذهان الفرنسيين. يتم تدريس كل الطلاب في المدارس العمومية منهجا موحدا من الصف الأول حتى المرحلة الثانوية. ويُنظر إلى المدارس على أنها بوتقة لتشكيل وعي المواطنين، ومكانا يساهم في غرس القيم، على غرار العلمانية وحرية التعبير والمساواة بين الرجال والنساء، ناهيك عن تعليم مهارات مثل القراءة والكتابة والرياضيات.
يتم فرض كل المناهج تحت شعار القيم الكونية، الذي يقدم فكرة مجردة عن مفهوم المواطنة التي يبغي على الجميع أن يؤمن به. في مقابلة حديثة مع صحيفة لوباريزيان، سُئلت الفيلسوفة الفرنسية النسوية إليزابيث بادينتر، التي تؤيد تطبيق مبادئ العلمانية بشدة، “ما الذي يمكن أن يجمع الأمة اليوم؟” أجابت: “المدارس!” وأضافت قائلة: “العلمانية والجمهورية، يمثلان جوهر الأمة الفرنسية”. لهذا، لم يكن اتخاذ حكومة ماكرون تدابير صارمة بشأن المدارس في مشروع قانون مناهضة الانفصالية أمرا مفاجئًا.
غالبًا ما يعرّف الأمريكيون أنفسهم على أسس عرقية ودينية. من المفترض أنه يمكننا التعبير عن هوياتنا المركبة دون خيانة المشروع الوطني الواسع. لكن في فرنسا، يُنظر إلى فلسفة التكاتف المجتمعي، أو تحديد نفسك من خلال الهوية العرقية أو الدينية الخاصة بك، على أنها تهديد للكيان السياسي.
من الشائع في الولايات المتحدة أن يُسأل المرء عن انتمائه العرقي في الاستمارات والدراسات الاستقصائية، لكن الدولة الفرنسية تعامل مواطنيها كأفراد، وليس كجزء من مجموعات، ولا تجمع رسميًا بيانات إحصائية باعتماد معايير مثل العرق أو الإثنية، والتي قد يُنظر إليها على أنها خيانة لمبدأ الكونية وانتهاك للخصوصية. (تلقي الحقبة المظلمة للحرب العالمية الثانية -عندما اعتقل نظام فيشي اليهود الفرنسيين لترحيلهم إلى معسكرات الموت النازية- بظلالها على هذا النوع من جمع البيانات).
ترى الولايات المتحدة أنه ينبغي ترك مساحة للمواطنين لممارسة معتقداتهم وحياتهم الخاصة، لكن في فرنسا تتسم التفاعلات بنوع من القسوة والبرود، وترى الدولة هذه المسافة شكل من أشكال احترام الآخر.
لابد من النظر إلى اللائكية التي تتصدر عناوين الصحف العالمية مع كل جدل جديد حول ارتداء النساء المسلمات للحجاب، في سياق مبدأ آخر من مبادئ الحياة العامة الفرنسية، وهو الاستيعاب. في هذا السياق، قال لي الكاتب الفرنسي مارك ويتزمان مؤخرًا: “الأمر لا يتعلق بالدين حقًا، إنه أعمق من ذلك بكثير. يُعرّف الأمريكيون أنفسهم باستمرار بطرق متنوعة. أما الفرنسيون، فإنهم يعرّفون أنفسهم من خلال ماهيتهم بدلاً من هويتهم، والتي تتجلى من خلال الأخلاق التي يكتسبونها. بعبارة أخرى، يتعلق الأمر بمدى قدرتهم على التناغم مع قيم بيئة معينة”.
وتحدث وايتزمان عن شخصيات في روايات أونوريه دي بلزاك، التي تعود إلى القرن التاسع عشر، والتي وصلت إلى باريس من المقاطعات الأخرى وغيرت قناعاتها وحققت نجاحًا اجتماعيًا أو سياسيًا أو أدبيًا. في المقابل، يدعو حكيم القروي، وهو كاتب ومستشار فرنسي تونسي، قدم استشارات غير رسمية للرئيس ماكرون، إلى تطوير تكوين الأئمة في فرنسا حتى يتبنوا إسلاما يتوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية، على حد تعبيره.
في الفترة الأخيرة، عندما أجريت مقابلة معه، قال مبتسما: “فرنسا مفتوحة لأي شخص، ولكن هناك طريق واحد فقط، وهو الكونية”. وأضاف: “هنا تكمن المفارقة الفرنسية، فمثلما تعتبر فرنسا بلدا منفتحا للغاية، فهي متشددة للغاية. في حياتك الخاصة، يمكنك تنمية ثقافتك ولغتك ودينك؛ أما في الأماكن العامة، عليك أن تتبنى المبادئ الفرنسية”.
في الولايات المتحدة، يحتفي السياسيون الأمريكيون بالتنوع الثقافي، أما في فرنسا، يبدو غالبًا كما لو أن هناك لونا ثقافيا واحدا يعبر عن الهوية الوطنية.
في هذا السياق، أشار وزير الداخلية المتشدد في حكومة ماكرون، جيرالد دارمانان، الذي ربما يكون ثاني أقوى رجل في فرنسا، في مقابلة تلفزيونية أجراها السنة الماضية، إلى أن “رفوف الطعام الحلال في محلات السوبر ماركت تمثل شكلا من أشكال الانفصالية الدينية”.
وينصح دارمانان المتقدمين للحصول على الجنسية الفرنسية بتعلم تاريخ فرنسا وجغرافيتها، وأيضًا الحصول على معلومات عن المأكولات الفرنسية. في هذا الشأن، هناك نقاش حول ما إذا كان ينبغي أن تقدم المدارس وجبات نباتية ولحوما حلالا للطلاب المسلمين، أو ما إذا كان هذا أيضًا تنازلا لصالح الانفصالية.
في الواقع، أشعر بالدهشة من هذا الهوس الفرنسي، الذي يبدو أنه يدعم المزاعم بأن بعض الوجبات يمكن أن تشكل تهديدا لقيم الجمهورية.
نشر دارمانان كتابًا صغيرًا هذه السنة بعنوان: “الانفصالية الإسلامية: بيان من أجل اللائكية”، أكد فيه أن الجمهورية بصدد فقدان الإيمان بقيمها الكونية. وتشير رؤيته إلى أن فرنسا لديها، أو يجب أن تكون لديها، فكرة ثابتة ودائمة عن كيانها، وأنها ليست (خلافا لأي بلد آخر في العالم) محاصرة بعملية تغيير مستمرة.
كثيرا ما تصرح مارين لوبان أنها إذا نجحت في الانتخابات، فإن فرنسا “ستعود إلى هويتها”. من جانبه، خصص دارمانان -رجل ماكرون القوي في معركة استمالة اليمين- فصلاً من كتابه لما يسميه “محاربة الانفصالية الإسلامية”، وهي النزعة التي يقول إنها “حصان طروادة الذي يحمل بداخله قنبلة تهدد بتقسيم مجتمعنا”.
يمكن أن نفهم مفهوم الاستيعاب الفرنسي من خلال شخصية إريك زمور، الصحفي اليميني المتطرف الذي أعلن ترشحه للرئاسة. تجدر الإشارة إلى أن زمور، الذين ينحدر من عائلة يهودية جزائرية مهاجرة، يؤيد “نظرية الاستبدال العظيم” الشائعة بين العنصريين البيض. صرح زمور في العديد من المناسبات أنه ينبغي على الآباء أن يطلقوا على أطفالهم أسماء فرنسية فقط، مؤكدا بأن الإسلام يتعارض بشكل أساسي مع قيم فرنسا. وتعدّ كتب إريك زمور، بما في ذلك كتابه بعنوان “الانتحار الفرنسي”، من أكثر الكتب مبيعًا في فرنسا حاليا.
في تاريخ العلمانية، هناك ثلاثة تواريخ مهمة: 1789 و1905 و1989. ألغت الثورة الفرنسية سنة 1789 الوضع الأرستقراطي القائم، ومنذ ذلك الحين، اعترفت فرنسا بفئتين فقط من الأشخاص، المواطنين والمهاجرين، وهما حجر الأساس في تجسيد قيمها الكونية.
تشير التقديرات اليوم إلى أن عدد المسلمين في فرنسا يزيد عن 5 ملايين، ويعيش كثير منهم في الأحياء الفقيرة في ضواحي المدن الكبرى.
رغم الثورة، استمر تأثير النظام القديم. في ظل اتفاقية “كونكوردات”، التي أبرمها نابليون، باتت الدولة تدفع أجورا لرجال الدين وتتدخل في تعيين الأساقفة الكاثوليك. بعد هزيمة نابليون، عادت فرنسا إلى النظام الملكي مرة أخرى، قبل أن يتم تأسيس جمهورية ديمقراطية دائمة سنة 1870.
طوال القرن التاسع عشر، كانت المدارس الكاثوليكية الشكل الوحيد للتعليم للعديد من الأطفال الفرنسيين، لاسيما في المناطق الريفية. ظلت الكاثوليكية اليمينية الصارمة تتمتع بنفوذ كبير. حتى بدايات القرن العشرين، كان الفاتيكان يدعو إلى استعادة النظام الملكي في فرنسا.
في نهاية المطاف، أصبح للجمهورية الفرنسية الحديثة نموذج خاص بها يمزج بين المركزية والعلمانية في آن واحد. ربطت الطرق والسكك الحديدية الجديدة البلاد ببعضها البعض. ألغيت اللغات الإقليمية – البريتونية والأوكسيتانية – لصالح اللغة الفرنسية الرسمية. وضعت الحكومة نظاما للمدارس العامة وفرضت إلزامية التعليم. لا تزال المدارس الكاثوليكية وغيرها من المدارس الأبرشية موجودة حتى الآن، والعديد منها يتلقى أموالا حكومية، لكن ينبغي عليها تدريس المنهج الحكومي مثل أي مدرسة عامة.
في مطلع القرن الماضي، بدأت الجمعية الوطنية مناقشة ما سيصبح قانون 1905 للعلمانية. حينها لم يكن الإسلام يمثل مشكلة في فرنسا، وكان العدو الرئيسي الكنيسة الكاثوليكية. مع دعم شعبي واسع ومنصة مناهضة للاكليروس وحماية العمال، كانت السلطة بين يدي تحالف من الاشتراكيين والراديكاليين. لم تُسبب إلا قوانين قليلة في التاريخ الفرنسي مناقشات مدوية مثلما حدث في 1905.
اصطدمت الجهود غير المكتملة للثورة مع الموروثات الكاثوليكية، وأدت في النهاية إلى سيادة الحكومة. يكفل قانون 1905 حرية الضمير وحرية ممارسة الدين، طالما لم يتعارضا مع النظام العام. أصبحت جميع المباني الدينية التي شُيدت قبل سنة 1905 – بما في ذلك كاتدرائية نوتردام – ملكا الدولة، وأُلغي نظام الكونكوردات.
ألغى قانون 1905 النقاش حول الفصل بين الكنيسة والدولة لمدة قرن كامل تقريبا. خلال هذا القرن، تغيرت السياسة والتركيبة السكانية. مع نهاية الحكم الاستعماري الفرنسي في شمال أفريقيا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، هاجر مئات الآلاف من الأشخاص إلى فرنسا من الجزائر وتونس والمغرب. كما مُنح اليهود من المستعمرات الفرنسية السابقة الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية.
أرسلت المستعمرات الأراضي السابقة الأئمة إلى فرنسا وساعدت في بناء المساجد. تشير التقديرات اليوم إلى أن عدد المسلمين في فرنسا يزيد عن 5 ملايين، ويعيش كثير منهم في الأحياء الفقيرة في ضواحي المدن الكبرى.
تزامنت سنة 1989 مع الذكرى المئوية الثانية للثورة الفرنسية ولحظة فخر وطني. في تشرين الأول/ أكتوبر من تلك السنة، رفضت ثلاث فتيات مسلمات في مدرسة إعدادية في كريل، شمال باريس، خلع الحجاب. علقت المديرة على فعل الفتيات قائلة إن الحجاب ينتهك حيادية الأماكن العامة التي تعتبر المدرسة واحدة منها. لأول مرة، دخل الإسلام المجال العام في فرنسا.
أصبح الحجاب اختصارا شكليا للإسلام السياسي، ولا يزال كذلك حتى يومنا هذا. سنة 1989، نُشرت هذه الواقعة كغلاف في مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور”، وهي مجلة أسبوعية مؤثرة، وحملت عنوان “التعصب: التهديد الديني” أسفل صورة لفتاة صغيرة ترتدي حجابا أسود.
سعت الحكومة للحصول على حكم من مجلس الدولة، وهي أعلى محكمة إدارية في البلاد، وقررت المحكمة ضرورة السماح بالتعبير عن قناعات المرء الدينية في المدرسة من خلال الملابس طالما أنها لا تشكل “عملا من أعمال الضغط أو الاستفزاز أو التبشير أو الدعاية”. باختصار، كان سلوك الفتيات، وليس ملابسهن ما يجب الحكم عليه. (في هذه الحالة، اعتُبر السلوك هو الإشكال، وطُردت الفتيات).
غابت القضية لفترة، ثم اندلعت الانتفاضة الثانية في إسرائيل والأراضي المحتلة سنة 2000 عندما صعّد الفلسطينيون احتجاجاتهم، وتضامن معهم العديد من المسلمين الفرنسيين. جاءت بعدها هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، ثم الغزو الأمريكي لأفغانستان. في ربيع سنة 2002، حقق جان ماري لوبان، والد مارين، نجاحا مفاجئا بوصوله إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية عن الجبهة الوطنية، وهو حزب يرتكز على معاداة السامية وكراهية المهاجرين المسلمين. اتحد اليمين واليسار لعرقلة لوبان وانتخاب جاك شيراك.
بعد سنة، قامت الولايات المتحدة بغزو العراق، وهو غزو عارضته فرنسا بشدة. مازالت عواقب تلك الحرب وأعمال العنف والفوضى التي أعقبته تؤثر على أوروبا بشكل كبير. أسفرت سنوات من هجرة المسلمين من الشرق الأوسط إلى أوروبا عن تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين في فرنسا وفي دول أخرى.
سنة 2003، وفي ظل التهديد الذي شكله لوبان، عين شيراك لجنة من 20 عضوا، بقيادة برنارد ستاسي، لإعادة النظر في متطلبات العلمانية. أصدرت لجنة ستاسي تقريرا ينص على حظر الرموز الدينية و”التباهي بها” في المدارس الفرنسية، وتم حظر الحجاب.
عمل المؤرخ باتريك ويل في لجنة ستاسي وقد حدثني مؤخرا عن بعض النقاشات التي دارت داخل اللجنة. قال ويل إنه في ذلك الوقت، كانت هناك مخاوف من قيام الإخوان المسلمين بالترويج للحجاب كجزء من عمليات التجنيد في الأحياء الفرنسية. كانت مطالبة مديري المدارس بالفصل في قضية الحجاب – أي متى يمكن اعتبار غطاء الرأس رمزا سياسية وليس مجرد ممارسة للشعائر الدينية؟ – محورا أساسيا في النقاشات، ومن هنا جاء الحظر التام. وأوضح ويل، أن الفكرة كانت الإعلان عن حيادية المدارس في ما يتعلق بعدم إكراه الفتيات في سن المدرسة على ارتداء الحجاب. وأضاف ويل: “كان الهدف حماية أولئك الذين لم يرتدوه. لم يكن قانونا ضد الحجاب بقدر ما كان قانونا ضد الضغط الديني”. أيا كانت النية، فإن القانون، كما هو متوقع، جعل العديد من المسلمين يشعرون بالتمييز ضدهم.
كان المؤرخ جان بوبيرو، وهو صاحب دراسة متعددة الجوانب لقانون 1905 الفرنسي، العضو الوحيد في اللجنة الذي امتنع عن التصويت. أخبرني بوبيرو أن اللجنة أجرت مقابلات مع عدد قليل من النساء المسلمات المتدينات. كان بوبيرو يرى أن حكم مجلس الدولة الأصلي – الذي قال إن القضية تكمن في سلوك الطالبة وليس ملابسها- ينبغي تكريسه كقانون. لكنه كان يعلم أنه سوف يُرفض بغالبية الأصوات، مضيفا: “كان هذا ما أراده شيراك”. ويوضح بوبيرو، وهو بروتستانتي، في بلد أغلبه من الكاثوليك، قائلا: “أعرف جيدا ما معنى أن تكون منتميا إلى أقلية دينية”.
يشكل حظر قطعة من الملابس المرتبطة بالدين في الولايات المتحدة، انتهاكا لا لبس فيه للتعديل الأول. والواقع أن الحظر في فرنسا مر بسهولة على مجلسي البرلمان، على الرغم من استمرار الارتباك حول قواعد الملابس الدينية خارج المدرسة (ناهيك عن ما تشكله الملابس الدينية من رمزية).
سنة 2011، ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك، وقامت بمنع تغطية الوجه بالكامل، أي منع النقاب والبرقع. كانت هناك القليل من الأشياء التي تثير الغضب في فرنسا أكثر من الملابس التي ترتديها النساء المسلمات المتدينات. سنة 2016، سعى رؤساء البلديات اليمينيون في منطقة الريفيرا إلى حظر البوركيني. نقضت محكمة فرنسية الحظر، لكن صورا انتشرت على الإنترنت وثقت تحرش الشرطة الفرنسية بنساء مسلمات على الشاطئ، وهو ما أثار غضب المسلمين.
سنة 2018، أطلقت زعيمة مجموعة طلابية جامعية جرس إنذار عندما ارتدت الحجاب في مقابلة تلفزيونية، على الرغم من عدم وجود قانون يحظر ارتداء الرموز الدينية في الحرم الجامعي. (يُنظر إلى طلاب الجامعات على أنهم بالغون، وقادرون على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم). في السنة التالية، قامت شركة ديكاتلون، المتخصصة في الملابس الرياضية، بإلغاء الحجاب الرياضي من رفوفها إثر احتجاجات عامة، كما منعت بعض حمامات السباحة العامة في فرنسا ارتداء البوركيني، متذرعة بمخاوف تتعلق بالسلامة العامة، مثل النظافة.
في مناقشة قانون مناهضة الانفصالية، كرس مجلس الشيوخ الفرنسي ساعات طويلة للتعديل الذي من شأنه أن يحظر على النساء ارتداء الحجاب أثناء في الرحلات المدرسية. تذمر عضو اشتراكي في مجلس الشيوخ قائلا: “قضينا ثلاث ساعات نتناقش حول الحجاب، ثم ثلاث ساعات أخرى عن البوركيني”.
في بلد لم يكن فيه حتى وقت قريب تحديد للسن القانوني لممارسة الجنس (وهو الآن 15 عامًا) ، يُحظر ارتداء الحجاب في المدرسة الثانوية، التي تنتهي في سن 18 تقريبًا.
يبدو من السهل على الجمهور أن يتفاعل مع قضية الحجاب بدلا من ملاحظة التغييرات في آلية الحكم التي قد تكون آثارها بعيدة المدى. يضع القانون الجديد قيودا أكبر على دور العبادة، حيث يتوجب على بعض الجمعيات حاليا إعادة تقديم طلب كل خمس سنوات للحفاظ على وضعهم القانوني. ولمواجهة الإسلام المتشدد، يفرض القانون أيضا ضوابط أكثر صرامة على الأموال الأجنبية المرسلة إلى الجمعيات الدينية من الخارج. وتُلزَم المنظمات الدينية بالتوقيع على “ميثاق المبادئ الجمهورية” الذي يعبر عن الالتزام بالمساواة بين الرجل والمرأة ونبذ التمييز على أساس التوجه الجنسي. أشار حكيم القروي وآخرون إلى أن ذلك كان جزءا من الجهد الذي بذلته الحكومة لخلق “إسلام ملائم لفرنسا”.
أصبح الدفاع عن العلمانية قضية انتخابية قبل انتخابات السنة المقبلة. في شباط/ فبراير، اتهم وزير الداخلية دارمانان مارين لوبان بالتساهل بشأن العلمانية. لطالما انتقد حزبها اليميني المتطرف العلمانية لأنها تقلص من سلطة الكنيسة الكاثوليكية. تحدث والد لوبان، وهو مؤسس حزبها، ومنكر للهولوكوست، عن فرنسا كدولة مسيحية. غيرت لوبان الآن خطابها، مدركة أن مصطلح العلمانية يمكن أن يستخدم كسلاح ضد المسلمين والهجرة. في غضون ذلك، دفع إريك زمور النقاش برمته إلى مزيد من التطرف إلى اليمين من خلال التأكيد على عدم وجود فرق بين الإسلام وتيارات الإسلام السياسي.
لكن العلمانية قضية تتخطى أي فجوة تقليدية بين أحزاب اليمين واليسار. على الرغم من أن العديد من النسويات الفرنسيات يعتبرن الحجاب والملابس التقليدية الأخرى شكلا من أشكال خضوع المرأة المسلمة، وأن العلمانية هي وسيلة للتحرر، إلا أن القضية أكثر تعقيدًا من ذلك. أجريتُ محادثة طويلة هذا الربيع مع يسرا، وهي شابة تدرس في جامعة خارج باريس، طلبت عدم الكشف عن اسمها بالكامل حفاظًا على خصوصيتها.
تمثل يسرا وجهة نظر كانت شبه غائبة تمامًا عن النقاش العلماني في فرنسا، فهي امرأة مسلمة ترتدي الحجاب خارج المدرسة باختيارها منذ سن السادسة عشرة. تقول يسرا: “قبلت عدم ارتدائه في المدرسة، لأن هذه هي قوانين الجمهورية”. أخبرتني أنها لا تحب أن ينظر إليها الرجال من الأعلى إلى الأسفل عندما تمشي في الشارع؛ كان ارتداء الحجاب وارتداء الملابس المحتشمة وسيلة لاستعادة قوتها.
مع ذلك، في بلد لم يكن فيه حتى وقت قريب تحديد للسن القانوني لممارسة الجنس (وهو الآن 15 عامًا) ، يُحظر ارتداء الحجاب في المدرسة الثانوية، التي تنتهي في سن 18 تقريبًا.
يبدو لي أن تجربة يسرا تجسد العديد من تناقضات فرنسا الحديثة. الحجاب نفسه الذي ارتدته كإثبات لشخصيتها، وشكل من أشكال الحماية الذاتية، يُنظر إليه من قبل الدولة على أنه استفزاز سياسي. المعارك المجردة حول العلمانية، ما “بين الجمهورية والدين، والحداثة والتقاليد، والعقل والخرافات”، كما تقول المؤرخة جوان والاش سكوت، هي بشكل ملموس معارك على أجساد النساء.
من الناحية الجيوسياسية، تقطع العلمانية طريقًا آخر. أصر ماكرون ودرمانان على أن فرنسا لا تخلط بين الإسلام والإرهاب الجهادي، لكن قانون مناهضة الانفصالية يتحدث بصراحة عن قضايا الأمن القومي والقيم الوطنية. تعتقد عالمة الاجتماع البارزة دومينيك شنابر، أن فرنسا يجب أن تدافع عن قيمها الديمقراطية، بما في ذلك اللائكية، في مواجهة الأنظمة الاستبدادية الصاعدة مثل روسيا وتركيا وإيران والهند والصين. شنابر هي ابنة ريمون آرون، الفيلسوف الفرنسي المعروف، والصديق اللدود لجان بول سارتر، وعدو الماركسيين الفرنسيين. كتبت إلي مؤخرًا: “تجربة الثلاثينيات تظهر أن سبيل الديمقراطية لإنقاذ نفسها ليس في الرضوخ لمطالب الأعداء، والسعي إلى حل وسط، بل في تأكيد قيمها والاستعداد للدفاع عنها بالقوة”.
الحديث عن العلمانية من زاوية نظرية يختلف عن التعامل مع تداعياتها على أرض الواقع. في الربيع الماضي، شاهدت محاضرة على زووم قدمها جان لويس بيانكو، الذي كان رئيسًا لهيئة حكومية يُطلق عليها المرصد الوطني للعلمانية. بدأت الهيئة عملها في عهد الرئيس فرانسوا هولاند سنة 2013، لمساعدة المسؤولين والشركات والمواطنين على فهم كيفية تطبيق الفصل بين الكنيسة والدولة في المواقف العملية.
يمكن القول إن فرنسا لديها أكثر جالية مسلمة علمانية في العالم. ولأن التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا، بينما تتجه البلاد نحو الانتخابات، تتحد مجموعة متنوعة من القضايا البارزة -حرية العبادة، حرية التعبير، الهوية الوطنية، إنفاذ القانون- ضمن حالة من الجدل السام حول هوية الدولة.
هل يحتاج السيخ إلى ارتداء قبعات صلبة في مواقع العمل حتى لو كانت القبعات الصلبة لا تتناسب مع عمائمهم؟ نعم. هل يمكن للمرأة المسلمة التي تعمل في توصيل الطعام الجاهز أن ترفض تقديم لحم الخنزير؟ يجب أن تحترم شروط عقد عملها. هل يستطيع مسيحي إنجيلي أن يوزع كتيبات لكنيسته في مكان عمله؟ لا، من شأنه ذلك أن يهدد حرية ضمير زملائه.
أخبرني بيانكو أنه قضى وقتًا طويلاً في الربيع الماضي للإجابة على أسئلة حول كيفية تطبيق العلمانية في مواقع التطعيم ضد كوفيد-19. المسألة بالتحديد: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس الحجاب أثناء التطعيم؟ يعتمد ذلك على ما إذا كان يتم إجراء التطعيم من قبل مؤسسة عامة أو خاصة. رغم أن فرنسا تواجه ارتفاعا في حصيلة الوفيات، إضافة إلى شكوك كبيرة بشأن اللقاح بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، والأضرار الاقتصادية الهائلة، لكن كان لدى مسؤوليها الوقت للدخول في نقاشات فرعية حول العلمانية.
قامت حكومة ماكرون مؤخرًا بحل مرصد العلمانية وسط اتهامات بأنه متساهل للغاية بشأن تطبيق اللائكية، وأسست هيئة جديدة. رغم ذلك، فإن ما تقوم به الحكومة نفسها قد يكون في بعض الأحيان أقل حزما من الناحية العملية مقارنة بالقواعد النظرية. القيم الكونية ليست دائما عالمية.
لا تجمع الحكومة الفرنسية رسميًا بيانات عرقية أو إثنية أو دينية، لكن القانون الفرنسي يعترف بوجود جرائم الكراهية، والتي تتطلب في الواقع اعترافًا رسميًا بالاختلاف العرقي والديني. ولأن قانون 1905 يضمن أيضًا حرية الممارسة الشخصية للدين، توفر الدولة قساوسة للمواطنين في مؤسسات معينة: الجيش والمستشفيات والسجون.
كما يُسمح للجنود في القوات المسلحة الفرنسية بأداء فريضة الحج إذا كانوا مسلمين، أو الحج إلى منطقة لورد، إذا كانوا كاثوليك؛ ولديهم أيضًا زيارات إلى الأماكن المقدسة تدعمها الحكومة الفرنسية من خلال جمعيات القساوسة التابعة للقوات المسلحة.
في خطاب ألقته في وقت سابق من هذا العام، أطلقت وزيرة المواطنة مارلين شيابا سلسلة من اللقاءات الوطنية حول العلمانية. ألقت خطابها في موقع تم اختياره بعناية، وهو كنيسة في وسط باريس أصبحت الآن متحفًا لتاريخ العلوم. يبدو أنه لا يمكن لأي أحد مقاومة استغلال الرموز بطريقة غير مباشرة.
الخوف من أن فرنسا أضاعت طريقها يسيطر على الكثير من السياسيين، من اليمين واليسار. في الحقيقة، تعد فرنسا مثل الولايات المتحدة، واحدة من أكثر الأنظمة السياسية التعددية تطوراً على وجه الأرض، وهي بلد الهجرة والديمقراطية وحرية الدين وحرية التعبير، حيث يعيش 67 مليون شخص، بما في ذلك أكبر الجاليات المسلمة واليهودية في أوروبا، في وئام إلى حد كبير.
في فرنسا، يُطلب من الأفراد إخفاء جوانب أساسية من هويتهم في الفضاء العام، وقد عبّر إيمانويل ماكرون عن ذلك عندما قال إنها هناك معركة وجودية
يمكن القول إن فرنسا لديها أكثر جالية مسلمة علمانية في العالم. ولأن التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا، بينما تتجه البلاد نحو الانتخابات، تتحد مجموعة متنوعة من القضايا البارزة -حرية العبادة، حرية التعبير، الهوية الوطنية، إنفاذ القانون- ضمن حالة من الجدل السام حول هوية الدولة.
وجدت الدراسات الاستقصائية أن معظم الناس في فرنسا يعتبرون العلمانية مبدأ مهمًا. لكن هناك فجوة بين الأجيال: المواطنون الأصغر سنًا من جميع الأديان، أكثر التزامًا من كبار السن، وهم أكثر تقبلا لفكرة ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة والتأكيد على هوياتهم على الطريقة الأمريكية. لكن الكونية الفرنسية أصبحت محدودة للغاية، وقد يتسبب الالتزام الصارم باللائكية بمزيد من الانقسامات. إذا كان تاريخ الدين يكشف عن حقيقة واحدة، فهو أن محاولات القمع تقوي إرادة المؤمنين.
يحدث التعارض بين التنوع والوحدة في قلب أي نظام حكم ديمقراطي، وليس ذلك أمرا جديدا، لاسيما فيما يتعلق بقضايا الدين. الدول الاستبدادية واجهت ذلك أيضًا، لكن من الصعب حل المشكل في الدول الديمقراطية، حيث يتمتع الناس بالسلطة ويمارسونها في كثير من الأحيان في مجموعات. يصبح تحقيق التوازن اختبارًا للديمقراطية الليبرالية نفسها، في شرعيتها وقدرتها على العمل.
هذا التناقض يحدث أيضا داخلنا كأفراد، وأنا أدرك ذلك بداخلي. عندما أعود إلى الولايات المتحدة أو أراها من بعيد، أحب تنوع الثقافات والمعتقدات، لكن من الصعب التكهن بعدم حدوث انقسام على المدى الطويل. لم تعد المدارس تقضي الكثير من الوقت في تدريس التربية المدنية، وأعلى الأصوات التي تحدد ما يجب وما لا يجب في الوقت الراهن هي أصوات متطرفة.
عندما أنظر إلى فرنسا، لا بد لي من الإعجاب بالنظام التعليمي الذي يحاول على الأقل إعطاء الجميع أرضية مشتركة من المبادئ الأساسية للحياة العامة. في الوقت الذي يتم فيه خصخصة كل شيء، من إجراء الانتخابات إلى خوض الحروب، من المفيد أن نتذكر أن هناك شيئًا مهمًا يسمى “الفضاء العام”، بخلاف اقتصاد السوق، ويجب علينا حمايته.
في التصور الديكارتي، هناك مكان في الحديقة لأي زهرة تقبل التصميم. ولكن كما توضح العلمانية، يمكن أن يكون النظام الرسمي جامدًا وغير متسامح، فالأفراد والجماعات مقيدون بموجب القانون الفرنسي بطرق لا مثيل لها في الديمقراطيات الأخرى. قد يكون الفرنسيون أكثر تقبلا للتنوع الثقافي في الممارسة مما هو في الجانب النظري، لكن النظرية لها وزن.
في فرنسا، يُطلب من الأفراد إخفاء جوانب أساسية من هويتهم في الفضاء العام، وقد عبّر إيمانويل ماكرون عن ذلك عندما قال إنها هناك معركة وجودية. لكن الحرب الأكبر تدور حول الديمقراطية نفسها، وهي تدور في ميدان أكبر من فرنسا.
المصدر: أتلانتيك