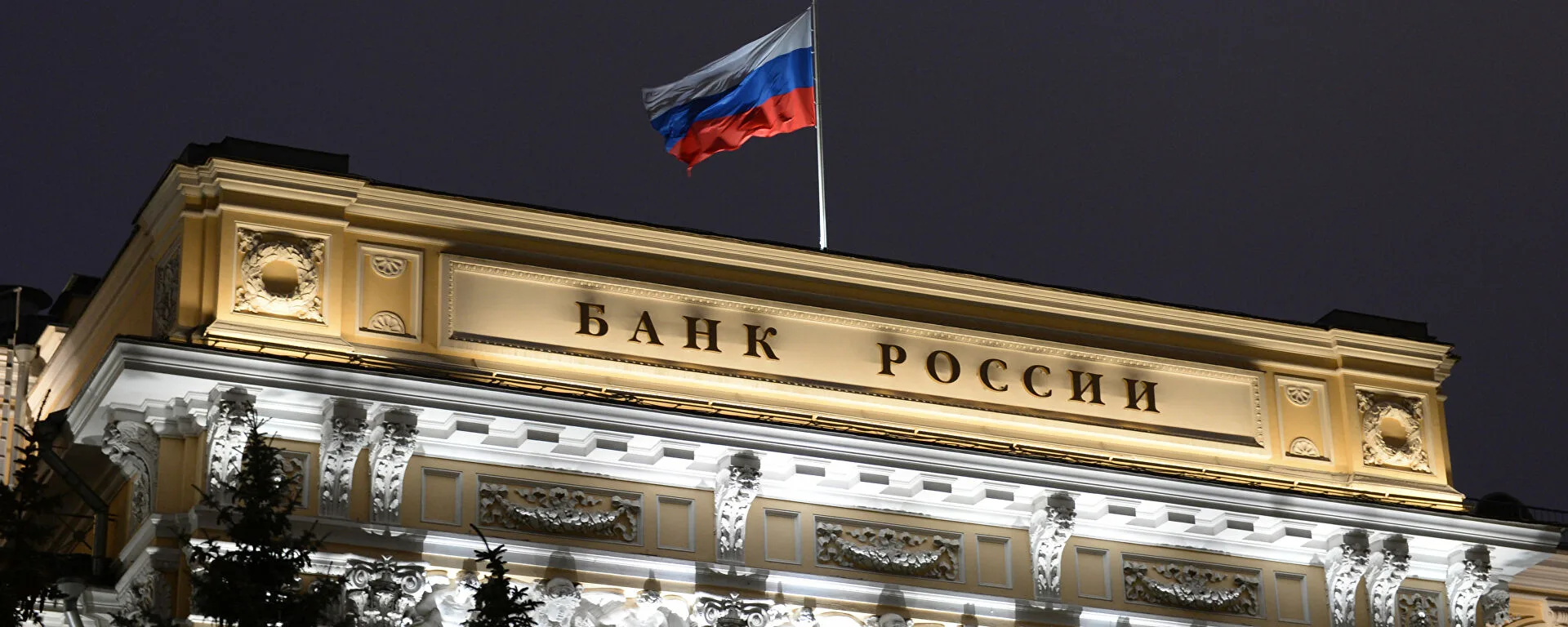فرضت الدول الغربية في الأيام الخمس الماضية حزمة عقوبات على روسيا، بسبب حربها ضد أوكرانيا، لم تتعرض لها دولة أخرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أطلقَ عليها البعض “أُمّ العقوبات”، شملت كافة المسارات الاقتصادية والسياسية، حتى باتت الدولة صاحبة التاريخ الكبير على أعتاب عزلة دولية شبه كاملة، بعد فرض حظر طيران عليها من عشرات الدول.
لو فُرضت تلك العقوبات على دولة لم تضع الحسابات الدقيقة للتعامل معها لربما سيكون الوضع كارثيًّا، خاصة أن استراتيجية الضغط على البلدان عبر العقوبات الاقتصادية استراتيجية تقليدية وذات إرث تاريخي كبير، غير أن الوضع مع كيان دولي بحجم روسيا لا شكّ أن فيه عدة سيناريوهات استعدادًا لتلك الخطوات المتوقعة.
العقوبات الأخيرة هي امتداد لسلسلة العقوبات المفروضة على موسكو منذ احتلالها شبه جزيرة القرم عام 2014، والتي من الواضح أن الروس استعدوا لها جيدًا عبر قائمة من السياسات والتوجُّهات طيلة السنوات السبع الماضية، وعليه يأتي هذا الإصرار على اجتياح كييف عسكريًّا دون مراعاة لتلك العقوبات.
فكيف استعدت روسيا إذًا؟ وهل يمكن لتلك الاستعدادات أن تصمد كثيرًا أمام التصعيد المستمر في الضغط عبر أدوات ومسارات ربما تعزل البلاد رسميًّا عن العالم الخارجي؟
7 سنوات من العقوبات
التصور بأن العقوبات الأخيرة ستكون بمثابة العصا السحرية التي تجبر موسكو على إعادة النظر في سياساتها الخارجية، وإحداث هزة عنيفة للاقتصاد الروسي تفقده التوازن بالكلية، هو تصور خاطئ إلى حدّ كبير، فما حدث لم يكن جديدًا من نوعه، إذ يقبع الروس تحت وطأة تلك العقوبات منذ عام 2014 وحتى اليوم.
7 سنوات كاملة تعاني فيها روسيا من عقوبات على كافة المستويات، تتباين في درجة حدّتها من مجال إلى آخر، تسبّبت في خسائر سنوية تتراوح ما بين 130 و140 مليار دولار، بما قيمته 7% من الناتج القومي للبلاد، هذا بخلاف هروب ما يزيد عن 75 مليار دولار من السوق الروسي خلال تلك الفترة، بحسب التقديرات الرسمية.
وكما جُمِّدت أرصدة وحسابات بنكية لمسؤولين روس في الساعات الماضية، جُمِّدت كذلك أرصدة لمسؤولين سابقين في إدارة بوتين، هذا بجانب حظر السفر الذي فرضته أمريكا وأوروبا ومعهما كندا، بينما أعلنت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعليق مباحثات انضمام روسيا إلى المنظمة كإحدى أدوات الضغط.
عمليًّا.. من الصعب تمادي موسكو في سياساتها الخارجية طيلة تلك السنوات، وفتح العديد من الجبهات التي كبّدتها كلفة عالية، كالتدخل في سوريا والنفوذ داخل ليبيا، هذا بجانب التحرشات المتتالية إزاء الدول الحدودية لها ومساعي توسيع دائرة النفوذ الجغرافي والسياسي، دون أن تكون هناك خطة لامتصاص العقوبات المفروضة عليها دوليًّا.
التحرر نسبيًّا من سيطرة الدولار
ارتباط الاقتصاد الروسي بالدولار في معظم أضلاعه طيلة العقود الماضية، وفق معطيات الخارطة الاقتصادية العالمية التي تتعامل بالعملة الأمريكية، كان عامل ضغط قوي على السياسة الروسية الخارجية، وتهديدًا مباشرًا لأطماع بوتين الإقليمية والدولية.
ومع حزمة العقوبات الأولى التي تعرضت لها موسكو عام 2014، بدأ التفكير جديًّا في التحرر نسبيًّا من هذا القيد، وذلك عبر مسارَين، الأول تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي بما يوفِّر السيولة في ظل الأزمة المتوقعة حال توقيع عقوبات جديدة، بما يساعد على امتصاصها لفترة طويلة نسبيًّا، أما المسار الثاني فهو تعدد منظومة العملات الأجنبية المتعامل معها، وسحب البساط من تحت الهيمنة الدولارية.
وبالفعل، وقبل أيام معدودة من شنّ القوات الروسية هجماتها ضد أوكرانيا، بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي الروسي 631 مليار دولار، وفق بيانات يناير/ كانون الثاني الماضي، لتصبح روسيا رابع أكبر احتياطي نقدي في العالم.
وخلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي استوردت البنوك الروسية نحو 5 مليارات دولار من الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية، مقارنة بـ 2.65 مليار دولار كانت قد استوردتها عام 2020 بحسب تقرير نشرته وكالة التصنيف الروسية “أكرا”، ما يشير إلى استعداد مسبَق للتعامل مع العقوبات المتوقعة حال شنَّت حربًا داخل الأراضي الأوكرانية.
وعلى المسار الثاني، يُلاحظ أن العملة الأمريكية (الدولار) لا تمثّل سوى 16% فقط من احتياطي روسيا من العملات الأجنبية، مقارنة بأضعاف تلك النسبة في السابق، والتي وصلت إلى 40% قبل عام 2014، فيما تمثّل العملة الصينية (رنمينبي) 13% من إجمالي الاحتياطي، مع توقعات بزيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة.
العزل الغربي للروس دفعهم إلى إعادة النظر في خرائط حلفائهم التقليدية، حيث أحدثوا بعض التغيرات والتموضعات الجديدة على تلك الخارطة في ضوء المستجدات الأخيرة، فكان التحالف مع خصوم الغرب هو الحل الأسرع والأكثر تأثيرًا
الخروج تدريجيًّا عن نظام “سويفت”
كان التلويح بعزل البنوك الروسية عن نظام “سويفت” العالمي لتحويل الأموال هو العقوبة الأكثر خطورة، والتطور الذي كشف عن إصرار غربي على جعل روسيا دولة منبوذة عالميًّا حتى إشعار آخر، حيث قررت كل من أمريكا وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، فصل بعض البنوك كخطوة أولى تمهيدًا للخطوة الأكثر حرجًا، وهي فصل البنك المركزي (رغم صعوبة ذلك عمليًّا)، ما يجعل البلاد رسميًّا معزولة عن الاقتصاد الدولي.
وإزاء تلك المخاطر التي ربما تصيب الاقتصاد الروسي بالشلل وتجميد نشاطاته الخارجية، استحدثت موسكو نظامًا ماليًّا مختلفًا عن “سويفت” وغيره من أنظمة التحويل المالي العالمية، يختص باستلام وتسلُّم الرسائل المالية من البنوك والشركات الروسية في إطار محلي ضيّق.
غير أن هذا النظام ليس بالكفاءة المطلوبة لتعويض “سويفت”، إذ لا تتجاوز حجم الرسائل المستخدمة من خلاله 20% من كافة التعاملات المالية الروسية، بخلاف مشاكله الفنية كالتباطؤ والتأخير، بجانب أن الجزء الأكبر من الاقتصاد الروسي يعتمد على الاستيراد والتصدير من وإلى الأسواق الأجنبية التي تتعامل وفق نظام “سويفت”، ما يعرقل التحركات الروسية بشكل كبير.
وفي هذا السياق حرص الروس خلال السنوات السبع الماضية على تقليل الاعتماد على الصادرات الأوروبية والأمريكية، حتى تلك التي تمثل أهمية محورية للكثير من الصناعات المحلية، فكان تشجيع المنتج المحلي واستغناء السوق الوطني تدريجيًّا عن الاستيراد، كذلك تقليل الاعتماد على القروض الخارجية بما يقلل من تأثير العقوبات.
تنويع خارطة التحالفات
العزل الغربي للروس دفعهم إلى إعادة النظر في خرائط حلفائهم التقليدية، حيث أحدثوا بعض التغيرات والتموضعات الجديدة على تلك الخارطة في ضوء المستجدات الأخيرة، فكان التحالف مع خصوم الغرب هو الحل الأسرع والأكثر تأثيرًا، وعليه عززت موسكو من تعاونها مع الصين وإيران تحديدًا (بجانب دول أخرى مثل باكستان)، مستغلة حالة الخصومة مع الغرب ومناصبة العداء لهما من بعض عواصم أوروبا وواشنطن.
ومن ثم كانت روسيا هي الذراع السياسي لهذا التحالف الشرقي الجديد، فيما كانت الصين وإيران ومعهما بعض دول آسيا الذراع الاقتصادي الذي يعوِّض موسكو تبعات العقوبات المفروضة عليها، فقبل أيام قليلة (4 فبراير/ شباط الماضي) من شنّ الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أبرمت روسيا والصين حزمة تاريخية من اتفاقيات التعاون في كافة المجالات، والتي تستهدفُ رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى ما قيمته 140 مليار دولار، مع زيادة إمدادات الغاز الروسي للصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويًّا.
تاريخيًّا.. لم ترغم العقوبات الاقتصادية دولًا على تغيير مواقفها، لا سيما إن كانت دولة بحجم روسيا، لكن في الوقت ذاته لم يشهد التاريخ عقوبات بهذا الحجم وهذا المستوى وهذا التوحُّد والتكاتف الغربي كالتي فُرضت على موسكو
واستعدادًا لتأثير عزل البنوك الروسية عن نظام “سويفت”، بما قد يؤثر على مبيعات موسكو من الطاقة التي تشكّل الضلع الأكبر للاقتصاد، حولت روسيا بوصلة سوق غازها ونفطها إلى حلفائها في آسيا، لتعويض الضرر الناجم عن وقف وتجميد أو عرقلة المعاملات التجارية مع الخارج.
وكان الاتفاق المبرم بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني خلال زيارة الأول للمشاركة في أولمبياد بكين الشتوية، والذي يقضي بزيادة صادرات النفط والغاز الروسية للصين بنسبة 48 مليار متر مكعب عن النسبة الحالية، بقيمة 80 مليار دولار، على مدى السنوات العشر المقبلة؛ الخطوة الأبرز في هذا الإطار.
هذا التحالف الاقتصادي كان له تبعاته السياسية، فكما كانت بكين الحاضنة الاقتصادية الأكبر للروس في المحافل الدولية، وهو ما ساعدَ بوتين على التأرجُح بين دولة وأخرى، وبين ملفٍّ وآخر، لتنفيذ أجندته السياسية التوسُّعية، استندت الصين على الثقل الروسي لتعويض غيابها السياسي، للتفرُّغ لحربها الاقتصادية وهو الأهم بالنسبة إليها.
هل تكفي للصمود؟
البعض قد يرى أن الاستعدادات الروسية الحالية كفيلة أن تمتصَّ مخاطر العقوبات الغربية، لكن فريقًا آخر يرى عكس ذلك، فكما تشير المديرة التنفيذية لدى كوريوليس تكنولوجيز، ريبيكا هاردينغ، فإن النظام المالي البديل لـ”سويفت” الذي استحدثته موسكو “لا يملك سوى شبكة ضعيفة الخيوط حول العالم، ما سيمثّل نقطة ضعف على المدى القصير”، وفق تصريحاتها لـ”بي بي سي عربي“.
حتى استراتيجية زيادة حجم تصدير الغاز والنفط إلى الصين وإيران، التي لجأ إليها الروس تفاديًا للعقوبات التي قد تؤثِّر على حركة البيع والشراء لأسواق الطاقة الغربية، فإنها لن تكون بالتأثير المتوقع، إذ إن تلك الاتفاقيات مهما بلغ مداها فلن تستطيع تعويض تعطُّل الصادرات الروسية لأوروبا والعائد المالي المتوقع منها، إذ إن الغاز الروسي يلبّي احتياجات 40% من الاحتياجات الأوروبية، وهو ما يصعب على الصين امتصاصه.
المحرِّر الاقتصادي بصحيفة “ذي غارديان” البريطانية، لاري إليوت، يرى في تحليلٍ ترجمه “نون بوست” أن الحروب الاقتصادية ليست بالأمر الجديد، إذ إنها تعود إلى بدايات القرن العاشر حين فرض نابليون بونابرت حصارًا على صادرات بريطانيا، لافتًا إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية تعرضت أو هُدِّدت أكثر من 1400 دولة لعقوبات اقتصادية.
وكشف إليوت أن استراتيجية العقوبات الاقتصادية كوسيلة لإجبار الدول على تغيير سياساتها ليست بالأمر المضمون وفق التجارب التاريخية، ناقلًا عن مندوب المملكة المتحدة السابق في الأمم المتحدة، جيرمي جرينستوك، قوله إنه “لا حل أمامك سوى الكلمات أو العمل العسكري للضغط على حكومة ما”.
التطورات الميدانية ربما ليست في صالح روسيا التي تواجه مقاومة غير متوقعة من القوات الأوكرانية، وهو ما عطّل نسبيًّا من حسم معركة كييف حتى كتابة تلك السطور، إذ إن الاستمرار في هذا المستنقع سيزيد أوجاع الروس الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ما سيفقدهم جزءًا من الأرصدة المخصَّصة لامتصاص العقوبات الغربية، هذا بخلاف حسابات الداخل التي لم يضعها أحد في الحسبان حتى الآن.
تاريخيًّا.. لم ترغم العقوبات الاقتصادية دولًا على تغيير مواقفها، لا سيما إن كانت دولة بحجم روسيا، لكن في الوقت ذاته لم يشهد التاريخ عقوبات بهذا الحجم وهذا المستوى وهذا التوحُّد والتكاتف الغربي كالتي فُرضت على موسكو، ما يدعو إلى التساؤل حول نجاح تلك الضغوط في تحقيق أهدافها، هذا يتوقف على إطالة أمد تلك العقوبات واستمرار خطواتها التصعيدية، التي بلا شك لن تتحمّلها روسيا ولا حواضنها السياسية والاقتصادية.. فهل يملك الغرب القدرة والإرادة على المضيّ قدمًا في مواصلة ضغوطه؟