كيف أرسى علماء المسلمين قواعد علم الموسيقى؟

ربما لا يعلم الكثير من فناني ومغنّي القرن الـ 21 أن الكثير من آلاتهم الموسيقية وقواعد الإيقاع التي يسيروا عليها تعود إلى إسهامات المسلمين، الذين تركوا بصمتهم واضحة ليس فقط في المجالات العلمية مثل الفلك والعلوم والطب والكيمياء والفيزياء والهندسة، بل امتدّت إلى المجالات الفنية مثل الرسم والعمارة والغناء والموسيقى.
في السطور التالية، نلقي الضوء على الدور الذي لعبه العلماء والموسيقيون والمغنّون المسلمون والعرب في تطور الموسيقى العالمية، وإسهاماتهم المختلفة في الدراسات المتعلقة بالتدوين والتسجيل الموسيقي اللذين مكّنا الناس من نقل الصوت المسموع إلى أي مكان وزمان، وتأثير هذه الإسهامات على الحضارة الغربية، ودور المسلمين في الحفاظ على التراث الموسيقي للبشرية.
بداية الموسيقى
تعود أقدم الكتابات الموجودة عن الموسيقى الإسلامية إلى نهاية القرن التاسع، أي بعد أكثر من 250 عامًا من ظهور الإسلام. في غياب الوثائق التاريخية التي سبقت ظهور الإسلام، بدأ الموسيقيون والكتّاب والفلاسفة بالتكهُّن بأصول موسيقاهم، فملأوا الثغرات من خلال المصادر المجهولة أو التقاليد الغامضة، حتى قيل إن أحدهم صنع أول عود من ساق ابنه الميت، الذي ندم عليه خسارته، ويُعتبر رثاؤه لابنه الأغنية الأولى.
في المجتمعات القَبَلية التي انتشرت في الجزيرة العربية، أكّدت الموسيقى على كل حدث في حياة الإنسان، وزيّنت اللقاءات الاجتماعية، وحرَّضت المحاربين على القتال، وشجّعت المسافرين عبر الصحراء، وحثّت الحجاج على زيارة الحجر الأسود، حيث كانت مكة مركزًا عقائديًّا تُقام فيه الشعائر الدينية، ووجهة للحجاج الذين كانوا يغنون غناءً فطريًّا يُسمّى بالتلبية والتهليل.

في الجزيرة العربية، برز النشاط الموسيقي في مركزين مهمَّين هما الحجاز ومكة، وفي أسواق العرب، ولا سيما سوق عكاظ، كانت تقام بشكل دوري مسابقات الشعر والعروض الموسيقية، التي استقطبت أبرز الشعراء والموسيقيين والمغنيين.
كانت موسيقاهم، الأكثر تطورًا من تلك التي كانت تُمارَس في القبائل البدوية، مرتبطة بموسيقى القينات (الفتيات المغنيات)، اللواتي يؤدّين في البلاط، وفي البيوت النبيلة، وفي الحانات المتناثرة.
كانت ثقافة مملكة الحيرة العربية الأخرى تحت حكم سلالة اللخميد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بثقافة بلاد فارس تحت الإمبراطورية الساسانية قبل الإسلام، وكان الساسانيون يحترمون الموسيقى العقائدية والدينية، حيث في اعتقاد طائفة المزدكية (ديانة فارسية ثنائية مرتبطة بالمانوية) كانت الموسيقى واحدة من القوى الروحية.
احتلَّ الموسيقيون في حاشية الملك مرتبة عالية، ونال البعض شهرة واسعة، مثل بارباد الذي كان شاعرًا موسيقيًّا فارسيًّا في عهد آخر ملوك الإمبراطورية الساسانية كسرى الثاني، ومنظّرًا وملحّنًا للموسيقى الساسانية، ويُنسَب إليه اختراع نظام الأنماط المعقّد قبل الإسلام، واستمرت مؤلفاته التي أصبحت نموذجًا للإنجاز الفني في الأدب العربي، على الأقل حتى القرن الـ 10.
قبل ظهور الإسلام، لم يكن العرب أشد حرصًا على استخدام الموسيقى في عباداتهم كما فعل الغرب، ولم تكن الموسيقى حينها أكثر من “ترنُّم ساذج بنوعه يحمله المغنّي أو المغنية تبعًا لذوقه أو انفعاله أو ما يريده من تأثير”، كما يقول المؤرِّخون، وبدلاً من ذلك ظهرت طبقة خاصة من القينات أو القيان في قصور الملوك وفي بيوت الأثرياء ورؤساء القبائل، وانتشرت آلات ضبط الوزن الموسيقية، وكان أكثرها انتشارًا الصنوج والجلاجل وآلات الزمر.
من أبرز المغنين العرب الذين ظهروا في بداية الحكم الأموي سائب خائر، أحد أئمة الغناة والتلحين عند العرب الذي أسبغ الروح العربية على الغناء الفارسي
واقتصر الاهتمام بالموسيقى في بداية ظهور الإسلام على أغاني الحروب والمناسبات الخاصة مثل الزفاف، وكان اتّساع حركة الفتوحات الإسلامية سببًا في تواصل العرب مع الثقافات الأخرى مثل الفرس والروم الذين أخذ عنهم العرب العزف على الآلات الموسيقية خصوصًا العود، وتمكّنوا من تطوير ما تعلّموه بما يتناسب مع أذواقهم وثقافتهم وأوزان أشعارهم.
وكان أبو عبد المنعم عيسى بن عبد الله الذائب المعروف باسم طويس بارباد الجزيرة العربية، أول موسيقي ظهر في الإسلام، اشتهر في الأعوام الأخيرة من عهد الخليفة عثمان بن عفان، وهو مغنٍّ رقيق استرعته ألحان الرقيق الفرس الذين كانوا يعملون في المدينة، وكان أول من غنَّى “الغناء المتقن” في الإسلام، وأضاف إليه الإيقاع الخفيف الحركة الذي يعطيه الهزج (أحد بحور الشعر) وقد برعَ فيه.
موسيقى إسلامية كلاسيكية
في ظل الخلافة الأموية (661-750)، انتقلت الموسيقى العربية إلى مرحلة جديدة، وتطور النمط الكلاسيكي للموسيقى الإسلامية بشكل أكبر، حيث نُقلت العاصمة إلى دمشق (في سوريا) واكتظت الساحات بالموسيقيين والموسيقيات، الذين شكّلوا طبقة منفصلة.
كان ظهور الأغنية الفردية التي تؤدَّى بمصاحبة العود من أبرز السمات الموسيقية لهذا العهد، فعلى سبيل المثال ظهر لأول مرة في عهد “راعي الموسيقى العربية” يزيد الأول ما عُرف بـ”منشد البلاط” أو “منشد القصر”.

ومن أبرز المغنين العرب الذين ظهروا في بداية الحكم الأموي سائب خائر، أحد أئمة الغناة والتلحين عند العرب الذي أسبغ الروح العربية على الغناء الفارسي، وكان أول مَن عزف على العود أثناء تأديته الغناء، وأول من ابتكر الإيقاع المُسمى بـ”الثقيل الأول”، وسار على المنهج نفسه آخرون أمثال ابن سريج ومعبد.
ولد ابن مسجح، أول وأعظم موسيقي في العصر الأموي، لُقّب بأبي الموسيقى الإسلامية؛ في مكة لعائلة فارسية، وكان منظّرًا موسيقيًّا ومغنيًا ماهرًا وعازفًا على العود، بدأ في ذلك العصر في وضع قواعد للعزف والأداء والتلحين، لهذا سُمّي الغناء العربي في ذلك الوقت بالغناء المتقن.
سافر ابن مسجح إلى سوريا وبلاد فارس، وتعلم نظريات وقواعد الموسيقى البيزنطية والفارسية، ودمج الكثير من معرفته المكتسبة في الأغنية الفنية العربية، ورغم أنه تبنّى عناصر جديدة مثل الأنماط الموسيقية الأجنبية، إلا أنه رفض السمات الموسيقية الأخرى باعتبارها غير مناسبة للموسيقى العربية، وأدخل من التجديدات اللحنية ما استطاعت الأذن العربية أن تستوعبه وتتذوقه.
المعرفة بإسهاماته واردة في أهم مصدر للمعلومات عن الموسيقى والحياة الموسيقية في القرون الثلاثة الأولى للإسلام، كتاب “الأغاني” لأبي الفرج الأصفهاني في القرن الـ 10، الذي يتحدث عن وضعه أُسُس وقواعد ونظريات الغناء والعزف على العود والتلحين أيضًا.
كذلك جمع الكاتب والشاعر والموسيقي العربي يونس الكاتب، مؤلف أول كتاب عربي عن النظرية الموسيقية، أول مجموعة من الأغاني في القرن الـ 8، وكان من أوائل العرب الذين وثّقوا فنّ الغناء، وأول من دوّن ونوّط الموسيقى العربية، وأثّرت مؤلفاته بالأصفهاني وكتابه “الأغاني”.
ومن النساء اللواتي حظين بشهرة كبيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة في عصر الدولة الأموية جميلة وعزة الميلاء، وأفرد لهما الأصفهاني أجزاء واسعة في كتاب “الأغاني”، خاصة أن عزة الميلاء غنّت في مجالس حضرها حسان بن ثابت، شاعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن الموسيقيين البارزين الآخرين في تلك الفترة ابن محرز ذو الأصول الفارسية، الذي اشتهر بلقب “صناج العرب”، وهو واحد من 5 صنّفهم إسحاق الموصلي في أصول الغناء، وتعلم محاسن الألحان من الروم ومزجها مع الألحان الفارسية ليؤلف منها أغاني صنعها من أشعار العرب.
كتب الكندي المعروف بـ”فيلسوف العرب”، الذي كان منغمسًا بعمق في التعلم اليوناني، أكثر من 13 أطروحة موسيقية، مثّلت أول بحوث جادة في هذا الفن في تاريخنا العربي
يُنسب إلى ابن محرز التجديد في الموسيقى العربية، فقد ابتكر إيقاعًا سُمّي بـ”إيقاع الرمل”، وغناء سمّي بـ”غناء الزوج”، وهو أول من غنّى بزوج من الألحان للبيت الشعرى الواحد، أي أنه لم يكتفِ بلحن واحد يردَّد مع كل بيت، وقد سار المغنّون من بعده على خطاه.
ابن سريج هو أيضًا من أصل فارسي، برع بالغناء والعزف على العود، واشتهر بمرثاته وارتجالاته، ومثل ابن سريج أسّس معبد بن وهب، إمام المغنين العرب، أسلوبًا شخصيًّا خاصًّا تبنّته الأجيال التالية من المطربين، وكان مبدأه في الغناء أنه يستمع أثناء نومه إلى صوت يجري في مسمعه فيستيقظ من سباته ويردده.
خلال تلك الفترة، طرأت تطورات كبيرة على الآلات الموسيقية، لكن العود بقيَ سيد الآلات، فقد اُستخدم في العزف المنفرد، ثم استخدم الفنانون إلى جانبه الآلات الهوائية الخشبية مثل المزمار، وفي بعض الأحيان اصطحبوا الطبل والدف لتمييز الإيقاع، فظهرت بوادر ما يُعرف اليوم بـ”الفرقة الموسيقية”.
العصر الذهبي للموسيقى
واصلت الموسيقى العربية سيرها في طريق الازدهار حتى بلغت ذروتها خلال حكم العباسيين، فمع تأسيس الخلافة العباسية عام 750 على أنقاض الخلافة الأموية، أصبحت بغداد (عاصمة العراق حاليًّا) المركز الموسيقي الرائد، واندمجت العناصر المتباينة في أسلوب الموسيقى الإسلامية الكلاسيكية، وشهدت الخلافة العباسية فترة العصر الذهبي في الموسيقى الإسلامية مع سائر الفنون والآداب، خصوصًا في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي اقترن اسمه بالأمجاد العربية في الفنون والآداب.
في مثل هذه الظروف الملائمة، كان من الطبيعي أن يتقدم فن الموسيقى، فظهر في هذا العهد أشهر المغنين في الإسلام، وكان من أمهر فناني تلك الفترة إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق، أفراد من عائلة فارسية نبيلة، كانوا من كبار الموسيقيين في البلاط الملكي ومن المقرّبين من الخلفاء هارون الرشيد والمأمون، وشارك الموصلي بفاعلية في الجدل المعاصر في مواجهة دعاة الحداثة ابن جامع والمغني الشهير الأمير إبراهيم بن المهدي.
كان إسحاق، المطرب والملحّن والمبتكر، الموسيقي البارز في عصره، رجلًا ذا ثقافة واسعة، له الفضل في تأليف ما يقارب الـ 40 عملًا عن الموسيقى، والتي فُقدت فيما بعد، ووفقًا لكتاب “الأغاني” هو مُنشئ أقدم نظرية إسلامية عن الأنماط اللحنية يُطلق عليها اسم “الأصابع”، حيث قام بتنظيم الأوضاع وفقًا للأوتار الموجودة على رقبة العود والأصابع المقابلة لها.
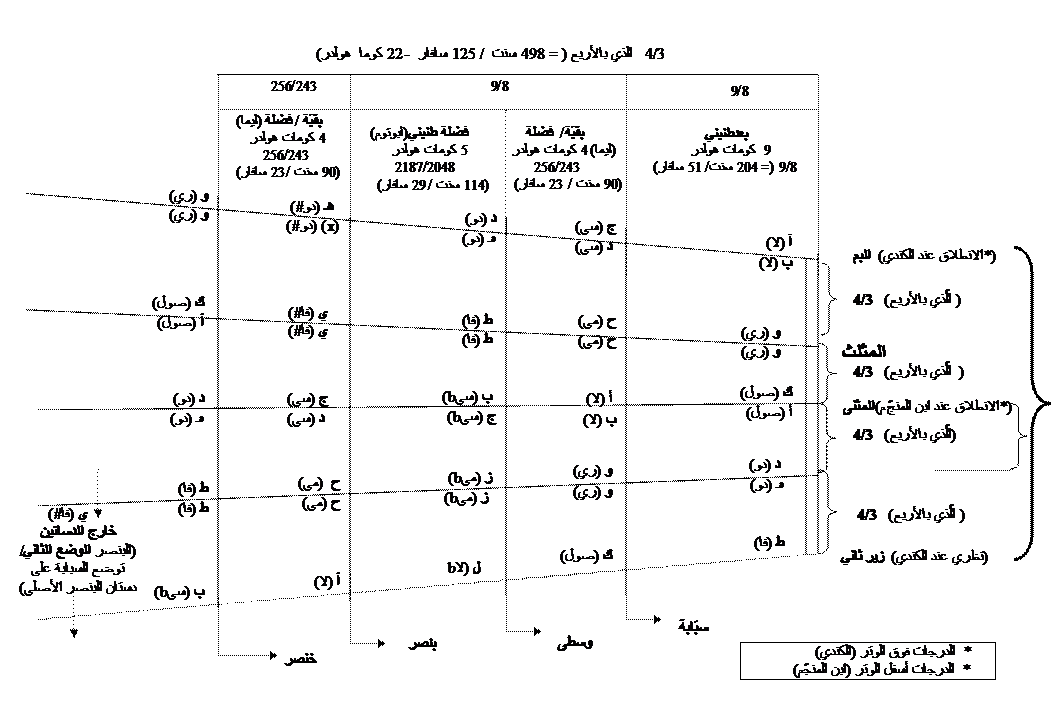
في النصف الثاني من القرن الـ 8، بدأ الأدب الإسلامي المكثِّف لنظرية الموسيقى في الازدهار، وتُرجمت الأطروحات اليونانية إلى العربية، وبدأ العلماء، الذين كانوا على دراية بالكتابات اليونانية، في تخصيص كتب أو أقسام من الكتب لنظرية الموسيقى، وقاموا في أعمالهم بتوسيع أو تغيير أو تحسين أو إلقاء ضوء جديد على النظرية الموسيقية اليونانية.
كتب أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي المعروف بـ”فيلسوف العرب”، الذي كان منغمسًا بعمق في التعلم اليوناني، أكثر من 13 أطروحة موسيقية، مثّلت أول بحوث جادّة في هذا الفن في تاريخنا العربي، بما في ذلك أول أطروحة موسيقية عربية وحيدة نجت، كما تناول نظرية التحري والجوانب الكونية للموسيقى.
كان الكندي أول من أدخل كلمة “موسيقى” للغة العربية، ومنها انتقلت إلى الفارسية والتركية وعدة لغات أخرى في العالم الإسلامي، وتفوّق على الموسيقيين اليونانيين في استخدام الثمن، واستعمل في “رسالة في خبر تأليف الألحان” -المخطوط الموجود الآن في المتحف البريطاني- الرموز والأحرف الأبجدية للتدوين، فكانت أول طرق خاصة للتدوين الموسيقي عرفها العرب.
أحب الكندي الموسيقى، فكان أول من وضع قواعدها في العالم العربي والإسلامي، وله الكثير من الأبحاث حولها، ووضع سُلّمًا موسيقيًّا من 12 نغمة ما زال يُستخدم في الموسيقى العربية، ووظّف الألحان الموسيقية في علاج الأمراض النفسية، وقيل إنه حاول علاج صبي مشلول بالموسيقى.
كان للعرب الفضل الكبير في تطوير آلة العود، ما جعلها أساسًا لتطوير آلات أخرى شبيهة بها اُستخدمت في الموسيقى الغربية
وفي القرن الـ 9 الميلادي، اخترع بنو موسى -محمد وأحمد والحسن بن محمد بن موسى بن شاكر- أقدم آلة موسيقية ميكانيكية معروفة، تُدار بالطاقة المائية، وتستخدم أسطوانات تتبادل ذاتيًّا، وظلّت الجهاز الأساسي لإنتاج وإعادة إنتاج الموسيقى ميكانيكيًّا حتى النصف الثاني من القرن الـ 19، كما اخترعوا لاعب مزمار آليًّا يبدو أنه كان أول آلة قابلة للبرمجة.
في القرن الـ 10 الميلادي، تعامل أعضاء جماعة إخوان الصفا، وهي جماعة أخوية مهمة في القرن الـ 10 اتحدوا على أن يوفّقوا بين العقائد الإسلامية والحقائق الفلسفية المعروفة، مع هذه الموضوعات الموسيقية، وقدموا نظرية الصوت التي تجاوزت النظريات اليونانية القديمة.
تناول الفلاسفة -مثل ابن سينا الذي استخدم آلة العود كتطبيق لنظرياته الموسيقية، وضمّنها في كتابه “الشفاء”، وفيه جزء مهم للغاية عن النظرية الموسيقية العربية، والفارابي، مؤلف كتاب “الموسيقى الكبير”، أحد أهم المؤلفات الموسيقية التي كُتبت على الإطلاق، لما فيه من دراسات رائعة عن الموسيقى وآلة العود وأهميتها وكيفية ضبط أوتارها- موضوعات مثل نظرية الصوت والفواصل والأنواع والأنظمة والتشكيل والإيقاع والآلات، كما فعل آخرون مثل شمس الأئمة السرخسي، وثابت بن قرة، وابن زيلة تلميذ ابن سينا.

وعبر كل العصور، كانت آلة العود واحدة من أهم الآلات التي استحوذت على اهتمام الباحثين في الغناء والموسيقى العربية، وكان للعرب الفضل الكبير في تطويرها، ما جعلها أساسًا لتطوير آلات أخرى شبيهة بها اُستخدمت في الموسيقى الغربية، وكان لعازفي العود على وجه الخصوص مكانة رفيعة في المجتمع العربي، وذاع صيتهم، وتناقلت كتب التراث أخبارهم، بحسب ما يذكر الباحث المصري فتحي الصنفاوي في كتاب “الآلات الموسيقية والإنسان.. الزمان والمكان”.
كيف أثّر المسلمون في موسيقى العالم الغربي؟
يمكن اكتشاف تأثير المسلمين على الإحياء الموسيقي لأوروبا في وقت مبكّر من فترة الإمبراطورية الكارولنجية في غرب ووسط أوروبا في أوائل العصور الوسطى، حيث حاول الإمبراطور الروماني شارلمان تقليد ومنافسة العواصم الإسلامية الكبيرة مثل بغداد وقرطبة، فقضى 7 سنوات في إسبانيا خلال دولة الأندلس، وبالإضافة إلى صداقته مع الخليفة العباسي هارون الرشيد، ودعا علماء من الخارج إلى بلاطه وأسّس مدارس.
وفقًا لبعض المصادر، توسّع بيبان القصير ملك الفرنجة وشارلمان إلى حدٍّ ما في استخدام الموسيقى الكنسية، من خلال إدخال بعض الآلات الموسيقية العربية الإسلامية التي جاءت من إسبانيا أو صقلية، كما يقول المؤرِّخ آرثر ماير شليزنغر.
ويلاحظ أن الآلات التي اُستخدمت في الكنيسة الإنجيلية في سانت ميدارد في القرن الـ 8 والمزامير المستخدمة في القرنين الـ 9 والـ 10، كانت جميعها أدوات شرقية مشتقة من الحضارة الآسيوية القديمة أو المصرية، وانتشرت في أوروبا بشكل رئيسي من خلال المسلمين.
“نحن مدينون للشرق والمغاربة في إسبانيا بكل ما هو نبيل في عاداتنا”، كتب المؤرِّخ الفرنسي رينات نيلي
بالتوازي مع ازدهار الموسيقى في المراكز الشرقية لدمشق وبغداد، تطور مركز موسيقي عام آخر في إسبانيا، أولًا تحت حكم الناجين من الحكّام الأمويين، ولاحقًا في عهد المرابطين البربر (حكّام شمال أفريقيا وإسبانيا في القرنين الـ 11 والـ 12) والموحّدين الذين امتدوا إلى إسبانيا بعد سقوط المرابطين.
بحلول القرن الـ 11، بلغ تدفُّق المعرفة الإسلامية، بما في ذلك الموسيقى، ذروته، ونُقلت الموسيقى من خلال اتصال إسبانيا وجنوب فرنسا، فقد أدّى الاتصال الاجتماعي والاقتصادي بين المسيحيين والمسلمين الإسبان وغيرهم من المسيحيين الأوروبيين إلى نشر التعليم والفنون الإسلامية في جميع أنحاء أوروبا.
يبدو تأثير الموسيقى الإسلامية في الموسيقى والفولكلور الإسباني والبرتغالي واضحًا تمامًا ولا يحتاج إلى أي دليل، فهناك قدر كبير من المؤلفات التي تشكِّل الحياة الثقافية والفنية لهاتين المنطقتين في ظل 800 عام من الحكم الإسلامي.
يمكن العثور على أقرب مثال على هذا التأثير في مجموعة كانتيغاس دي سانتا ماريا. تتألف المجموعة من التدوينات الموسيقية الأندلسية التي كانت تُنشد في البلاط الملكي لألفونسو الحكيم ملك قشتالة وليون خلال النصف الثاني من القرن الـ 13، وتتكون من 415 أغنية دينية أخذت طابع تراتيل المديح للعذراء، وهذه الأغاني هي أول الأعمال الأدبية المعروفة، المحفوظة مع تدوينها الموسيقي الأصلي في اللغة الجاليكية.
خلصت الدراسات التفصيلية حول هيكل الأغاني وشكلها إلى أنها كانت مستمدة بشكل مباشر من الموسيقى العربية، حيث كان 335 منها من قصائد الزجل، وأثبت بعض المؤرِّخين أنها مستوحاة من الأغاني المعروفة باسم الموشحات الأندلسية، وفي الواقع يعتقد جموع الأكاديميين الغربيين أن تفسير ظهور الزجل في الغرب لا يمكن أن يُنسب إلّا إلى الموشح الأندلسي.
كان التأثير الإسلامي محسوسًا في وقت مبكر في شعر التروبادور الذي تأثر بالشعر الأندلسي العربي، حيث انتشر هؤلاء الشعراء والموسيقيون والمغنون في العصور الوسطى بشكل رئيسي في منطقة لانغدوك في جنوب فرنسا، وكذلك في شمال إسبانيا وإيطاليا، واقتبسوا منه أنماطًا من الحب لم تكن معهودة في أوروبا، فكانت بمثابة ثورة في وجه الكنيسة المهيمنة على الحياة هناك، والتي كانت تحتقر المرأة وتراها مخلوقًا أقل من الرجل.
هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن شعراء التروبادور تأثروا بالشعر والموسيقى الأندلسيَّين، حيث الموضوعات الأندلسية مثل الحب العفيف والفضيل وتمثيل المرأة في الشعر الأوروبي، ولا يمكن العثور على مثل هذه الموضوعات النبيلة في الشعر الغربي قبل النمط الأندلسي.

اعترف المؤرِّخ الفرنسي رينات نيلي أن شعوب أوروبا في القرن الـ 10، وخاصة منطقة بروفانس، تعلموا من العرب أنواعًا جديدة من الحب، على عكس تقاليد السرقة والاغتصاب والذبح التي اجتاحت بقية أوروبا في تلك الأوقات، ولخّص الأمر عندما كتب: “نحن مدينون للشرق والمغاربة في إسبانيا بكل ما هو نبيل في عاداتنا”.
في الواقع، كان تأثير الموضوعات والشعر الأندلسي كبيرًا، ما مهّد الطريق لتغيير المواقف والأخلاق التي كانت البذور الأساسية لعصر النهضة، ولعب الارتباط الإسباني دورًا آخر من خلال توسيع النفوذ الإسلامي ليشمل العالم الجديد بدءًا من أمريكا اللاتينية، ونقلت هجرة الموريسكيين (المسلمون الذين بقُوا في الأندلس تحت الحكم المسيحي) إلى أمريكا اللاتينية معارفهم وفنونهم الأندلسية، بما في ذلك الموسيقى، إلى تلك القارة.
في إسبانيا، أدّى اللقاء مع ثقافات مختلفة إلى تحفيز تطور الفرع الأندلسي أو المغربي للموسيقى الإسلامية، وكانت الشخصية الأكثر تأثيرًا في هذا التطور أبو الحسن علي بن نافع الملقب بـ”زرياب”، تلميذ إسحاق الموصلي، الذي غادر بغداد خوفًا من أستاذه، بسبب الغيرة تجاهه لتفضيل هارون الرشيد لصوته، فشدَّ الرحال إلى الأندلس، وهناك أطلق العنان لإبداعه، ولاقى ترحيبًا، وحصل على امتيازات ورواتب سخية فور وصوله البلاد، ومكّنته عبقريته وتفرُّده اللحني أن يصل مكانة لم يصل إليها موسيقي عربي من قبل.
كان زرياب موسيقار ومسؤول الترفيه بالبلاط الملكي في عهد عبد الرحمن الأوسط الذي استدعاه وأكرم وفادته بعد أن فرَّ من بغداد، وأسّس دار المدنيات، وهو أول معهد لتعليم الموسيقى والغناء وقواعدها في مدينة قرطبة، وطوَّر مجموعة متنوِّعة من الأساليب الجديدة لتعليم الغناء في مدرسته الموسيقية المعروفة، التي خضعَ ملتحقوها الموهوبون لاختبارات منهجية شكّلت أُسُس الغناء.
المغني الموهوب والموسيقي البارز في بلاط قرطبة، أدخل على فن الغناء والموسيقى في الأندلس تحسينات كثيرة، أهمها أنه زاد الوتر الخامس إلى العود، واعتبره روح الآلة، وأحب آلة العود وأبدع بها ألحانًا قوية، وجدّد طريقة العزف على العود، واستخدم ريشة النسر بدلًا من الخشب، وكان سببًا رئيسيًّا في انتشار النشاط الموسيقي في المدن الكبيرة، وأصبحت إشبيلية مركزًا رائدًا لتصنيع الآلات الموسيقية.
وضع زرياب قواعد لتعليم الغناء للمبتدئين، وأدخل على الموسيقى مقامات كثيرة لم تكن معروفة من قبل، وافتتح الغناء بالنشيد قبل البدء بالنقر، وابتكر عددًا من الأشكال الجديدة للتأليف، وقدّم أنواعًا من الموسيقى والغناء منها ما تطور إلى موسيقى الفلامنكو الإسبانية، التي تنشأ وفقًا للمفكر والكاتب الأندلسي المعروف بـ”أبو القومية الأندلسية الحديثة” بلاس إنفانتي، من الكلمة العربية “فلاح منغو”، وهي كلمة مركّبة تستخدم لوصف مجموعة من المتجولين الريفيين.
الفرضية وفقًا لإنفانتي أنه “عندما طُرد الموريسكيون، ومعظمهم من المزارعين، من منازلهم لتجنُّب الموت أو الاضطهاد أو الترحيل القسري، لجأوا بين الغجر ليصبحوا فلاح مينغو، أي فلاحًا منكوبًا، وتمكنوا من العودة إلى ممارساتهم واحتفالاتهم الثقافية بما في ذلك الغناء، وهم يتظاهرون بأنهم غجر”.

بالتكامل مع التقاليد والإيقاعات المحلية، أدّت موسيقى وألحان زرياب إلى ظهور عدد من الأساليب الموسيقية وإيقاعات الرقص المتميزة في أمريكا اللاتينية مثل الغارابي في المكسيك، والكويكا والتونادا في تشيلي، وإلسكونديدو التي انتشرت في الأرجنتين وأوروغواي، والسامبا والباياو في البرازيل، والغواجيرا والدانزون في كوبا، ويعود أصل العديد من هذه الأساليب الموسيقية إلى موسيقى الفلامنكو التي تشتهرُ بارتباطها بالعربية.
على مدى هذه القرون، عرف العرب والمسلمون من الآلات الموسيقية عددًا كبيرًا حتى بلغ من كثرتها أن قال الباحث هنري جورج إننا لا نستطيع أن نحصيها على كثرتها إلّا عُشرها، ففي مجموعة الوتريات نجد المزهر، وهو العود العربي الجاهلي، والربابة التي تُعزَف بالقوس بدلاً من ريش الطير، وهي أمّ الآلات عند العرب، ومنها تفرّعت آلة الكمان والقانون والسنطور والجنك أو الهارب، ومن النايات الشبانة والجواق والصفارة، ومن الدفوف الطار والدائرة والمثمنة، ومن الطبول النقارة والطبل والقصعة.
كما عرف المسلمون في القرن الـ 10 الميلادي الأرغن ذا الأنابيب الذي كان معروفًا باسم “ملك الآلات”، وموسيقى القرب الذي شاع استعماله خاصة في الهند وبلاد الملايو والأندلس، كما انتشرت فكرة فرق الموسيقى العسكرية (المارشات) خلال فترة الدولة العثمانية، إذ كانت تلك الفرق تعزف الموسيقى بعد انتهاء المعارك وتحقيق الانتصارات، ونقل الأوروبيون هذه الفكرة من خلال حروبهم مع الإمبراطورية العثمانية.