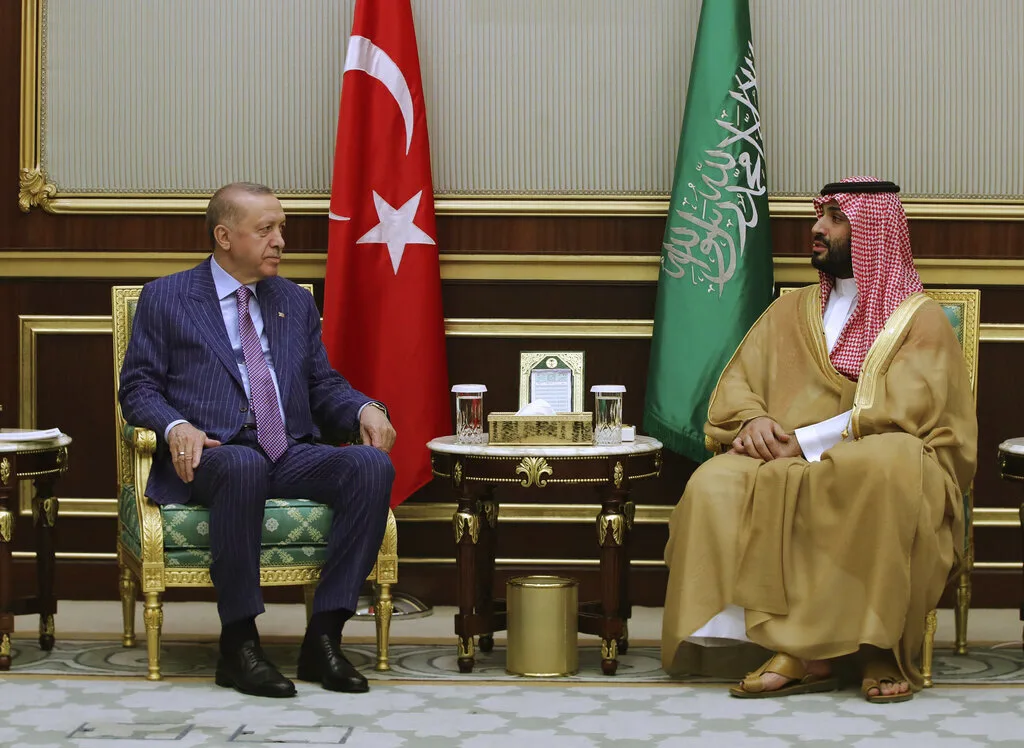ترجمة وتحرير: نون بوست
في مخيم البداوي للاجئين في ضواحي مدينة طرابلس اللبنانية، جلس شاب فلسطيني يُدعى محمد بجوار مدخل محصن يحرسه جنود. كان يتحدث مع أصدقائه أمام متجر عائلته الذي يبيع الدجاج والديوك والقطط وقرد كابوشين في قفص مقابل 500 دولار. وعندما سألته عن الانتخابات النيابية في لبنان، التي نُظمت الشهر الماضي، أجاب محمد – الذي رفض ذكر لقبه – بإيجاز: “هذا ليس من شأننا”.
يتشارك العديد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان هذا الشعور. وبالنسبة للعديد من الشباب والناشطين اللبنانيين، كانت نتائج الانتخابات مدعاة للفرح وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة والفساد المستشري: تم انتخاب 14 مرشحا مستقلا مناهضا للنظام في مجلس النواب، مما يمثل تحولا صغيرا ولكنه مهم في المشهد السياسي اللبناني، الذي هيمنت عليه نفس الأطراف السياسية لعقود.
لكن لاجئي البلد، الذين يواجهون التمييز في كل جانب من جوانب الحياة اليومية تقريبًا، لم يشاركوا هذا الحماس الخاطف. بالنسبة لهم، ليس للانتخابات جانب إيجابي خاصة مع انحدار قيمة الليرة اللبنانية يوما بعد يوم.
عبّر اللاجئون عن نفس اليأس في جيوب اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، بدءا من مخيم البداوي وغيره من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وصولا إلى التجمعات العشوائية للسوريين. لقد تخلوا منذ فترة طويلة عن مستقبلهم في لبنان. قال أسامة العلي، رئيس النادي الثقافي الفلسطيني في البداوي، إنه “ليس هناك ما يشير إلى أن الانتخابات ستحسن الوضع، لذلك لست متفائلاً”.
لا تخفى أسباب هذا اليأس عن أحد. فقد رفضت بيروت إلى حد كبير منح وضع قانوني للاجئين منذ دخول الفلسطينيين البلاد بعد أن أجبروا على ترك منازلهم خلال حرب 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل. وبالإضافة إلى ما يقارب 192 ألف لاجئ فلسطيني في البلاد، يستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون سوري فروا لأول مرة من الحرب في سنة 2011. واعتبارًا من سنة 2020، بات أكثر من 80 بالمئة من هؤلاء اللاجئين السوريين يفتقرون إلى الإقامة القانونية.
يشكل اللاجئون حوالي ربع إجمالي سكان البلاد – أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم. وتعيش هذه الفئة في ظروف مزرية حيث يفتقرون إلى الوظائف والسكن والتعليم والرعاية الصحية. ومن بين القيود الأخرى، يُمنع اللاجئون من ممارسة المهن المختصين فيها، بدءا من الطب وصولا إلى القانون، ولا يمكنهم شراء العقارات بأسمائهم الخاصة.
مكنتهم برامج المساعدة النقدية من وكالات الأمم المتحدة من خلال التحويلات الشهرية، غالبًا بالدولار الأمريكي، من العيش لكن العديد من عائلات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وجدوا أنفسهم في مواقف يائسة بشكل متزايد مع التدهور السريع للاقتصاد.
في الدورة الانتخابية الماضية، لم يكترث المرشحون المستقلون الجدد للاجئين، وتجاهلوهم إلى حد كبير وركزوا بدلاً من ذلك على الأزمة الاقتصادية. كان اللاجئون – الذين كانوا ذات يوم كبش فداء من قبل السياسيين التقليديين بحجة سرقتهم للوظائف، وإثقال كاهل البنية التحتية المدنية، والعيش على الإعانات الحكومية – غائبين بشكل أساسي عن الخطاب السياسي منذ انخفاض قيمة العملة اللبنانية في أواخر سنة 2019. ومع ذلك، لا يزال التمييز المستمر الذي تفرضه الحكومة واضحًا.
في 14 أيار/ مايو، قبل يوم من الانتخابات، أمرت محافظة النبطية ومنطقة البقاع الغربي جميع البلديات بمنع اللاجئين السوريين من مغادرة منازلهم لمدة 38 ساعة في “إغلاق” غير رسمي. وقد أثار هذا المرسوم، الذي يشير إلى السوريين باعتبارهم “مهاجرين” وليسوا “لاجئين”، مخاوف السوريين الذين يُزعم أنهم يهددون وظائف المواطنين.
في وقت لاحق من ذلك الشهر، تعرّضت عضوة البرلمان المنتخبة حديثًا سينثيا زرازير، التي خرجت من حركة الاحتجاج لسنة 2019، لانتقادات من قبل نشطاء وأكاديميين بسبب تغريدة نشرتها في سنة 2016 تدعو إلى الإبادة الجماعية للسوريين. وفي مقابلة حديثة على التلفزيون المحلي، اعتذرت عن انتقائها للكلمات ولكن ليس عن موقفها تجاه اللاجئين السوريين.
ورغم إدانة الجماعات الحقوقية لهذه الممارسات باعتبارها عنصرية وتمييزية، إلا أن حظر التجول يُفرض بشكل متكرر على السوريين في لبنان خلال فترات حساسة، مثل بداية جائحة كوفيد-19 أو يوم عاشوراء.
من جانبه، ادعى محافظ النبطية، حسن فقيه، في مقابلة مع صحيفة “ناشيونال” التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، أن حظر التجول ليس سوى “إجراء عادي” و”ليس عنصريا” مضيفا أن “هذا الإجراء احترازي لأن هناك الكثير من السوريين في البلاد. نحن لا نريد أي مشاكل”.
كان محمود كنو، البالغ من العمر 27 سنة، الذي يعمل حارس أمن مبنى في مكتب شبه شاغر بالقرب من ميناء بيروت، من بين السوريين الذين أُمروا بالبقاء في منازلهم مع أسرته يوم الانتخابات في مدينة صيدا الساحلية. وقد وصل إلى لبنان سنة 2008 ليس كلاجئ بل كعامل بناء. وبمرور الوقت، شعر بأنه محظوظ.
من خلال العزيمة والحظ، تمكن من الحصول على شهادة في الرسم الهندسي من أكاديمية محلية. وقبل ثلاث سنوات، بعد ما يقارب عقدا من الكفاح، حقق أحلامه. أصبح رئيس عمال يشرف على ستة مبانٍ في شركة عقارية وفرت له سيارة ومنزلا وراتبًا قدره 1400 دولار شهريًا.
لكن في ظل تعمق الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقم معدلات التضخم، بدأ راتبه يتضاءل. بعد ذلك، في الرابع من آب/ أغسطس 2020، انفجر ما يقارب 3000 طن متري من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت وقتل ما لا يقل عن 218 شخصًا – بما في ذلك شقيقته سيدرا البالغة من العمر 15 سنة، وما لا يقل عن 40 سوريا آخرين.
بعد وقت قصير من وفاة أخته، انتقلت عائلة كنو إلى صيدا، لكنه ظل يقيم ويعمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع بالقرب من ميناء بيروت. علاوة على الصدمة، يكافح كنو لدفع تكاليف الأدوية اليومية باهظة الثمن التي يحتاجها أفراد أسرته الذين اُصيبوا في الانفجار. وقد قال محدقا في الفراغ بينما تهتز ساقاه على كرسي بلاستيكي داخل المبنى الذي يعمل فيه في بيروت: “ليس لدي خيار سوى العمل، وسداد ديوني، ومحاولة المغادرة إلى الغرب. لم أفكر في المغادرة أو التسجيل كلاجئ إلا بعد الانفجار”. (كونه مسجلا يؤهله للحصول على طلب اللجوء، مما يزيد من فرصة مغادرته البلاد).
قبل الانفجار، لم يكن كنو لاجئا من الناحية الفنية، إلا أنه كان لا يزال ضحية الانتقاد اللاذع المناهض لسوريا الذي تسامح معه نظرا لأسلوب حياته المريح. لكن بعد الانفجار، أدرك ما يشعر به معظم اللاجئين منذ فترة طويلة؛ ألا وهو انعدام الأمن في البلاد. وقد كافح في يوم الانفجار من أجل العثور على مستشفى لعلاج أفراد أسرته الجرحى نظرا لما يتلقاه اللبنانيون من معاملة تفضيلية في بلد يعاني بالفعل من محدودية الموارد.
رغم الدعم القليل الذي يتلقاه اللاجئون السوريون من الحكومة اللبنانية، إلا أن الفقراء اللبنانيين في جميع أنحاء البلاد كثيرا ما يشتكون من حصول هذه الفئة على المزيد من المساعدة وعيشهم حياة أفضل منهم لأنهم غالبا ما يتلقون المساعدات الدولية بعملة الدولار، بما في ذلك معونة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومنذ الانهيار الاقتصادي في سنة 2019، انقسم المجتمع اللبناني بين النخب القليلة التي تمتلك الدولارات وأغلبية السكان الذين يضطرون إلى استخدام الليرة اللبنانية غير المستقرة التي فقدت ما بين 80 و90 بالمئة من قيمتها في السنة الماضية – وذلك وفقا لسعر الصرف اليومي في السوق السوداء.
مع ذلك، يصعب دعم الادعاءات القائلة إن اللاجئين يعيشون حياةً أفضل من اللبنانيين الفقراء، لأنهم عادة ما يتلقون مبلغًا بالكاد يكفي لتغطية حاجياتهم ويعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك عدد المنظمات الإنسانية المسجلة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، تكون المساعدة المالية المقدمة من بعض المنظمات بالليرة اللبنانية وليس الدولار.
تتجلى المعاناة الموازية بين فقراء اللبنانيين واللاجئين بشكل خاص في بلدة عرسال الواقعة على الحدود بالقرب من جبال القلمون السورية. وأثناء عبوري إلى المدينة في سيارة دفع رباعي تابعة لمنظمة إنسانية، قال الجندي الذي يحرس حاجز البلدة مازحا إنه يتمنى لو كان سوريا حتى نتمكن من مساعدته.
في بداية الحرب السورية، عبر العديد من اللاجئين جبال القلمون للوصول إلى لبنان، ليتجاوز عددهم في النهاية عدد اللبنانيين الذين يعيشون بالقرب من الحدود. (تشتهر الجبال الوعرة بأنها أصبحت موطنا للعديد من المتمردين الإسلاميين السوريين – بما في ذلك مقاتلو الدولة الإسلامية الذين طُردوا عندما شن الجيشان اللبناني والسوري، إلى جانب حزب الله، هجوما كبيرا في سنة 2017).
من بين الأعداد الكبيرة ممن عبروا توجد مجموعة صغيرة من العائدين اللبنانيين، الذين يُنظر إليهم على أنهم لبنانيون على الورق فقط. فعندما اندلعت الحرب في سنة 2011، عاد هؤلاء المواطنون اللبنانيون، بعد أن أمضوا حياتهم كلها في سوريا، إلى جانب اللاجئين السوريين. وهم يشعرون الآن وكأنهم لاجئون في بلد آبائهم، وبسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف السكن، بنى بعضهم خياما خارج التجمعات العشوائية التي يسكنها عادة السوريون المنتشرون في جميع أنحاء المنطقة.
يقولون إن هناك ما لا يقل عن ألفي عائلة لبنانية عائدة وأن المجلس النرويجي للاجئين كان الجمعية الإنسانية الوحيدة التي استقبلت شكاواهم، حيث قدم لهم الخشب والألواح البلاستيكية لبناء الخيام. ورغم عدم معرفة عددهم بالضبط، إلا أنه في سنة 2015 سجلت المنظمات الإنسانية أكثر من 28 ألف عائد لبناني.
عندما سألت أسرة لبنانية مكونة من 13 فردا كانت قد انتقلت مؤخرا إلى خيمة عما إذا كانوا يشعرون بأنهم لبنانيون، نظرت إليَّ الأم عزيزة فارس، وأجابت ساخرة: “هل هكذا يعيش اللبنانيون؟”. كانت تشير إلى الخيمة العارية، والموقد الصغير الصدئ على أرضية خرسانية عارية متصل بعبوة غاز وإبريقان للشاي بدون مغسلة.
على عكس السوريين، لا يتلقى العائدون اللبنانيون الدعم من المفوضية لأن لديهم جوازات سفر لبنانية. ومن ناحية أخرى، لا تعطيهم البلديات المحلية الأولوية لأنها تعتبر العائدين جزءا من مجتمع اللاجئين. ولا يقع الاعتراف بهم إلا في إطار وعود ورشاوى من قبل بعض السياسيين من الأحزاب التقليدية عندما يحين وقت الانتخابات نظرًا لقدرتهم على التصويت.
أوضح الزميل اللبناني العائد وزوج عزيزة فارس أحمد فارس، الذي يعمل في مقلع الحجارة، على الرغم من خضوعه لعملية قلب مفتوح مؤخرًا، أنه في سنة 2018، قام بالتصويت وزوجته لصالح المرشح السني بكر الحجيري الذي كان متحالفا مع رئيس الوزراء آنذاك سعد الحريري. وقد وعد الحجيري بمساعدة العائلة في العثور على شقيق فارس الذي اُعتقل بشكل تعسفي في سوريا في وقت مبكر من الحرب. ولكن مكان وجوده لا يزال مجهولا إلى حد الآن. قال فارس: “لماذا نصوت هذه السنة؟ لم يقوموا بمساعدتنا على الإطلاق في آخر مرة”.
المصدر: فورين بوليسي