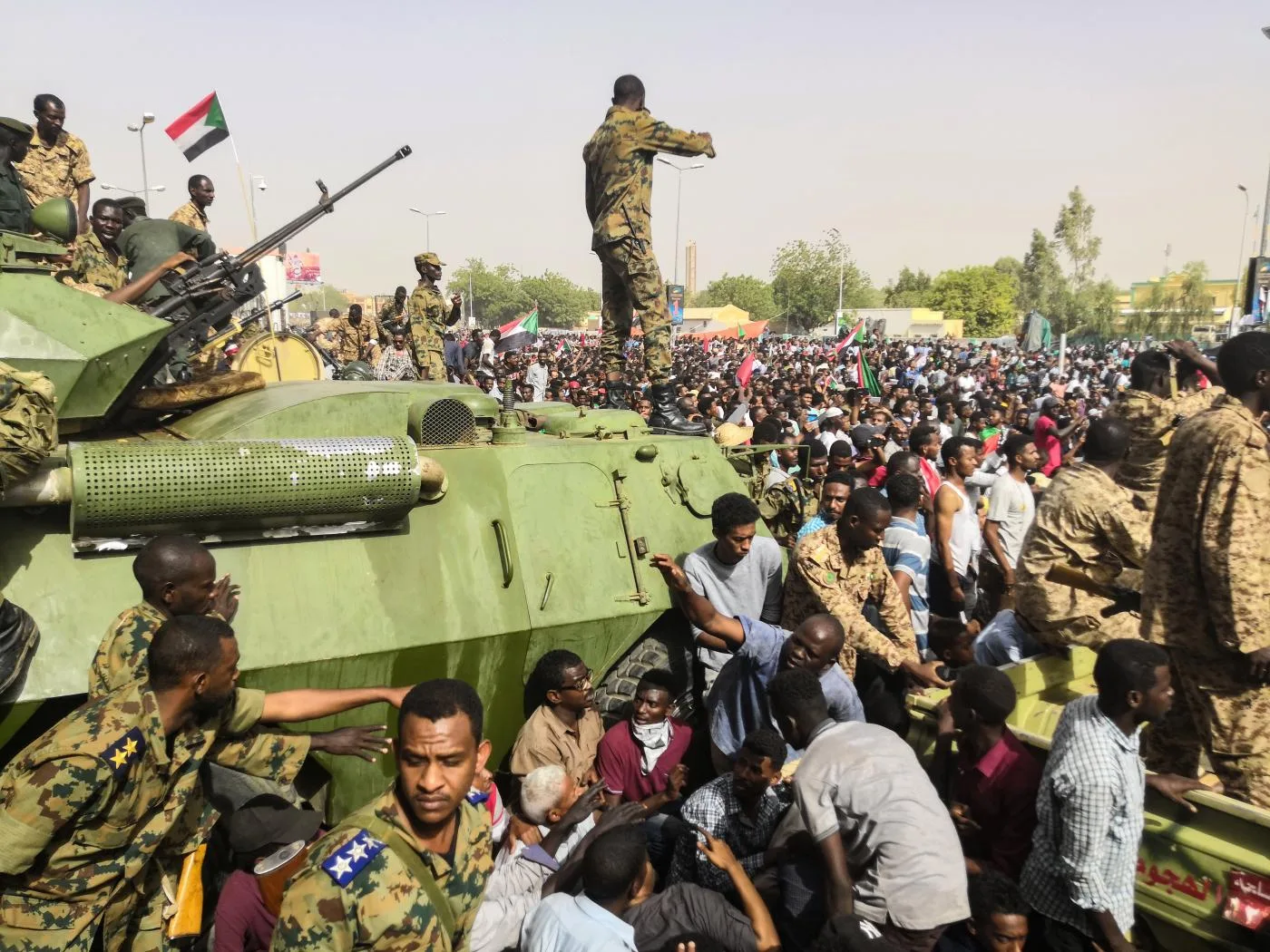وصل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الإثنين 18 يوليو/تموز 2022 إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة هي الأولى له أوروبيًا منذ توليه السلطة رسميًا منتصف مايو/أيار الماضي، وكان في استقباله وزير الاقتصاد برونو لو مير، أعقبه لقاء سريع بوزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، قبل لقائه المهم بالرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.
اختيار فرنسا كوجهة أولى للرئيس الإماراتي خارج البلدان العربية في زيارة تستغرق يومين يحمل الكثير من الدلالات بشأن عمق العلاقات بين البلدين، التي تجاوزت بروتوكلات التعاون التقليدي بين دول أوروبا والشرق الأوسط لتصل إلى مستويات غير مسبوقة من التناغم، في ظل تطابق الأجندات أحيانًا إزاء الكثير من الملفات.
الأجواء تشبه كثيرًا تلك التي كانت في سبتمبر/أيلول 2021 حين التقى ابن زايد ماكرون في قصر شاتو دو فونتينبلو بوسط باريس، ونظيرتها في دبي ديسمبر/كانون الأول 2021 حين رد الرئيس الفرنسي الزيارة، لينسج زعيما البلدين شبكة عنكبوتية من العلاقات الشخصية المثيرة للجدل، علمًا بأن الرئيس الإماراتي سيغادر فرنسا دون أن يلتقي برئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
الزيارة وما تحمله من دلالات تعيد إلى طاولة النقاش مرة أخرى ملف العلاقات الفرنسية الإماراتية، تلك العلاقات المحاطة بسياج من الشكوك والتساؤلات عن مرتكزاتها التقليدية الثابتة على مدار عشرات السنين، والأخرى المتغيرة منذ 2011 وحتى اليوم، التي حملت دور البطولة في كثير من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الأخير وغيرت الكثير من ملامح خريطته الجيوسياسية.
To Receive the UAE President… Playing the UAE National Anthem#Mohamed_bin_Zayed_in_France #UAE #France #Paris #محمد_بن_زايد_في_فرنسا@MohamedBinZayed@FranceEmirats@UAEEmbassyParis pic.twitter.com/Ts9b4YNl8H
— UAE Forsan (@UAE_Forsan) July 18, 2022
الشريك الضال والمثير للجدل
صحيفة “لوموند” الفرنسية استبقت الزيارة بتقرير حذرت فيه من تجاهل الملف الحقوقي الإماراتي الذي يعاني من شروخات وانتهاكات غائرة وفق التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك نظير الحصول على صفقة نفط في ظل الأزمة الراهنة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشفت الصحيفة عن النقلة النوعية في مسار العلاقات بين البلدين، حيث التحول الكبير من التوازن النسبي في سبعينيات القرن الماضي حين اتخذت باريس موقفًا إيجابيًا نسبيًا إزاء قضايا العرب وأبرزها القضية الفلسطينية، ما جذب أنظار ملوك الخليج وقتها لرؤساء الدولة الفرنسية وعلى رأسهم جاك شيراك الذي طالما أبدى إعجابة بمؤسس الإمارات، الشيخ زايد آل نهيان، إلى عصر ماكرون حيث وصلت الشراكة لمستويات غير مسبوقة، “فلم تعد الدولة النفطية الخليجية عميلًا رائدًا للصناعات الدفاعية الفرنسية فقط، بل تحولت إلى ركيزة فرنسا الأساسية في العالم العربي والإسلامي” على حد وصف “لوموند”.
وتحكم العلاقات بين البلدين البرغماتية البحتة التي تتجاوز كل الشعارات والقيم الأخلاقية التي تتشدق بها فرنسا بين الحين والآخر، التي يبدو أنها تحولت في الوقت الحاليّ إلى أداة ضغط تستخدم حين يكون توظيفها يخدم المصالح الفرنسية والعكس، وهو التوجه الذي دفع باريس لغض الطرف عن الانتهاكات التي يمارسها النظام الإماراتي وعلى رأسه ابن زايد الذي وصفته الصحيفة بـ”شريك فرنسا الضال والمثير للجدل”.
يسير ماكرون عكس عقارب الساعة الأمريكية فيما يتعلق بالبوصلة إزاء الشرق الأوسط، فبينما يقلص بايدن بصمة بلاده في المنطقة عبر الانسحابات المتتالية ورفع الغطاء عن حلفاء الخليج، عززت باريس من حضورها
ورفضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سياسة المقايضة التي يتبعها ماكرون مع الإمارات، النفط والطاقة مقابل تجاهل الانتهاكات الحقوقية، لافتة أن حاجة الفرنسيين للطاقة لا تبرر غض الطرف عن السجل الإماراتي المشين حقوقيًا، مضيفة أنه وحتى كتابة تلك السطور ما زالت المعارضة الإماراتية مستهدفة في الداخل والخارج حيث القبض على كل من يغرد خارج السرب، نشطاء وحقوقيون ومدرسون ومحامون وأطباء وكتاب وغيرهم.
المنظمة حمّلت الأنظمة السياسية الداعمة للسلطات الديكتاتورية في الشرق الأوسط مسؤولية تفاقم الأوضاع في تلك البلدان، حيث شجع هذا الدعم تلك الدول على ترسيخ منظومتها القمعية عبر حزمة من القوانين المكبلة للحريات، فيما اتهمت الإمارات – بدعم فرنسي – بتأجيج العديد من النزاعات في الخارج، هذا بخلاف استهدافها لإرادات الشعوب التواقة للحريات والديمقراطيات وعلى رأسها شعوب مصر وتونس واليمن وليبيا.
الإمارات: بوابة ماكرون للشرق الأوسط
يشير “World Politics Review” المتخصص في تحليلات السياسة العالمية، إلى أن الإمارات بوابة ماكرون للدخول نحو الشرق الأوسط، لتعزيز نفوذ بلاده المتراجع والبحث عن موضع قدم لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب من تلك المنطقة الدسمة والمتخمة بالكثير من مقومات الإغراء.
ويرى الموقع أن ماكرون يسير عكس عقارب الساعة الأمريكية فيما يتعلق بالبوصلة إزاء الشرق الأوسط، فبينما يقلص بايدن بصمة بلاده في المنطقة عبر الانسحابات المتتالية ورفع الغطاء عن حلفاء الخليج، عززت باريس من حضورها، فكانت الزيارات المكوكية للرئيس ورفاقه إلى لبنان والعراق ودول الخليج، هذا بجانب إطلاقه سلسلة من المبادرات الدبلوماسية في محاولة لمعالجة الأزمات الإقليمية والبحث عن دور جديد لفرنسا المتراجعة منذ سنوات لحساب قوى أخرى.
وبينما كانت أمريكا وبعض قوى العالم يتخذون موقفًا مناوئًا من حكام الإمارات والسعودية ومصر بسبب سياستهم الإقصائية واستهداف المعارضين والانقلاب على الديمقراطية، حرص ماكرون على تعزيز علاقاته الشخصية مع زعماء تلك الدول، فكان أول رئيس أوروبي أيد ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أحداث 2013، كما التقى ولي العهد السعودي في الوقت الذي كان تصفه النخب الأمريكية والرئيس بايدن بـ”المنبوذ”، هذا بخلاف تعميق علاقته بولي عهد أبو ظبي سابقًا والرئيس الإماراتي حاليًا رغم الانتقادات الموجهة له دوليًا، حتى نجحت فرنسا في أن تكون الشريك الموثوق به لدى القوى الكبرى العربية.
وتنظر فرنسا لحليفها الخليجي على أنه “بئر النفط” الذي لا ينضب أبدًا، وحائط الصد القوي أمام تداعيات أي أزمة تهز سوق الطاقة، ومن ثم يعول الفرنسيون على تلك الزيارة في ضخ المزيد من النفط داخل صهاريج فرنسا الفارغة منذ وقف الإمدادات الروسية التي كانت تلبي أكثر من ثلث احتياجات أوروبا بأكملها من الطاقة سنويًا.
جاء الربيع العربي 2011 بمثابة نقطة الالتقاء المشتركة التي جمعت بين الإمارات وفرنسا على مسرح واحد، فالبلدان لديهما توجهات مسبقة إزاء أي مساعي لدمقرطة المنطقة العربية، لما تحمله من تهديد واضح ومباشر على مصالح البلدين التي ترتكز في الأساس على حلفائهما من الأنظمة الديكتاتورية
فرنسا: الحاضنة الأوروبية لـ”ابن زايد”
بمنطق أن لكل شيء ثمن، نجح أبناء زايد في إسالة لعاب ماكرون عبر لغة المال والصفقات والاستثمارات التي أنعشت الخزانة الفرنسية وساهمت طيلة السنوات الماضية في عبورها للمأزق الاقتصادي الخانق الذي تعاني منه وكان أحد أسباب زيادة الاحتقان الشعبي الداخلي ضد الحكومة والحزب الحاكم.
ما كان لأبناء زايد تمرير أجندتهم التوسعية في المنطقة دون حليف أوروبي قوي، يكون لهم حاضنة سياسية دولية قادرة على الدفاع عنهم داخل أروقة المؤسسات الدولية، خاصة فيما يتعلق بإجهاض أي مساعي دولية لمعاقبة الدولة الخليجية على انتهاكاتها الحقوقية المستمرة، سواء في الداخل أم في بعض دول الجوار كاليمن، بجانب تدخلاتها المباشرة في شؤون عدد من الدول.
وبعد التوتر المتأرجح الذي شاب العلاقات مع إدارة دونالد ترامب ومن بعدها جو بايدن، وعدم استقرارها بالشكل المطلوب، فضلًا عن المخاطر الناجمة عن الارتماء في أحضان المعسكر الشرقي، لم يجد الإماراتيون أفضل من فرنسا كحليف بديل له حضوره القوي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة، مستغلة أوراق الضغط الاقتصادية التي بحوزتها وكان لها عامل السحر في أن يغمض ماكرون عينيه عن السياسة الخارجية الإماراتية في المنطقة رغم المناشدات الدولية بضرورة إعادة تقييمها لما تتضمنه من قنابل موقوتة تؤجج المنطقة وتزيد احتمالية إشعالها.
الربيع العربي.. مسرح التقاء المصالح
جاء الربيع العربي 2011 بمثابة نقطة الالتقاء المشتركة التي جمعت بين الإمارات وفرنسا على مسرح واحد، فالبلدان لديهما توجهات مسبقة إزاء أي مساعي لدمقرطة المنطقة العربية، لما تحمله من تهديد واضح ومباشر على مصالح البلدين التي ترتكز في الأساس على حلفائهما من الأنظمة الديكتاتورية.
ومن ثم وبعد حالة صمت مقنع إبان انطلاق قطار الربيع العربي، كشف البلدان عن وجههما الحقيقي منذ 2013، حيث اتهمت أبو ظبي بأنها الداعم الأبرز لما عرف بـ”الثورة المضادة” كما فتحت خزائنها أمام كل التيارات المجهدة لإرادة الشعوب، فكانت ضلعًا أصيلًا في إجهاض التجربة المصرية والتونسية والليبية، هذا بخلاف العبث الذي مارسته لوأد التجربة اليمنية.
ولم تجد فرنسا أفضل من الإمارات لتمرير أجندتها الشرق أوسطية لإنقاذ الحلفاء المطاح بهم من السلطة كنتيجة منطقية للحراك الثوري، وقد شهد الملف الليبي تحديدًا قمة التناغم بل التطابق بين الموقف الإماراتي الفرنسي، فكان الدعم المادي واللوجستي للواء متقاعد خليفة حفتر، حيث كشفت حكومة الوفاق فيما بعد عن تورط فرنسا والإمارات في دعم جيش حفتر بالسلاح والعتاد فضلًا عن التعاون الاستخباراتي.
ومن الملف الليبي إلى التركي، حيث اتحد أبناء زايد مع ماكرون في العمل على تقزيم الدور التركي في المنطقة من خلال العديد من المناوشات والتحركات التي أرهقت أنقرة بصورة كبيرة ودفعتها للتخلي عن قضاياها الداخلية المهمة بالانشغال بملفات أخذت من تركيا ما أخذت، وذلك بزعم محاربة التيار الإسلامي وحزب العدالة والتنمية والتصدي لنفوذه المتصاعد في المنطقة منذ 2011، وقد تعرضت أبو ظبي لاتهامات عدة بشأن تقديم دعم للوحدات الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المنصف إرهابيًا لدى أنقرة).
ما زالنا في المحطة التركية.. حيث كثفت فرنسا والإمارات من جهودهما للضغط على تركيا اقتصاديًا من خلال زعزعة النزاع على مصادر الطاقة في شرق المتوسط، فالبلدان قادا تكتلًا مناهضًا لتركيا ضم خصوم الأخير الإقليميين، مصر واليونان وقبرص، هذا بخلاف تعاونهما معًا في تشويه صورة الدولة التركية لدى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بهدف قطع الطريق أمام أي محاولة للتمدد غربًا.
ثم جاءت مصر كإحدى المحطات البارزة لهذا التناغم الفرنسي الإماراتي حيث تطابق الرؤية في ضرورة دعم نظام السيسي، سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وإعلاميًا، في مواجهة أي محاولات لتهديد أركانه، فيما وضعت باريس النظام المصري تحت وصايتها لبضع سنوات كان يبحث فيها السيسي عن شرعية لنظامه.
ولم يكن المشهد اليمني ببعيد عن حميمية العلاقة بين البلدين، أو على الأرجح بين الزعيمين، ابن زايد وماكرون، حيث كانت باريس واحدة من أكثر دول العالم دعمًا لمهمة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ضد نظام الحوثي، فيما غضت الطرف عن الانتهاكات الممارسة هناك التي لم يختلف عليها أحد ووثقتها المنظمات الدولية.
تعاون غير مسبوق
شهدت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة موجات متتالية من التعاون البناء في كل المجالات، دفعت فرنسا لأن تتربع على رأس الدول الأكثر تعاونًا مع الإمارات داخل القارة العجوز، في محاولة لترجمة هذا التناغم السياسي والأيديولوجي لخدمة مصالح البلدين اقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا.
ويتصدر الجانب العسكري قائمة المجالات ذات التطور اللافت في العلاقات المتبادلة مؤخرًا، بداية من اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة في 1995، وحتى اليوم، حيث إبرام عشرات الصفقات التسليحية والمناورات العسكرية المشتركة، أبرزها صفقة تطوير 400 دبابة من طراز لوكليرك والطائرات المقاتلة التي تكلفت أكثر من 6 مليارات دولار.
رغم أهمية البعدين الاقتصادي والعسكري، ودورهما في تعزيز الحضور السياسي لفرنسا، فإنها لم تغفل البعد الثقافي كأحد المسارات المهمة وأبرز أدوات القوى الناعمة في إحياء النفوذ الفرنسي في المنطقة العربية
كما عززت فرنسا من حضورها الشرق أوسطي من خلال إنشاء قاعدة عسكرية لها في الإمارات عام 2009، كما تعد أحد أبرز الحضور الدائمين في معرض الدفاع الدولي “آيدكس”، بينما تلتزم الإمارات بالمشاركة الدورية المنتظمة في معرض يوروسا توري في باريس.
أما على الجانب الاقتصادي، فتعتبر الإمارات ثاني أكبر مستثمر من مجلس التعاون لدول الخليج العربي في فرنسا بعد قطر، كما بلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في السوق الإماراتي 2.5 مليار يورو في نهاية عام 2020، بينما تحتل الإمارات المركز الـ35 في قائمة المستثمرين الأجانب في فرنسا، ووصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى ما يزيد على 25.2 مليار درهم بنهاية عام 2021 وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وفي نهاية العام الماضي أبرم البلدان أكثر من 13 اتفاقية لتعزيز التعاون أبرزها في مجالات الطاقة والنفط والتكنولوجيا، فيما دشن الجانبان في 3 يونيو/حزيران 2020 خريطة طريق جديدة لتعميق الشراكة الإستراتيجية في السنوات العشرة المقبلة من 2020 – 2030، كأحد أبرز التوجهات الخارجية لدى البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ورغم أهمية البعدين الاقتصادي والعسكري، ودورهما في تعزيز الحضور السياسي لفرنسا، فإنها لم تغفل البعد الثقافي كأحد المسارات المهمة وأبرز أدوات القوى الناعمة في إحياء النفوذ الفرنسي في المنطقة العربية، فتبنى البلدان حزمة من مشروعات التعاون الثقافي لعل أبرزها متحف “اللوفر” الباريسي، الذي استنسخت الإمارات نموذجًا مصغرًا منه في أبو ظبي، ليكون أول متحف عالمي على أرض عربية، وذلك نظير صفقة بقيمة مليار يورو، تحصل فرنسا على 400 مليون منها نظير السماح بإطلاق اسم متحفها على نظيره الإماراتي حتى عام 2037، حسبما نشرت صحيفة The Times البريطانية.
وفي المسار ذاته سمحت فرنسا بافتتاح فرع لجامعة السوربون في أبو ظبي، ضمن إستراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون بينهما، فيما تعد الإمارات الأولى بين دول الخليج في استقبال الجاليات الفرنسية، كما أصبحت عضوًا في المنظمة الدولية للفرانكوفونية عام 2018 وتم إدراج اللغة الفرنسية ضمن المناهج الدراسية بالدولة الخليجية اعتبارًا من 2019/2020.
وتجاوزت العلاقات بين البلدين حاجز المصالح المتبادلة إلى المرتكزات الدينية، فكانت الإمارات الدولة العربية الأبرز الداعمة لفرنسا في الأزمة التي واجهتها في أعقاب حملة الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، والهجمة على الجالية المسلمة في البلاد، ودعوات المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الفرنسية، فقد جيشت الدولة الخليجية جيوشها الإعلامية والثقافية للدفاع عن الموقف الفرنسي وتقديم كل سبل الدعم للحكومة الفرنسية في الوقت الذي كان فيه المسلمون في أنحاء العالم كافة يستشيطون غضبًا جراء إصرار ماكرون على المضي قدمًا في سياساته العنصرية ضد الأقلية المسلمة في بلاده.
في ضوء ما سبق، فإن اختيار ابن زايد لفرنسا لتكون محطته الأولى خارج البلدان العربية بعد توليه السلطة رسميًا، ليس بالمستغرب، فهو اختيار يؤكد حميمية العلاقة بين البلدين التي وصلت إلى مستويات عمق غير مسبوقة، ويعزز هذا التحالف المشبوه الذي يعتبره البعض الخنجر الأكثر حدة في ظهر استقرار المنطقة بأكملها.