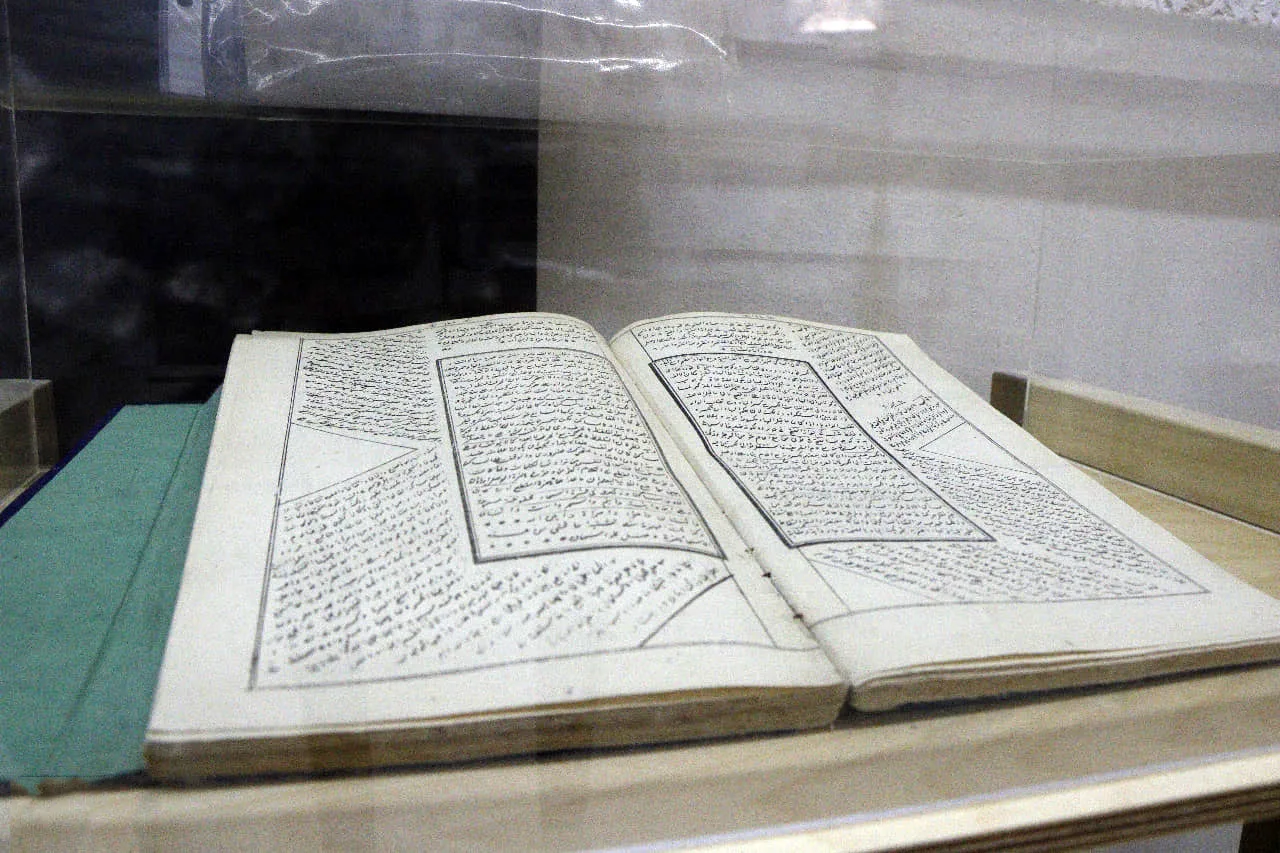تنمو مجتمعات ما بعد الحداثة بعمق واتساع فج يتناسب مع حجم بنيتها الصناعية ومدى انخراطها في نمط معماري هندسي يوفر في المساحة ويغذي الهياكل الفولاذية والألسنة الخرسانية، وفي الوقت ذاته تنمو الكثافة السكانية حول هذه الدوائر، يتطورون بما يتناسب مع هويتهم داخل المدينة، لكن هذا التطور يسير بمحاذاة هذه المجتمعات ولا يتقاطع معها إلا في مواضع معينة تتعلق بالعمل والضرورات والاحتياجات، وينجر الإنسان فيما يسمى الاغتراب بأشكاله وتنويعاته، اغتراب الإنسان عن ذاته وعن المجتمع وانهيار كل البنى القيمية والسقوط في هوة الهواجس.
تتفشى ظاهرة الاغتراب داخل المجتمعات، لكنها على النقيض تفتقد للمفهوم القطعي والمعايير المحددة، بيد أن هناك ملامح مميزة يمكن رصدها في فيلم المراقب ـ Watcher للمخرجة “كلوي أوكونو” الذي يؤسس لعالم ينتمي لنوعية الرعب النفسي، ويخلق اضطرابًا واغترابًا من خلال الإيقاع والمكان، فيصنع شخصية ويحيطها بظروفٍ تبدو عادية ويومية إذا نظرنا لها نظرة ثانوية من الخارج.
لكن من خلال إيقاع الفيلم البطيء والرؤية البصرية والعوامل المكانية والبيئية والحواجز التي يتآلف معها الشخص رغمًا عنه، سيبدأ الفيلم في استكشاف مساحة اغتراب الشخصية وإزاحتها من خانة الترفيهي أو الوظيفي إلى منطقة حدسية، تتعرض لجانب قائم على التكهنات والرؤية الفردية، وهذا لعدة أسباب يمكن الوقوف عليها خلال النصف الأول من الفيلم.
يدور الفيلم حول جوليا – الممثلة مايكا مونرو – وزوجها فرانسس – كارل جلوسمان – الذي ينقل محل سكنهما من نيويورك إلى رومانيا موطن والدته الأصلي نظرًا لظروف العمل التي تحتم عليه المكوث هناك، لا يتعرض الزوج لأي نوع من المشكلات خلال إقامته في المدينة لإجادته اللغة وانشغاله شبه الكلي بالعمل، لهذا لا نراه كثيرًا على الشاشة، فيما تضعنا المخرجة كلوي في مواجهة شخصيتها الرئيسية، في محاولة لتفكيك الجو القصصي العام.
فمنذ الوهلة الأولى سنلاحظ حالة الانزعاج والضجر التي تحاصر جوليا على كل المستويات الإنسانية والنفسية، فهي محتجزة داخل إطار اللغة، ترى العالم من خلف حجاب يشوه اللغة ويمسخها كأداة للتواصل ويحولها إلى سجن اضطراري لا يمكن تجاوزه لكن يمكن التكيف معه، إلى جانب ذلك تقضي جوليا ساعات يومها بمفردها، وهذا لا يولد شعورًا فردانيًا وانشغالًا بالذات في مستواها المادي، لكن يوفر مساحة هائلة للهواجس، فالضجر والفضاء الزمني والمكاني يمكن يخلق اغترابًا عن الذات، يسفر عن فراغ داخلي وفجوة عاطفية ومادية.
الاغتراب هو خلل في المنظومة الاجتماعية، لكن على المستوى الفردي هو اضطراب في علاقة الفرد بالمجتمع والعالم، يختبر خلاله المرء مجموعة من المشاعر والأفعال، تؤدي هذه الفجوة – في حالة جوليا – إلى انشغال بالآخر، فكل هذه الحواجز والمشاعر تعمل على إلغاء الذات ككيان مستقل، وفي حالة الفيلم، ترتبط الذات بالآخر وتأخذ قيمتها منه، وهنا تبدو العلاقة مشوهة، فجوليا تحفز كل حواسها لرصد الجاسوس والمراقب الذي يتربص بها ويشاهدها من النافذة، يبدو الأمر أنها تفعل ذلك بدافع الخوف، وهو الرأي الأرجح، لكن الخوف وحده لا يدفع جوليا للاهتمام والانتباه للمراقب، بل الحاجة لملء الفراغ الحياتي، بالإضافة للضجر كعامل له أهمية كبيرة في خلق الدوافع.
فهي لا تفعل شيئًا في يومها إلا الانتظار، دون أصدقاء، دون معارف، دون ذكريات، لم تستطع تحمل وطأة الزمن المكثف، فتمنح أفعال المراقب قيمة مضاعفة، كوجهة مؤكدة يمكنها التعاطي معها حتى لو بشكل مؤقت ومشوه، فالعلاقة هي علاقة خوف وتربص، ورغم حفاظ المخرج على هذا الجو القاتم، واتجاهه – حتى انقضاء الساعة الأولى – إلى جعل الفيلم أشبه بدارسة حالة للقلق والاضطراب ومدى تأثير العوامل الخارجية على الشعور النهائي، فإن العشر دقائق الأخيرة غيرت من هذا السياق تمامًا وحولت وجهته إلى اتجاه معاكس ونمطي، لكنه يبقى ممتعًا أيضًا، إلا أن قيمة السردية ذاتها انخفضت.
في العمارة المقابلة لمسكن جوليا، في أحد الطوابق، هناك رجل غامض يراقب جوليا من خلف النافذة، ينفذ بكيانه الأسود غير المرئي إلى زجاج الحائط الذي يغطي الوجهة الأمامية للمسكن، تشعر جوليا بثقل هذه العيون، تحاول أن تبتعد عن فكرة المراقبة والترصد، إلا أنها لا تستطيع، لأن الأمر تخطى حدود النافذة الزجاجية والمساحة الآمنة، وتحول إلى تتبع وتقصي في السينما والسوبرماركت، ففي كل مرة كان شعور جوليا يتضاعف، من مجرد حدسٍ لا يتخطى التخيلات، إلى حقيقة شبه مؤكدة، وهوس لا يمكن الفرار من خيوطه.
يرصد الفيلم صراعًا روحيًا في شطره الأول، صراعًا نفسيًا وجوهريًا عن قيمة الذات في مواجهة الآخر، إقحام الإنسان في عزلة اضطرارية واستكشافه تحت عين المراقِب، نموذج حي للاغتراب الهيجلي، فالشخصية مسلوبة الحرية والمعرفة، كلاهما منقوص أو غير موجود، مراقبة الشخص تسلب حريته، والحاجز اللغوي والبيئي جراء الانتقال إلى مجتمع جديد تسلب الشخص معرفته وتزيل حيز الذكريات.
فالمكان الجديد معلق زمانيًا، ليس له ماضٍ أو مستقبل، ربما هذه الأشياء حاضرة، في انتظار استكشافها، إنما بالنسبة لشخص جديد كليًا، فهي سطح أملس، فضاء من الملل والرتابة والخوف بحيث لا ترى إلا الهواجس على مد البصر، يلح عليها شعور الفقد، شعور النقصان والضياع، لذا من الطبيعي أن يهتم الفرد اهتمامًا بالغًا بظلٍ يتبعه، بعيون ترصده كأنه محط اهتمام في عالم أملس، دون لغة أو ذكريات، خصوصًا مع الذراع الصناعية الحداثية الهائلة التي تجتذب الزوج في دوامة من العمل الشاق وتهمش الزوجة بطريقة تزيد من شقائها الاجتماعي، لتصل إلى حالة تشبه البرانويا، تصور أشياء غريبة وسماع أصوات غير حقيقية، أو هكذا كانت تبدو في الساعة الأولى من الفيلم.
بعدها تغير المنظور بشكل كبير، وتحرك الفيلم من الهواجس المفتوحة إلى الدوائر المغلقة، حتى فنيًا تحرك الفيلم من الانفتاح النوعي إلى النوعية المحددة، ليختمه كفيلم نوعية طبيعي يحمل المتعة للمتفرج لكنه فوت فرصة الوصول لما هو أكثر من النتيجة المرضية، سمح لفرصة النفاذ لعقول المشاهدين والتلاعب بهم، وفتح مساحة أكبر للتفكير بإلقاء الأسئلة دون إجابات، لكن المخرجة فضلت أن تلقي بالإجابة في نهاية الفيلم، ليندرج المنتج الفني تحت مظلة السائد، يلتزم بصوت نهائي واضح ويقيني، لا يسمح بالارتياب أن يتسلل إلى مشهد النهاية.
تشهد مسيرة الممثلة مايكا مونرو تطورًا هائلًا خلال العقد الماضي، بعد أن احترفت التمثيل وشاركت في بطولة فيلم It Follows بأداء مميز، وتواصل تقديم الأداءات الجيدة على مدار السنوات السابقة في مشاريع مختلفة، لتعود مرة أخرى إلى نوعية الرعب في فيلم Watcher، بأداء أكثر من ممتاز، لكن المخرِجة لم تستغل هذا الأداء إلا في سياق الإثارة النفسية والرعب، رغم شحن الجو العام وإعمال الكاميرا بصورة تعكس الجانب النفسي للبطلة وتحفز المخاوف المرتبطة بالمنطق الاجتماعي والظروف المكانية والزمانية، بيد أنها قررت أن تروي الحكاية بطريقة تغلق السردية عند نقطة معينة، لم تحاول أن تمد خط الهوس النفسي والاغتراب بحيث يصبح الفيلم أقرب لرصدٍ واقعي لحالة سيدة تعاني من الوحدة والاغتراب والقلق.
كان من الممكن أن تتمسك بألاعيبها البصرية والذهنية، أن تكثف السردية في اتجاه المعاناة الداخلية للبطلة داخل دائرة اجتماعية تخلع عنها الصفات الآدمية، بدلًا من النهاية الحتمية للنوعية السائدة، خصوصًا مع وجود بناء متماسك لشخصية المراقب – الممثل بيرن جورمان – على مستوى الشكل والأداء، إلا أن المخرجة قررت إهدار كل هذه العوامل المميزة في حيز التقليدي، بمنطق تشيكوفي يحتم استخدام السلاح عند ظهوره.
فبدا الفيلم كبناء ضخم منفتح على مساحات شاسعة، لكنه ينتهي بطابق علوي لا يمكن الفرار منه، كلما صعدنا نعلم يقينًا أننا لن نهرب من الطابق الأخير، من النهاية المحتمة، لذلك فالمنتج البصري والحكائي فرصة ضائعة لكنها ممتعة جدًا خصوصًا في ربعها الأخير حينما تتحرك الأحداث بشكل معهود ونمطي، وتلجأ المخرجة للخدع والانحرافات المفاجئة في الحبكة حتى تصنع التشويق والمفاجأة التي بدت متوقعة ويمكن رؤيتها من بعيد.
لكن هذا لا ينفي مقدرة المخرجة الهائلة على صنع المزاج اللوني والجو العام واللغة البصرية التي ترفع الفيلم من حيز النوعية إلى الآرت هاوس، انتقال الممثلة في شوارع البلدة بمفردها، ورصدها في لقطات واسعة تسمح برؤية الفراغ الكامن حولها صدر شعورًا بالقلق والاغتراب، حتى لو بدا أن الفيلم متأثر بأجواء سينما شرق أوروبا البصرية خصوصًا مع حضور البيئة الأوروبية كعامل رئيسي، لكن هذا لا يفقد التجربة قيمتها.