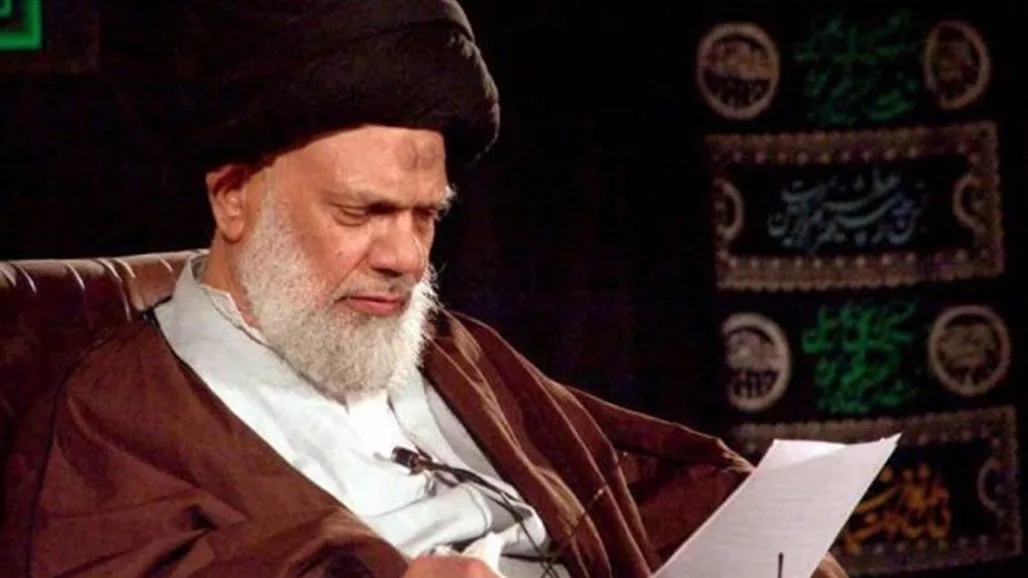“كل اللي بتمناه من ربنا إني أشوفه واضمّه لحضني ولو مرة واحدة، مش طالبة المستحيل، عاوزه أعرف بس هو عمل إيه، إيه جريمته عشان يحرمونا منه 3 سنوات كاملة”… بصوت هدّه الألم ونبرات كسرها الحزن، انهمرت بالبكاء والدة محمود القدرة، المختفي قسريًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تتسوّل كلمة عن ابنها الأصغر، تناشد الصغير والكبير في أن يطمئنَ قلبها الذي تفطّر حرقة على غيابه، فكان ساعدها الأيمن وعينها التي تبصر بها في الحياة.
لم يكن محمود الضحية الوحيدة لجريمة “الاختفاء القسري”، والتي تحوّلت في مصر إلى ظاهرة خلال السنوات الماضية، حتى باتت سياسة ممنهَجة تلجأ إليها السلطات للتخلُّص من معارضيها والمغرّدين عكس سربها، غير أن الوضع تجاوز خطوطه الحمراء ليكتوي بنيران هذا السوط المؤلم المعارضون وغير المعارضين، من لهم في السياسة ومن هم عنها ببعيد.
في السنوات الأولى لجمهورية الضباط الجديدة التي نشأت أعقاب يوليو/ تموز 1952، كان مصطلح “ورا الشمس” رائجًا بين العامة، وهو مصطلح دعائي استقاه الناس من مسارَين مختلفَين، الدراما وشهود العيان، للترهيب من السير عكس هوى السلطة العسكرية، ويعني إخفاء أي شخص معارض للنظام عن وجه الأرض، حتى أنه يذهب خلف الشمس، كناية عن فقدان الأمل في عودته مرة أخرى، ومع مرور الوقت تحول هذا المصطلح الاستثنائي إلى واقع يومي.
وأمام عشرات الحالات الموثَّقة بالصوت والصورة لجرائم الاختفاء القسري في مصر، تعزف الأجهزة الرسمية، الداخلية والقضاء ومجلس حقوق الإنسان الحكومي، على وتر النفي والإنكار الدائم، متهمة الجمعيات الحقوقية التي توثّق تلك الحالات بمحاولة تشويه صورة الدولة التي تبذل قصارى جهدها لتحقيق العدالة والالتزام بالقانون والمبادئ الدولية في هذا المسار، على حدّ قولها، ما يقابَل حينًا بالسخرية وآخر بالقلق ممّا هو قادم، في ظل الإصرار على المضيّ قدمًا في تلك السياسة، ما يعني مواصلة الزجّ بالعشرات بل بالمئات “ورا الشمس”.
ويعرَّف الاختفاء القسري على أنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتمّ على يد موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون”، بحسب المادة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
من يُطمئن الأم المكلومة؟
بينما كان عائدًا مع زوجته عقب الانتهاء من عمله كمدرّب لياقة بدنية في أحد مراكز اللياقة (الجيم) في منطقة هليوبوليس بالقاهرة، مساء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، فوجئ محمود راتب القدرة (31 عامًا) أثناء نزوله من الميكروباص الذي كان يستقله للعودة إلى منزله في التجمع الأول، برجلَين يرتديان ملابس مدنية في انتظاره.
وما أن وطأ بأقدامه ثرى الأرض حتى انقضّا عليه، الأول أعصب عينَيه بشارة سوداء، والآخر قيّد يدَيه وطوّقه بشدة ثم ألقيا به داخل سيارة ميكروباص كانت في انتظاره على جانب الطريق، هنا صرخت الزوجة تطالبهما بتركه، متسائلة عن هويتهما وسبب ما فعلاه، لكن سرعان ما جاءها الرد، ركل وضرب ورميها على الأرض.. وتلك كانت المرة الأخيرة التي يُرى فيها محمود.
3 سنوات كاملة منذ الاختفاء الأول للشاب الثلاثيني وحتى كتابة تلك السطور، وليس هناك خبر أو معلومة مؤكَّدة عن مكان تواجده، ولا عن ملابسات اختفائه، عشرات الزيارات قامت بها أسرته لقسم الشرطة التابع له (قسم التجمع)، تخللتها عدة زيارات لمقرّ وزارتَي الداخلية والعدل ومكتب النائب العام، لكن الإجابة الوحيدة التي كانوا يتلقونها: “لا نعلم عنه شيئًا”.
أرسل ذووه العديد من الاستغاثات والتلغرافات للنائب العام لسرعة الكشف عن مكان محمود، لكن دون ردّ أو إجابة تهدئ الأم المكلومة التي كادت أن تفقد بصرها حزنًا على ابنها الأصغر الذي كان يتولى رعايتها ووالده، وبشهادة الجميع لم يكن للشاب أي نشاط سياسي ولم يعتقَل قبل ذلك، كما أنه بعيد تمامًا عن دائرة الأصدقاء أصحاب الميول السياسية، وبعد اعتقاله لم يتعرّض أي من أصدقائه لأي أذى، كما أنه لم يثبت عليه يومًا ما أن شارك في تظاهرة أو نشر منشورًا على منصات التواصل يتعرّض فيه للنظام أو الحكومة، وهو ما أثار الشكوك لدى أسرته.
وبعد أكثر من عام كامل على الاختفاء دون أي أخبار، فوجئت الأم باتصال هاتفي في رمضان 2020 يخبرها بأن ابنها متواجد في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للأمن الوطني في العباسية، وكان المتصل أحد المرافقين له هناك بعد الإفراج عنه، على حدّ قوله، وسرعان ما توجهوا إلى المركز إلا أنهم لم يتوصلوا إلى شيء.
أكثر من 3 أعوام وأسرة محمود لا تتوقف عن الاستغاثة والمناشدة، منشورات يومية، تلغرافات مستمرة، تواصُل مع الجهات الحقوقية والمعنية بشكل متواصل، كل همّهم معرفة مكان الاختفاء، وما هي الأسباب، وهل هو على قيد الحياة أم لا، صرخات الأم المقهورة لا تتوقف، وأنّات شقيقته لا تهدأ، في انتظار خبر يدخل السرور عليهما بعد 36 شهرًا من الحزن والبكاء والقهر.

بكاء أبنائه الثلاثة لا يتوقف
أما محمد عبد اللطيف عمر (42 عامًا)، ابن مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، فوجئ خلال عودته لمصر قادمًا من السودان على متن الرحلة رقم 845 فى تمام الساعة الخامسة صباح يوم الاثنين 27 يناير/ كانون الثاني 2020، باستيقافه في مطار القاهرة من قبل أحد أفراد الأمن المتواجدين بالمطار، والذي يبدو أنه كان بانتظاره بالاسم، إذ كان برفقته بعض زملائه لكنه الوحيد الذي تمَّ القبض عليه.
كان يعمل محمود في السودان فنّي كهرباء، واعتاد السفر ذهابًا وإيابًا ما بين القاهرة والخرطوم، ما جعله وأسرته لا يتوجّسان أي خيفة من القدوم إلى وطنه بين الحين والآخر 3 أو 4 مرات في العام للقاء عائلته، زوجته وأولاده الثلاثة.
لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا، حيث اختفى عن الأنظار منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، رغم أنه لا يمتلك أي سجل سياسي وليس له أي أنشطة معارضة، ربما المسألة الوحيدة التي تثير الشكوك هي تواجده في السودان، حسبما نقل البعض للعائلة، رغم أن ذلك ليس دليل إدانة، فهناك عشرات الآلاف من المصريين يعملون هناك.
وبعدما تنامى إلى علم أسرته ما حدث، سارعوا إلى المطار للسؤال عن اختفائه وسبب ذلك، لكن دون ردّ، كانت الإجابة الوحيدة أنهم لا يعرفون عنه شيئًا، ما اضطر الأسرة لتقديم العديد من الشكاوى والبلاغات إلى النيابة العامة والداخلية، كما أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري دون ردّ حتى اليوم.
اتصالات بين الحين والآخر تتلقاها أسرة محمود عن مكان تواجده، لكنها جميعها دون جدوى، وبين الأمل في لقاء قريب والرعب من مصير مجهول، يقبع الأبناء الثلاثة برفقة والدتهم في انتظار من يجيب عن تساؤلَين: أين الأب؟ وماذا فعل ليختفي طيلة هذين العامَين؟
يعيش ابن أسوان، أحمد جمال الدين محمد طاهر (35 عامًا) قصة مشابهة، حيث أُلقي القبض عليه في أحد الأكمنة الأمنية مساء 21 سبتمبر/ أيلول 2016 بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، دون إبداء أي أسباب.
وبسؤال أسرته عنه لم يتوصّلوا إلى أي معلومة مؤكدة، فيما علموا بطرق غير رسمية عبر أحد المعتقلين داخل مركز احتجاز الأمن الوطني بأكتوبر، ممّن أُفرج عنهم لاحقًا، أنه كان برفقتهم لمدة يومَين ثم تمَّ تحويله بعد ذلك إلى الأمن الوطني بمدينة أسيوط (جنوب)، لكن بالعودة إليهم أنكروا تواجده، فيما نما إلى علم ذويه مؤخرًا وجوده في سجن العازولي الحربي بمحافظة الإسماعيلية (شرق).
مَن للوالد المقعَد؟
ما أصعب أن يُختطف الابن أمام عين والده المقعَد، هذا الابن الذي كان قدمَي أبيه اللتين يمشي عليهما، وعينه التي ترى ما لم يرَه، أي إحساس يمكن أن يصف حالة هذا الوالد الذي لم يمنعه عجزه من الهرولة لمعرفة مكان اختفاء نجله، لكن دون أمل، فكانت النتيجة مزيدًا من الألم واعتصارًا قاهرًا من الحزن للقلب والروح معًا.
في تمام العاشرة مساء 8 يوليو/ تموز 2019، وبينما كان عمرو محمد عمر، طالب السنة الرابعة بكلية الهندسة، يرافق والده المقعَد في القطار لزيارة أهله في أسيوط، وقبيل وصول المحطة بدقائق معدودة، فوجئ الوالد بمجموعة من المدنيين يحيطون بنجله، أغمضوا عينَيه، وقيّدوا يدَيه، وأنزلوه بقوة الدفع القصوى من القطار.
لم يصدّق الوالد، المقعَد على كرسي متحرك نتيجة إصابته بشلل نصفي، ما حدث، وعلت صرخاته جنبات القطار بحثًا عن ولده الذي يرافقه، لكن لم يسمعه أحد، فغيّر وجهته فورًا واستعان بأحد ركّاب القطار لإنزاله في محطة أسيوط ليعود إلى الجيزة مرة أخرى، مهاتفًا ابنته لانتظاره في المحطة لمساعدته على العودة إلى منزله.
لكن المفاجأة أنه وعقب وصوله لمحطة الجيزة، كان في انتظاره بعض أفراد الأمن، حيث اقتادوه وابنته التي كانت في انتظاره إلى قسم الجيزة، وخضعا للتحقيق من الساعة الرابعة فجرًا وحتى السابعة والنصف صباح اليوم التالي، الغريب أنهم سألوه عن مكان اختفاء ولده، وذهبوا إلى منزله للسؤال عنه كذلك، في محاولة لإنكار معرفتهم بمكانه.
لم يقف الوالد مكتوف الأيدَي، إذ طرق كافة الأبواب الشرعية والرسمية، مخاطبات وتلغرافات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية، لكن كان التجاهل هو سيد الموقف، وحتى اليوم وبعد مرور 3 أعوام تقريبًا، ما زال الوالد المقعَد الذي لم تفارق دمعاته وجنتَيه في انتظار عمرو، قدماه اللتين كان يسير عليهما والمخدِّر الذي أنساه شلله لسنوات طويلة.
بين التأكيد والنفي
تضاربت الآراء والأرقام الخاصة بأعداد المختفين قسرًا، بين تأكيدات الجمعيات الحقوقية للحالات التي تحوّلت إلى ظاهرة واضحة ومكتملة المعالم، ونكران على طول الخط من قبل الجهات الرسمية المصرية التي نفت كافة التقارير الموثَّقة لوقائع الاختفاء، مدّعية أنها تستهدف تشويه الدولة وصورتها الخارجية.
في تقريرها السنوي السادس لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري” (حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في 30 أغسطس/ آب 2015، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، بهدف نشر الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسري على المجتمع المصري، وضرورة الوقوف أمام جريمة الاختفاء القسري في مصر)، والصادر تزامنًا مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس/ آب 2021، والذي جاء تحت عنوان “جريمة الاختفاء القسري مستمرة: الإنكار الرسمي ما زال بلا جدوى”، وثّقت الحملة 3029 حالة اختفاء في الـ 6 سنوات الأخيرة، منذ 30 أغسطس/ آب 2015 حتى أغسطس/ آب 2021.
وجاءت القاهرة والجيزة في مقدمة محافظات مصر التي شهدت حالات اختفاء قسري، بمعدل 93 و57 حالة على التوالي خلال عام 2021، وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة كفر الشيخ بواقع 46 حالة اختفاء، وسجّلت محافظتا بورسعيد وسوهاج أقل عدد في حالات الاختفاء، حيث تمَّ توثيق اختفاء ضحية واحدة في كل محافظة منهما.
أما عن أماكن تواجُد الضحايا قبل القبض عليهم، فتصدّر الشارع القائمة بـ 49%، يليه المنزل بـ 21%، ثم المقرّات الأمنية مثل أقسام الشرطة بنسبة 7%، والأكمنة الأمنية على الطرقات 6%، بحسب توثيق المفوضية المصرية.
وفي إحصائية أخرى وثّقتها مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان (مستقلة)، كشفت عن بلوغ حالات الاختفاء القسري طيلة السنوات الأخيرة 14% من إجمالي عدد حالات الانتهاكات الحقوقية التي رصدتها عام 2020، والبالغ عددها 13 ألف انتهاك، ما يعني أن العملية باتت سياسة ممنهَجة وليست مجرد حالات عشوائية.
صمت على أوتار العجز والأمل
ليس هناك تعريف واضح وشامل ومحدِّد للاختفاء القسري في القانون المصري، غير أن دستور 2014 شدّد في بعض مواده على ضمان حريات المواطنين وعدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال، كما جاء في المادة 54 منه ضرورة أن “يبلَّغ فورًا كل من تقيَّد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابةً، ويمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدَّم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته”.
وفي المادتَين 40 و41 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لعام 1950، والمعدَّل بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2020، أُكِّد على عدم جواز احتجاز المتهم إلا في الأماكن المخصَّصة لذلك، فيما تتيح المادتان 42 و43 لأعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية، والتأكد من عدم وجود محتجزين بصفة غير قانونية.
ورغم أحقية وقانونية ضحايا الاختفاء القسري رفع دعاوى قضائية ضد جهات الاحتجاز والاعتقال، والمطالبة بمعاقبة المسؤولين والحصول على تعويضات مادية، إلا أنه في الغالب لم يلجأ أحد لهذا الحق، إما تشكيكًا في جديّة التعامل مع مثل تلك الدعوات من قبل النيابة العامة، وإما خشية الانتقام من المؤسسات الأمنية ردًّا على مثل تلك التحركات التي تكذّب ادّعاءات الجهات الرسمية بنفي عملية الاختفاء القسري.
حالة من الصمت العاجز تخيّم على ذوي المختفين، تحفُّظ واضح في الإدلاء بأي تصريحات حول أبنائهم، خوفًا من مزيد من الانتقام، الكل يؤمل نفسه أن يكون ابنه أو شقيقه ضمن قائمة المفرَج عنهم في إطار سياسة العفو الرئاسي التي تتّبعها الدولة مؤخرًا، منوّهًا أنه في حال التصريح والانتقاد لأي جهة ما، ربما يقود ذلك إلى حرمان ذويهم من العفو أو الإفراج عنهم أو حتى على الأقل الكشف عن أماكنهم، وهو ما حدث مع بعضهم على حد قولهم، حتى لو كان الأمل ضعيفًا فلا بدَّ من التمسُّك به، هذا حال الكثير من أُسر الضحايا.