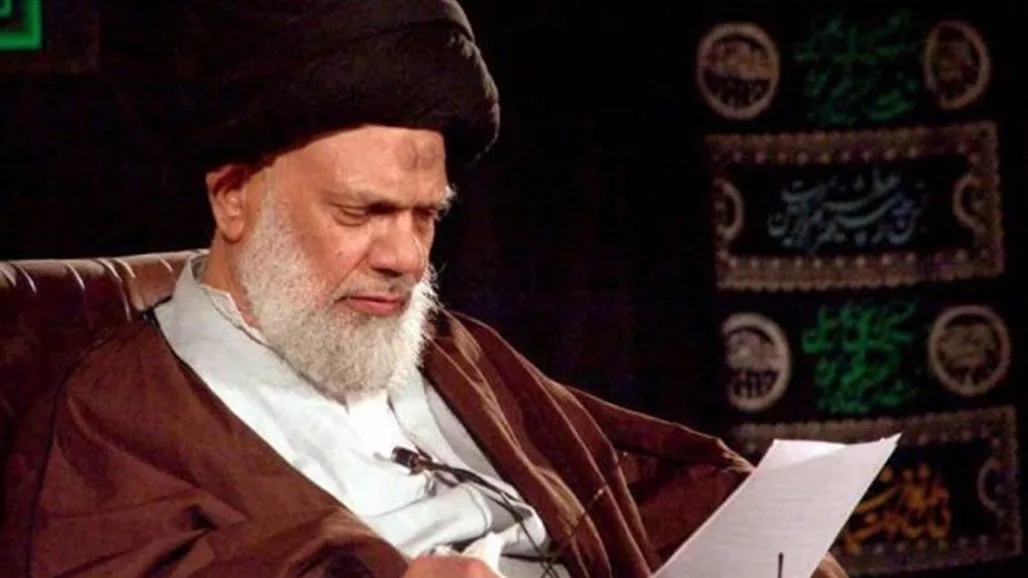تشي القرائن بأن تداعيات حركة 3 يوليو/ تموز 2013 لم تقتصر على مجرد الإطاحة بالرئيس المنتخَب واستبداله بآخر مؤقت، لحين هندسة المشهد العام لتصعيد من أطاح بالمنتخَب، وإنما امتدت تلك الآثار لتشمل المساس بالتماسُك الاجتماعي للبلاد.
هنا، تقول المنظمات الحقوقية المهتمة بالملف المصري، إنّ عملية التغيير القهري للحكم تلك، لم تكن لترسخ، بهذه الصورة، على مدار 9 أعوام، لتمتدّ إلى مجالات أبعد من كرسي الرئاسة قليلًا، مثل هندسة العمران والقوانين على مقاس الحكم الجديد، لولا “متوالية” هدر القانون وحقوق الإنسان التي تمَّ إطلاقها بحق كل رافضي تلك الإجراءات.
كمّاشة القهر
وفقًا لاستقراء الوقائع وشهادات الضحايا والعاملين في المجال الحقوقي، فإنّ تلك المتوالية، التي يدخلها إجباريًّا كل رافض للواقع السياسي الذي نشأ خلال عامَي 2013 و2014، تبدأ بـ”المطارَدة”، حيث تتحول العلاقة بين أجهزة الأمن التابعة للسلطة والمعارضين، إلى ما يشبه في المخيال الشعبي لعبة “القط والفأر”.
حينئذ تكون المسلَّمة التي تحرك هذا الصراع هي أنّ السلطة إذا لم تتمكن من الإمساك بخصمها مباشرة عبر الملاحقة، فإنه سيأتي إليها، بنفسه، عاجلًا أو آجلًا، لإتمام أيّ معاملة “رسمية”، وعليه، لا تكون المطاردة بالمعنى الحرفي وحسب، وإنما تكون أيضًا في خيال المطارَد الذي يشعر بالتهديد، في تلك الحالة، حتى من ظله، خوفًا من الوشاية، أو من الاقتراب من أي موقع ذي رمزية رسمية.
يحرَم المواطنُ عادةً من حقوقه الأساسية في التواصل مع محامٍ منتدَب بواسطته للدفاع عنه.
بعد القبض على المطلوب، وهي عملية تنجح عادةً طال الوقت أو قصر، يكون المقبوض عليه أمام خيارَين، بالمعنى المجازي طبعًا، لأنه مسلوب الإرادة كليًّا ولا خيارات حقيقية أمامه، إما الاختفاء القسري، إذ يصبح بلا أثر في السجلّات الرسمية رغم وجوده لديها، وإما الاعتقال التعسفي.
وفي الحالتَين، يحرَم المواطنُ عادةً من حقوقه الأساسية في التواصل مع محامٍ منتدَب بواسطته للدفاع عنه، ومقابلة ذويه، مرورًا بالحبس الاحتياطي المفتوح، والتعذيب بواسطة الأمن ومعاونيه، وصولًا إلى نهاية المتوالية، والتي تكون عادة إما بالقتل بواسطة حكم قضائي شكلي، وإما خارج القانون كليًّا، وفي أحسن الأحوال بالسجن بالأحكام النهائية المشددة التي يصدرها قضاة مختارون في دوائر استثنائية مستحدثة، عُرفت باسم “دوائر الإرهاب”.
الاختفاء القسري
هكذا، يتوسّط “الاختفاء القسري” متوالية القهر، حتى أن حقوقيين بارزين في العناية بهذا الملف، مثل مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ذهبوا إلى أنّ 90% من المعتقلين تعسفيًّا في الأقسام والسجون المصرية، لا بدَّ أنهم مرّوا، لساعات أو لأيام أو أكثر، على مرحلة التغييب، أو الاختطاف، أو الإخفاء القسري، أيًّا كان المصطلح التقني المستخدَم لوصف تلك الحالة.
رغم مرارة مراحل تلك المتوالية كلها، من المطاردة إلى تقرير المصير، إفناءً أو سجنًا، إلا أنه تظل مرحلة الاختفاء القسري، كما شرح عزب لـ”نون بوست”، هي الأصعب والأخطر على طرف المعادلة الأضعف، المواطن وأسرته، فبينما تكون الأسرة على اتصال بالشخص المنتمي إليها، في كل المراحل السابقة، إلا أنّ ذلك الاتصال ينقطع تمامًا في حالة الاختفاء القسري.
يعني ذلك عمليًّا، كما يقول عزب، أن “هذا المواطن مجرَّد من حماية القانون تمامًا، لأن السلطة لا تعترف بوجوده لديها أصلًا، وهو ما دفع كل المنظمات والمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي، مثل قانون روما والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تجريم تلك الممارسة أيما تجريم، وهو ما بتنا نفهم وجاهته عند معاينة سلوك أجهزة الأمن المصرية مع المختفين قسريًّا، والذي انتهى في كثير من الأوقات إلى التصفية خارج نطاق القانون”.
ومن الجهة الأخرى من العلاقة، فإنّ ذوي المختطف قسريًّا، يدخلون، طوال مرحلة اختفائه، في “مسار استنزاف نفسي”، بنصّ كلام عزب، نتيجة حالة عدم اليقين التي تعتريهم إزاء مصير هذا المواطن، يا ترى سيظهر مجددًا؟ أم سيظلّ مصيره معلقًا، بلا حماية، إلى الأبد، وتظل معاناتهم معه مفتوحة؟
الأسرة هي كل شيء
من واقع تعامله مع عدد كبير جدًّا من حالات الاختفاء القسري خلال العقد الأخير، يلخّص عزب دورَ الأسرة التي تعرّض أحد أفرادها إلى التغييب القسري، قائلًا في حديثه معنا إن “الأسرة، سواء كانت الأبوَين، أو الزوجة والأبناء، تتجرّع ويلات العذاب كل يوم يظل نجلها خلاله مخفيًّا بشكل قسري، وفي الوقت نفسه تُلقى على كاهل نفس الأسرة المستنزَفة مسؤولية توفير الحماية لابنها”، فكيف ذلك؟
فمن ناحيةٍ، “تستنزَف تلك الأسرة في زيارات المشارح وأقسام الشرطة دوريًّا مع كل إعلان عن واقعة تصفية جسدية لمعارضين، وبعض الأسر تغامر بالذهاب إلى أقبية لا يجرؤ أعتى محامٍ على التفكير فيها، مثل سجنَي العزولي والسويس، أملًا في العثور على أي خيط قد يوصلهم إلى نجلهم”.
“كما أنّ هذه الأسرة، من كثرة طرقها أبواب المقارّ الأمنية، تكون عرضة لشتى أنواع الخداع والنصب والابتزاز من أمناء الشرطة والمخبرين المتعاونين مع الأجهزة الأمنية، الذين يستغلون أمل تلك الأسر في الوصول إلى الحقيقة، حتى لو كانت تلك الحقيقة هي تصفية نجلهم والعثور على جثته، في طلب أموال، مقابل معلومات يظهر لاحقًا معظم الوقت أنها غير حقيقية”، يقول عزب.
وفي ظل تلك الظروف المأساوية، فإنه يكون لزامًا على تلك الأسرة وفقًا لعزب، “أن تملأ الدنيا ضجيجًا في وسائل الإعلام والجهات الرسمية، وتوثيق ملابسات الاختفاء، لأن هذا الأسلوب يساعد في لجم وغلِّ يد أجهزة الأمن نسبيًّا عن المواطن المنتمي إلى تلك الأسرة خلال اختفائه قسريًّا”.
تثير تلك الحالات المطّردة تساؤلًا ملحًّا عن “الوظيفة” الإجرائية التي يؤدّيها أسلوب الإخفاء القسري للخصوم والمعارضين.
وبينما تشير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، إلى أنّ ذلك النشاط المتعلق بإثارة الرأي العام المحلي والعالمي من جانب الأسرة لإجبار السلطات على إظهار المختفي قد يكون محفوفًا بالمخاطر عليها، فإنّ أحد ذوي أحد المختفين قسريًا قد اعتذر منّا عن مشاركة مستجدات قضية أخيه، الشاب العشريني الجامعي الذي ينتمي إلى إحدى محافظات القاهرة الكبرى، نظرًا إلى ما أسماه “أسبابًا أمنية”.
“أخي مختفٍ قسريًّا منذ مدة طويلة بسبب نشاطه في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، ومن الجيد أن أتحدث عنه، ولكن المشكلة أني أيضًا، وأنا عائل الأسرة، مهدَّد، ولدي مشكلة كبيرة مع جهاز الأمن السياسي في القاهرة، الذي احتجزني أكثر من مرة، ويطلب مني الذهاب إلى المقر دوريًّا كل أسبوع، ولا تنقطع اتصالاتهم معي ليلًا نهارًا، حتى أنهم وضعوا لي خط سير محدد من العمل إلى البيت، فالوضع حاليًّا أني سأحاسب على أي همسة”، قال شقيق الشاب المختفي لـ”نون بوست”.
قصص مروعة.. لا حماية لأحد
في أبريل/ نيسان الماضي، تفجّرت أمام الرأي العام المحلي والعالمي، قضيةٌ عن النهاية المأساوية التي لاقاها أحد المختفين قسريًّا في مصر، إلى درجة أن “نيويورك تايمز” الأمريكية سلّطت الضوء على تلك الواقعة، التي راح ضحيتها مواطن مصري يُدعى أيمن هدهود.
يقول عبد الرحمن يوسف، وهو صحفي مصري متخصص في الشؤون الأمريكية، إن أسبابًا كثيرة دفعت الإعلام الأمريكي لتسليط الضوء على تلك الحالة تحديدًا، منها أن هدهود كان باحثًا أكاديميًّا في مجال الاقتصاد، وأنه كان عضوًا في حزب مقرَّب من السلطة، هو حزب الإصلاح والتنمية، الذي يرأسه النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات، الذي ينحدر من عائلة السادات، الرئيس الأسبق لمصر.
وقد اتّهمت السلطات المصرية هدهود، الذي كان قد بدأ لتوّه العمل على موضوع يخصّ اقتصاد الجيش، بالجنون ومحاولة السطو على شقة في منطقة الزمالك بالقاهرة، ما اضطرها إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية، حيث جرت تصفيته بطريقة بشعة، وانفردت “نيويورك تايمز” حينها ببثّ صور تظهر طريقة تعذيبه من قلب المشرحة.. فكانت كلها ملابسات دفعت الصحيفة الأمريكية البارزة إلى تناول القصة.
وقبل أسبوعَين، كتبت إيمان النجار، شقيقة البرلماني المصري وطبيب الأسنان والناشط البارز في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، مصطفى النجار، في تدوينة على فيسبوك، أن كل الأخبار التي وصلتهم عنه تؤكد أنه ما زال حيًّا يرزق، رغم اختفائه قسريًّا قبل 4 أعوام، لأسباب تتعلق بانتقاده مؤسسة القضاء خلال كلمة أمام البرلمان.
وبحسب ما وثّقه لنا مصطفى عزب، فإن السلطات المصرية أعدمت 6 من الشباب، عام 2015، بناءً على حكم صادر عن القضاء العسكري، الذي اتّهمهم بالضلوع في اشتباكات واقعة “عرب شركس” عام 2014، رغم أن ذوي الشباب كانوا قد قدّموا بلاغات رسمية نهاية عام 2013 تفيد بأنهم مختفون قسريًّا، “وهو ما يثبت أننا أمام مأساة عميقة ومتجذّرة تنتهَج بشكل مكثَّف من جانب النظام المصري”.
أسلوب مافياوي
تثير تلك الحالات المطردة تساؤلًا ملحًّا عن “الوظيفة” الإجرائية التي يؤدّيها أسلوب الإخفاء القسري للخصوم والمعارضين، والتي تدفع أجهزة الأمن إلى الاعتماد عليه معظم الوقت، بدلًا من الأسلوب التقليدي في القبض والاعتقال الرسمي.
ضرورة دعم أسر المختفين قسريًّا بكل السبل الممكنة بلا كلل أو ملل، لأنهم حائط الصدّ الحقيقي أمام تفشّي تلك الممارسة على نحو أكثر من ذلك.
وردًّا على ذلك التساؤل، أوضح الباحث الأمني أحمد مولانا أن “الإخفاء القسري، دونًا عن الأساليب التقليدية، يمنح أجهزة الأمن عدة امتيازات، على رأسها إمكان إنهاء حياة المعارض سريعًا وفي هدوء شديد، بالمقارنة بالإجراءات البيروقراطية التي قد تحتاج سنوات طويلة، وصلت أحيانًا إلى 7 سنوات أمام المحاكم العادية، وبمعزل عن الإعدامات النظامية التي تثير الرأي العام العالمي كل مرة”.
وفي حديث صاحب كتاب “العقلية الأمنية“، الذي يتناول تشريح أساليب جهاز الأمن الوطني في إخضاع المعارضين، لـ”نون بوست”، أضاف مولانا أيضًا أن الإخفاء القسري يؤدّي وظيفة غاية في الأهمية لرجال الأمن، وهي “الاسئئثار بالمعارض، بعيدًا عن أسرته ومحاميه وقاضيه الطبيعي ورفاقه، ما يؤدي إلى تحطيمه معنويًّا، ويسهّل انتزاع أي اعترافات مطلوبة منه، دون تسريب للمعلومات”.
ويتّفق عزب مع مولانا في تلك النتيجة، التي يمكن رصدها في ملابسات اعتراف المختفين قسريًّا في بعض الوقائع بتُهم، أمام شاشات التلفزيون، تؤدّي إلى حبل المشنقة، وهو ما يصعّب تصور إمكان حدوثه في حال خضوع الأشخاص أنفسهم إلى إجراءات القبض والتحقيق العادية.
ويحتّم هذا، وفقًا لعزب، ضرورة دعم أسر المختفين قسريًّا بكل السبل الممكنة بلا كلل أو ملل، لأنهم حائط الصدّ الحقيقي أمام تفشّي تلك الممارسة على نحو أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أنه “واجب أخلاقي على كل العاملين في مجال حقوق الإنسان، في ظل وصول بعض الحالات إلى مرحلة “الفقد”، وهو مصطلح تقني يفيد أن المختفي تجاوز 4 سنوات، بلا أي أثر”.