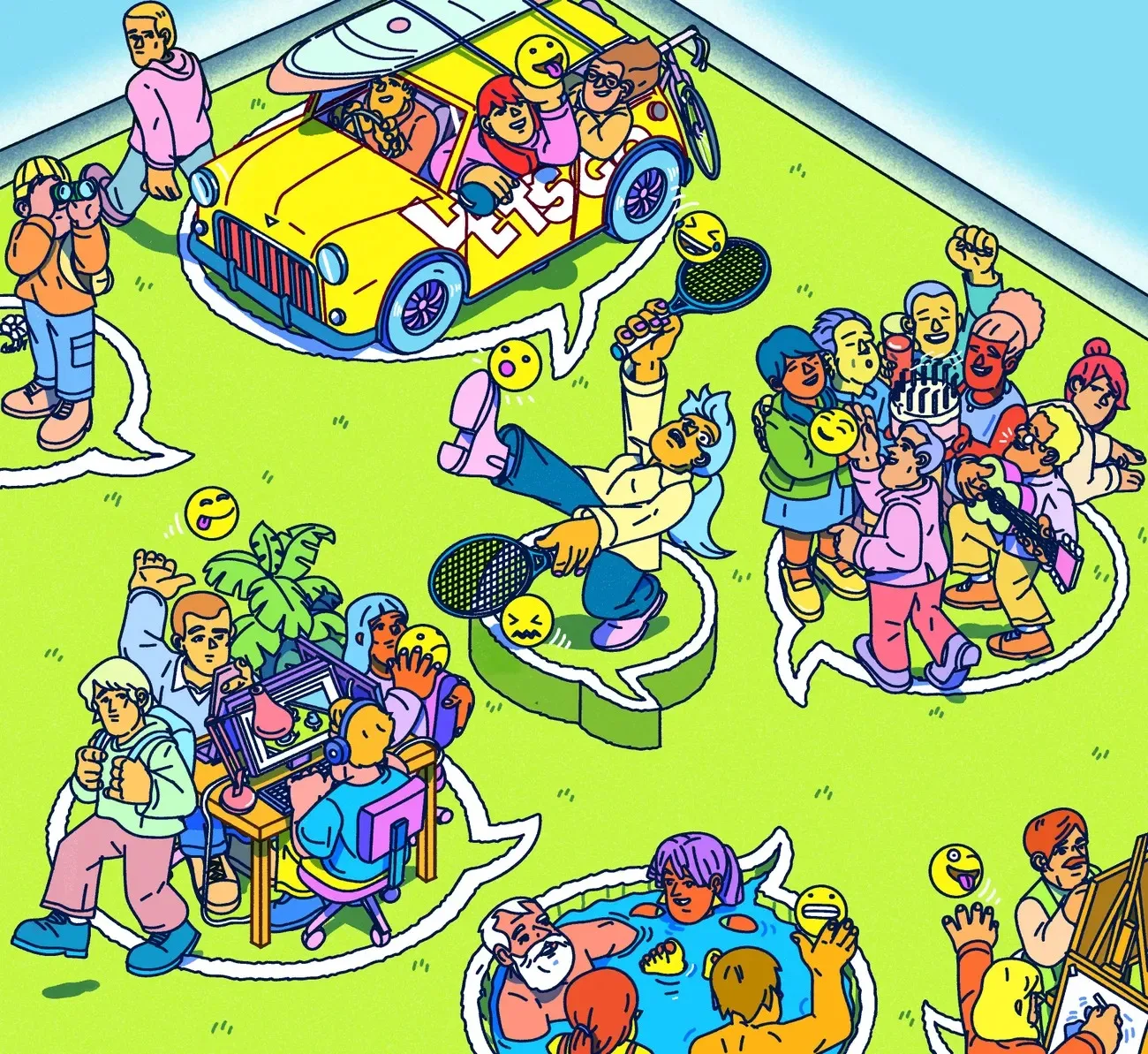ترجمة وتحرير نون بوست
قبل بضعة أشهر، أصبتُ بفيروس كورونا وكانت الأعراض الأولى جسدية، ولكن مع انحسار التهاب الحلق والسعال، بقيت أشعر بالكآبة والخمول وضبابية الوعي لمدة أسبوع تقريبًا، وتحولت عدوى جسدي إلى تجربة قصيرة الأجل من أعراض الاكتئاب والإدراك؛ ولم يكن هناك تمييز واضح بين صحتي الجسدية والعقلية.
لن تكون قصتي خبرًا لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين عانوا من نتائج صحية عقلية أكثر خطورة أو مطولة جراء عدوى فيروس كورونا؛ حيث إنه لا يضيف شيئًا إلى الأدلة القوية على زيادة معدلات الاكتئاب أو القلق أو الضعف الإدراكي بعد كوفيد. وليس من المستغرب من الناحية النظرية؛ في ضوء المعرفة المتزايدة بأن التهاب الجسم، الناجم عن أمراض المناعة الذاتية أو الأمراض المعدية، يمكن أن يكون له تأثيرات على الدماغ تبدو وكأنها أعراض مرض عقلي.
ومع ذلك؛ فإن هذا الالتقاء السلس للصحة الجسدية والعقلية يكاد يكون غير متوافق تمامًا مع الطريقة السائدة للتعامل مع المرض في الجسم والعقل كما لو كانا مستقلين تمامًا عن بعضهما البعض.
عالم منقسم بشكل خادع
في الممارسة العملية؛ يتم علاج الأمراض الجسدية من قبل الأطباء العاملين في الخدمات الطبية، ويتم علاج الأمراض العقلية من قبل الأطباء النفسيين أو الأخصائيين النفسيين الذين يعملون في خدمات الصحة العقلية المنظمة بشكل منفصل، وتتبع هذه التخصصات المهنية تدريبات ومسارات وظيفية متباينة: غالبًا ما يتخصص الأطباء للتركيز حصريًّا على جزء واحد من الجسم، بينما يعالج النفسيون الأمراض العقلية دون الكثير من الاهتمام بالدماغ المتجسد الذي يعتمد عليه العقل.
نحن نعيش في عالم منقسم بشكل خادع، والذي يرسم خطًّا فاصلًا – أو يميز بشكل خاطئ – بين الصحة الجسدية والعقلية، فلم يتم إضفاء الطابع المؤسسي على الخط بشكل صارم كما هو الحال عندما تم نفي “المجانين” إلى المصحات البعيدة، لكن التمييز لا يزال راسخًا بعمق على الرغم من كونه غير مواتٍ للمرضى على جانبي الانقسام.
تشترك امرأة تبلغ من العمر 55 سنة مصابة بالتهاب المفاصل والاكتئاب والتعب، ورجل يبلغ من العمر 25 سنة مصابٌ بالفصام والسمنة ومرض السكري، في هذا على الأقل من القواسم المشتركة: من المحتمل أن كلاهما سيكافح للوصول إلى الرعاية الصحية المشتركة للجسم والعقل، ومن المحتمل أن تكون الأعراض النفسية لدى المرضى المصابين بأمراض جسدية تؤدي إلى إعاقة ولكنها لا تُعالج بشكل روتيني، وتساهم مشاكل الصحة الجسدية لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية كبيرة في انخفاض متوسط العمر المتوقع لديهم بشكل صادم، وهو أقصر بحوالي 15 سنة من الأشخاص الذين لا يعانون منها.
لماذا نتمسك بمثل هذا النظام المتصدع وغير الفعال؟ سوف أركز على حجتين للوضع الراهن: واحدة من كل جانب، من مجموعة الأطباء والمعالجين النفسيين.
بالنسبة للمسعفين؛ المشكلة هي أننا لا نعرف ما يكفي عن الأسباب البيولوجية للأمراض العقلية حتى يكون هناك تكامل عميق وهادف مع بقية العلوم الطبية، ويتخلف الطب النفسي عن التخصصات الأكثر تقدمًا علميًا، مثل علم الأورام أو علم المناعة، ولا يمكن ضمه في الممارسة العملية حتى يلتحق بها من الناحية النظرية. الذي أود أن أقول نعم ولكن لا: نعم، هناك المزيد من التفاصيل حول الآليات البيولوجية للأعراض العقلية ستكون أساسية لدمج العقل مع طب الجسم في المستقبل ؛ لكن لا، هذا ليس دفاعًا كافيًا عن الوضع الراهن، لأسباب ليس أبسطها أنه يقلل من مدى التقدم الذي تم إحرازه بالفعل في فهم الطب الحيوي لأمراض مثل الفصام.
عندما بدأت كطبيب نفسي، منذ حوالي 30 سنة، علمنا أن الفصام يميل إلى الانتشار في العائلات، ولكن لم يتم تحديد الجينات الفردية التي تمنح المخاطر الوراثية إلا في السنوات الخمس إلى العشر الماضية، ولم نكن متأكدين مما إذا كان الفصام مرتبطًا بالتغيرات الهيكلية في الدماغ، لكن دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أنها كذلك. لقد شعرنا بالحيرة من أن خطر التشخيص زاد بين الشباب الذين ولدوا في أشهر الشتاء؛ حيث تكون العدوى الفيروسية أكثر شيوعًا؛ ولكن الآن يمكننا أن نبدأ في رؤية كيف يمكن للاستجابة المناعية للأم والطفل بالعدوى في الفترة المحيطة بالولادة أن تعطل عملية التقليم المشبكي التي تعد ضرورية لتنمية شبكات الدماغ خلال الطفولة والمراهقة.
بالنسبة إلى النفسيين؛ تكمن المشكلة في الخوف من الاختزالية المفرطة: حيث سيتم إهمال السياق الشخصي والاجتماعي للمرض العقلي في السعي وراء جزيء كلي القدرة أو آلية بيولوجية أخرى في جذورها كلها، وسيكون هذا بالفعل طريقًا مسدودًا، لكنه ليس غاية محتملة.
لقد عرفنا منذ فرويد أن تجربة الطفولة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على الصحة العقلية للبالغين، فهناك الآن أدلة وبائية ضخمة على أن الضغط الاجتماعي بشكل عام، والتعرض للشدائد في أول الحياة على وجه الخصوص، هي مؤشرات قوية للتنبؤ بكل من الأمراض العقلية والجسدية، والتي لا يُغفلها إلّا المتعصب للطب الحيوي الذي يعيش في حالة إنكار. ولكن يبقى السؤال: كيف يكون للفقر أو الإهمال أو سوء المعاملة أو الصدمة في السنوات الأولى من الحياة آثار دائمة على الصحة بعد عدة عقود؟
كانت إجابة فرويد هي أن الذكريات المؤلمة مدفونة في أعماق العقل اللاواعي، لكن هناك إجابة أكثر حداثة وهي أن الضغط الاجتماعي يمكنه حرفيًّا “التسلل إلى داخل الإنسان” عن طريق “إعادة تكوين المخطط الجيني”؛ حيث تسبب التعديلات الجزيئية التي تسمى العلامات اللاجينية تغيرات طويلة المدى في دماغ وسلوك الفئران الصغيرة المحرومة من عاطفة الأم أو المعرضة للعدوان. وبالتالي يمكن لآليات مماثلة أن تدمج بيولوجيًّا الآثار السلبية للشدائد المبكرة في الحياة على البشر، مما يؤدي إلى تفاقم الالتهاب وتوجيه نمو الدماغ إلى المسارات التي تؤدي إلى مشاكل الصحة العقلية في المستقبل.
تُعد هذه نظريات التي تستند إلى التجارب على الحيوانات بدلًا من الحقائق الثابتة في المرضى معقولة في الوضع الحالي، لكنهم بالفعل يخبروننا أن هذه ليست لعبة ذات محصلة صفرية. فالتنقيب عن الآليات البيولوجية لا يعني أنه يجب علينا التخلي عن ما نعرفه عن العوامل الاجتماعية التي تسبب المرض العقلي أو أن نقلل من شأنها؛ حيث إن الترقب القلق لمثل هذا الخيار المزدوج هو في حد ذاته أحد أعراض طريقة التفكير المنقسمة التي نحتاج إلى الهروب منها.
تغييرات
لذلك إذا استطعنا تحرير أنفسنا تمامًا من هذه التفرقة الطبقية غير المبررة بين الصحة العقلية والبدنية، فما هي التغييرات التي قد نأمل في رؤيتها في المستقبل؟
بالنسبة للأطباء والمعالجين النفسيين؛ سيكون هناك المزيد من المسارات التعليمية والوظيفية التي تتقاطع فيها التخصصات بدلًا من تلك التي تفصل بينها؛ حيث ستتم إعادة صياغة المسميات التشخيصية المحددة بشكل قاطع من قبل الكتاب المقدس للتشخيص النفسي؛ الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، وذلك من حيث التفاعلات بين العوامل الطبية الحيوية والاجتماعية التي تسبب الأعراض العقلية.
وسيكون هناك علاجات جديدة لمعالجة الأسباب الجسدية للأمراض العقلية – والتي من المتوقع أن تكون كثيرة ومتغيرة على حسب المرضى – بدلًا من محاولة خنق الأعراض بعلاج واحد يناسب الجميع بغض النظر عن السبب. وبمعرفة المزيد عن الجذور الجسدية للأعراض، يمكن أن نكون أكثر نجاحًا في التنبؤ باضطرابات الصحة العقلية والوقاية منها.
أما بالنسبة للمرضى، فإن النتيجة ستكون مخرجات أفضل للصحة البدنية والعقلية؛ حيث سيكون هناك المزيد من خدمات المتكاملة والمتخصصة في الصحة البدنية والعقلية، مثل المستشفى الجديد الذي نخطط لإقامته في كامبريدج للأطفال والشباب، بحيث يمكن معالجة الجسد والعقل تحت سقف واحد طوال العقدين الأولين من الحياة. وسيكون هناك المزيد من الفرص للأشخاص ذوي الخبرة المعيشية ذات الصلة للمشاركة في إنتاج البحوث التي تبحث في الروابط بين الصحة البدنية والعقلية. لكن التأثير الأكبر بالنسبة للجميع يمكن أن يكون على وصمة العار، ذلك الشعور بالخزي أو الذنب الذي يشعر به الناس حيال مرضهم العقلي، والذي يشكل عبئًا إضافيًا وعرَضًا فوقيًّا، يفرضه ثقافيًّا الانقسام الزائف بين الصحة البدنية والعقلية، والذي بتلاشيه يجب أن تتلاشى وصمة المرض العقلي، تمامًا كما تضاءلت وصمة العار المرتبطة بالصرع والسل وغيره من الاضطرابات الغامضة تاريخياً بفعل فهم أسبابها الجسدية.
في نهاية المطاف، من الأسهل تخيل مستقبل أفضل للصحة العقلية والبدنية معًا أكثر من تخيله لكل لأحدهما بمفردهم.
المصدر: صحيفة الغارديان