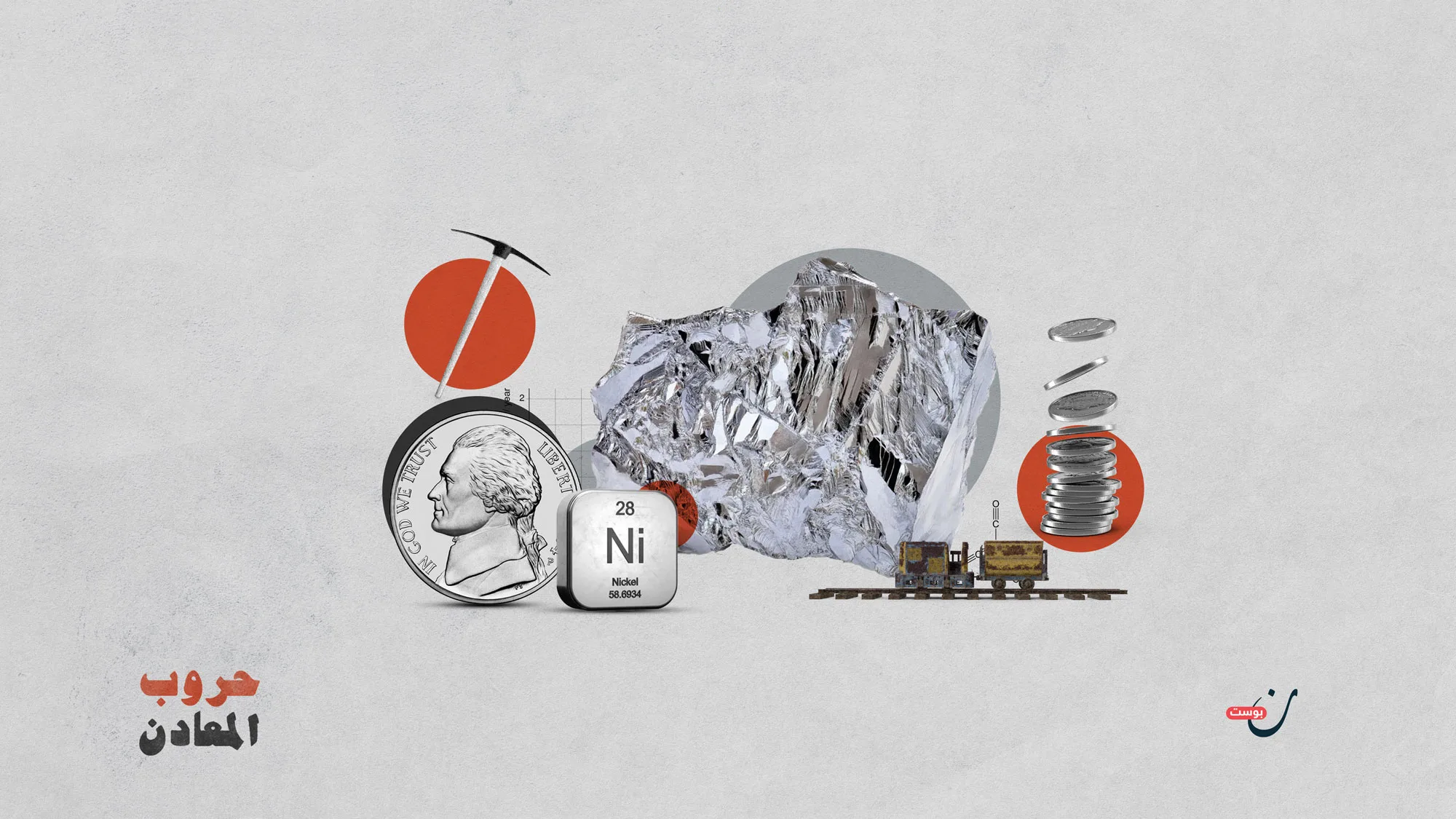عندما وصل الرحالة العسكري بيير لوتي إلى فاس بصحبة سفارة فرنسية عام 1889، اعترف أن المدينة ليست فقط العاصمة الدينية للغرب الإسلامي وأقدس مدن الإسلام بعد مكّة، حيث يأتي طلاب العلم لدراسة الفقه من جميع أقطار أفريقيا، بل هي أيضًا مركزه التجاري، حيث تتصل موانئ الشمال مع أوروبا، فيما ترتبط تافيلالت والصحراء مع السودان وتمبوكتو وسينيغامبيا.
فاس الإدريسية
لعلّ أكثر ما أدهش الرحالة الشرقيين والغربيين خلال بعثاتهم إلى فاس قبل قرون مضت، هو امتزاج المعمار بالمقدّس، على اعتبار أن الهندسة، في جانب منها، طريقة للتعبير عن الثقافات والمعتقدات والأديان، بالتالي تنفرد فاس بصفتها العتيقة التي ما زالت تنبض بالحياة الاجتماعية، بخلاف جُلّ الفضاءات التاريخية المشابهة التي تحولت إلى شواهد معزولة عن الحركة السكانية في مختلف أنحاء العالم.
كتب بيير لوتي كتابًا رائعًا عنوانه “في المغرب”، ألهمَ من خلاله الرحّالة والمصور الأمريكي بورتون هولمز، الذي قرر تقفّي أثره عام 1894 ليدخل “فاس الغامضة”، كما وصفها، في صباح اليوم الحادي عشر من رحلته التي بدأت في طنجة، إذ كتب هولمز قائلًا: “كانت فاس في عهدها واحدة من أفخر وأروع مدن العالم الإسلامي، بيد أن سقوطها كان تدريجيًّا، لدرجة أنه لم يُحدث أي تغيير، ولم يخلف ندوبًا على المدينة القديمة”.
ثم يستدرك هولمز: “لكن جمالها، أي فاس، مثل البندقية، فهي لا تتطلب سوى لمسة من الخيال، مدعومة بظلال الصباح الباكر الطويلة، أو متاهة الشفق، أو سحر ضوء القمر الفضي، من أجل استعادة فاس كما كانت منذ 800 عام مضت، استعادة جمالها الحزين حاليًّا”، كما جاء في كتاب “نحو المغرب. فاس. الإمبراطورية المغربية”.
لعلّ هولمز كان يقصد تحديدًا فاس الإدريسية، رغم أن عهد الأدارسة، خلال 8 قرون التي تحدّث عنها، كان قد ولّى، لكنهم بالفعل تركوا وراءهم حضارة مجيدة، ولا تزال مآثر عاصمتهم الأولى شاهدة على قدسية المدينة التي شيّد المولى إدريس الأول نواتها عام 789، على الضفة اليمنى لنهر فاس في حي الأندلسيين، فصارت عدوة الأندلس.
وفي عام 808 شيّد ابنه إدريس الثاني مدينة جديدة على الضفة اليسرى لوادي فاس بحي القيروانيين، نسبة إلى أصل ساكنته المنحدرة من القيروان بأفريقيا، ولهذا سُمّي القسم الغربي من فاس بعدوة القيروان، كما كان هناك حي خاص باليهود يسمّى بالملاح، ما زال قائمًا إلى الآن.
إنها واحدة من أكثر المدن أصالة في المغرب، وقد خدمت فاس كعاصمة للبلاد ما لا يقلّ عن 3 مرات طوال تاريخها، بدءًا من الدولة الإدريسية (788-974)، مرورًا بالمرينيين (1244-1465) حيث شهدت هذه الفترة أزهى مراحل تطور المدينة، إذ قاموا بتحصين المدينة بسور وتخصيصها بمسجد كبير وأحياء سكنية، وقصور ومدارس ومارستانات وحدائق.
خلال فترة الحماية الفرنسية (1912-1956) لعب المقيم العام الجنرال ليوطي دورًا فعّالًا في نقل العاصمة من فاس إلى الرباط، التي كانت في ذلك الوقت مدينة مهجورة ومنسية، فقد أراد ليوطي من وراء ذلك تهميش مدينة فاس التي تحمل رصيدًا تاريخيًّا وشرعية رمزية، وهي المدينة التي كانت تشهد احتجاجات تتخذ في عدة أحايين طابعًا عنيفًا ضد المستعمر الفرنسي.
في هذا التقرير ضمن ملف “مدن مستترة”، نكتشف ما بقيَ من فاس الإدريسية، أي المعالم الأولى للحضارة الإسلامية في المغرب الأقصى، التي أضحت الآن تقاوم النسيان وتدهور العمارة وضغوط التنمية الحضرية غير المتجانسة.
جامع الأشياخ.. أول بقعة مقدسة

إذا سألت أهل فاس عن مآثرها، سيعددون لك المعالم الدينية، بدءًا من جامع القرويين وجامع الأندلس وليس انتهاء بضريح المولى ادريس والمدرسة البوعنانية وغير ذلك، لكنهم حتمًا لن يأتوا على ذكر جامع الأشياخ، الذي يُعتبَر أقدم بقعة مقدّسة، شيّدها المولى ادريس الأول (743-793) برحبة البئر الذي تمّت البيعة بمحاذاته.
ورد عن وزارة الأوقاف المغربية أن إقامة ادريس الأول كانت بعدوة الأندلس، “حيث أدار عليها أسوارًا وبنى بها الجامع المعروف بجامع الأشياخ، وبعد ذلك اختط عدوة القرويين، حيث بنى داره المعروفة الآن بدار القيطون”.
وذكرت كذلك أن المولى إدريس بنى القيسارية إلى جانب الجامع، وأدار الأسوار حوله، ثم أمر الناس بالبناء، وحتى يشجّعهم على ذلك أعطاهم كل ما استطاعوا بناءه، قائلًا لهم: “من بنى موضعًا أو اغترسه قبل تمام السور فهو له”.
قيل إن المولى إدريس الأول عندما أنهى بناء المسجد خطب شكرًا لله، ودعا قائلًا: “اللهمّ إنك تعلم أني ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة، ولا مفاخرة، ولا سمعة ولا مكابرة، وإنما أردت أن تعبد بها، ويتلى بها كتابك، وتقام بها حدودك، وشرائع دينك..”.
منذ قرون لم تعد تقام الصلاة في جامع الأشياخ، وهو معروف كذلك باسم مسجد الأنوار أو أمغارت (كلمة أمازيغية تشير إلى منصب سياسي عالٍ)، ويقول المؤرخ الفرنسي روجي لوتورنو: “إن الأشياخ هم أعيان قبائل الأمازيغ الذين كانوا أول من سكن عدوة الأندلس (قبل مجيء الأندلسيين)، ونقصد هنا أصحاب إدريس من قبيلة أوربة (الذين رافقوه إلى فاس) وأفراد قبيلتَي زواغة وبني يرغش اللتين اشترى منهما المولى إدريس الأرض التي بنى عليها مدينة فاس”، وفقًا لما ورد ذكره في كتاب “فاس قبل الحماية”.
تهمل وزارة السياحة إدراج جامع الأشياخ في لائحة مزارات فاس، رغم أن عمره يتعدّى 12 قرنًا، أما الآن فهو يصارع النسيان حيث تلاشت عنه الزخارف والنقوش بسبب الإهمال، ولم يكن للجامع صومعة، كما أدّت الإصلاحات اللاحقة إلى تغيير بنائه بشكل كبير، ولم يتبقَّ من آثاره سوى هيكله الأصلي.
دار القيطون.. لبنة الضريح الادريسي
يرقد جثمان ادريس الثاني في ضريح فاس، أما والده ومؤسّس الدولة فهو دفين مدينة مولاي إدريس زرهون وهناك يوجد ضريحه، وسبق أن ذكرنا أن ادريس الأول انتقل إلى عدوة القرويين وبنى داره المعروفة بدار القيطون، وقد سكنها من بعده أحفاده الجوطيون والعمرانيون.
تُعرَف كذلك بدار الخيمة، وهي جزء من ضريح مولاي ادريس، الذي هو عبارة عن مسجد واسع وجميل تقام فيه صلاة الجمعة، بنيَ خلال تأسيس فاس، لكنه فقد جزءًا من إشعاعه في القرن التاسع ميلادي، وبعد بناء مسجد القرويين ونقل خطبة الجمعة إليه.
عرف الضريح تعديلات عديدة وترميمات وتوسيعات، فخلال عهد المرينيين قام الشرفاء الأدارسة عام 1308 بإعادة بناء الضريح بمبادرة من مفتي فاس الحاج مبارك، وبعد ذلك في القرن الخامس عشر ميلادي شرعَ الوطاسيون في أعمال ترميم المسجد، فاكتشفوا في عام 1437 تابوت إدريس الثاني، وتمَّ تعرُّف رفاته.
خلال عهد العلويين قام السلطان المولى إسماعيل (1672-1727) ببناء القبة الكبيرة الخضراء الهرمية، التي تحتضن القبر الادريسي المغطّى بقبة من الخشب المقوّس والمرصّع بالنحاس، كما زُيّن الفناء بنافورة بديعة، شُيّدت صومعة كبيرة هي الأعلى في المدينة العتيقة، وبعد الاستقلال قام الملك محمد الخامس بترميمات عديدة للضريح منحته هيئته الحالية.
القيسارية.. قلب المدينة العتيقة
يقع هذا البازار التاريخي في فاس البالي بين ضريح مولاي إدريس الثاني وجامع القرويين، وقد اُشتقّ اسم القيسارية (أو القيصرية) من القيصر في اللاتينية، بحسب ما ورد ذكره في كتاب “وصف أفريقيا” لصاحبه الحسن الوزاني الملقب بـ”ليون الأفريقي”، فاسم القيصرية يوجد في كل مدن شمال أفريقيا، أسوة بالمراكز التجارية المحاطة بأسوار موريتانيا القيصرية، حيث كان موظفو القيصر يقتطعون مستحقاتهم الجمركية.
أُنشئ البازار خلال فترة حكم الأدارسة المبكرة للمدينة، لكن معالمه الأولى اختفت، فقد أُعيد بناء شوارع القيسارية مرة واحدة على الأقل بعد الدمار المزدوج الناتج عن حريق في عام 1324، وفيضان في عام 1325.
في عشرينيات القرن الماضي سيلتهم حريق آخر البازار، بالتالي أعيد بناء العديد من هياكله بالخرسانة، كما استبدلت التجديدات الأخيرة بين عامَي 2016 و2017 أسقف الشوارع بأسقف خشبية جديدة، وتم إجراء إصلاحات مختلفة وتحسينات عملية، وإضافة زخرفة القرميد على طول الجدران السفلى.
جامع الشرفاء.. أو القرويين في مرحلته الأولى
بدأ جامع القرويين صغيرًا بسيطًا، أُطلق عليه أولًا اسم جامع الشرفاء، حيث إن من بناه هو ادريس الثاني عندما تحول من مدينة وليلي إلى فاس ليتّخذها عاصمة له ومركزًا لجماعته، وذلك عام 808، وكان موقع الجامع في عدوة القرويين، مقابل جامع الأشياخ الموجود في عدوة الأندلسيين من مدينة فاس.
استنادًا على كتاب “مساجد المغرب” الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 2011، كانت صلاة الجمعة تقام بكل من جامع الأشياخ وجامع الشرفاء، وقد كانا النواة الأصلية لكل من جامعَي الأندلس والقرويين، وإذا كان الجامعان الأولان قد اندثرا، فإن التنقيبات الأثرية كشفت ما تغطيه الأتربة من بقاياهما وقامت بدراستها.
ويضيف المصدر ذاته، بناءً على ما أورده البكري، “أن مسجد الأشراف كان يتكون من ثلاثة بلاطات عمودية، ممتدة من الشرق إلى الغرب في اتجاه القبلة، أما الجامعان الآخران (الأندلس والقرويين) فقد بقيا قائمَين، لكنهما خضعا لأعمال شملت توسعة المساحة وتنظيمها، أثّرت على شكلهما الأولي، إن لم تكن قد غيّرته بشكل كبير”.
لا توجد معلومات كثيرة عن مسجد القرويين في مرحلته الأولى، وغالبية المراجع تتحدث عن عام 859، أي أوج الدولة الإدريسية، حيث عرفت فاس استقرارًا سياسيًّا وازدهارًا اقتصاديًّا، فتوافد عليها الناس من عرب وأمازيغ، فاتّسعت رقعة المدينة، وتزاحم الناس في القرويين، فدعت الضرورة إلى توسعة الجامع ليستوعب الأعداد الوفيرة التي تأتي إليه كل جمعة وعيد ومناسبة دينية.
جامع القرويين هو أول مسجد في العالم تبنيه امرأة، فاطمة الفهرية، المولودة عام 800، وقد هاجرت من موطنها الأصلي القيروان مع العرب الذين سكنوا أحياء فاس في أول عهدها وهو عدوة القرويين، فتزوجت هناك، ولم يمضِ زمن طويل حتى توفي والدها وزوجها فورثت عن والدها ثروة طائلة تشاركتها مع أختها مريم التي كانت تكنّى بأمّ القاسم، وكانت فاطمة تكنّى بأمّ البنين.
مكّنتها هذه الثروة من تأسيس الجامع الذي تحول إلى جامعة تدرَّس فيها شتى أنواع العلوم في القرون الوسطى، وذلك بفضل عناية الدول المتعاقبة على حكم المغرب، حيث تخرّج منها ابن خلدون، وابن رشد، والشريف الإدريسي، وموسى بن ميمون، وليون الأفريقي وغيرهم كثير.
جامع الأندلس.. فخر أمّ القاسم
على الضفة اليمنى لواد فاس، أي عدوة الأندلسيين، شيّدت مريم الفهرية جامع الأندلس وقد شرعت في ذلك مع أختها أمّ البنين عام 859، ليصير هذا الشعور الديني الذي شعَّ من هاتين المرأتين مفخرة من مفاخر المرأة العربية المسلمة، وليعتبر من أقوى مظاهر الرقي الفكري عند نسائنا في الماضي.
ورد في كتاب “الأنيس المطرب بروض القرطاس” عام 1326، أن المسجدَين بقيا على ما بنتهما الأختان بقية أيام الأدارسة كلها حتى انقضت أيامهم وتملّكت زناتة البلاد، فبنوا الأسوار على رباط العدوتين، فزادوا في الجامعَين القرويين والأندلس زيادة كثيرة حدودها باقية إلى الآن.
وقيل إن من نقل الخطبة من مسجد الأشياخ إلى جامع الأندلس هو الأمير حامد بن حمدان الهمدان عامل عبد الله الشيعي على المغرب، وذلك عام 933، فصار للجامع دور سياسي خطير لأن منبره كان يوجّه الشعب حسب آراء الدولة الحاكمة، ويشرح للرعايا نظام الحكم الجديد ويحلّل لهم المبادئ والخطط التي يسير عليها الملوك الحاكمون، خصوصًا في تلك الفترة الحاسمة التي استقوى فيها الفاطميون في تونس، بينما كان الأمويون يرون أن سلطتهم على وشك الانهيار في الاندلس.