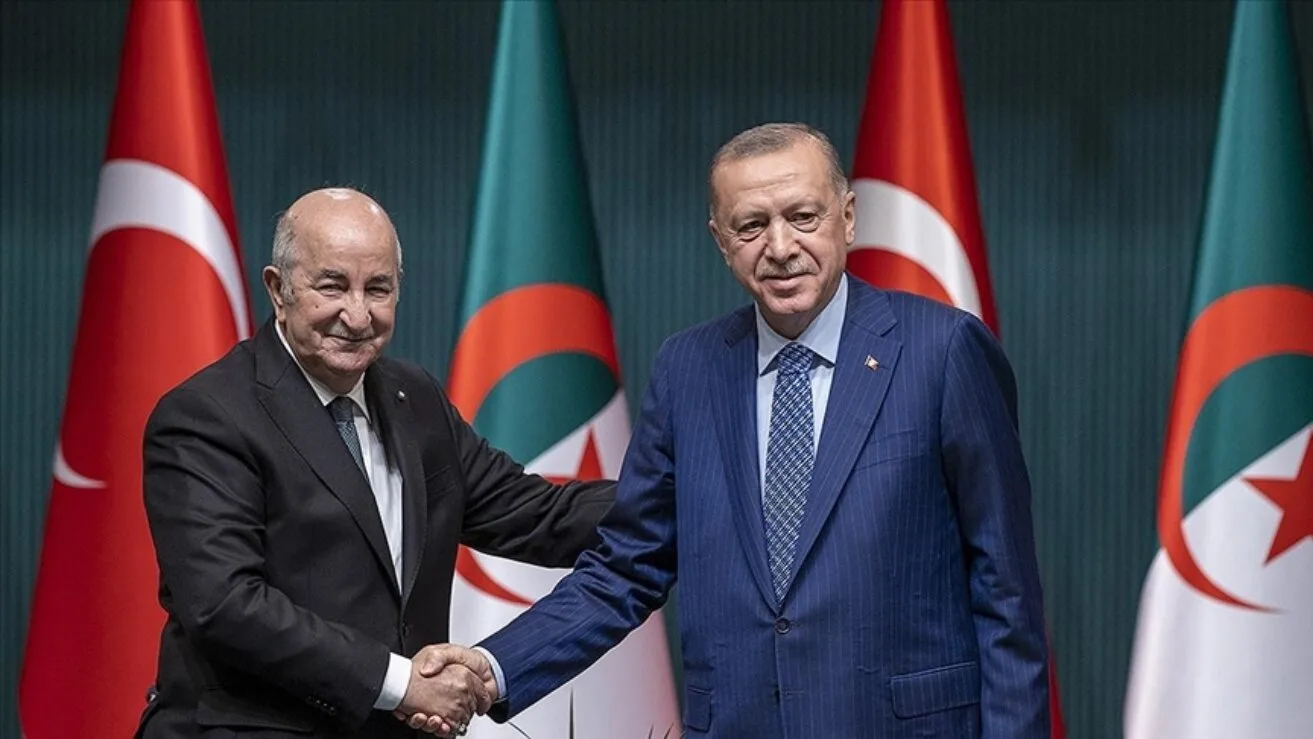كثيرًا ما نقرأ كتبًا وإنتاجات فكرية صادرة عن مؤسسات لها هُويتها وشخصيتها المستقلة عن الكُتّاب، بخصائصها وميزاتها، إلا أن الصلة تبقى بين الكاتب والقارئ حية وشخصية وحميمية. فما يقدَّمه الكاتب لقرائه إنما هو عصارة فكره ونتاج بحثه وفهمه، وذلك لمحاولة فتح حوار ثقافي غير مباشر، حيث تُلقى الأفكار للقارئ ليتأمّلها وينقدها، فيردّها أو يبني عليها.
تمثّلت غايتنا من مقالاتنا ضمن ملف “مجددون“، بقراءة قوانين الحركة الفكرية وجدليتها التي تلدُ التجديد والتطوير، عبر الاطّلاع على مفهوم التجديد ومجال نشاط بعض الشخصيات التي أثرَت عالم الأفكار في المجتمعات العربية.
لا يمكن استقصاء كل ملامح المنهج الفكري لهذه الشخصيات عبر بضع مقالات بطبيعة الحال، ولا بيان كل الانتقادات التي وُجّهت إليها، لكننا نبيّن جوانب التجديد في الرحلة الفكرية لهذه الشخصيات وأثرها العميق في حياة المسلمين المعاصرين.
الأطروحات التي تحمل بذور أفكار جديدة هي التي تبثّ الحياة في المجتمعات، وتدفع ماء الحياة في عروقها لتخرجها من حالة الركود، فكم من رسائل علمية تصدر كل يوم في مختلف البلدان، ولكنها تكرار للمكرر، لا يبرز وينتشر منها إلا القليل الذي يحدث فارقًا ملحوظًا في الحياة العلمية.
أما شخصية هذه المقالة فهي من أكثر الشخصيات التي يصعب تركيز الكتابة عنها في مقالة واحدة، وذلك لغزارة إنتاجها وتعدد مجالات تأثيرها.
الشيخ محمد الغزالي أحمد السقا، المعروف باسمه الأول المركب “محمد الغزالي”، الذي يشعر كل قارئ لكتبه أنه يقرأ لجندي من جنود الدعوة، حياته كلها للدعوة، بإصرار لا يفتر وعزيمة لا تلين وثبات لا يعرف التردد.
وقد مرَّ الحديث في مقالات سابقة عن مجددين برزوا في تقريب علوم الإسلام من قضايا العصر، أو في إعطاء نموذج للعالم القدوة بقوته وورعه وزهده وثباته، أو في الإسهام في تطوير بعض العلوم الشرعية واللغوية، ولكن الشيخ محمد الغزالي كان واسع النشاط بشكل يصعب حصره والإلمام بجوانبه، بين نشاط دعوي وفكري وسياسي وغيره.
الشيخ محمد الغزالي
تختلف رؤية كل مجدد أو مصلح عن غيره، كما تختلف مواهبه واهتماماته، وهذا الاختلاف هو الذي يجعل جهود المجددين تتكامل، فيهتمّ كل منهم بمجال علمي أو عملي يؤثر فيه ويجعل عمره وقفًا لخدمته، فيكون عميق الأثر في مجاله، ويكون أثره ممتدًا.
ويهتم آخرون بمجالات مختلفة متنوعة من مجالات التجديد والإصلاح، لا يحصرون رؤيتهم ونشاطهم ولا يركّزون جهودهم في مجال واحد، فتكون نظرتهم أكثر شمولًا وإحاطة، ويكون أثرهم متسعًا في أفق عريض.
فالصنف الذي اختار الامتداد في العمق يؤصّل في علم ما ويكون من أساطينه ويفصل في مسائله، وهذا مهم، والصنف الذي اختار الاتساع الأفقي يبثّ رؤيته الإصلاحية الشاملة في مختلف الجوانب ليعطي نظرة شاملة متكاملة، تدفع من خلال ما تقدمه مختلف شرائح المجتمع للتغيير.
من الصنف الثاني كان الشيخ الغزالي، الذي حمل على عاتقه مهمة صعبة، عندما نظر نظرةً شاملة ناقدة إلى أحوال العالم الإسلامي، وأراد أن يقدّم بذور الإصلاح في مختلف مجالات الخلل.
لقد أثنى القرآن على نموذج من رجال الدعوة “وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى”، يسعى مسرعًا، وكان الغزالي مسرعًا كذلك وكأنه يخاف انقضاء أجله قبل أداء رسالته؛ “قال يا قوم اتبعوا المرسلين” فأراد أن يبيّن منهج الصواب لهم ليتبعوه ويثبتوا عليه؛ ثم قال لقومه: “أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون”، فحذّرهم ممّا هم عليه من أخطاء؛ “قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون”، فكان حريصًا على نفع قومه في شفقة عليهم حتى آخر لحظات حياته.
وباستقراء سريع لمجالات نشاطه وتجديده، إما بنقد الأوضاع الفاسدة وإما بتقديم اجتهادات جديدة وإما بإيقاظ الشعور الديني، يتضح تنوعها، فمنها:
1- تسليط الضوء على السلوك الديني الخاطئ والمفاهيم المغلوطة التي عطّلت طاقات كبيرة كان يجب أن توظَّف لتغيير أوضاع المسلمين، وقد سمّى الإيمان الذي لا يعطي المؤمن قوة ونشاطًا وعبودية “الإيمان المزيف”، يتجلى ذلك في عدة كتب له، ككتاب “الإسلام والطاقات المعطلة”، وكتاب “ليس من الإسلام”.
2- التنبيه إلى ضرورة التوظيف الصحيح للعلوم الإسلامية حتى تثمر الغاية التي جُعلت من أجلها، ويعدّ كتابه “عقيدة المسلم” من الكتب التي تهزّ الوجدان وتوقظ الإيمان في القلب، وغيره من كتبه مثل “ركائز الإيمان” فجعل الإيمان سلوكًا عمليًّا لا جدليات نظرية.
3- تقديم نظرات تجديدية في العلوم الإسلامية كتنبيهه وجهوده في الاهتمام بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، الجانب الذي يهتم بالوحدة الموضوعية للسُّوَر، والجانب الذي يهتم بدراسة موضوع معيّن في مختلف السُّوَر.
4- تقديم دراسات نقدية لأحوال الدعوة وأحوال الدعاة في عدة كتب، منها كتاب “هموم داعية” و”الدعوة الإسلامية” و”علل وأدوية” و”مع الله”.
5- ردّه على الانحرافات الفكرية والدينية ومحاربة الإسلام داخل أرضه، مثل ردّه على كتاب خالد محمد خالد “من هنا نبدأ”، وكتابه “قذائف الحق” وغيرها من الكتب.
6- والاهتمام بالتنبيه من المكائد التي تكاد للإسلام من قوى الاستعمار في كتابات كثيرة، منها “كفاح دين” و”الاستعمار أحقاد وأطماع”.
7- وله في السيرة كتابه المشهور “فقه السيرة”، الذي لا يقف عند أحداث السيرة بل يريد من القارئ أن يعيش بشعوره مع النبي ﷺ.
8- وفي الرقائق والأخلاق “فن الذكر والدعاء” و”خلق المسلم”، وفي التوجيه للتعامل مع الضغوط النفسية والحياتية “جدد حياتك”.
9- قدّم دراسات جديدة تعدّ استجابة لأسئلة فكرية وحضارية معاصرة، كحديثه عن السياسة والاقتصاد في النظام الإسلامي.
10- الحديث عن نظام المجتمع المسلم خصوصًا فيما يتعلق بالمرأة، وعودته إلى التعاليم الصافية بعيدًا عن العادات الاجتماعية وبعيدًا عن النموذج الغربي، والتفريق بين وظيفة المرأة الأولى في المجتمع بصورة عامة، وإتاحة المجال لها للمشاركة في الحياة العامة بعد ذلك مستدلًّا بأدلة شرعية.
وغيرها من العطاءات الفكرية والدينية، كل ذلك في مجال الكتابة والتأليف، بالإضافة إلى كونه خطيبًا مفوهًا ورجل مواقف، حتى في السجن فجّر ثورة ضد سرقة طعام السجناء كما يروي الشيخ القرضاوي في كتابه “الشيخ الغزالي كما عرفته”.
إن كون الداعية المجدد مستوعبًا لكل تلك المجالات التي أشرنا إليها، يستوجب همّة عالية وتضحية كبيرة وتفرغًا تامًّا لقضايا الأمة، يتطلب ثقافة عالية واطّلاعًا واسعًا على علوم العصر وأدواته البحثية، يظهر ذلك في كثرة نقله عن فلاسفة ومفكرين غربيين معاصرين له.
كما يستوجب ارتباطًا وثيقًا بواقع أمّته ومجتمعه ومشكلات الناس فيه، فكتابه “الإسلام والاستبداد السياسي” إنما كان محاضرات أُلقيت في السجن، كما يؤكد الشيخ القرضاوي ارتباطه بمشكلات الواقع بقوله: “الواقع كتاب مفتوح لدى الشيخ (الغزالي)، يقرأ سطوره وما بين سطوره”.
منهجية متميّزة
وحتى يغطي بدراساته المجالات الكثيرة التي تحدّث عنها، وحتى يعمّ تأثيرها ونفعها، لم تكن منهجيت الشيخ محمد الغزالي في أطروحاته منهجية دراسات علمية أكاديمية، بل كتبَ بمنهجية فريدة، تسلّط الضوء على المشكلة وتبيّن آثارها وتحلّل أسبابها، ثم ترغب وترهب بأسلوب بياني رشيق، يقنع العقل ويمتع العاطفة، ويفهمه العامي ويستفيد منه المتخصص.
فلم يكن أسلوبًا وعظيًا بعيدًا عن الطرح الفكري، ولم يكن أسلوبًا أكاديميًّا بعيدًا عن العاطفة والوجدان والتأثير، وكأنه استلهم ذلك من القرآن حيث يعطي منهاج حياة عامًّا، مع الإتيان بما يدفع لتطبيقه ويُحذّر من مخالفته، كما لا ينسى الإجابة عما قد يرد من اعتراضات.
والقول إنه ليس أسلوبًا أكاديميًّا تخصصيًّا لا يُقصد الحط من منزلته، بل هو أسلوب مختلف متفرّد، غني بالأفكار الناقدة والمبدعة، التي تصلح لتكون نواة لدراسات واهتمامات الباحثين المتخصصين، ولتوجيه عموم المثقفين، والتأثير في وجدان العوام.
بالإضافة إلى سبب آخر، هو أنه لو قام بتقديم دراسة أكاديمية لكل طرح ممّا قدمه، لاحتاج زمانًا طويلًا لا يتّسع له عمره، فكان يلقي الأفكار عن علم ودراية وبصيرة، ويترك للباحثين التأسيس عليها والتفصيل فيها، وكأن عمره قد ضاق بأفكاره.
لمحات من منهجية الغزالي
من ملامح منهجيته التجديدية التي تظهر في كل الميادين التي تكلّمَ فيها:
1- إصرار الغزالي على حرية البحث العلمي، وحرية الفكر وحرية الكلمة، وهذه الحريات ضرورة لازمة من أجل إتاحة المجال للمصلحين لتقديم أطروحاتهم ومناقشتها ونقدها، لذلك رفضَ سحب شهادة خالد محمد خالد، مع أنه كان من السابقين في الردّ عليه.
2- تأكيده على ضرورة الحرية السياسية، وإقرار الخلاف في الرأي، وهذه الحرية هي الضامن لمنع الاستبداد السياسي وتضييع مصالح المجتمعات، وكان له في ذلك مواقف شجاعة في نقد الحكّام، وفي خلافه مع الإخوان عندما قام بعض الرُّعن من شبابهم بتهديده بعد خلافه مع الجماعة، حيث قال في كتابه “معالم الحق”: “وقد كنت حريصًا على الصمت الجميل يوم عرفت أني سأعمل للإسلام وحدي، بيد أن أحدًا من خلق الله اعترضني ليقول لي: إن تكلمت قُتلت! فكان ذلك هو الحافز الفذ على أن أتكلم وأطنب”.
3- تحذير الغزالي من آفة التعصب، وهي آفة كثيرًا ما استنزفت طاقات المسلمين في العصر الحاضر، في معارك جانبية حول أمور خلافية، وشغلتهم عن قضاياهم الكبرى المهمة، فرغم ميله السلفي في قضايا العقيدة إلا أنه يدافع عن الإمام الغزالي، وهو أحد كبار أئمة الأشاعرة، ويشدد نكيره على الذين يتمسّكون ببعض الأحكام الفقهية الجزئية الخلافية، ويقيمون حولها المعارك الكلامية.
4- تكرار التنبيه والتحذير من الأفهام الخاطئة لبعض الآيات والأحاديث، والتي تصيب المجتمع بالخمول، كتعليقه على الفهم السلبي لأحاديث الفتن التي تناقلها الناس في دعوة للاستسلام للوضع الراهن، فيقول في كتابه “قذائف الحق”: “ولو سرت جرثومة هذا المرض إلى صلاح الدين الأيوبي ما فكر في استنقاذ بيت المقدس من الصليبيين القدامى! ولو سرت جرثومة هذا المرض إلى سيف الدين قطز ما نهض إلى دحر التتار في عين جالوت”.
5- الاهتمام بالقضايا والأفكار (العملية) المنتجة في حياة الناس، والبُعد والتنفير من الجدليات النظرية العقيمة التي تستهلك أوقات الباحثين دون جدوى، فهو -على سبيل المثال- يؤكّد على أهمية التزكية أو التربية، ويأخذ من ذلك ما كتبه علماء التصوف غير مبالٍ بالأسماء والمصطلحات.
ويقول في مقالة من مقالاته المنشورة في مجلة “الوعي الإسلامي” بعنوان “التصوف الذي نريد”: “إن فقهاءنا الذين كتبوا المجلدات في غسل الأطراف ما كان يعيبهم أن يتناولوا هذا الجانب (يقصد التصوف) وأن يضبطوه بأدلتهم الفقهية، وإن المتكلمين الذين عقدوا الفصول الخطيرة في الشؤون الإلهية المغيبة ما كان يعيبهم أن يحببوا الناس في الله ويرفعوهم إلى حضرته بأسلوب علمي محكم، لقد كان ذلك والله أجدى على الإسلام وأهله من بحوثهم العقيمة في الذات والصفات”، إلا أن ما انتقده على الفقهاء والمتكلمين كان حاجة ملحّة في الأزمنة التي وُضعت فيها هذه العلوم.
6- الاهتمام بالجانب الروحي في معظم كتاباته، حيث يُكثر من الكلام عن أثر الإيمان الصحيح في سلوك الإنسان، ولعلّه استلهم ذلك أيضًا من القرآن الذي يربط الإيمان بالعمل والورع، فيقول في مقالة “صدق المعرفة ووحدة الوجود” في مجلة “الوعي الإسلامي”: “إن القرآن الكريم ينقل الإيمان من ميدان التصورات النظرية المعزولة، إلى ميدان الشعور الحي المأنوس الواقع”.
7- شمول الرؤية وتكاملها وعمقها في قضايا الدين والفكر وفي قضايا الواقع، فالنظرة الجزئية لأحكام الدين تقصر بالفقيه عن وضع الأحكام والتعاليم في ميزانها الصحيح، والنظرة السطحية لمشكلات الواقع لا تجدي في إيجاد حلول لها، فهو يؤكّد على أن الإسلام نموذج متكامل، وأحكام الشريعة تُفهم في سياقها الكلي، فلا يصحّ مقارنة حكم جزئي من الأحكام المتعلقة بالمرأة في الإسلام مع حكم جزئي من أحكام حياة المرأة في الحياة الغربية، بل تكون المقارنة بين نظام متكامل لحياة المجتمع والأسرة المسلمة مع نظيره في غيرها من المجتمعات.
ويوضّح شيئًا عن ذلك في مقالته “تفتيت الحقيقة بداية التحول عنها”، وفي علاجه لمشكلات المجتمعات المسلمة ينظر في عمق الأسباب من أجل علاجها، ويوضّح ذلك فيقول: “وترك الصلاة ليس معصية خاصة فقط، بل هو ذريعة إلى انهيار الأخلاق وانتشار الآثام”، ويوضّح مكائد الاستعمار في استغلال هذه الناحية وأنه لا يهاجم الإسلام جملة، بل ينتقد بعض الجزئيات التي يؤدّي تركها إلى خلخلة الحياة الإسلامية ثم زعزعة الإيمان في قلوب الناس.
لقد حمل الغزالي همَّ الدعوة والدعاة، وجعل عنوان أحد كتبه “هموم داعية” ليكون ابنًا بارًّا لهذه الأمة حتى آخر أيام حياته، ولأنه قد يكون من المحال ألا يقع المجددون في بعض الأخطاء، فهم يُقْدمون على طرح أمور لم يسبَقوا إليها، وكانت عليه بعض المآخذ، منها ما هو لخلاف في المدرسة العلمية، ومنها ما هو أخطاء انتقدها عليه حتى أبناء مدرسته.
فعندما أراد الغزلي أن ينصر السنّة ويدافع عنها ألّف كتاب “السنّة بين أهل الفقه وأهل الحديث”، ليتحدث عن رد الحديث الذي يوجد في متنه ما يستوجب رده وإن صحَّ سنده، وهذا مبدأ معروف وقاعدة معمول بها، ولكنه بالغَ في ردّ أحاديث صحيحة يمكن تأويل أو فهم متنها فهمًا سائغًا ولا حاجة لردّها، فأراد بكتابه نصر السنّة لا الهجوم عليها، فهو نصير للسنّة النبوية يكثر من مدح أئمة الحديث كالإمام البخاري، ولعلّ أخطاءه تضيع في بحر جهوده العظيمة.