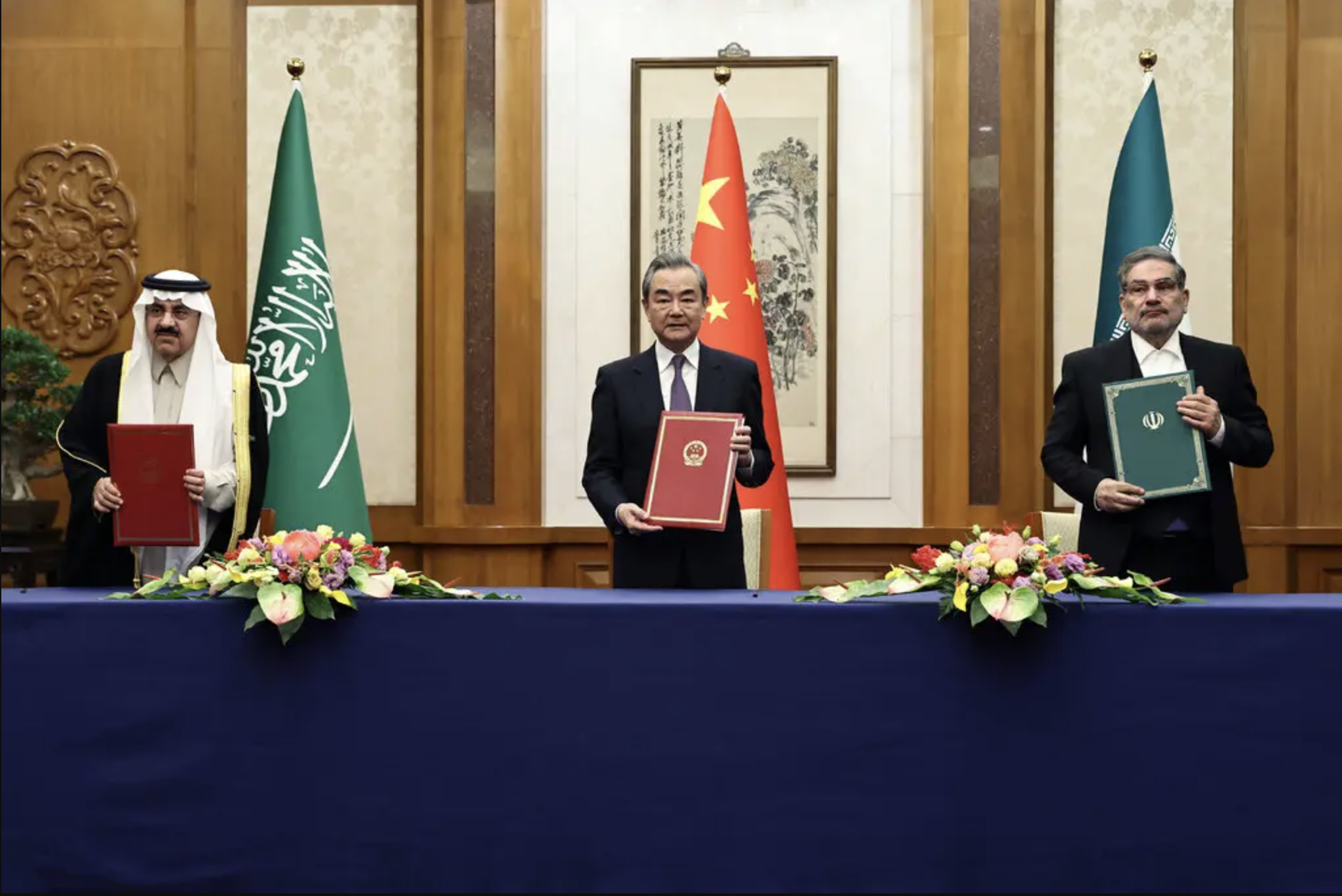الشاعر ابن زيدون
“أهم شاعر وجداني ظهر في الأندلس.. إذ كان أول من اعتصر فؤاده شعرًا عذبًا فيه جوى وحرقة وهوى ولوعة”، هكذا وصفه عالم اللغويات الدكتور شوقي ضيف، فيما عّده المؤرّخون شاعر الأندلس الأبرز ومنارتها الأدبية واللغوية الخالدة، وصاحب الجماليات والفنون الإبداعية التي لا يزال عبيرها يعطر بساتين الشعر والنثر العربي رغم مرور أكثر من 950 عامًا على رحيله.
السياسي ابن زيدون
أديب جمع بين الحسنَين، الشعر والنثر، وسياسي محنّك من الطراز الأول، لُقّب بـ”صاحب الوزارتَين”، الدبلوماسي الذي ملك بيدَيه السيف والقلم، فاستحق أن يكون رفيق الملوك وجليسهم، صديق الأمراء ومرجعهم، أستاذ الشعراء وملهمهم، رائد الغزل والرثاء والفخر، أسير الطبيعة وعاشقها الأول.
أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي، المعروف بـ”ابن زيدون” (1003-1071)، الشاعر السياسي الأديب، صاحب المكانة البارزة في تاريخ الأندلس، وأحد علاماتها المضيئة التي يستدلّ بها العاشقون شعرًا والملهمون نثرًا، وتعدّ رسائله من عيون الأدب العربي، فماذا نعرف عن حياة هذا الرجل ضحية الوشاية والحسد؟
من هو ابن زيدون ؟
وُلد ابن زيدون في منطقة الرصافة، إحدى ضواحي قرطبة، وينتمي إلى أسرة ميسورة الحال تنتهي بنسبها إلى بني مخزوم (قبيلة الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه)، فوالده كان يعمل قاضيًا ذا حيثية مجتمعية كبيرة، فكان أحد رموز العلم والأدب في قرطبة، وإليه يرجع الفضل الأول في إذكاء روح البلاغة وحب اللغة في نفس ولده أبو الوليد.
وكان شغوفًا بالعلم منذ الصغر، فتتلمذ على أيدي كبار علماء قرطبة ومشاهيرها في الأدب واللغة، منهم أبو بكر مسلم بن أحمد بن أفلح، النحوي المتوفى عام 1042، أحد أعلام المدينة في ذلك الوقت، والذي تمتع بوفرة كبيرة في العلم والعقيدة، وله باع كبير في العربية ورواية الشعر.
تعرّض ابن زيدون إلى صدمة كبيرة حين توفى والده وهو في الحادية عشر من عمره، ليتولى جده لأمّه، محمد بن محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، مسؤولية تربيته، إذ كان من العلماء البارزين في ذلك الوقت، وكان شديد العناية بالعلوم، وقد تولّى القضاء بمدينة سالم، ثم تولّى أحكام الشرطة في قرطبة.
التحق ابن زيدون بجامعة قرطبة، وكانت حينها إحدى أهم الجامعات في الأندلس لا يلتحق بها إلّا الصفوة والنخبة، حيث كانت الحاضنة الأكبر للشعراء والأدباء والعلماء
أولى الجد لحفيده عناية فائقة، حيث حرص على تنشئته تنشئة علمية رصينة، فعلّمه القرآن والشعر والأدب والنحو، ساعدته على ذلك البيئة الخصبة المناسبة التي وفّرها له الجد، مستوى اجتماعي مرموق، توفير المشايخ والعلماء لتعليمه، مع تهيئته مجتمعيًّا من خلال الصفوة التي كانت تحيط به فأثّرت في شخصيته فيما بعد.
ومن المسائل التي ساعدت في تنمية مهارات أبو الوليد اللغوية نشأته في بيئة خضراء بديعة الألوان والأزهار والأشجار، إذ كانت الرصافة، مسقط رأسه، هي الضاحية التي أنشأها الأمير عبد الرحمن الداخل بقرطبة، وجعلها مقرًّا لحكمه، ونقل إليها الأشجار النادرة والنباتات الجميلة، وشقّ فيها بعض الجداول حتى تحولت إلى لوحة فنية رائعة، يشدوها المطربون ويتغزّل الشعراء بحسنها.
وما أن كبر وصار شابًّا حتى التحق ابن زيدون بجامعة قرطبة، وكانت حينها إحدى أهم الجامعات في الأندلس لا يلتحق بها إلّا الصفوة والنخبة، حيث كانت الحاضنة الأكبر للشعراء والأدباء والعلماء، المسلمين والمسيحيين على حد سواء، ليتخرج منها وقد كان شاعرًا مفوهًا وأديبًا لا يشق له غبار، ما ساعد في انتشار صيته وتعبيد الطريق نحو الوزارة.
الوزير السياسي
لم يكن أبو الوليد كغيره من شعراء الأندلس بمنأى عن السياسة، متلحّفًا برداء الشعر والأدب دون غيره، لكنه كان سياسيًّا من الطراز الأول، منخرطًا في العمل العام منذ صغره، ساعده على ذلك اتساع أفقه وشدة وعيه ونبوغه الفطري، فلعب دورًا كبيرًا في القضاء على الخلافة الأموية بقرطبة، والتي شهدت أواخر أيامها تدهورًا وفسادًا، ما أثار حفيظة ابن زيدون الذي قرر أن يواجه ذلك بالكلمة والتوعية.
وبالفعل نجح في أداء مهمته، وشارك في ثورة أبي الحزم بن جهور على بني أمية، ومع تأسيس دولة بني جهور بقرطبة جعله الخليفة كاتبه ووزيره، وعمره حينها لم يتجاوز 30 عامًا، وكان أحد المقرّبين من السلطة التي اختارته لأن يكون سفيرًا بين ملوك الأندلس لما يتمتع به من فصاحة وبلاغة قادرة على تفتيت الأحجار الصلبة وتليين المسائل المعقّدة.
لم يقتنع ابن زيدون كثيرًا بتلك الوظيفة رغم رقيها وسموها في المجتمع الأندلسي في ذلك الوقت، رافضًا أن يكون ظلًّا للخليفة دون إرادة منه أو رأي، إذ كانت له نزعة استقلالية بعض الشيء، فسّرها خصومه من الشعراء على أنها غرور وتعالٍ على ابن جهور، فأوغروا صدره تجاه شاعر الأندلس الأول وبليغها الأشهر، فما كان منه إلا أن زجَّ به في السجن عقابًا على عدم رضوخه له.
وبينما هو في السجن كتب عدة رسائل إلى الخليفة بالعفو عنه فأبى، ثم استعان بنجل الخليفة وصديقه المقرّب، أبي الوليد بن أبي الحزم، للتشفُّع عند والده فشفعه، ليخرج من الحبس ويظل في قرطبة حتى توفى ابن جهور عام 1061، ويتولى ابنه خلفًا له على العرش، والذي عيّن ابن زيدون في الوزارة مرة أخرى، لكنه خشي أن يلقى المصير ذاته الذي لقاه إبّان والده فقرر مغادرة قرطبة متوجّهًا إلى إشبيلية عام 1067.
مع تأسيس دولة بني جهور بقرطبة جعله الخليفة كاتبه ووزيره، وعمره حينها لم يتجاوز 30 عامًا
وفي إشبيلية استقرَّ به المطاف عند بني عباد وكان يحكمها في ذلك الوقت المعتضد بن عباد، وكان شاعرًا وأديبًا، وقد سمع كثيرًا عن ابن زيدون وقيمته الأدبية، فقرر أن يجعله من المحظيين، وقرّبه منه، وقلّده الوزارة ليصبح المستشار الأول للأمير، كما عُهد إليه بالسفارة بينه وبين أمراء الطوائف في الأمور الجليلة والسفارات المهمة.
ورغم هذه الجاه والسلطان اللذين حباهما المعتضد لابن زيدون، إلا أن الأخير لم يكن راضيًا عنهما، فالأهم بالنسبة إليه هو الكتابة، وبالفعل عُهد إليه لأن يكون كاتب الدولة، ليجمع بين الوزارتَين، ويمتلك زمام السيف والقلم، مجمعًا بين يدَيه أفضل المناصب في بلاط المعتضد.
واستمرَّ الوضع على ما هو عليه بعد وفاة المعتضد، وتولى نجله المعتمد مقاليد الحكم، حيث كانت تجمعه علاقة قوية بابن زيدون الذي كان بمثابة الأستاذ والمعلم له، واستمرت تلك العلاقة لأكثر من 20 عامًا، كان أبو الوليد فيها أعلى مكانة وأرفع قدرًا وأكثر نفوذًا وقوة وجاهًا.
ثم جعله كبيرًا لوزرائه، ولكن ابن زيدون كان يتطلع إلى أن يتقلد الكتابة وهي من أهم مناصب الدولة وأخطرها، وظلَّ يسعى للفوز بهذا المنصب ولا يألو جهدًا في إزاحة كل من يعترض طريقه إليه حتى استطاع أن يظفر بهذا المنصب الجليل، وأصبح بذلك يجمع في يدَيه أهم مناصب الدولة وأخطرها وأصبحت معظم مقاليد الأمور في يده.
وبعد انتقال المعتمد إلى قرطبة حيث جعلها مقرًّا لملكه، انتقل معه ابن زيدون كذلك الذي زاد في ملكه ونفوذه، إذ أصبح ساعد الأمير الأول ومستشاره الأكثر مصداقية وثقة، لكن كما حدث مع ابن جهور ها هو يتكرر مرة أخرى وللأسباب ذاتها، إذ أوغر خصوم أبي الوليد صدر الأمير الذي رضخ في النهاية للوشاية ليدفع بشاعره ومعلمه ومستشاره إلى الهاوية، رغم الخدمات التي قدّمها له طيلة حياته، ليلقى حتفه، كما سيرد ذكره لاحقًا.
ولّادة بنت المستكفي.. الملهمة
كان ابن زيدون مرهف الحس، جياش العواطف، مال قلبه سريعًا ناحية واحدة من أكثر فتيات قرطبة جمالًا في العصر الأموي، هي ولّادة بنت المستكفي الخليفة الأموي الذي كان يعاني من ضعف الحكم وفوضوية الشخصية، إذ كان معول الهدم الأخير للخلافة الأموية في الأندلس.
جمع أبو الوليد وولّادة حبهما للشعر، إذ كانت إحدى أبرز شاعرات الأندلس، وكانت تتمتع بجمال أخّاذ، ورقّة لافتة لأنظار الجميع، قيل عنها إنها “نادرة زمانها ظرفًا وحسنًا وأدبًا”، كذلك “إنها أديبة شاعرة جزلة القول، مطبوعة الشعر، تساجل الأدباء، وتفوق البرعاء”، وكانت محط أنظار الشعراء والأدباء في ذلك الوقت ممّن وقعوا في حبها، فنظموا لها الأشعار تقرّبًا منها.
وبعد سقوط الخلافة الأموية، حوّلت ولّادة قصر أبيها إلى سوق كبير للشعر تستقبل فيه شعراء قرطبة، وكان ابن زيدون أحد رواد هذا المنتدى الذي ضمَّ فطاحل الشعر آنذاك، منهم أبو عبد الله بن القلاس وأبو عامر بن عبدوس، وكانا الخصمَين الأكبر لابن زيدون في حب ولادة.
نجح الشاعر الأندلسي في سحق منافسيه في نظم الشعر وفنونه، حتى أنه كتب رسالة هزلية إلى ابن عبدوس على أنها من ولّادة، وكانت رسالة ساخرة فأوقعت عبدوس في مأزق حرج أمام محبوبته، ما أوغر صدره تجاه ابن زيدون، ومن ثم قرر استهدافه والانتقام منه، فأحدث الوقيعة بينه وبين الأمير ابن جهور الذي انقلب عليه ووضعه في السجن بدعوى التآمر لقلب نظام الحكم.
ورغم دخوله السجن، إلا أن قلبه ما زال معلقًا بولّادة، وما إن خرج حتى تودّد إليها مرة أخرى على أمل إعادة المياه إلى ما كانت عليه قبل سجنه، لكن العلاقة قد وصلت إلى طريق مسدود خاصة بعدما فتحت الشاعرة الجميلة قلبها لآخرين ممّن تودّدوا إليها وأسروها بأشعارهم ورسائلهم النثرية، ورغم ذلك ظلت ولّادة هي ملهمة ابن زيدون الذي ما نسيها مطلقًا حتى بعد انتقاله إلى إشبيلية، وظلت رفيقة أشعاره حتى وفاته.
شاعر الأندلس وأديبها
يعدّ “ديوان ابن زيدون” أفضل ما كُتب في الأندلس وقرطبة خلال القرن الحادي عشر، هذا الديوان الذي جمع بين دفتَيه أنواع الشعر المختلفة، الغزل الذي احتل نحو ثلثه تقريبًا، والمديح والهجاء وغير ذلك من الفنون الشعرية المتنوعة.
واحتلت ولّادة بنت المستكفي نصيب الأسد في قصائد هذا الديوان، ولعلّ قصيدة “يا غزالًا أصارني” التي تُسمّى بـ”النونية” من بين القصائد التي توثّق عشقه لها رغم ابتعاده عنها، إذ كان حينها في إشبيلية لكن قلبه كان معلقًا بمعشوقته رغم هجرانها له، وفيها يقول:
يا غَزالًا أَصارَني
موثَقًا في يَدِ المِحَن
إِنَّني مُذ هَجَرتَني
لَم أَذُق لَذَّةَ الوَسَن
لَيتَ حَظّي إِشارَةٌ
مِنكَ أَو لَحظَةٌ عَنَن
شافِعي يا مُعَذِّبي
في الهَوى وَجهُكَ الحَسَن
كُنتُ خِلوًّا مِنَ الهَوى
فَأَنا اليَومَ مُرتَهَن
وإلى جانب الشعر، تمكّن ابن زيدون من كتابة النثر كذلك، وله عدة رسائل تعدّ علامات فارقة في هذا الفن، تلك الرسائل التي تعبّر عن تجارب صادقة وأحداث عاشها الشاعر، حلوها ومرّها، رغدها وضيقها، ومن بين تلك الرسائل رسالتان هما الأشهر على الإطلاق بين مكتبته النثرية، هما الرسالة الهزلية والرسالة الجدّية.
وكتب ابن زيدون الرسالة الهزلية كما أشرنا سالفًا على لسان ولّادة ليرسلها إلى عاشقها ابن عبدوس، المنافس الأشرس لشاعر الأندلس في حب بنت الخليفة، وجاءت الرسالة ساخرة مليئة بالقذع والهجاء، ولاقت سخرية عارمة من قبل شعراء قرطبة الذين سخروا من ابن عبدوس، ما أثار غضبه لينتقم من ابن زيدون.
أما الرسالة الجدّية فكتبها وهو في سجنه إلى ابن جهور، يستعطفه فيها بأن يطلق سراحه، مبرّئًا ساحته من التهم التي كنّها لها خصومه وجاء فيها مخاطبًا الأمير: “يا مولاي وسيدي الذي ودادي له، واعتمادي عليه، واعتدادي به، وامتدادي منه، ومن أبقاه الله تعالى ماضيَ حدّ العزم، واريَ زند الأمل، ثابت عهد النعمة. إن سلبتَني أعزّك الله لباس نعمائك، وعطّلتَني من حلْي إيناسك، وغضضت عني طرف حمايتك، بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلي لك، وسمع الأصم ثنائي عليك، فلا غرو، قد يغصّ بالماء شاربه، ويقتل الدواءُ المستشفيَ به، ويـؤتى الحذِرُ من مأمنه”.
وتوثق هاتان الرسالتان مدى ما كان يتمتّع به ابن زيدون من ثقافة ونضج فكري وقدرة هائلة على النظم والكتابة، متلاعبًا بالأحرف والأساليب البلاغية كما يتلاعب عازف الكمان على أوتاره، وهو ما ميّزه عن أقرانه من شعراء وأدباء الأندلس رغم كثرة عددهم وتشعُّب فنونهم.
كان ابن زيدون نابغة الشعر في الأندلس، وأديبها الأبرز والأكثر وجاهة، الأديب الذي عاش حياته أسيرًا بين عشقه وطموحه، ضحية الهوى على يد ولّادة، وضحية الصراع السياسي على أيدي أصدقائه الأمراء.
وهناك العديد من الرسائل الأخرى التي كتبها ابن زيدون لكنها لم تبلغ من الشهرة ما بلغته الرسالتان، الساخرة والجدّية، ومنها الرسالة البكرية التي كتبها إلى أستاذه وصديقه أبي بكر بن مُسَلّم النحوي، عاتبًا وآملًا وشارحًا موقفه، والرسالة العبّادية الأولى والثانية اللتين كتبهما إلى المعتضد بن عباد، بجانب الرسالة المظفرية التي كتبها إلى المظفر سيف الدولة أبي بكر بن الأفطس، أمير بطليوس، مستشفعًا متوددًا.
وبعد انتقال المعتمد من إشبيلية إلى قرطبة بعدما حوّلها إلى مقرّ ملكه، كان ابن زيدون من المحظيين بقرابة وودّ الأمير، الذي أغدق عليه بالمال والجاه والوزارة، لكن هذا لم يعجب حسّاده ومنافسوه من الشعراء الذين وشوا إلى المعتمد بتآمر ابن زيدون عليه وضرورة التخلص منه.
وسقط الأمير في فخ الوشاية بالفعل، ليأمر شاعره المقرب الذي تجاوز الـ 60 من عمره ويعاني من عدة أمراض، بالسفر إلى إشبيلية للتهدئة بين اليهود والعامة عقب التوتر الذي ساد المدينة هناك، وألحق به بعد ذلك ابنه أبا بكر، ليلقى ابن زيدون حتفه وهو عائد من الحملة بعدما حقق المراد، وكان ذلك عام 1071، حيث دفنه ولده وشيّع جثمانه في إشبيلية.
وهكذا كان ابن زيدون نابغة الشعر في الأندلس، وأديبها الأبرز والأكثر وجاهة، الأديب الذي عاش حياته أسيرًا بين عشقه وطموحه، ضحية الهوى على يد ولّادة، وضحية الصراع السياسي على أيدي أصدقائه الأمراء، ليدفع ثمن الوشاية مرّتَين، مرّة من قلبه وولعه وأخرى من حريته وحياته، تاركًا خلفه إرثًا من الشعر والنثر جعله في مصاف صفوة الشعراء في التاريخ العربي والإسلامي، ليرتبط اسمه بالأندلس، فأيهما ذُكر، ذُكر الآخر.