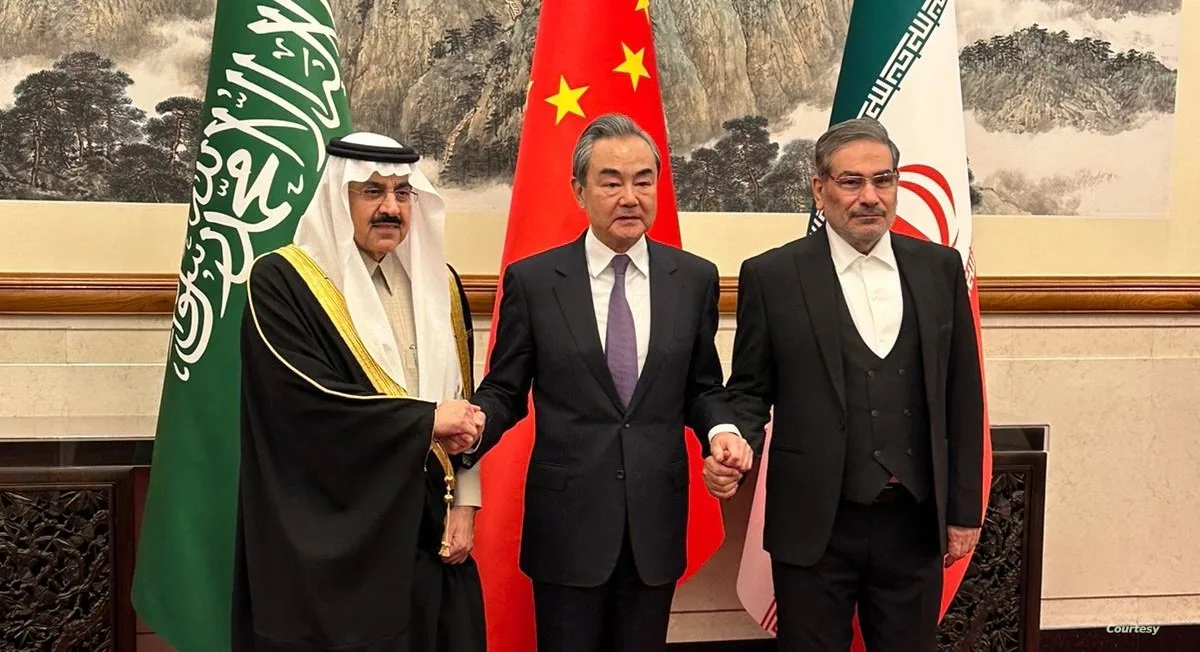في مسيرته الطويلة، حقق ديفيد كرونينبرغ الاحتفاء الجماهيري والريادة النوعية السينمائية في رعب الجسد، ليسير ابنه براندن على خطاه، وينخرط في النوعية ذاتها مع اختلاف المنهجيات السردية، بدايةً من فيلمه الطويل الأول “Antiviral” عام 2011، مرورًا بتجربته الثانية “Possessor” عام 2020، وأخيرًا منتجه الثالث والأخير “Infinity Pool المسبح الأبدي” الذي لا يختلف مع التجربتين السابقتين من حيث التيمة والمضمون.
فثلاثتهم – إلى جانب أفلامه القصيرة – يتعاطون مع فكرة الاستحواذ الجسدي والانفصال الهوياتي والتحكم المستقل بالجسد عن طريق كيان خارجي، تصور الجسد في أفلام كبراندن، كما في أفلام أبيه، تصورٌ ميتافيزيقي ينحي الجانب المادي بشكله التقليدي ويلعب في مساحة ميتافيزيقية ليخلق تجربة متجاوزة للمعنى السائد للجسد، تجربة انفصال تتماهي مع الجانب الماورائي في مفهومه الأكثر دموية وقسوة.
يتحرك الفيلم من وجوده المادي، كل شيء يبدو ماديًا ونفعيًا، يتعلق بالمال والطبقة الاجتماعية، تتشكل المادة كمحفز أساسي للكاتب المغمور لكي يتعاطى مع فشله الإبداعي، يغير المكان طلبًا للإلهام، لكن في الحقيقة أن السفر كنمط استعادي للإبداع، على الأقل بالنسبة للمكان، يتماس بشكل مباشر مع محاولة الترقي الاجتماعي، ما يمكن ملاحظته بسهولة في شخصية البطل جيمس فوستر “ألكسندر سكارسجارد” لأنه يتميز بطبيعة طفيلية متسلقة، حتى إن لم يشعر بذلك.
فبمجرد انخراطه في مجتمع منفتح على العنف والشهوة، يسلم نفسه ليختبر لذة تدمير ذاتٍ مستقلة، نسخته في عالمٍ آخر، أو نسخته الحاليّة، بحيث يفتقد القدرة على التمييز بين ذاته الأصلية والزائفة، إلا أن الإشكالية تقع في كون المنسوخ ليس زائفًا، ومن هنا يفقد البطل جزءًا من ذاته مع تدمير كل نسخة جديدة.
يعيش جيمس على أموال زوجته الثرية إم فوستر “كليوباترا كولمان”، ومنذ اللحظة الأولى يترقى إلى طبقة اجتماعية لا ينتمي لها، لكنه يأخذ لونها، بما يمتلك من مقومات تسمح له بالاندماج، الجسد القوي والوجه الحسن، صفات جسدية تؤهله إلى انتحال الترقي، بحيث يتظاهر كونه برجوازيًا أمام أبناء طبقته، إنما لن تستره عن بصيرة أثرياء الطبقة.
فالأنظار تتوجه صوبه منذ اللحظة الأولى كدخيل، ما يمنحهم حق التلاعب به، التسلية المجردة واختبار أنماط جديدة من الترفيه، كونهم يتمتعون بمميزات طبقية واجتماعية ومادية تشعرهم بالتفوق، فأمر الاستبدال وتدمير النسخة المخلوقة بالنسبة لهم تسلية محضة، لذة من نوع جديد، فيما يقع الإنسان الأدنى في معضلة اضطراب الهوية، لا يعرف نفسه، ولا يميز من حوله، كل ما تخلفه تقنية التناسخ هو الفضول المحض تجاه الجانب المادي والروحاني، إلى جانب الإضراب الهوياتي، فالأمر أشبه بنوع من الاستنزاف الذاتي للهوية، في النسخة الاولي تتبدى المتعة، يظهر الأمر كما المسرحية الفنية، حين يقتل البطل نسخة من ذاته على المسرح، لكن في المرة الثانية يلتبس الأمر.
فتقنية الاستنساخ لا تخلق بديلًا مجردًا من المشاعر، أي لا تتعاطى مع الجانب المادي كالحواس والجلد والشكل، إنما تستنسخ الذكريات والمشاعر، تستنسخ الحب والندم، إذا فلماذا لا يرتاب الإنسان تجاه ذاته التي يقدمها قربانًا لفداء ذات تبدو مستقلة، لكنها في الحقيقة متصلة بشكل رئيسي مع الجسد المستنسخ، إنهما واحد، فأي منهما الحقيقي؟
يدور الفيلم حول جيمس وزوجته، حينما يذهبان إلى جزيرة متخيلة “لا توكا” ليستجما، وفيما يقضيان العطلة يقابل جيمس امرأةً معجبةً بكتاباته، جابي باور “يا جوث” وتعرض عليهما قضاء يوم خارج المنتجع، وفي طريق عودتهما يصدم جيمس أحد سكان الجزيرة ويقتله.
ومن هنا تبدأ الاحداث بالتعقد والانكشاف، فشرطة المدينة تصادق على قانون ينص على قتل الجاني على يد أحد أبناء الضحية، لكن على الجانب الآخر، تعمل الشرطة بشكل سري على خدمة أبناء الطبقة البرجوازية من خلال تقنية استنساخ، فتنسخ شكل الجاني بصفاته ومشاعره وحتى ذاكرته، وتنفذ فيه القانون، بحيث ترضي أبناء القرية، لكن في الوقت ذاته تحافظ على قاطني المنتجع، والاحتفاظ هنا مادي ومعنوي، فالتقنية مكلفة، بيد أنها تمنح الأثرياء ميزةً لا يتمتعون بها خارج حيز المنتجع، التطرف المطلق تجاه الطبقات الدنيا، والاحتقار الكلي إلى درجة المحو أو التلاعب من أجل المتعة، سلوك تفريغي متطرف ينتج ممارسات سلطوية تأخذ منحى شهواني، فيما تؤطر سؤالًا عن الهوية بالنسبة لجيمس ابن الطبقة الدنيا.
في البداية يخرج جيمس وزوجته عن مساحتهما الآمنة، فالمنتجع السياحي ليس مجرد مكان يتسم بطبيعة ترفيهية خدمية ذات جودة عالية، بل يتجاوز كونه مكانًا، ويتضاد مع البيئة المحيطة على كل المستويات، فالمنتجع يمنح قاطنيه مميزات إلهية، ويرفعهم إلى درجة مقدسة مقارنة بالبشر المحيطين، حتى القيمة التاريخية للجزيرة يتم تضمينها داخل إطار رأسمالي سلعي في سياق المنتجات الخدمية الترفيهية، غير أن خروجهم من البقعة المركزية الآمنة لا يسمح بوجود تلك الخدمات على نطاق واسع، ويسمح بوقوع الحوادث بطريقة مفاجئة.
ومن هذا المنطلق تبدأ غابي وزوجها ألبا “جاليل لسبرت” بالتقرب من الكاتب وزوجته، وتعرض عليهما قضاء يوم لطيف خارج إطار المنتجع السياحي، وفي طريق عودتهما، وفيما يقود جيمس السيارة مخمورًا، يصدم أحد أبناء الجزيرة، تقبض عليه الشرطة في اليوم التالي، وتبدأ بعدها الأحداث بالتدفق في اتجاه واحد، اتجاه ميتافيزيقي ممزوج بطبيعة هوائية لمجموعة من الأفراد يفرضون أسلوبًا معينًا، منهجية تجريدية لكل أنساق الحضارة والتحضر، متطرفة إلى حد التخريب المطلق، ليتحولوا مع امتداد الممارسات وتكرارها إلى مسوخ مشوهة، تختبر حدودًا جديدة من السلطوية والعشوائية المحببة لطبقة اجتماعية مقيدة بقواعد وأنظمة حياتية ذات مبادئ صارمة مقارنة بالطبقة الأقل.
فالصعلكة تتيح نوعًا من الحرية والتمادي، على عكس الالتزامات الاجتماعية التي تكبل الطبقة العليا من الأثرياء، بين بعضهم، وأمام الطبقات الأخرى، إلا أن المكان البعيد وفر نوعًا من غياب الرقابة الاجتماعية إلى جانب الآلية السرية التي تعمل بها الجزيرة لترفيه الأثرياء، التي بدورها تؤسس لعالمٍ فوق قانوني، عالم لا يعمل بالورقة والقلم، لا يخضع لتشريع حقيقي، أو يمرر الأفعال داخل دستور يمنح نوعًا من المساواة بين الأفراد – حتى لو بشكل صوري – بغض النظر عن طبقتهم، بيد أنه هنا يرجح كفة الأثرياء بطريقة متطرفة وراديكالية، يجعلهم يتهيجون ويستوحشون.
فهم ينظرون لذلك النمط الاجتماعي، كنمط مؤقت، مبني على التواطؤ، فينهلون منه إلى درجة الغثيان، كما يفعلون دائمًا في المجتمعات والأنظمة الاجتماعية الحقيقية، لكن في الخفاء، تحت حجاب، بيد أنهم هنا يجمحون بشدة، ويمارسون آلاعيب لها أصول طبقية على جيمس، الذي يرصدونه بوضوح كدخيل، حتى في نهاية الفيلم يصرحون بأنهم الأفضل، وأنه مجرد طفيلي.
يبتعد براندن في حكيه عن النمط الكلاسيكي ويتجاوز نقطة الامتداد الخطي للسرد، بحيث يتحول الفيلم في نصفه الثاني إلى لقطات مكثفة، منفصلة نوعًا ما عن الواقع الخارجي، ذروات انفعالية جسدية، سواء على مستوى اللغة السينمائية أم السياق السردي، بحيث يوجهنا المخرج إلى عالم داخلي، مضطرب وعنيف.
ويبدأ في التوغل بسلاسة داخل أروقة هذا العالم من خلال إعمال الكاميرا بمنهجية بصرية تعادل وطأة الموقف، فيتحول الفيلم مع الوقت إلى نوبات من الجنون، خفقات من الخبل والهوس والوساوس، مطموسة تحت عدسة المخرج، بحيث يشكل صورة مشوهة، ويخلق إحساسًا يتجاوز القيمة البصرية، شعورًا بالنشوة المضاعفة، والاستهلاك المتطرف للذات، لكنه في الوقت ذاته، ومع تكرر هذه المشاهد، يطرح سؤالًا عن الهوية.
فالمتوالية البصرية التي ترتبط بالجلوس جانبًا ومراقبة موتك تؤسس لإشكالية الوجود ذاتها، من نحن وإلى أين يمكن أن نتأكد من ذواتنا، وما المعايير الهوياتية الحقيقية لليقين الذاتي، إلى جانب ذلك، فالموضوع أشبه بدمية ماتريوشكا، دمية داخل دمية داخل دمية، ومع كل قشرة تنتزع، مع كل نسخة تقتل، يظهر شعورًا جديدًا، وتأثيرًا أعمق، وسؤالًا أكثر حدة، فيما يرى الأثرياء الأمر من منظور ترفيهي، منتزع عن سياقه، لأن السياق ذاته شيء مفروض على حياة الإنسان في المجتمع الرأسمالي، خصوصًا الأثرياء أو الطبقة الوسطى العليا.