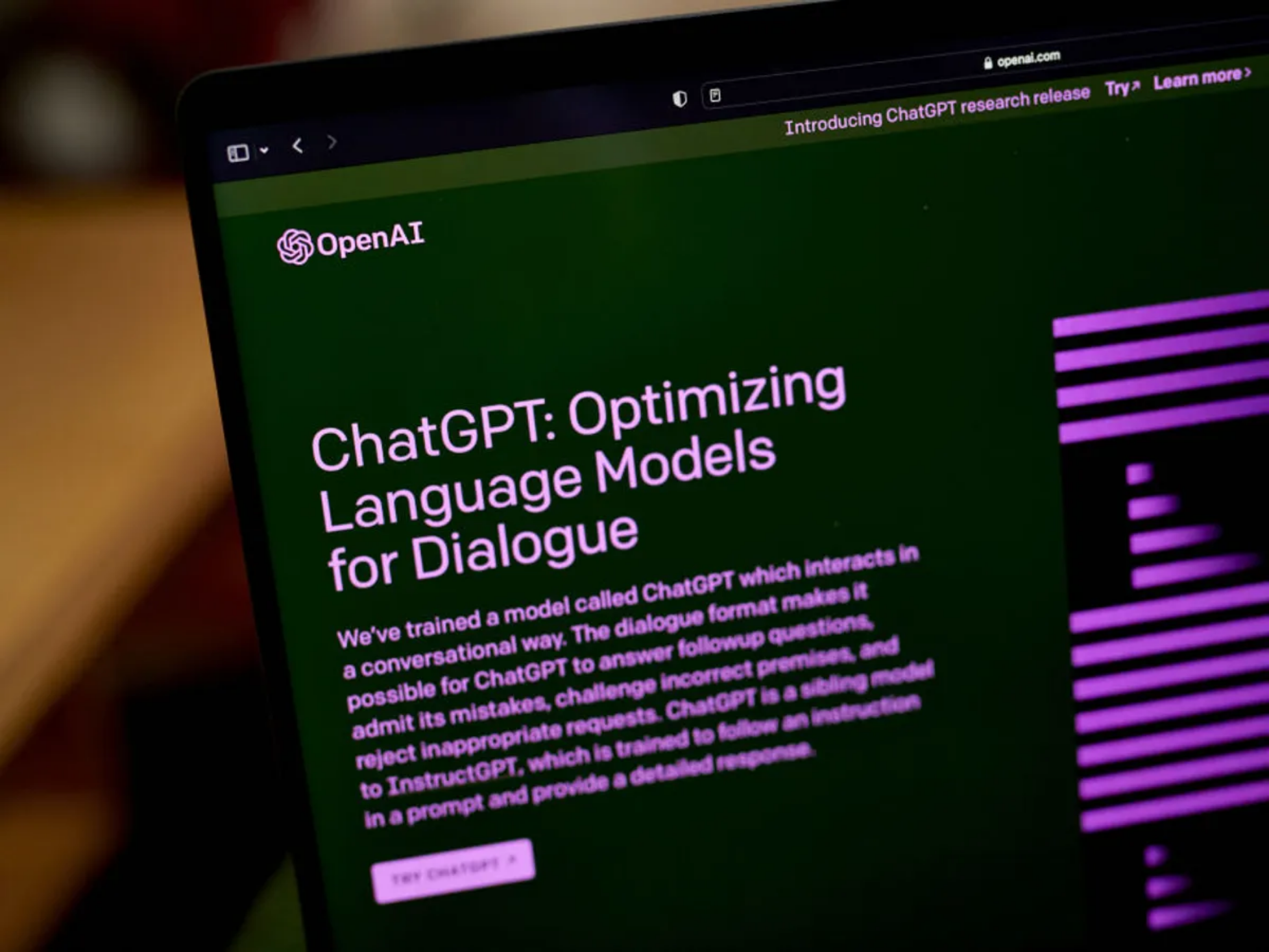نادرًا ما تجالس شيخًا أو عجوزًا، رجلًا كان أو امرأةً، إلا ويحدثك عن أيام زمان، وحلاوة زمان، وروعة وعظمة تلك الأيام الخوالي التي أجهضتها الحياة العصرية بتفاصيلها المتسارعة وحضورها الزئبقي الذي من الصعب أن يترك أثرًا تدوم رائحته طويلًا، فهذا يسترجع ذكريات رمضان الطفولة، وذاك طقوس العيد المبهجة، وثالث يتحدث عن كيف كان الناس قديمًا وفيما أصبحوا اليوم.
ومن أبرز الساحات الواسعة التي تحضر فيها مشاعر النوستالجيا، عيدا الفطر والأضحى، فحين تطلب من أي من كبار السن اليوم أن يحدثنا عن كيف كانوا يحتفلون بتلك الأعياد قديمًا، حتمًا ستداعب آذانك تنهيدات تلو التنهيدات، تحسرًا أو حنينًا على وإلى ما فات، خاصة إذا ما قورن بما بات عليه الناس الآن، حيث اعتصرتهم العصرنة عصرًا، وزجت بهم في ترس الحياة السريعة التي لا ترحم.
في تلك الإطلالة الخفيفة نحاول العودة بالذاكرة إلى الوراء قليلًا، نتعرف على أبرز طقوس الاحتفال بالعيد قديمًا، في محاولة لفك شفرة الفرحة العارمة والسعادة الغارمة التي كانت تغلف الشارع والبيوت لأيام طويلة، قبل وفي أثناء وبعد العيد، وليس أيامه فقط، وما الذي حدث لها بعد أن مزجت بماء التطور والتكنولوجيا الحديثة.
هكذا كانت الاحتفالات قديمًا
كان الاحتفال بالعيد قديمًا يبدأ مع استشراف هلال رمضان، ففرحة الشهر الكريم هنا لم تكن مقصورة عليه دون غيره، بل كانت ممزوجة بفرحة اقتراب العيد، حيث تعم أجواء البهجة جميع البيوت دون استثناء، وما إن ينتصف رمضان حتى تبدأ الطوارئ داخل منازل المسلمين، تشعر أن كل بيت تحول إلى خلية نحل وشعلة نشاط لا تتوقف، ويتشارك في ذلك الكبار والصغار، النساء والرجال.
وبعد مرور عشرة أيام تقريبًا من رمضان تتحول محال الحياكة والخياطة إلى قبلة المسلمين الأولى في ذلك الوقت، فالغالبية كانوا يحيكون ملابس العيد في تلك المحال، وسط فرحة كبيرة خاصة بين الفتيات والشباب صغار السن، والبعض كان يمتلك في منزله ماكينة خياطة يحيك بها ملابس أطفاله، أما فكرة شراء ملابس جديدة جاهزة فكانت فكرة مستبعدة قديمًا، بل كانت سيئة السمعة كونها تتعارض شكلًا ومضمونًا مع ما اعتاده الناس في مثل تلك المناسبات.
وما إن تدخل العشر الأواخر حتى تفوح روائح المخبوزات من جدران وأبواب المنازل دون استثناء، الكعك والبسكويت من بيوت المصريين والفلسطينيين واللبنانيين، والغريبة والمعمول من داخل منازل السوريين، و”الكليجة” و”القيمر” و”الكاهي” من داخل الشوارع العراقية، وغيرها من بلدان العالمين العربي والإسلامي.
وكان الأمر قديمًا لا يقتصر على ميسوري الحال فقط، بل كان الجميع يشارك تلك الطقوس احتفاءً واحتفالًا وابتهاجًا بقدوم العيد الذي كان بمثابة متنفس حقيقي لانتشال الناس من معاناة العام كله، ومن ثم كانوا يخلصون له الاستقبال ويجزلون له العطاء، كل على حسب مقدرته، المهم في النهاية أن تكون الفرحة والبهجة والسعادة كلمات السر.
المساجد هي الأخرى كانت ركنًا أصيلًا في طقوس الماضي، فصلوات التراويح والتهجد ما كانت تغيب عن أحد، فرغم صغر حجم المساجد قديمًا، كانت تشع نورًا وبهجةً عارمةً، فمن الصعب أن تجد موطئ قدم طيلة أيام رمضان وفي الأيام الأخيرة منه وقبيل ساعات من العيد، ملامح الفرحة المرسومة على وجوه المصلين قبيل العيد تعكس حجم الابتهاج بهذا الضيف الكريم، وتبادل التهاني بينهم يرسخ لحكم التلاحم الذي كان عليه الناس في السابق.
وكانت صلاة العيد قديمًا لوحة فنية مبهرة، فالصلاة كانت كلها في العراء التزامًا بالسنة النبوية، وكان الناس يشبكون أيديهم وهم ذاهبون للصلاة، يسيرون تجمعات في شكل أمواج مختلفة الألوان والأشكال، الكبار يلتحفون بالصغار الممسكين بتلابيب الشباب، الكل في واحد، وتتعالى الأصوات من بين ثنايا الشوارع الضيقة والأزقة، الكل يهنئ الكل بقدوم العيد.

لُحمة اجتماعية رائعة
كانت ساحات صلاة العيد قاعات اجتماعات كبيرة، همهمات التبريكات لا تتوقف، توزيع منسق ومنمق للابتسامات بين الناس، أحضان وقبلات بعد انتهاء الصلاة، لا حديث هنا يعلو على الفرحة والبهجة، أيًا كانت منغصات الحياة وعثراتها، لكن في هذا اليوم الكل يخلع رداء الحزن على عتبة منزله، مستبشرًا نسيمًا جديدًا يغسل ما علق به طيلة العام من هموم ومشاكل.
وتعد الزيارات المتبادلة السمة الأبرز للمسلمين في الأعياد قديمًا، تشعر أنك أمام خلية نحل تمارس عملها بمنتهى الدقة، فهذا خارج من بيت جاره متجهًا إلى منزل الجار الآخر، وذاك خارج من منزل شقيقه في اتجاه بيت شقيقته، وتلك خارجة للتو من منزل جارتها في اتجاه أقاربها، ديمومة من تبادل الزيارات لا تتوقف طيلة أيام العيد الثلاث، فلا مجال هنا لغير الزيارات لتقديم التهاني والتبريكات.
وفي المساء يجتمع الكل على موائد واحدة، حيث تتحول منازل الآباء والأجداد إلى ملتقى الأسرة كلها، الكل يجتمع عند الكبير، سواء أب أم جد، لتبدأ مراسم الاحتفال العائلي بتناول أشهى المأكولات ومشاهدة التلفاز لمن كان ميسرًا ويمتلك جهازًا، فيما كانت الأغاني تهز أرجاء البيوت ليل نهار.
أما الأطفال فحدث ولا حرج، فقبل العيد بيومين أو ثلاثة على أقل تقدير كان الطفل يجلب ملابس العيد الذي اشتراها ويضعها بجواره في فراشه، تلازمه ويلازمها، فرحًا بها – رغم بساطتها – وممنيًا نفسه بارتدائها مع أول تكبيرة للعيد، لتبدأ غزوة “العيدية”، التي كانت أحد أبرز طقوس الفرحة عند الصغار، بل إن بعض الكبار ظلوا ملتزمين بحصولهم على أموال العيدية حتى بعد زواجهم، فطالما الوالد على قيد الحياة فلن أتخلى عن حصولي على العيدية ولو شاب شعر رأسي.. هكذا يقول البعض.
وهكذا صارت اليوم
مع دخول عصر التكنولوجيا الحديثة وتحويل العالم من دول ومدن ومناطق وأزقة وحواري إلى قرية صغيرة بل إلى غرفة صغيرة، فقدت الأعياد الكثير من طقوسها الاحتفالية التي تحولت فيما بعد إلى إرث أدبي وشعبي يُقص على مسامع الأجيال، لا حضور له في الواقع، بل إن بعض المتمسكين به كثيرًا ما يتهمون بالتخلف.
غابت فرحة حياكة الملابس واستبدلت بفرحة أخرى حين شرائها من بوتيكات الأزياء، وانزوت أجواء صناعة المخبوزات بالبيت وروائحها التي كانت تزكم الأنوف فرحة وبهجة تحت وطأة الجاهز المعمول في المحال المخصصة، حتى البيوت تحولت إلى خواء دون أي أجواء توحي بأن العيد قد اقترب، فيما غابت ملامح الفرحة بفعل الضغوط الحياتية الصعبة.
حتى صلاة العيد التي كانت طقسًا مقدسًا في السابق تحولت اليوم إلى مسألة خيارية ترفيهية، فالكثيرون يغيبون عنها نظرًا لقضائهم معظم أوقات الليل إما أمام التلفاز وإما في الشوارع وهو ما يفوت عليهم وقت الصلاة، هذا بخلاف فقدان الصلاة للكثير من رونقها بعدما تحولت إلى حدث تقليدي لأداء الواجب والفريضة فقط، حيث تقلص عدد ساحات الصلاة في العراء ومُنع بعضها وفُرض على المتبقي قيود أمنية وإدارية مشددة أفقدتها الكثير من رونقها وروحانياتها.
وعلى مستوى اللحمة الاجتماعية، فاستبدلت الزيارات بالاتصالات الهاتفية ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تعميق الفجوة بين أفراد المجتمع، بل بين الأشقاء، فبينما كان البعض يعول على تلك المناسبات لإحياء التواصل مع عائلته وإزالة أي خلافات وسد فجوة الجفاء طيلة العام بسبب الضغوط، إذ بالأمر اليوم يختلف كثيرًا، فاتصال أو رسالة كافية وتعوض عن الزيارة، وهو ما أدى في النهاية إلى تشققات مجتمعية خانقة يدفع ثمنها اليوم الجميع.
ورغم إجهاض العصرنة والتكنولوجيا للكثير من طقوس الأعياد القديمة، يصر البعض على التمسك بها، وتسول الفرحة والبهجة والسعادة أيًا كان مصدرها، ملقيًا بهموم الحياة خلف ظهره ولو لأيام أو ساعات قليلة، يلتقط فيها أنفاسه، ويحظى باستراحة قبل أن يعاود معاركه اليومية مرة أخرى.