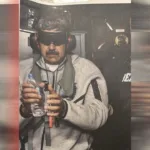ينطلق بعض المخرجين من نقطة ملتبسة اتجاه ذاتهم، وبالضرورة اتجاه العالم الخارجي، نقطة التقاء لامتدادات تتجاوز الفردي وتتحرك نحو إشكالات تتعلق بالهوية والتعريف، ذلك الاضطراب الهوياتي يحدث نوعًا من الارتياب في موقف الشخص اتجاه المجتمع، ويتطلب لغة سينمائية ذات بُعد جغرافي وامتداد اجتماعي وكتابة منفتحة على مناطق ومساحات جديدة، تخلق نموذجًا سرديًّا عابرًا للحدود.
تجعل هذه المعطيات، المخرج الألماني من أصل تركي، فاتح أكين، متفردًا فيما يقدمه للمشاهد، من إشكالات تنبع من الجانب الهوياتي كنواة ينتج عنها نموذج قصصي يتراوح بين الداخلي الشاعري والخارجي اللامنتمي، ويؤسّس لمحاولات فردية وأقاصيص فرعية كنماذج تائهة ترتدّ إلى القديم الموروث، وتهتدي إلى الأصول كوجهة نهائية، وتبتعد عن البديل كمجاز عن التيه، يتطاول على الأفراد بنزعة أشد تكثيفًا ومادية تقصيهم روحيًّا فيعودون إلى الأصول، ليخوضوا عملية إعادة تكوين تتماسّ أكثر مع الروحي والعاطفي، وتمتدّ إلى ما هو تجريدي.
دائمًا ما يضع المخرج، أكين، أبطاله في نقطة بداية شائكة، تدفعهم إلى الخارج، أشبه بعملية إزاحة ترتبط أكثر بالاضطراب الهوياتي لدى فاتح، الذي وُلد في مدينة هامبورغ بألمانيا لأبوَين مهاجرَين من تركيا، فأصوله التركية حصرته في المعبر بين ما هو تركي وما هو ألماني، فهو مواطن ألماني محبّ لدولته، بيد أنه مهموم بمشاكل الهوية التي يتعرض لها المواطنون الأتراك في ألمانيا.
خصوصًا أن الكثير منهم -على حسب كلماته- يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، ما يجعل الاشتباك مع هذا النوع من الإشكالات جزءًا ضروريًّا من الرصد والتعبير والمكاشفة التي تضيف الكثير من الطبقات غير المرئية بالنسبة إلى الطرفَين الألماني والتركي.
يتعاطى أكين في معظم أفلامه مع تيمة الحدود، كل أبطالها مغتربين في نقطة ما من حيواتهم، أصلهم المغاير يمنحهم خيارًا آخر، وفكرة الرحلة ذاتها لا يمكن إرساؤها على خاصية الحرية الحركية التي يمنحها الجواز الألماني لمواطنيه، فالفكرة أعمق من كونها حركة ذات بُعد جغرافي أو هدف سياحي، بل تتولد من طبيعة المعاناة الكامنة في شريحة أبناء المهاجرين على حسب أجيالهم، وهذا ما يمنح سينما فاتح أكين قوتها.
لا ينطلق أكين من فكرة الرفاه، بل يستهلّ قصصه من حضور المعاناة داخل مجتمع امتياز طبقي ورفاه اجتماعي، حتى أبطاله الأكثر رفاهًا يسقطون في هوة القلق الهوياتي أو حتى الحاجة إلى البحث عن شيء ما، ربما هذا الشيء لا يخصّه على المستوى المادي، لكنه ينتمي إليه على مستوى جوهري، إنها الرحلة التي يجد فيها البطل نفسه، أو لا يجد شيئًا على الإطلاق، ربما يتوقف عند لحظة ما من اللاشيء، لكنها لحظة من الهدوء النفسي، المرسى الروحي، حيث النهايات المفتوحة على كل شيء.
يمنح أكين أفلامه ديناميكية عالية من خلال استقطابها من جهات مختلفة غير ألمانية، أي أن أبطاله ينحدرون من أصول أخرى حتى لو وُلدوا في ألمانيا ذاتها، ما يجعلهم أكثر ديناميكية على المستوى الداخلي، قدرتهم على الحركة ودوافعهم لارتكاب الأفعال تأتي من الغصة الصغيرة في حلوقهم كمواطنين درجة ثانية، محاولتهم للترقي، سواء على المستوى الاجتماعي والمادي أو الروحي، هي ما تحفزهم نحو الأفعال وأنماط الحياة التي ينخرطون فيها دون وعي.
في فيلمه الأول “صدمة حادة خاطفة”، ينتقي أكين 3 أبطال من خلفيات عرقية مختلفة، غابريل من أصول تركية يخرج من السجن في ثوب جديد، يحاول أن يعيش حياة الأسوياء في ظل القانون، لكن بعد أن يتوحّد بصديقَيه القديمَين، اللص بوبي من أصول صربية ورجل العصابات كوستا من أصول يونانية، تتعقد الأمور مرة أخرى، خصوصًا مع تورُّط الاثنين مع مافيا ألبانية، حيث يعرض الفيلم للاغتراب ومحاولات الترقي الاجتماعي والاضطراب والمشاكل التي تتعلق بالهوية والعادات والتقاليد والخلفية العرقية.
يتحرك أكين دائمًا بين عالمَين، يحرص على وجود الطرف الآخر من العالم، حتى لو لم ينتقل إليه أبطاله، فيضعه كمحفّز لأن أفلامه تعتمد في سردها على ما يسمّى السرديات الكبرى (Metanarrative)، علاقة الإنسان بالجغرافيا علاقة مفتوحة ليست متجذرة أو قومية بقدر كونها هلامية.
لقد حوّل أكين قضية العمال المهاجرين في الضواحي المهمشة بمختلف أجيالهم إلى موضوع متعدد اللغات، ينفذ إلى المساحات والحدود الأوروبية المتاخمة لألمانيا أو البعيدة عنها، سواء في تمثيلاته للذكورية أو قدرته على تسييل تلك الحدود بشكل يجعلها جزءًا أصليًّا وأساسيًّا من سينماه على المستوى السردي والبصري، خصوصًا أنه يجانب كل الاتهامات العرقية التي توصمه بتجاهل نقد النزعة العرقية، لأنه ينتقدها بالضرورة داخل نموذجه الفيلمي الأشمل.
لكنه لا يتوقف عندها، بل يتجاوزها بالحركة والديناميكية التي تنقل الفيلم إلى الجهة الأخرى، لأنه لا يخلق نماذج محلية بل يخلق نماذج سائلة، عابرة للحدود، تتأرجح بين المادي والروحاني، والحقيقة أن تعريف المواطن التركي لذاته في ألمانيا ما زال محل التباس وتشكُّك، سواء على مستوى الهوية الفردية أو الجماعية، ويقول أكين في إحدى مقابلاته:
“توجد مشاكل في تعيين الهوية (لدى المهاجرين الأتراك) مع ألمانيا ذاتها، رغم أن هذا يتغير أيضًا. لا يجدي أن يرى الفرد نفسه خارج منظومة البلد الذي وُلد وترعرع فيه، ويعتقد أن بلده في مكان آخر. هذا يخلق الأوهام. لا يمكنك التمسك بوهم. أعتقد أن الكثير من هذا يرجع إلى حقيقة أن الكثير من الأتراك ما زالوا لا يشعرون بأنهم موضع ترحيب في ألمانيا. إنهم يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية (…) حتى أن الجيلَين الثاني والثالث يشعرون بذلك. رغم ذلك الأمور تتطور للأفضل. إنهم يجدون أنفسهم أكثر فأكثر داخل المجتمع الألماني، بيد أنهم يظلون عددًا متواضعًا جدًّا. لا يزال الكثيرون يتقيدون بفكرة ثبات الموروث الاجتماعي والثقافي التركي، دون أن يدركوا أن تركيا نفسها تتحرك”.
بالنسبة إلى البعض، فاتح أكين ألماني مزعوم، مزيف، بيد أن البعض الآخر يعتبره مُخرجًا له بُعد سياسي ضروري ومثير للجدل بالنسبة إلى المجتمع الألماني، فيما تعتبره الطبقة المثقفة التركية كمُلهم تركي ومخرج بارز، لكنه في الحقيقة يعرّف نفسه كألماني لكن بطريقة مختلفة قليلًا في أحد لقاءاته بمهرجان البحر الأحمر:
“لقد أثاروا الضجة حول هذا الأمر، سأقولها مرة أخرى أنا جزء من صناعة السينما الألمانية. أعيش في ألمانيا، وشركتي في ألمانيا، وأنا أصنع أفلامي بأموال ألمانية، لذا فهي أفلام ألمانية. لكن يجب ألا يكون للأفلام هذا الحد. إنه فيلم جيد أو فيلم سيّئ”.
رغم ذلك، يمكن تعريف فاتح أكين من خلال أفلامه كرجل بهويتَين، يصنع أفلامًا كما وصفها: “أنا لا أصنع أفلام مثيرة للجدل، أنا أصنع أفلام حول أفراد بثقافتَين/ حضارتَين”، لهذا الأفلام هي من تعرّف صاحبها وليس العكس، لكن صاحبها هو الأكثر دراية بمنتجه السينمائي، لذا يمكن إدراج فاتح أكين تحت خانة مفتوحة، كنتاج لنوع من التهجين الثقافي، نوع بيني، يتمادى وينكمش ويعبّر ويقفز طبقًا للفرد وتخيلاته.
يبدأ بعدها فاتح بالانتقال إلى مستوى أعلى في مسيرته السينمائية، مستوى أكثر شاعرية ورومانسية في فيلمه “ضد الجدار (Head-On)” عام 2004، الذي حاز جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي، ليبدأ العالم في معرفة فاتح أكين كمخرج عالمي له خصوصية فنية، حيث فتح الفيلم الطريق لفلسفة أكين السينمائية ليجري تناولها بطريقة أكثر جدية، ويتحول أكين إلى رائد من رواد السينما الألمانية الجديدة، التي تحاول فتح مساحات جديدة ونخر جروح قديمة.
يدور الفيلم حول كاهيت تومروك، مهاجر تركي في الأربعينيات من عمره يعيش في ألمانيا، ذو ميول انتحارية يهدئها بتعاطي المخدرات، حتى يلتقى بسيبل، ألمانية تركية، تبتغي التحرر من وطأة العادات والتقاليد التركية بأي ثمن، فتطلب من كاهيت الزواج حتى تنفلت من القواعد الصارمة لعائلتها التركية المحافظة.
يعتبر فيلم “حافة الجنة” أكثر أفلام أكين تعقيدًا، وأكثرها في عدد الشخصيات والخطوط السردية المتشابكة.
يضمّن فاتح أكين كل أفكاره داخل معاناة إنسانية صريحة، في نموذج صريح ينتقد فيه الموروث التقليدي للثقافة التركية والذكورية السامة، بيد أن الإطار نفسه أكثر نضوجًا وشاعرية من أفلامه السابقة، فكرة الحدود السائلة والأبطال العابرين للثقافات تتضح هنا بشكل أعمق، لأنها تنطلق من ديناميكية حركية.
فأحد الأبطال يسافر إلى تركيا للهرب من أهله، يعاني هناك لكن يبني لنفسه شخصية جديدة كليًّا، كأن الانتقال الجغرافي يتماهى مع قابلية الانخراط داخل شخصية جديدة، في الأغلب تكون أكثر حكمة وفهمًا لعواقب الحياة، عكس مدينة هامبورغ الألمانية التي تنتمي أكثر إلى العنفوان والمخدرات والهياج الجنسي كثقافة أكثر انفتاحًا، إلى جانب توظيفه للموسيقى بطريقة أكثر مسرحية في قطعات خاصة بالأداء الموسيقي والغنائي الذي يمنح الفيلم صبغة الفصول المسرحية.
لا يختلف فيلم “حافة الجنة” -أفضل أفلام أكين على الإطلاق- عن أفلامه السابقة في تناول إشكالات عابرة ومجاوزة للحدود بشكلها التقليدي، حيث يعتبر هذا الفيلم أكثر أفلام أكين تعقيدًا، وأكثرها في عدد الشخصيات والخطوط السردية المتشابكة، لكننا يمكن من خلاله هو وفيلم “ضد الجدار” أن نقف على تعريف للمدينة داخل سينما فاتح أكين.
المدينة
تعتبَر المدينة أهم معالم فاتح أكين بجانب الموسيقى، لأنها غير مرئية داخل السرد بشكل ثانوي، إنها السرد نفسه، إنها الممرات والإحاطة الكاملة، يعيد أكين إنتاج المدينة في كل فيلم تقريبًا، لأن حيوية الأبطال تأتي من قدرتهم على الحركة، والحركة هنا سينمائية ليست واقعية صرفة، أي أنها تعزز الإحساس بالزمان والمكان.
فالأفلام لا تعرض المدينة ذاتها كحجارة وخطوط هندسية، بل تعرض انعكاساتها وتأثيرها وفاعليتها في فرش وتأسيس للحكاية بشكل غير مباشر، لا يوجد حنين للمدينة بشكلها التقليدي، بل انجذاب للذاكرة، للموروث الروحاني أكثر من أي شيء آخر، فإسطنبول مدينة تقف على أعمدة روحانية لكنها لا تفتقد للسراديب والأزقة والواقع الاجتماعي القاسي، ربما بشكل أكثر حدة من هامبورغ مدينة فاتح أكين، لكن كلا الوجهَين لا ينفي الآخر.
يقوم أكين بما يسمّى الإدارة الفنية للمدينة، يحجب أشياء ويكشف أخرى بما يتناسب مع إيقاع وموتيفات الشخصية، لدرجة أنه -كما فعل قبله إدوارد يانغ والكثير من المخرجين- يترك تأثيرًا تكوينيًّا على المدينة داخل أفلامه، هامبورغ تتبدى كمدينة قاتمة، سوداء، مساحة للضياع والسقوط في هوة لا نهائية، حيّز يحتشد فيه الكثير من الألوان والأشكال، والرؤية هنا من منظور تركي داخل إطار ألماني.
فالعين التركية حتى لو كانت ألمانية على الورق تظل مسيّرة بالوعي التركي، خصوصًا في لحظة التنوير والمكاشفة، مثل أن يقول البطل: “سأذهب إلى إسطنبول وأبدأ حياة جديدة”، ورغم شاعرية مدينة إسطنبول داخل أفلامه، وتنوعها وثرائها على النمطَين المعماري والاجتماعي، إلا أنها مدينة ملغّمة، عرضية وعشوائية، بحيث يمكن للصدفة أن تحكم، خصوصًا في حياة الأجانب والدخلاء.
في فيلم “حافة الجنة”، أطلق أحد الأطفال النار على رأس الفتاة الألمانية، إذًا العنف متأصّل في المدينتَين، ربما يبدو العنف أكثر عشوائية في إسطنبول، فالصبي الصغير لم ينوِ أن يقتل المرأة الألمانية، بل كان مدجّجًا بسلاح لا يفهمه، ويحاول المزاح أو التجريب أو حتى ممارسة عنف يتبدّى في مستهله كلعبة وينتهي كجناية، وهذا في حد ذاته نقد اجتماعي، لأنه يرصد عنفًا جوهريًّا داخل إسطنبول، عنفًا له جذور اجتماعية واقتصادية وبيئية.
بيد أنه لا يمسّ شاعرية المدينة بأي شكل، حتى في فيلمه “ضد الجدار” يرصد عنفًا ذكوريًّا لمجموعة من الشباب يضربون سيبل بشكل مبالغ، لكنه يمنح ذلك العنف نوعًا من الشاعرية غير المفهومة، فبطلته تنهض مجددًا وتسدد لكمة للرجل، فيضربها الرجال، فتنهض مجددًا، كأن العنف هنا بالنسبة إلى الفتاة فعل تطهير، أو حركة تنوير ومكاشفة، إنها اللحظة التي سترى خلالها الأمور بشكل أوضح، لتغيّر الفتاة المدمنة والتي تمارس دور اللعبة الجنسية في كثير من الأوقات نمط حياتها إلى الأبد، وتتحول إلى شخص جديد كليًّا.
إذًا المدينة ذاتها كتلة مختلطة، كصورة ونموذج فني مفتوح على التأويلات، وحتى على مستوى العمارة، فهامبورغ أكثر شراسة، على عكس تركيا التي تتميز بأكثر من نموذج حضاري معماري يتباين مع ضرورات السرد، غير أن الشيء الأساسي الذي يمكن استنباطه من مدن فاتح أكين، أن لا أحد يمتلك المدينة، خصوصًا في ألمانيا، فالمهاجرون جزء كبير يراكم ثقافة مهجّنة، هؤلاء هم أبطال أكين، وهم في الأغلب منبوذون، لكن هذا لا ينفي تواجدهم بكثرة وانتماءهم إلى طبقة اجتماعية عمّالية غير مرئية في القمم الاجتماعية الألمانية.
يمكننا فهم الحالة التي يصنع بها أكين أفلامه، حالة مهجنة، ودماء مختلطة.
تتعلق المدينة بالهوية، علاقة الشخص بنفسه وبالجماعة تأخذ شكلًا مختلفًا تبعًا لكل مدينة، وفكرة أن يملك الشخص وطنَين، وطنًا مضيفًا ووطنًا أمًّا، تجعل أفلام أكين تتعلق أكثر بالحنين والاشتياق، أفلام تضمر شعورًا مخفيًّا بالنوستالجيا، يتحقق بوجود الأفراد في مجتمعات متغرّبة، وينطلق من إحاطة المرء بانفصاله عن المجتمع الألماني بشكل ما.
الإلمام بذلك الإحساس، أنك في الوسط، يدفعك إلى استكشاف ذاتك من خلال استكشاف المدينة على الجانب الآخر، وخياراتها المتاحة على كل المستويات، لذلك أفلام أكين ألمانية تعمل بآلية تنشيط الذاكرة، تكثيف الصور، إعادة إنتاج المدينة والموروث واختبار ذلك الشعور بالعودة، بالطبع أكين لا يعتصر المدينة بشكل قسري، لا يحفّز الأشياء برغبات مزيفة، فاستدعاء المدينة يعني استدعاء كلّي للعادات والتقاليد بالقدر التي يمكن للصورة استيعابه.
لكن هل أكين نفسه مؤمن بالعادات والتقاليد التركية أو يتمسّك بها؟ الحقيقة أنه لا يختلف عن أبطاله، فهو يريد أن يهجر بعض الأشياء ويودّ التمسك بأخرى، فيقول في إحدى مقابلاته مع “دويتشه فيله”، حينما سأله المحاور إذا كان يجب أن يترك المهاجرين عاداتهم ويندمجوا أكثر مع المجتمع الجديد:
“الجواب في مكان ما بالوسط بينهما. أنا شخصيًّا أعارض التقاليد، لكنني أيضًا مخلص لها. لا أقول إن كل شيء غير مناسب، لا أعتقد هذا. أرغب في الاحتفاظ بالكثير من الأشياء من التراث التركي، بعض الأشياء الأخرى لا أرغب في إبقائها لأنني لا أقبلها. وُلدت في ألمانيا، وذهبت إلى مدرسة ألمانية”.
من خلال الاقتباس، يمكننا فهم الحالة التي يصنع بها أكين أفلامه، حالة مهجّنة، ودماء مختلطة، في فيلم “حافة الجنة” يسافر البطل -بروفيسور ألماني للغة الألمانية في إحدى الجامعات الألمانية من أصول تركية- إلى إسطنبول ليبحث عن ابنة زوجة والده، فيشتري إحدى المكتبات الألمانية في تركيا ويشغّل فيها دائمًا الموسيقى الكلاسيكية الألمانية.
تلك الإشارات تعضّد من فكرة التركيب المعقد والتوليفة الغريبة لأبطال يعيشون بذاكرتَين، ذاكرة ألمانية على السطح وذاكرة تركية متخيلة، غير موجودة لكنها تستدعى وتبعث من جديد، في حال ترك البطل نفسه للمدينة وتكويناتها وتعددها.
الموسيقى
سيناريوهات أكين منغّمة، يكتبها على أنغام الموسيقى، والحقيقة أن الموضوع يتجاوز الأداة المجردة أو المحسّن البديعي، فأفلام أكين أفلام موسيقية، لدرجة أنه صرّح في أحد المرّات أن الموسيقى هي من تكتب أفلامه.
علاقة أكين بالموسيقى تتماهى بين ما هو كلاسيكي أنيق وما هو تراثي فاخر، مزيج من الثقافات التي تنزع إلى الجانب التركي أكثر من الألماني، فالموسيقى التركية الشعبية تقع موقع الذاكرة في أفلام أكين، فشحذ الصورة وصقلها بالموسيقى يمنحان طابعًا استعاديًّا للسرد، فالوجود المستمر للأغاني الشعبية وحفلات الزفاف التقليدية على الطريقة التركية، يلعب دورًا غير مباشر في العودة إلى الجذور، ليس فقط على المستوى السطحي، بل تصبح جزءًا من كلية متماسكة، وتتغلغل داخل سياق مختلف تمامًا عن سياقها الأصلي، فالمشاهد السينمائية عند أكين منغومة، تكتَب بلهجتَين؛ الأولى نوتات موسيقية وألحان غنائية، والثانية لسانية باللهجتَين الألمانية والتركية.
تخلق اللغة الموسيقية نوعًا من الحنين للهوية الجماعية، خصوصًا أنها في موقف متناثر داخل ألمانيا كأقلية مهاجرة، لكنها تستدعي الموسيقى لتؤسّس موقفًا واضحًا ومناسبات ذات صلة قوية بالثقافة والتقاليد التركية مثل الزواج، وتلك العادات والموسيقى في سياق ألماني داخلي على المستوى الجغرافي والاجتماعي، يحدثان ما يشبه الربط بين الوطن المضيف والوطن الأمّ.
تعدّ الموسيقى عنصرًا أساسيًّا في سينما أكين، لدرجة لا يمكن فصلها عن جسد الفيلم، لأنها بمثابة الهيكل الذي يوحّد الأعضاء والأطراف، إذ تعمل الموسيقى كطبقة ثانية للسرد، بل تروي بالوكالة نيابة عن الشخصيات والمخرج.
الكثير من المشاهد والأغاني، خصوصًا في فيلم “حافة الجنة”، كانت بمثابة الجسد الحقيقي الذي يحيلنا نحو دواخل الشخصيات بمنهجية أعمق وأبسط، وحتى القطعات المسرحية والرصد المقصود للموسيقى الشعبية وكلماتها كانت راويًا موازيًا نيابة عن البطل المعذّب.
فلسفة الحدود
ينطلق أكين من مآسٍ مشتركة، معاناة جمعية، أفلام الشعوب المتعبة كما يصفها البعض، تتماسّ في امتدادها مع الحدود الخارجية المتاخمة، والمهاجرين من الأجيال المتباينة، ما يجعل من المهم التطرُّق إلى فلسفة الحدود عند أكين، وكيف يتناولها في أفلامه، وكيف يتأثر بها الأبطال بشكل يتجاوز اللحظي والمؤقت، ويتحرك إلى نقطة أبعد من الحاضر.
فأكين يبني أفلامه على جماعة لها خصوصية فردية تاريخية واجتماعية، جماعة ذات هوية مزدوجة، أي أنه يفرض وجود طرف آخر في الحكاية، وفعل فرض الحدود هو أمر تقديري، لكنه ينتج على الفور الجانب الآخر، يخلق “الرحلة” التي يتعرض لها أكين كتيمة أساسية في معظم أفلامه، وخلال تلك الرحلة يتعرّف الإنسان إلى نفسه من خلال كسر الحدود.
فمثلًا، في فيلميه الأشهر “ضد الجدار” و”حافة الجنة” لا توجد عوائق لغوية بالمعنى الحرفي، يتحدث الأبطال الألمانية والتركية أو حتى الإنجليزية، كما ينتقلون بسهولة بين ألمانيا وتركيا، بحرية شديدة، إلا في بعض الحالات المعقّدة، ما يحيلنا إلى إشكالات مختلفة عمّا يتناوله الكثير في أفلامهم، إشكالية الحدود هنا مختلفة، تنطلق من أزمة اغتراب فردي في معرفة الذات ومواكبتها، فشعور الغربة، الجميع غرباء يتعرّفون إلى بعضهم من جديد، أحساس سائد في أفلامه.
فالبطل يخرج من السجن ليجدَ الوضع أسوأ ممّا كان، والرجل العجوز الذي لم يعد يتقيّد بالدين أو اللاهوت يقتل عشيقته دون قصد بسبب غروره الذكوري، والأستاذ الذي بنى منصبه الجامعي بسنوات من التعب يتحول فجأة إلى غريب، ويتخلى عن كل شيء للبحث عن فتاة أخرى.
وحتى الأرستقراطية الألمانية والعرق الأبيض يتخليان عن نزعتهما المتعجرفة ويستكشفان هويتهما في مكان آخر، مخلفَين وراءهما السلطة الأبوية، والبناء الهرمي الذي يوفّر مساحة أمان لهما كمواطنين ألمان، كل هذه حدود وحواجز تكسَر بنمط لا شعوري.
يرمي أكين ناحية الغريب، يخلق سردية “حافة الجنة” شديدة التعقيد، نمط من التلاقي بحيث يكشف الغريب جوانب من الآخر، جوانب لا يستطيع رؤيتها، حتى يتحول الآخر إلى غريب، وبهذا يتعرى أمام نفسه والعالم.
أفلام أكين بدوية في علاقتها مع الحدود، فنموذج البدو المتحررين من قيود المكان يتوافق مع مذهبه المفتوح.
وضعت موجات الهجرة الضخمة مفهومنا لألفاظ ومصطلحات مثل الحدود والوطن والأمة محل شكّ، أعادت تشكيلها وتفكيكها خصوصًا في ظل التكنولوجيا المعاصرة، بيد أن تلك الموجات ألزمتنا التفكير في هذه المفاهيم بطريقة أكثر شمولًا، فالأمر لا يتعلق بالفردية أو الذاتية، والوطن أصبح يتجاوز كونه مساحة جغرافية مسوّرة بشريًّا أو مغلقة طبيعيًّا.
تلك التحديات في تعريف الوطن والحدود أضافت كثيرًا إلى مفهوم الجانب الآخر، وفتحت مصطلح الهوية أكثر على التأويلات، ليأتي أكين ويختبر مفهومه الخاص عن الهوية والحدود، يحاول تفكيك المفهوم الهوياتي القومي القديم لألمانيا، وخلق هوية جديدة في أفلامه، لذلك يثمّن أكين منطقة الوسط، المساحة البينية، لتحرُّرها من إملاءات العقل أو الخواص الثابتة، فهي بقعة تحويلية.
كثيرًا ما ينظَر إلى الحدود على أنها خطوط مقاومة وكبح، جوهرها الاستقلال الإقليمي والمالي بالإضافة إلى الثقافة، بيد أن أفلام أكين بدوية في علاقتها مع الحدود، فنموذج البدو المتحررين من قيود المكان يتوافق مع مذهبه المفتوح، فمن حيث المكان تتماسّ القبائل البدوية في تضاريس بلا حدود مع شعوب وقبائل أخرى متجولة، لكنهم جميعًا يكفلون حرية الحركة والتنقل.
كما أنهم بشكل ما عديمو الجنسية بشكلها المتعارف عليه، لذلك مساحتهم علائقية أكثر، وممتدة بأنماط شكلانية غريبة، وهذا بالضبط ما يحقّقه فاتح أكين داخل أفلامه، الارتياب في ثنائيات معهودة مثل الشخصية والهوية، المواطن والوطن، الحدود والأجانب، المهاجرين والقوميين، اليمين واليسار، فالمجتمع المسوّر بالنسبة إليه يربّي الخوف ويقوي العنصرية.
البحر: الامتداد اللانهائي
يتحلى أكين بسمة سينمائية استثنائية عندما يتعلق الأمر بنهاية أفلامه، كما يعشق المساحات البينية في أفلامه، فلا يعيّن حدودًا جغرافية للأماكن والشخصيات، يمرر منهجيته في خاتمة أفلامه، فيوظف البحر/ المحيط كتيمة لها أثر ممتدّ على المستوى المادي والمعنوي، لا تمثل كونها قيمة جمالية، بل تتجاوز المادي لتتحول إلى خاصية سينمائية لها فاعلية موسعة وفسيحة على المستوى السردي، بحيث تتبدّى كونها مساحة ملتبسة تمثل الحافة أو الجانب الآخر.
فوجود الأبطال على شواطئ أحد السواحل، يعني بالضرورة وجود جانب آخر، بالإضافة إلى وجود البحر بهيبته ورهبته وسيولته يجمع في بطنه الكثير من التساؤلات غير المجابة، كأن ترمي شيئًا داخل البحر، بمجرد اختراقه للمياه لن تستطيع تتبُّعه، بيد أن وجوده في الداخل يغذّي الكثير من التساؤلات التي لا يمكن نفيها بأي شكل؛ هل ستحمله الأمواج إلى الشاطئ أم ستغوص إلى القاع أم سيسافر إلى البر الثاني؟
حتى الخواص الفيزيائية لا تمنح جوابًا مطلقًا لمصير ذلك الشيء، مثل أبطال أكين، دائمًا ما يهتدون في النهاية إلى البحر، حيث يقضون أمامه لحظاتهم السينمائية الأخيرة قبل أن ينقضي الفيلم وتنزل الشاشة السوداء، ما يفعله أكين هو الموت في لحظة التأمل، النهاية تؤكد عدم وجود نهاية، والحد الفاصل بين الطرفَين يؤكد على مساحة الاغتراب.
ودلالة البحر ذاته بشاعريته وقوته في الوقت ذاته تمنح خاتمة الأفلام التناقض المناسب، والشاعرية غير المبتذلة، لأن الأبطال بمجرد وقوفهم أمام البحر -خصوصًا في فيلمَي “ضد الجدار” و”حافة الجنة”- يرتقون روحيًّا، بحيث تترفع تساؤلاتهم عن الجانب المادي، ويرون في البحر الوجهة المناسبة التي يمكن أن تتحمل تلك التساؤلات والمشاعر حول الهوية والوطن والخطأ والصواب.
البحر هنا أداة تطهير، يحجّ إليها الأبطال، يرفعون كومة المشاعر وحشد التساؤلات ويلقونها في البحر، لا يعرفون مصيرها لكنهم -كما في “حافة الجنة”- ينتظرون شيئًا ما من الجانب الآخر، من البحر، ينتظرون الخلاص.