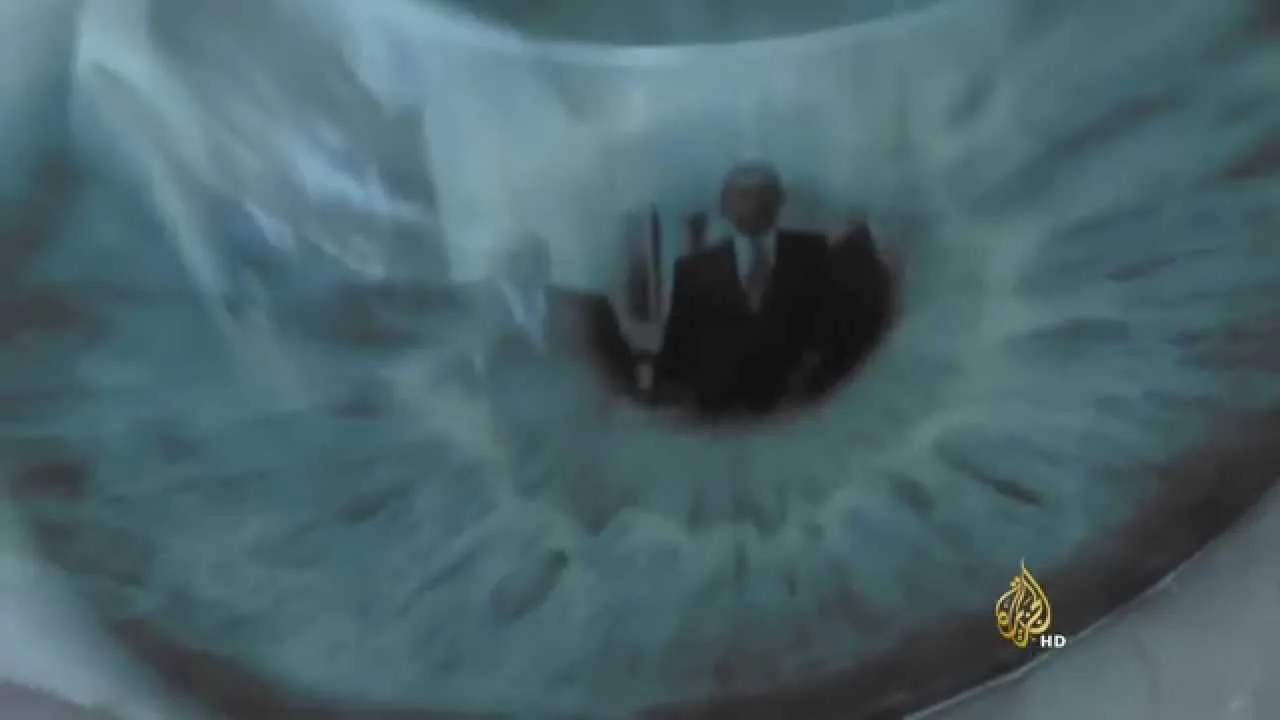صدر تقرير توقعات العقد Decade Forecast الذي تصدره شركة ستراتفور كل خمس سنوات لتتكهن بما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في شتى أنحاء العالم خلال السنوات المقبلة، وهو تقريرها الخامس منذ صدور أول تقرير عام 1996، وكان التقرير السابق الصادر عام 2010 قد تنّبأ بالكثير مما جرى خلال الأعوام الخمس الماضية، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتزايد الاضطرابات في شرق أوروبا وتفاقم الأزمة المالية الأوربية وبداية احتواء الولايات المتحدة لإيران.
هنا، نقدم أبرز ما جاء في تقرير 2015 فيما يخص القارة الأوربية.
تراجع اقتصاد ألمانيا
في خضم تزايد الفجوة بين اقتصادات جنوب أوروبا (المتوسط) وشمال أوروبا، يتنبأ تقرير إستراتفور بفشل الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الاقتصادية الأوروبية، ويشير إلى أن الخلل الرئيسي يكمن في طبيعة منطقة التجارة الحرة الأوروبية لا السوق الأوروبية نفسها، والذي ينبع من قدرات ألمانيا الصناعية وقوتها الاقتصادية التي تفوق بمراحل رغبة سكانها في الاستهلاك، مما يدفع الألمان إلى الاعتماد على التصدير بشكل كبير، حيث تقوم ألمانيا بتصدير أكثر من نصف ناتجها القومي، وهي صادرات يصل نصفها إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مستفيدة من قوانين منطقة التجارة الحرة الأوروبية التي ساهمت بوضعها، لتصبح المحرّك الرئيسي لنموها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي.
بطبيعة الحال، وبالنظر للأزمة الجارية والموجات المعادية للتقشّف المفروضة من البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، لا يبدو أن هذا الوضع مرشح للاستمرار، خاصة والقومية في صعود في كافة أنحاء القارة، من فرنسا إلى المجر، ومن الدنمارك إلى اليونان، مما سيؤدي إلى عودة الدولة القومية باعتبارها الفاعل الرئيسي في أوروبا بناءً على رغبة الشعوب المختلفة في القارة، ورُغم أن هذا لن يعني بالطبع نهاية المشروع الأوروبي برمته، إلا أنه سيغيّر كثيرًا من طبيعته، وستكون العلاقات الأوروبية محددة بالأساس عن طريق العلاقات الثنائية بين البلدان الكبرى المحركة للقارة، أكثر منها عن طريق مؤسسات الاتحاد الموجودة الآن، والواقعة تحت نقد شديد من شرائح شعبية واسعة في بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا، باعتبارها مؤسسات غير منتخبة وتعاني من “عجز ديمقراطي” مقابل البرلمانات الوطنية المنتخبة مباشرة.
من سيكون المتضرر الرئيس من هذا التحوّل؟ بالطبع ستكون ألمانيا، والتي نجح نموذجها الاقتصادي بالاعتماد على صادراتها، فالاقتصادات المرتكزة للتصدير مهما كانت قوتها، تظل أسيرة العرض والطلب بينها وبين مشتريها في البلدان الأخرى، وإذا ما تراجعت مؤسسات الاتحاد مقابل الدول القومية، فإن هذا سيؤدي إلى عودة بعض القيود على سوق العمالة ورأس المال في أوروبا، لاسيما من دول الجنوب، والتي ستحتاج إلى بناء بعض الحواجز بينها وبين اقتصادات الشمال القوية لتعيد بناء قواعدها الاقتصادية التي عصفت بها الأزمة الأخيرة، والتي تتنامى فيها حاليًا حركات اليسار الشعبوي (سريزا اليوناني، بوديموس الأسباني، النجوم الخمسة الإيطالي).
قد يقول قائل إن ألمانيا قد تجد بديلًا في التصدير خارج أوروبا، ولكن معظم اقتصادات العالم النامية، مثل الهند والصين وأمريكا اللاتينية، لا يسعها أن تستهلك بنفس القدر الذي تستهلك به دول أوروبا الأغنى نسبيًا، أضف إلى ذلك أن الألمان، وبدون مميزات السوق الأوروبية التي تعطيهم تفوقًا في السوق الأوروبية، سيواجهون منافسة شرسة من الأمريكيين واليابانيين وغيرهم، مما يعني أن السوق العالمي لا يمكن أن يعوّض ألمانيا بتقلباته وتنافسيته الشديدة عن أوروبا.
تباعًا، ستشهد ألمانيا في العقد المقبل انحدارًا اقتصاديًا بطيئًا وطويلًا، وسيؤثر ذلك بشكل جذري على أوروبا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
صعود بولندا ومعسكر شرق أوروبا
بينما تبدأ ألمانيا في الركود، ستسعى بولندا، واحدة من أفضل وأقوى اقتصادات أوروبا حاليًا، إلى تنويع روابطها التجارية نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على الألمان، وسيؤدي هذا إلى بزوغها كقوة رئيسية في وسط وشرق أوروبا، وبالنظر لعدائها الشديد للسياسيات الروسية الحالية، مقارنة بالتفهّم الألماني للموقف الروسي الذي يحتاجه الألمان للحفاظ على صادراتهم للسوق الروسية، ستقوم بولندا بلعب دور أكبر سياسيًا مع دول شرق أوروبا لتشكيل معسكر معادٍ للروس، وسيضم بلا شك رومانيا والمجر ودول البلطيق، وستسعى لتعويض الخسائر الأوروبية التي جرت على مدار العقد المنصرم لصالح روسيا، من جيورجيا إلى أوكرانيا، بل وقد تحاول جذب بيلاروسيا، حليف الروس، إلى مدارها الاقتصادي.
في هذا السياق، ستستفيد بولندا من علاقاتها الثنائية الوطيدة مع الولايات المتحدة، اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، لتستطيع تعزيز اقتصادها واقتصاد المعسكر الجديد، وكذلك الاستعانة بقوة واشنطن في احتواء الروس، أضف إلى ذلك أنها قد تستعين بها لبناء قوة عسكرية بولندية تقف بوجه موسكو، لاسيما والأمريكيين قد عبروا بوضوح عن رغبتهم في تخفيف الأعباء العسكرية التي يقومون بها في شرق أوروبا، والتي لا تملك أوروبا لها بديلًا في هذه المرحلة، فالفرنسيون والبريطانيون لا يملكون الوقوف عسكريًا في وجه روسيا في هذه اللحظة، والألمان يملكون قوة عسكرية صغيرة تحمل إرثًا تاريخيًا لن يمكّن برلين من لعب أي دور بارز، خاصة وأن الألمان أنفسهم لا يحبذون ضلوع بلادهم في أي صراعات عسكرية.
نتيجة لذلك، ستشهد أوروبا نوعًا من التصدّع بين الشرق المرتكز إلى وارسو، والجنوب المنكب على إعادة بناء اقتصاده، ودول القلب الأوروبي، ألمانيا وفرنسا بشكل رئيسي، والتي سيتحتم عليها إعادة صياغة المشروع الأوروبي بشكل فضفاض أكثر، وهي خطوات ستجد صدى بالتأكيد في بريطانيا وإسكندنافيا، الذين يرغبون أيضًا في مشروع أوروبي يعطي مساحة أكبر للدولة القومية.
بداية التصدّع الروسي
على الناحية الأخرى من القارة الأوربية، حيث يقبع العملاق الروسي ويسجّل انتصارات على المدى القصير في أوروبا الشرقية، لا يبدو على المدى البعيد أن الاتحاد الروسي سيستمر بشكله المعروف حاليًا ولأسباب كثيرة، أبرزها فشل روسيا في استغلال نمو دخلها القومي على مدار العقد الماضي، جراء استقرار أسعار النفط والغاز، في خلق قاعدة صناعية وتكنولوجية تعطيها قوة اقتصادية مستقرة، وهو ما يجعلها قوة اقتصادية ضعيفة مرهونة بتقلّبات السوق في أي لحظة، وبالتالي قد تكون عاجزة في ليلة وضحاها عن الإمساك بخيوط الاتحاد الروسي مترامي الأطراف، والذي تغذيه بشكل مستمر عبر موسكو الواقعة على بُعد آلاف الأميال، وهو خلل جيوإستراتيجي كامن في روسيا منذ سيطرتها على المساحات الشاسعة في شمال أسيا.
يقول البعض إن موسكو بالفعل تعرّضت لمثل هذه الهزات حين هبطت أسعار النفط في الثمانينيات والتسعينيات، وظهر إلى السطح عجزها عن تشغيل البنية التحتية في مناطق مختلفة ونائية، ولكن هذا لم يؤد إلى تشرذمها، فما الفرق هذه المرة؟ الفرق هذه المرة يمكن بشكل أساسي في وجود عملاق صيني على الأبواب يستطيع أن يملأ هذه الفارغ بشكل واضح، وهو دور سترحب به كافة الحكومات الإقليمية في الجمهوريات الروسية، بل وسترحب به أيضًا بلدان أسيا الوسطى، والتي ستعاني هي الأخرى جراء ارتباطها باقتصاد روسيا الضعيف بينما تنمو كافة بلدان أسيا من حولها.
في هذا السياق، سيكون ممكنًا وسهلًا، خاصة إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية الحالية، أن تقوم تلك الجمهوريات في روسيا باستغلال ارتخاء قبضة موسكو بخلق روابط اقتصادية مع الصين، وربما مع بلدان أسيوية أخرى ومع الولايات المتحدة، وبالمثل ستفعل الجمهوريات الروسية القريبة من أوروبا جغرافيًا، والتي قد تقترب من ألمانيا وبولندا وتركيا، لتخلق مع الوقت جمهوريات حكم ذاتي سيكون صعبًا على موسكو، المشغولة بالصراع في أوربا الشرقية، أن تلتفت لها.
الأزمة الرئيسية جراء تشرذم الاتحاد الروسي ستكون بخصوص ترسانته النووية، والموزّعة على مختلف الجمهوريات الروسية لتكون بالقرب من المحيط الهادي في أقصى الشرق حيث تقع الولايات المتحدة، وهي أزمة لا تستطيع موسكو أن تتعامل معها منفردة، بسحب هذه القواعد مثلًا، إذ سيكون ذلك بمثابة اعتراف ضمني بتراجع نفوذها، وهو اعتراف لن يود الروس أن يقرّوا به إلا حين يقع بالفعل، كما جرى مع تفكك الاتحاد السوفيتي، وحينها قد تكون تلك الجمهوريات من القوة بما يسمح لها برفض السيطرة الروسية على ترسانتها النووية.
تباعًا، وأيضًا كما جرى في التسعينيات، لن يحل أزمة كهذه إلا تدخل الولايات المتحدة، والتي ساهم تنسيقها مع روسيا في سحب الأسلحة النووية بشكل ناجح من أوكرانيا وكازاخستان بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وهو أمر سيكون مرهونًا بنفوذ الولايات المتحدة في هذه الجمهوريات، والذي ستحتاج واشنطن إلى تعزيزه مباشرة إذا ما بدأ يلوح في الأفق اقتراب سيناريو التشرذم الروسي، وهي جهود قد تساعدها فيها الصين، والتي لن تحبّذ هي الأخرى رؤية هذه الأسلحة وهي تمثل خطرًا على استقرارها وأمنها.
***
في المُجمَل، ستشهد أوروبا كقارة بداية ارتخاء الاتحادَين الأساسيَّين فيها، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الفيدرالي الروسي، حيث سيعود الأول إلى صيغة اقتصادية وسياسية فضفاضة تُعيد الدول القومية الأوروبية إلى الواجهة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، بينما سيفقد الثاني قدرته على بث قوته في تلك المساحات الأوراسية الشاسعة، وسيضطر إلى التعامل مع واقع جديد أكثر تشرذمًا واستقلالية، وسيركّز جهوده كلها في الأغلب في الحفاظ على موقعه في شرق أوروبا قبل أي شيء.
البلدان الأبرز التي ستتأثر من هذه التحولات الأوروبية ستكون ألمانيا، والتي من المتوقع بداية انحدار قوتها، وبولندا، التي ستسجل صعودًا في قوتها على مستوى القارة ربما غير مسبوق في تاريخها، وكذلك تنامي أهمية الدور التركي، والذي قد تحاول دول شرق أوروبا الاستعانة به لتعزيز اقتصاداتها، ولتوطيد سياسات احتوائها للروس.
ما إذا كانت تركيا ستستطيع لعب هذا الدور، بالطبع هو أمر يعتمد على استقرارها الاجتماعي والاقتصادي، وتفرّغها عسكريًا لأي تحالفات إلى شمالها وغربها، وهي مسألة مرهونة بالطبع بما يجري في جوارها المباشر في الجنوب والشرق، وهو ما سيناقشه الجزء الثاني من هذا المقال.