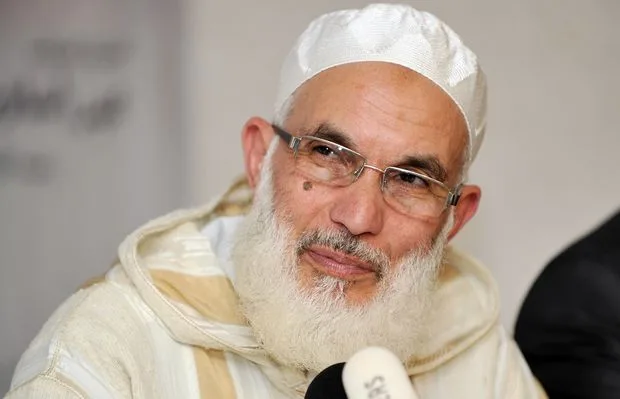لم تكن الفلسفة زخارف ملونة نتأمل ونلتمس جمالها؛ بل هي مادة تثقيفية تم تشكيلها لمساندة العقل الإنساني على الفهم والتبصرـ فهي ليست صورة خيالية للتسلية، فمن هذه النظرة يساء العمل بها فلا تعد تعتبر عملية ومجابهة للواقع، أما إذا تعاملنا مع الفلسفة كأسلوب حياة، حينها يبدأ الحراك العقلي بالتكون والتفاوض بحيث يعزز مسؤولية الفرد أمام الحياة، ويخلق الوعي الذي ينشأ بين الجماعة في سبيل الحرية والقيم الاجتماعية والأخلاق، فمن الحركات العديدة التي نشأت على يد الفلسفة خُلقت الحركة الوجودية المنتمية للقرن العشرين على يد سارتر، إبان انتهاء الحرب العالمية الثانية التي أرعبت العقول وشكلت بعد انتهائها حركة الوعي لدى المثقفين الطامحين إلى إعلاء المجتمع والتحرر من القيود التي ساهمت في تنميط الحراك الجمعي الذي أدى استلاب عقله إلى الانخراط مع الحشود فنتج منه الكسل الفكري والتلاعب بالوعي وأدلجة العقل على نحوٍ نسقي.
نشأت فكرة العقل والثورة لتحرير المجتمعات؛ التي ارتبط وجودها بسلطة سياسية أو دينية، ومن هذا المنطلق يجب الفهم أنه ما من عبودية إلا واقترنت بحركة تحرر تهدف إلى تحرير الفرد من الأضرار التي جعلت من وجوده العقلي والاجتماعي أحاديًا، إلا أن تأثير الرأي العام وصدى الحشود أدى لتدهور كثير من الجماعات الإنسانية عقليًا واجتماعيًا، كما يؤكد الفيلسوف سيناك “العلامة الدالة على الأسوأ هي إجماع الحشد”، بحيث أن مبدأ الوحدة الجماعية قد لا يكون بشرط حراك إيجابي وهدفًا خالصًا للتحرر والاستقلال، فالرأي الجمعي قد يؤدي إلى هلاك كثير من الجماعات المختلفة التي يلحق بها الضرر، كما أن الرأي الجمعي لا يؤدي في النهاية إلا إلى الكسل الفكري الذي لا يقود الحشود إلا إلى العدم الذي لا حراك ينتج منه سوى بطريقة آلية، هذا التلاعب العقلي، التلاعب السلبي هو ما أدى بقيمة الإنسان إلى الانحدار والذي أسهم في إشعال الحروب التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء في سبيل أهداف سلطوية، أو دينية، كالحرب العالمية الثانية التي وقع ضحاياها أكثر من 60 مليون قتيل، وهذه الفكرة لا تعتبر إطارًا حديثًا بل هي فكرة تاريخية قديمة نشأت منذ بدء الحروب الدينية التي كانت نتاج مسيحي اتخذته كثير من الديانات لاحقًا في بناء أطراف معادية، وفرق يقودها جمهور متطرف كالحركة الداعشية في العصر الحديث التي اتخذت الدين ظاهرًا لها بينما الجوهر هو الهدف السياسي لمسيرتها الدموية، إلا أن النظام الجمعي ليس سلبيًا دائمًا على كل حال، فهو البناء الذي يرمز إلى القوة البشرية الجمعية وهو ما جسد بحركة أيديولوجية فكرة “القومية العربية” التي قامت على أساس (اللغة، حدة المصير، والحرية الدينية) والتي نشأ منها التيار البعثي عام 1947، واكتسبت شعبية كبيرة خلال القرن الـ 21 في “الربيع العربي” والتي بُرغم أهدافها السامية لم تحقق وحدة عربية متكاملة.
تأثير الرأي العام وصدى الحشد هو الذي أدى إلى استلاب العقل الإنساني وهو مصطلح يعني بوجهٍ عام فقد الإنسان لحريته واستقلاله الذاتي فيكف على أن يكون ملك نفسه، وهذه المهمة التي تأثرت بالسلطة السياسية والاقتصادية والدينية لم تُخلق عن طريق الخطب وأهداف الوهم الجمعي فقط، بل أصبحت هدفًا مستمرًا في الحياة اليومية للإنسان في العالم الحديث عن طريق الإشهار أو الإعلان كما نسميه في وقتنا هذا، من هنا بدأ التلاعب بالوعي الذي جعل من الجماعة تسير على نظام استهلاكي وإنتاجي واحد تفقد معها القدرة على التمييز بين الحاجة وفائض الحاجة، وبين القيم السائدة والقيم الصحيحة، وبين ما هو أجدر بالاعتبار كالحرية الدينية، والاستقلال الفكري، كما أنها وعن طريق أدلجة العقول صنعت من الفكر مادة يسود فيها الخاطئ وينتشر بدون تمحيص وإدراك من العيون في الأخبار التي تحتاج النظر والمساءلة، وبرغم التراث الغني أهملنا العقل حتى سادت النسقية والرأي الخاطئ في المجتمع الذي يُقدر تراثه الشرقي أكثر في الغرب، فأهملنا قاعدة المؤرخ ابن خلدون التي تقول: “علينا إعمال العقل في الخبر”، حتى باتت مفاتيح المعرفة صدئة لا تفتح باب العقل العربي الحديث.
من البدء حين نقول للرأي الآخر كلمة “لا” نخسر قضية الحرية، ونقوم “بأدلجة العقل”، فمفهوم الأيديولوجيا Ideology نشأ في عصر التنوير الفرنسي على يد دي تراسي De Tracy ويقصد به علم الأفكار، يقاس به مدى الصح من الخطأ بأدلة عقلية ونظريات تلائم الفرد في المجتمع، فهي في الأخير أداة توضيح هادفة تشتمل على نظام فكري شامل يحدد الأمور ويؤثر في سلوكياتها ومعناها، ويقسم كارل مانهايم Mannheim الأيديولوجيا إلى مستويين: المستوى التقويمي الذي يعني ببناء الوعي والأفكار، والمستوى الدينامي الذي يقيس الأحكام عن طريق الواقع، وكمثل ما ترمز الأيديولوجيا إلى بناء الأفكار وجريانها لمساعدة الفرد، فهي تشير أحيانًا كما ذكرنا إلى التفكير الخاطئ الذي يؤدي إلى الوعي الزائف وبه الوجود الزائف الذي يصل بالفرد إلى النمط التفكيري السائد، ولا يتوقف دور الأيديولوجيا هنا، فهي تفسّر أيضًا على نمطين بحسب مانهايم: الخاصة التي تتعلق بالفرد وردات فعله، والكلية التي تسود في نمط تفكير طبقة اجتماعية كالبروليتاريا – الطبقة العاملة- وبهذا فإن حيز هذا المفهوم واسع ويتنوع بحسب الطبقة أو الجماعة التي تحمل معناه فهو منظومة فكرية، تحدد بأفكار أفرادها وتوضح سلوكياتهم السياسية والاجتماعية بطريقة شاملة، وهي قادرة على الإصلاح الاجتماعي عن طريق نسق الأفكار وتطبيقها، وهي بلا شك قابلة لتغير.
إن الاستلاب الفكري أدى باستمالة الإنسان إلى الكسل العقلي حتى باتت المغالطات حقائق يؤمن بها الفرد بدون أدلة عقلية تسعى إلى التفسير والتطور، فهذه الآفة نشأت قديمًا حين آمن البشر أن الأرض مسطحة كقرص صلب عائم في الأوقيانوس – المحيط بحسب الميثولوجيا الإغريقية – كما جاء في الكتاب المقدس حتى تطور العقل البشري وخرج من إطار الأدلجة الدينية ليرى أن نموذج شكل الأرض كروي وهي فكرة بدأت في علم الفلك في القرن السادس قبل الميلاد على يد عالم الفلك اليوناني فيثاغورس وانتشرت في العالم، فالإنسان لن يصل إلى ملكته الفكرية إذا ما بات أسير المجتمع، وسجين تلك الأغلال التي تقيد العقل عن التأمل والإدراك، فإذا فقد العقل وسيلة الإحساس يكون بذلك أصدر الحكم على نفسه بأن لا يستدل في المعرفة على أي إجراء عقلي، وبهذا يكون العيش نمطي، ويكون الشعب المتأخر في أفولٍ وعدمٍ فكري، من هنا نشأ الفكر النيتشوي في القرن العشرين متخذًا أسلوب فلسفة المطرقة على رأس كل عقل إنساني ليخلصه من كل معتقد سائد لا يقوم على ثبات عقلي، هادمًا كالإعصار الرأي الذي لا يزال يصدر من رأس النعامة في الأرض التي لا تدري ما يجري حولها، وهو بذلك يقشع قتامة التفكير النمطي ليحلق به نحو سموٍ كامل ونحو تفوق إنساني متنوع ومتطور.
“لنفترض أن إنسانًا كان يعلم دائمًا أن بإمكانه أن يطير، وأنه اقتنع في النهاية بأنه يستطيع ويعرف كيف يطير، وأن ليس في ذلك امتياز فقط، بل فيه سعادته الخاصة والمحسود عليها جدًا، إن هذا الإنسان الذي يؤمن أن بوسعه أن يحقق بفضل اندفاعةٍ خفيفة كل أشكال الانحناءات والاستدارات، والذي يخبر الإحساس بخفة إلهية ما، الذي يعتقد أن بإمكانه أن يعلو دون ضغط أو إكراه، وأن يهبط دون تنازل أو ذل، هو الغريب عن الجاذبية، كيف لا يمنح هذا الإنسان الذي يعرف مغامرات وعاداتٍ مماثلة في الحلم، لكلمة سعادة حتى في حالة اليقظة، لونًا آخر ومعنى آخر، كيف لا تكون له طريقة مغايرة في اشتهاء السعادة؟ ومقارنة مع هذا الطيران، سيبدو له بلا ريب، أن التحليق الذي وصفه الشعراء أرضيًا، إراديًا وثقيلًا بإفراط”، ما وراء الخير والشر، فريدريك نيتشه.
حتمًا إن إفلاس التعليم كما سماه جول بايو هو مصير الانحدار الذي وصل له الإنسان ذو العقل المؤدلج، فما يجب الإيمان به هو أن “سبات العقل يولد مسوخًا”، كما يقول الفنان فرانسيسكو غويا بحتمية مطلقة، مشيرًا إلى أن السبات لا يشرك الإنسان في شيء، وإنما الحرية والتعقل، ففي الأخير “المعرفة قوة” كما يذكر الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو/ فما الذي نحتاجه إذًا كي نصل إلى إنقاذ أنفسنا من أزمة الفكر العربي؟ ألا يعد مسمى “الثورة الثقافية” هو بِدء لنهضة يترتب عليها دراسات وتحليلات للوضع الاجتماعي المعاصر؟ إن جزء من هذه الفكرة يهدف إلى بناء منظومة حضارية وتطويرها فكريًا وثقافيًا من دون تمييز، ونشر الدراسات والاهتمام بالمكتبات والجامعات ورفع مستوى التعليم ومن ثم فقط! قد نجد ما نسمو إليه بعد عقدين من الزمان وحينها يتحرر العقل العربي من كل أمراضه، أما هذا المسمى، مسمى “الثورة الثقافية” لن يفعل شيئًا سوى أن يعلي من شأن النهضة ويقمع الاستبداد.
قد تكون الأطروحات والرسائل الفلسفية خير مثال على بناء النفعية والوعي في المجتمعات، كما أنها خير مساعد لعقل الفرد على إبصار الحقائق التي حوّلها المجتمع إلى قوانين وأنظمة يساق بها العقل الجمعي، كما أن كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي يُعد من أهم الكتب التي يجب تدريسها في كل منظمة تعليمية لما به من مخزون فكري وسياسي لأوضاع الماضي والحاضر السياسية الرديئة، فالعقل هو المصدر الوحيد للحرية والمعرفة وهو قوة بشرية هائلة، إذا ما تم توظيفها بشكل صحيح برزت وتميزت، وإذا ما تم توظيفها بشكل نمطي مالت واندثرت، وبهذا الاندثار والسلطة على العقل البشري سيؤدي بنا الأمر إلى حملنا أسماء لا يبقي لها التاريخ أثرًا، وستستمر جماعاتنا بالتكاثر البشري الذي لا يُعوّل عليه في الأخير ولا يؤدي إلى قيمة، وسنغدوا كمن تنبأ بهم الفراعنة قديمًا في كتاباتهم “لقد دنت نهاية العالم إذ فسد الجيل الجديد وفقد قيمه”، أما القول الصادق، القول الذي سيؤدي إلى تعطيل الأيدولوجيا العقلية الهدامة هو “الرأي” و”الاستدلال” و”الثورة الفكرية”.