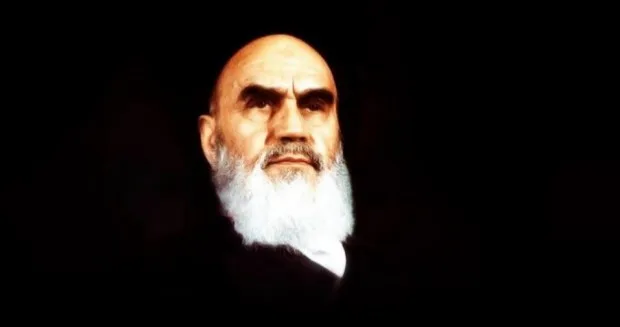ترجمة: محمد زيدان
تواصل معي قبل بضعة أيام محرر إحدى الصحف، وطلب مني كتابة مقال يوضح لماذا لم تتحول الثقافة الإسلامية إلى العلمانية كما حصل مع الثقافة المسيحية الأوروبية.
ولا بد أن أقول إن إجابة أي سؤال يتعلق بالعلمانية في “الثقافة الإسلامية” لن تكون ممكنة إلا من خلال التعرض أولًا بالنقد والرد لعدد من الأفكار المسبقة التي نجدها عند الكثيرين منا، ذلك أن السؤال يكرر افتراض وجود مكون مسيحي أوروبي متمايز، جرت عليه عملية العلمنة، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.
باختصار:
– يظهر أن الغالبية الساحقة من الأوروبيين يقبلون تحكم الدولة بالدين وإدارتها له في المجال العام.
– المسلمون مطالبون من جهة بقبول قيم التحرر الأوروبية، إلا أنهم يتعرضون بالمقابل إلى الرفض المستمر ويُنظر إليهم دومًا على أنهم أشرار أو مشتبه بهم.
– المسلمون متهمون حتى تثبت براءتهم، وعليهم دومًا أن يثبتوا ولاءهم للنهج الأوروبي، ولكن من الذي يا ترى سيكون الحكم في هذا الاختبار؟
هذه الأسئلة تٌطرح باستمرار في السياق الأوروبي العام، وجميع وسائل الإعلام لا تنفك تطالعنا بأمور لتفحص مستوى تماشي الإسلام مع القيم الليبرالية والعلمانية، هل يمكن إصلاح الإسلام؟ هل يمكن أن يتسق مع قيم العلمانية في المجتمعات الأوروبية؟ هل المسلمون قادرون على الاندماج في أوروبا؟ ألا يستطيع المسلمون تحمل المزاح؟
غير أن هذه الأسئلة خاطئة، وينبع خطؤها من فشلها في تحديد، عدا عن تعرية، إطار الهيمنة الذي تُطرح هذه الأسئلة ضمنه، هذا الإطار الذي يقيس مدى انسجام المسلمين مع قيم النظام الليبرالي العلماني.
إنها الأسئلة الخاطئة لأنها تتنكر للعديد من السياقات الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، والثقافية التي يعيش المسلمون إسلامهم ضمنها ويفسرونه وفق تأثيراتها، كما أنها ليست الأسئلة الصحيحة لأنها تستدعي إجابات من شأنها أن “تستثني” المسلمين أو تحكم بأنهم “غير مختلفين”.
ما أريد أن أقوله هنا ليس بالأمر الجديد، فقد توصل إليه العديدون قبلي، ولكن يلزم تكراره؛ لأن هذه الأسئلة وأمثالها تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتشكيل النقاشات العامة بخصوص المسلمين في أوروبا، ومن هنا تنبع أهمية تكرار النظر في وظيفتها والآثار التي تترتب عليها.
عادة ما يظهر الإسلام على أنه فاعل بذاته أو كأنه شخص قائم في مكان ما، ويتم التعامل معه على أنه أمر ناجز ومكتمل، وعليه فإنه يخضع للإقصاء الرمزي، لهذه الأسئلة طريق واحد لا غير؛ إنها تنزع الصفة السياسية عن قضايا مبدئية وتوجه اتهامات من طرف واحد لتقول، ما مشكلة الإسلام؟
وحتى لو تقدمنا بإجابة غير سلبية وقلنا إن المسلمين في أوروبا يمضون قدمًا نحو العلمانية وأن معظمهم ينسجمون مع قيم النظام الليبرالي العلماني، إلا أن الطريقة التي طرحت بها الأسئلة لا تنال نصيبًا وافرًا من التحليل.
في الحين الذي نرى السياسيين فيه يدّعون بحماسة بالغة أن “الإسلام جزء من أوروبا” لا يلحظ الكثيرون تلك السمة الأبوية للسياسة المعاصرة المتعلقة بالإسلام هناك، فهذه الحفاوة تنضوي على الفكرة التقليدية التي تدعو إلى ضرورة التعامل مع المهاجرين باعتبارهم ضيوفًا، فبالرغم من الترحيب بهم إلا أنهم لا ينفكون عن كونهم مجرد ضيوف عابرين.
أضف إلى ذلك أن هذه الفكرة القائلة بأن الإسلام جزء من أوروبا عادة ما ترتبط بعدد من الشروط، إذ يبدو المسلمون أنهم ضمن برنامج إطلاق سراح مشروط وأن عليهم إثبات ولاءهم للأسس التي قامت عليها أوروبا، ولكن كيف يمكن أن يكون للشخص ولاء لأمر هو في ذاته متضارب وهش ومتغير؟ ومن ذا الذي يحق له يا ترى التقرير بشأن هذا الولاء؟ إن الأمر أشبه باتخاذ قرار حول من يمكنه أن يشارك، ومتى يشارك وكيف يشارك.
تجلى هذا الأمر بوضوح بعد هجمات باريس، فقد انتشر في البداية شعور بالتكاتف حين قام المسلمون منظمات وأفرادًا باستنكار الإرهاب الحاصل باسم الإسلام، ولكن بعدها بوهلة بدأت المطالبات من المجتمع الفرنسي بضرورة تبني الأسس الليبرالية للنظام العلماني للبلاد.
لم يكن استنكار الإرهاب والعنف كافيًا ليحصل المواطن المسلم على اعتراف بأنه عضو كامل العضوية في المجتمع، ويبدو أنه لن يتم الاعتراف بالمسلمين كأعضاء كاملي العضوية في مجتمعهم إلا إذا اتسق تدينهم مع بعض الأفكار المتعلقة بالتدين المعلمن وأن يكون هذا الأمر على رؤوس الأشهاد، كأن يهتفوا في الشوارع مثلًا قائلين: “أنا تشارلي”.
الأمر الإشكالي الآخر هو أن يُطلب من المسلمين تبني قيم الليبرالية الأوروبية في حين يتم التعامل معهم بالرفض والشيطنة والاتهام، والنظر إليهم على أنهم في حاجة ماسة للإصلاح، هذا هو التناقض التقليدي التي تنضوي عليها عملية الدمج هذه والتي تتمظهر في مسألة “مسلمو أوروبا”.
هذا الشكل من الرفض بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية المتدنية أمران يشعر بهما المسلمون، خاصة أولئك الذين يظهرون ممارستهم للإسلام في المجتمع، وفي حال استمرت آليات الإقصاء البنيوية هذه من دون الوقوف عليها وتعريتها، فإن المبادئ المتعلقة بالاندماج في المجتمع ستبقى عناصر في مشروع حضاري شعاره “كن مسلمًا ولكن ابق بعيدًا عن أعيننا”.
حتى هذا الحديث الذي عاد إلى الساحة مجددًا عن “الإسلام الأوروبي” يعود بنا عند تفحصه إلى النقطة ذاتها، “كن مسلمًا ولكن على طريقتنا”، أي “كن كما نود نحن أنفسنا أن نكون”.
هنالك جانب آخر لهذا الاستجواب الذي يخضع له المسلمون من طرف واحد، إنه يجعل من الممكن بعث الحياة مجددًا في نزعة كونية كانت قد علقت خضم أزمة كبيرة، لا بد أن يتضح تمامًا أن العلاقة التي تربط السياسة بالدين في أوروبا أكثر تعقيدًا مما قد توحي به فكرة العلمنة للوهلة الأولى.
إن العلمنة كأداة رسمية تستهدف فصل الدولة عن الدين هي أمر كان وما يزال يشوبه الكثير من التعقيد والتضارب، ذلك لأنها تقوم على وجود خط يتم رسمه بين مساحات السياسي والديني، والقضية هنا هي أن مثل هذه الخطوط لا يمكن أن تكون محايدة ولا ثابتة كما أنها تقوم على هرمية من نوع ما، إنها خطوط تعج بالافتراضات التي لا تنتهي كما أنها تتسم بالحركة والديناميكية.
لذلك علينا أن نسأل كذلك عن سبب تكرار هذه القصة عن المسيحية المروَضة والمعلمنة، والتي يفترض البعض أن تكون نموذجًا يمكن للإسلام أن يسير على هديه، خاصة حين يكون “الآخر” معنيًا بالأمر، مع أن هنالك العديد من الخلافات العميقة التي تتعلق بالأسس التي قامت عليها أوروبا والقيم السائدة فيها.
إن الفكرة التي يطرحها جيل أنيدجار بأن أوروبا قد شكلت وعرفت نفسها من خلال استحضار الآخر اليهودي أو المسلم على أنه الخارجي أو العدو الداخلي قد توضح الكثير مما أرمي إليه هنا.
لا بد أن نستمر في انتقاد الخبث التي تنضوي عليه هذه الأسئلة، علينا أن نغير وجهتها، وأن نظهر كيف أن السؤال المتعلق بالمسلم يشير بالضرورة إلى أسئلة أخرى، ما الاحتمالات والفجوات التي يمكن أن نعثر عليها في المبادئ والقيم التي تمثلها أوروبا؟
ما وظيفة عملية الاستجواب هذه التي يخضع لما المسلمون باستمرار ليجيبوا على الأسئلة ذاتها التي لا تتغير؟ وكيف لهذه الأسئلة أن تشكل الظروف الذي يكون فيه الكلام ممكنًا؟ ما هي أشكال العنف السياسي والمعرفي التي ترتبط بمثل هذه الدعوات وآليات الإقصاء التي ترتبط بها؟ إلى أي مدى ينجح تكرار هذه الأسئلة في إخفاء هذه الأنماط من التحكم والسلطة؟
إن السؤال لن يكون متعلقًا بإنشاء الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي سافر خلالها المسلمون إلى أوروبا، فالماضي الاستعماري لا يمكن أن يخفى على أحد ولا يمكن استثناؤه من هذا النقاش، علينا كذلك أن نسأل عن مقدار الارتباط الوجداني هناك بقيم الليبرالية والعلمانية، التي يفترض أنها توفر منظومة محايدة منصفة حين يُسأل المسلمون عن إمكان الاندماج لديهم في المجتمع الأوروبي.
في كل مرة يطرح فيها السؤال المشروع عن السبب الذي يدعو الناس إلى ارتكاب الجرائم باسم الدين لا بد أن ننظر بجدية أكثر إلى تلك العلاقة بالعلمانية، التي ترتبط بحد كبير بالعاطفة والتجسد الواقعي لها.
لا شك في أن الكثير من المسلمين المتدينين قد شعروا بالإهانة بسبب الرسوم التي انتشرت، إلا أنه يلزمنا كذلك أن نفكر بجدية أكبر بالمكونات العاطفية المرتبطة بالأفكار العلمانية وتمثلاتها في أوروبا.
إن العلماني، وإن بدا هنا تناقض في هذه العبارة، صار أمرًا مفترضًا إلى الحد الذي بات فيه معظم الأوروبيين يقبلون تحكم الدولة بالدين وتنظيم شؤونه في المجال العام من دون أية تحفظات، يظهر ذلك في النقاش الذي لا ينقطع حول ممارسة المسلم لشعائره في الأماكن العامة أو المؤسسات التابعة للدولة في أوروبا، وفي كل مرة ينجم عن هذه النقاشات مشاعر متباينة بين السخرية والمقت، أو الكراهية العلنية لهذه الأشكال الشاذة من التدين.
إن هذه القضية المتعلقة بمركب علماني عميق يدعونا إلى توسيع مداركنا، والتوقف عن طرح الأسئلة على المسلمين من طرف واحد لنعرف رأيهم عن الدين في دولة علمانية وفق حكم القانون، وأن نبدأ التعامل مع التمظهرات العلمانية على أنها مواقف مكتسبة أو مفروضة على شكل ممارسات وتعلقات وجدانية لا نعيرها اهتمامًا بسبب طبيعتها الكامنة، إن توسيع مداركنا بهذه الصورة لا يفترض بالضرورة انتقال اللوم من طرف إلى آخر، ولكنها تجعل أي نظر وتجاوب مع القضية أكثر تعقيدًا، نظرًا لزيادة التعقيد في الأسئلة.
وهكذا لن يكون السؤال عن إمكانية اندماج المسلمين في “أوروبا متخيلة”، بل سيكون علينا أن نسأل من جهة أخرى عن إمكانية المؤسسات والقيم والمبادئ الأوروبية على التأقلم مع الواقع الذي يفرض تعددية دينية وثقافية لا مفر منها.