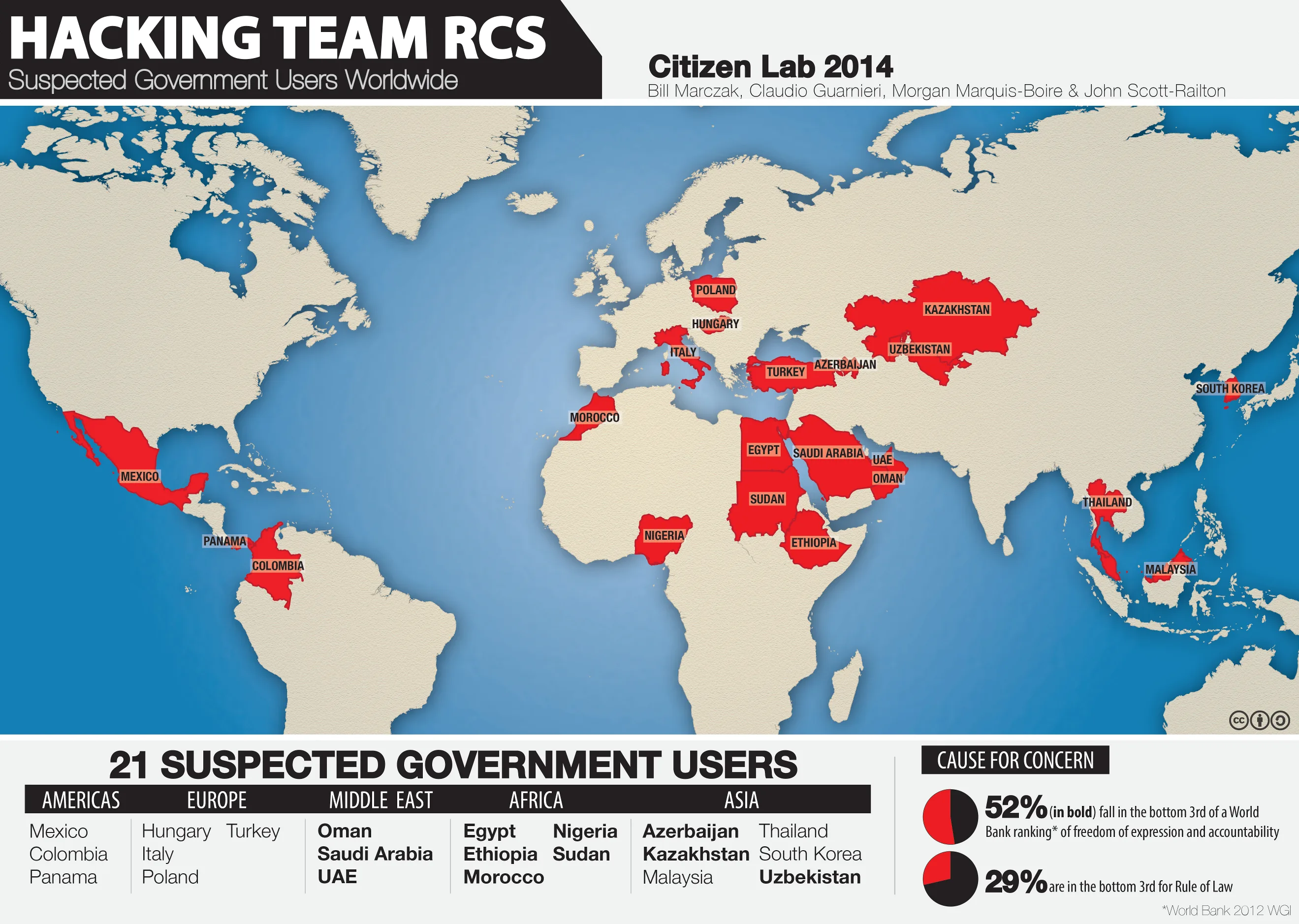تشهد نُظُم إنتاج السياسات بروزًا مُطّردًا للخبراء أو التقنيين (التكنوقراط) الذين باتوا في قلب العملية السياسية في العالم، والذين عادة ما تجمعهم غرف التفكير “think tanks”، في حين يتراجع حضور ما يُعرف بالمثقف العضوي وهو ما يُمثل عملية تحول عميقة في عالم صناعة الأفكار السياسية.
وفي الحقيقة، لا يمكن الحديث عن هذا التدافع بين المثقف العضوي أو السياسي الكلاسيكي وبين الخبير التقني (بمختلف المجالات) على أنه وليد هذه الأيام، فبالرجوع إلى دفاتر التاريخ نجد أن التكنوقراطية (أو التقنقراطية) ككلمة أصلها يوناني وتتكون من كلمتين هما تِكني وتعني “فني وتقني” وكراتُس وتعني “سلطة وحكم”، وباعتبارها شكلاً من أشكال الحكومة، تعني حرفيًا حكومة التقنية ويقال حكومة الكفاءات؛ وبناء على ذلك فإن الحكومة التكنوقراطية تتشكل من الطبقة العلمية الفنية المثقفة، وهي حكومة متخصصة في الاقتصاد والصناعة والتجارة، غالبًا تكون غير حزبية فهي لا تهتم كثيرًا بالفكر الحزبي والحوار السياسي.
والتكنوقراطية في العالم الحديث هي حركة بدأت عام 1932 في الولايات المتحدة، قادها مهندسون ومعماريون واقتصاديون ومشتغلون بباقي العلوم وطالبوا عبرها بقياس الظواهر الاجتماعية واستخلاص القوانين التي يمكن استخدامها للحكم عليها (الظواهر)، واعتبروا أن تفاصيل النظام الاجتماعي هي أعقد من أن يفهمها رجال السياسة وبالتالي يجب أن تخضع إدارة الشؤون الاقتصادية للعلماء والمهندسين، وكانت هذه الدعوة نتيجة طبيعية لتقدم العلوم والتكنولوجيا.
بوادر التحول وظهور التقنيين
نحن الآن في يونيو 1979، في إحدى المحاكم الفرنسية أين يقف اثنين من أكبر مثقفي تلك الفترة،رايموند آرون وجون بول سارتر، في نفس الزاوية للدفاع على قضية لاجئي القوارب الفيتنامية الهاربين من الحكم الشيوعي الذي يقوده هانوي عبر ركوب البحر.
مثل هذا المشهد الذي يجمع مؤسس صحيفة ليبيراسيون وكبير محرري لوفيغارو، والذي يصور رجُل اليمين مع رجُل اليسار يخوضان نفس المعركة رغم اختلافهما الفكري الحاد لا يمكن إلا أن يطرح عديدًا من الأسئلة التي تحاول تفكيك هذا النشاز لنجد الإجابة فيما قاله سارتر: “حتما لم يكن لي أصدقاء فيتناميون أثناء خوض الفيتنام صراعها من أجل الحرية، إلا أن الإيمان العميق والمبدئي بحقوق الإنسان يفرض علينا أن نتناول المسألة من تلك الزاوية الأخلاقية”.
وقد مثل هذا الحدث المنسي نقلة نوعية باعتباره كرّس أن الدفاع عن حقوق الإنسان يتجاوز الخلافات الأيديولوجية التي صبغت العلاقة بين الفكر والسياسة في عصر الحرب الباردة، أيام كان المثقفون يخوضون في الشأن العام بناءً على مواقفهم الرافضة للاشتراكية أو الرأسمالية وبناءً على موالاتهم لأحد المعسكرين.
ورغم تواصل حالة التصارع الأيديولوجي في أيامنا هذه، إلا أن أغلب المثقفين يجتمعون حول تمسكهم بالمثل الديمقراطية وهو ما سمح بظهور أطروحات جديدة في عالم الأفكار مثل ما يطرحه “التكنوقراطيون” وإن كان أقل بريقًا، مستفيدين من وضع ما بعد سقوط النموذج الاشتراكي الذي خفف من جرعة التعاطي الأيديولوجي للملفات لفائدة البحث في أنجع سبل إدارة المجتمع الديمقراطي؛ وهو ما فتح الباب لمصراعيه لصعود نجم غرف الخبرات أو think tanks كمزودات أفكار لأصحاب القرار السياسي.
بنوك الفكر ومراكز التقنية
وفي الحقيقة، تُترجم عبارة think tanks إلى اللغة العربية بصور مختلفة؛ فهناك من يترجمها إلى مراكز التفكير وهناك من يترجمها إلى بنوك الفكر أو بنوك التفكير، ولكن في الغالب يُستخدم تعبير مراكز الأبحاث والدراسات، للإشارة إليها وذلك لأن معظم المؤسسات أو المراكز التي تقع تحت القطاع المذكور لا تعرف نفسها في وثائق تعريف الهوية الذاتية.
وفي اللغة الإنجليزية، وحتى الأربعينيات من القرن العشرين، عُرفت أغلبية think tanks باسم المؤسسات أو مراكز الدراسات والأبحاث، وأثناء الحرب العالمية الثانية استخدمت عبارة brainbuxes أو صناديق الأدمغة في اللغة العامية في الولايات المتحدة للإشارة إلى هذه المراكز، كما استُخدم نفس التعبير زمن الحرب للإشارة إلى الغرف التي ناقش فيها الإستراتيجيون التخطيط الحربي.
ويرجع أول استخدام مدون لعبارة think tanks إلى الخمسينيات والسبعينيات؛ حيث استخدمت هذه العبارة بشكل عام للإشارة إلى مؤسسة راند وإلى المجموعات الأخرى التي ساعدت القوات المسلحة الأمريكية في مرحلة أولى ثم توجهت للخوض في باقي المسائل الداخلية؛ في الوقت الراهن، تستخدم العبارة بدرجة كبيرة للإشارة إلى مؤسسات إعطاء النصح.
نحو ديمقراطية الخبراء
وفي فترة لاحقة، شهدت ديمقراطيات العالم هيمنة مجموعات الخبراء على المنظومة البرامجية داخل الأحزاب، ليتم الانتقال تباعًا لمرحلة مؤسستها وإخراجها من الدوائرالداخلية للأحزاب وتعويض ذلك من خلال التعامل معها كشركات ومؤسسات تقدم خدمات مدفوعة الأجر بمنطق المُناولة أو المقاولة الفرعية.
ففي أيامنا هذه، يستنجد الساسة المنتخبون المشغولون بإدارة نفوذهم بالخبراء لإعداد برامج عملهم وهو ما يرى فيه البعض علامة أزمة تعيشها الأحزاب السياسية بل الديمقراطية ذاتها، ويُؤذن بنشوء ما يُطلق عليه بعض علماء الاجتماع “ديمقراطية الخبراء” والتي تشهد مناهضة تنبع من تعارضها مع مبادئ المعرفة المفتوحة أو الشعبية وأيضًا مع مشاركة الشعب بمختلف فئاته في الحياة السياسية.
فحسب دافيد أيستلاند، يمثل تعاظم نفوذ الخبراء أو التكنوقراط خطرًا باعتباره يمنحهم تدريجيًا حصريّة التفكير؛ ما يهدّد بنشوء نخبة جديدة تحتكر إنتاج الأفكار والمعرفة ثم السلطة في إقصاء تام لباقي الشعب من دوائر الفعل الحقيقي في الساحة السياسية وهو ما يتعارض مع جوهرالديمقراطية.
كما أن مجموعات التفكير هذه أصبح يُنظر إليها على أنها اللسان الناطق باسم الأيديولوجيا المهيمنة في العالم وأنها حاضنة لعرابي النظام النيوليبرالي الذي يثير دائمًا مشاكل للتوازن الديمقراطي، ومما تلام عليه مجموعات الخبراء هذه هو تماهيها الآلي مع توجهات النفوذ السياسي والاقتصادي بحيث إنها تُدفع لشرعنة خيارات سياسية عبر العلم دون أدنى تفكير.
في الجهة المقابلة، برز تيار فكري يقوده باحثون في علم الاجتماع النقدي حاول إعادة تشكيل المعرفة حتى يكون سلطة أو نفوذًا مضادًا، وكان الهدف أن يتم تسليح أكثر ما يمكن من المجتمع بالآليات العلمية التي تساعد على النقد والفعل.
ومهما اختلفت المقاربات السياسية وأشكال التأثير في النقاش العام، من المهم التأكيد على أننا إزاء نقلة نوعية يشهدها عالم الأفكار السياسية، في السابق وخلال حقبة الحرب الباردة، استأثرالمُثقفون بالشأن العام وخاصة الفلاسفة والمؤرخين الذين انحصرت مهمتهم في تقديم تصورات عامة إما اشتراكية أو ليبرالية حول السياسة والتطور؛ أما اليوم، يشهد المثقف منافسة من الباحث أو الخبير التقني وخاصة الباحث الاجتماعي والخبير الاقتصادي حول امتلاك المعرفة والحقيقة.
هؤلاء “المثقفون الجدد” (الخبراء أو التكنوكراطيين) وإن كانوا في أغلبهم يرفضون هذا اللقب، ينتجون بحوثًا بهدف توجيه القرار السياسي في مجال محدد أو تغذية الحالة الاحتجاجية والنقدية في المجتمع، ورغم أن هذا التخصص في مستوى العلوم ينتج معرفة أدق كل يوم، إلا أنها لا تقدر منفصلة على تشكيل رؤية شاملة للمستقبل.