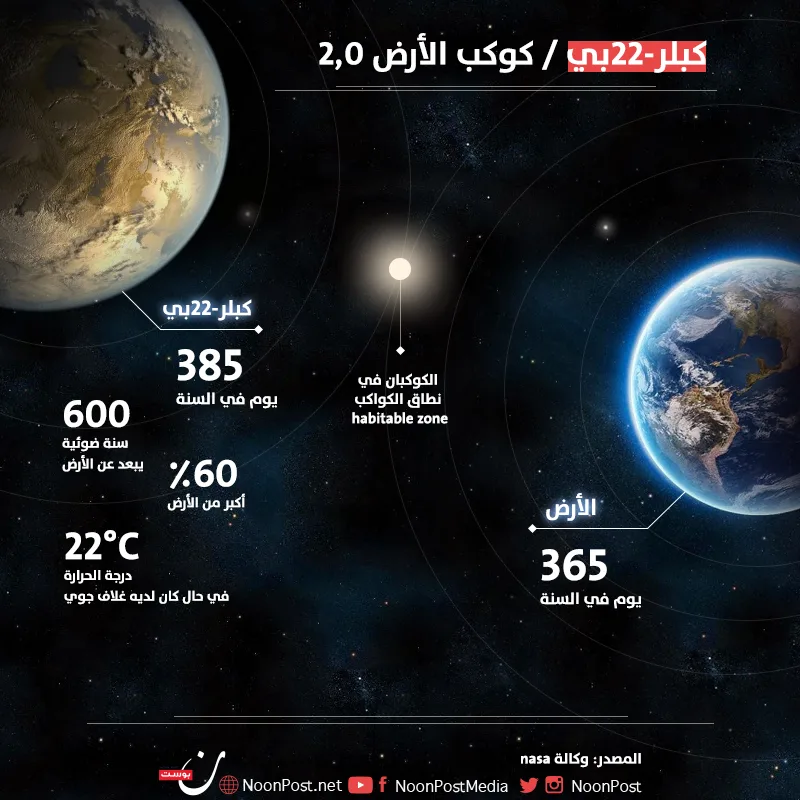ترجمة وتحرير نون بوست
الشيء الذي لا يمكنك تجاهله حول مصنع الحرباوي للغزل والنسيج في مدينة الخليل هو ضجيجه الدائم، ضجيج الأنوال الميكانيكية التي تعمل بسرعة عالية وبطريقة تصم الآذان، هذا الصوت الهادر الصادر عن الآلات القديمة، يشبه تماماً صوت تكتكة القاطرات البخارية المسرعة.
من بعدها يمكنك ملاحظة النسيج، مع الغبار الناتج عنه، النسيج السميك والرقيق المتوضع على آليات النول، هذا المشهد برمته يعطيك انطباعاً بأن المكان استيقظ من رقاده الطويل، بعد أن أُلقيت عليه تعويذة شريرة جعلته يبدو كما يبدو عليه.
في هذا اليوم، كان يوجد 14 نولاً يعمل داخل المصنع، جميعها تحيك الرمز الفلسطيني المحبب، الكوفية، “الحمد لله”، بهذه العبارة ابتدر عبد حرباوي، وهو أحد الأشقاء الثلاثة الذين يديرون المصنع، كلامه شاكراً منة الله عليهم والمتمثلة بزيادة الطلب على الكوفية، بعد أن مضى وقت طويل على صمت أنوال المصنع المستديم.
الكوفية في فلسطين
مصنع الحرباوي للغزل والنسيج يعمل في مجال تصنيع الكوفيات، والتي أصبحت تُعرف اليوم على أنها رمز للقومية الفلسطينية، منذ عام 1961، ومنذ ذلك الحين، لم يبقَ في فلسطين سوى هذا المصنع المتخصص بصناعة الكوفيات الفلسطينية، وقبل إنشاء متجر للكوفيات في مسقط رأسه في مدينة الخليل، كان والد عبد، المدعو ياسر، والذي أصبح الآن في عقده الثمانين، يستورد أغطية الرأس التقليدية هذه من سورية.
التوقيت الذي تم اختياره للمباشرة بأعمل تصنيع وبيع الكوفيات من قِبل آل الحرباوي كان توقيتاً حكيماً ومناسباً؛ فبعد إنشاء دولة إسرائيل، شهدت الفترة ما بين خمسينيات وأواخر تسعينيات القرن الماضي، ازدياداً بنشاط الحركة الوطنية الفلسطينية، وتلازم هذا النشاط أيضاً مع ازدياد التعلق بالرمز الشعبي المعتمد للقومية الفلسطينية المتمثل بالكوفية، حتى أن هذا الوشاح المطوي بطريقة معينة وجد طريقه إلى الصحف والمجلات وشاشات التلفزيون في جميع أنحاء العالم، للتعبير على القومية الفلسطينية.
مما لا شك فيه أن المقاتل الشاب الذي يدعى ياسر عرفات، مؤسس حركة فتح والذي أصبح فيما بعد زعيماً لمنظمة التحرير الفلسطينية، يرجع له الفضل أكثر من أي شخص آخر لتعريف الجمهور غير العربي بالكوفية والعقال، وهو الحبل الأسود الذي يوضع على قمة الرأس لتثبيت الكوفية في مكانها، فإذا كان وجه عرفات قد أصبح على مر السنين أحد الوجوه المرتبطة بفلسطين، فإن كوفيته وعقاله، اللذان كانا دائماً مايلازمان رأسه، سرعان ما أصبحا الشعار غير الرسمي لفلسطين.
ولكن قبل انتشار وسائل الإعلام الشاملة، لعبت الكوفية على أرض الواقع دوراً موحداً في مواجهة محتل آخر، المحتل البريطاني؛ فخلال ما أصبح يعرف باسم الثورات العربية 1936-1939، تبنى المقاتلون غطاء الرأس التقليدي “الكوفية” لحث طبقات المجتمع الحضرية للتخلي عن الطربوش العثماني التقليدي لصالح الكوفية، حيث يوضح تيد سويدنبورغ من جامعة أركنساس في بحثه، أنه قبل الثورات، كان يتم ارتداء الكوفية بشكل تقليدي من قِبل الفلاحين الفلسطينيين، والهدف الأساسي من وضعها كان يتمثل بحماية الرأس والوجه من أشعة الشمس الحارقة في الصيف، ومن رياح الشتاء العاتية، وإن اعتماد الكوفية من قِبل الطبقات المجتمعية الحضرية، كان يمثل، على حد تعبير سويدنبورغ، لحظة “انقلاب في التراتبية الهرمية الاجتماعية”، حيث استطاع الفلاح المحارب أن يملي بنجاح لباسه التقليدي كدلالة على الوحدة الوطنية.
التصنيع تحت وطأة الاحتلال
أوضح لنا عبد حرباوي أنه خلال سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم، أنتجت عائلة الحرباوي الكوفية السوداء والبيضاء بكميات كبيرة، بمعدل ينوف عن 100.000 كوفية في سنة، ويضيف قائلاً “العمل كان جيداً حينها، حيث قمنا بشراء الأنوال من اليابان، وكنا نعمل على تشغيلها طوال الوقت، ومع ذلك لم نستطع تلبية طلب السوق”.
بعد فترة قصيرة من بداية الانتاج، سرعان ما تمت إضافة الكوفية الحمراء والبيضاء لخط الإنتاج؛ ففي فلسطين، كان هذا النوع من الكوفيات هو المفضل من قِبل أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما يقول حرباوي، علماً أن هذا اللون هو الشائع في الأردن والدول العربية الأخرى حتى الآن.
تابع المصنع أعماله بسلاسة خلال الحروب، والاحتلال، والانتفاضة الأولى، ولكن في النهاية توقف في وقت مبكر من التسعينيات، حيث بدأ انتاجه بالتراجع إبان توقيع بروتوكول باريس لعام 1994، وهو اتفاق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي تم إبرامه إثر اتفاقات أوسلو، حيث عمد هذا البروتوكول على إحكام ربط الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني ببعضهما، ولكنه تجاهل عدم التوازن في القوة الاقتصادية التي تميز العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين.
من المتفق عليه على نطاق واسع بين العديد من الاقتصاديين الفلسطينيين والدوليين، أنه في الفترة الواقعة ما بين عام 1967، بداية احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وبروتوكول باريس لعام 1994، تمتعت إسرائيل بالكثير من الوقت لضمان تقزيم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وإبقائها بعيدة عن الاستقلال، ومعتمدة بالكامل على الاقتصاد الإسرائيلي.
على وجه الخصوص، عمدت إسرائيل إلى اتباع سياسة تدمير البنى التحتية، والرفض المتكرر لطلبات الحصول على تراخيص لبدء مشاريع صناعية جديدة، لوضع العصي بالعجلات للحيلولة دون تنمية الصناعية الفلسطينية منذ عام 1967، وبمعنى معين، استطاع بروتوكول باريس أن يضمن عدم تغيير هذا الواقع إلا بشكل ضئيل.
العولمة والاحتلال
يقول وجيه عامر، أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح في مدينة شمال نابلس بالضفة الغربية “الصناعة تساهم بحوالي 12% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدينا”، ويضيف “المؤسسات الصغيرة تتمتع بضرورة قصوى بغية بناء قاعدة تنمية اقتصادية متينة في فلسطين”.
ولكن تدمير البنية التحتية الصناعية من قِبل إسرائيل لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا، والحلقة الأكثر وضوحاً من هذا المسلسل المستمر، تمثلت بقصف أكثر من 250 مصنعاً في قطاع غزة في حرب عام 2014، كما أن سياسة رفض منح تصاريح البناء مازالت مستمرة أيضاً، وهي ممارسة تثير قلقاً بشكل خاص في المنطقة جـ (C)، والتي تمتد على قرابة 60% من أراضي الضفة الغربية والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
مصطلح “الاعتماد المتبادل” الذي جاء في بروتوكول باريس، يعني على أرض الواقع أن الاقتصاد الإسرائيلي هو وحده الذي سيستفيد من العمالة الفلسطينية الرخيصة والسوق الفلسطينية الكبيرة المفتوحة أمام بضائعه، والعمالة الفلسطينية التي تعمل في مجالات الصناعة والزراعة والبناء في إسرائيل، هي مجرد مثال بسيط على ذلك، حيث أن جهد هذه العمالة يساهم في النمو الاقتصادي في إسرائيل، وغالباً ما تعود التحويلات المالية التي ترسلها هذه العمالة لتدخل إلى فلك الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال شراء منتجات إسرائيلية بهذه الحوالات، والتي كان من الممكن أن تكون -من الناحية النظرية- من انتاج الصناعات الفلسطينية أو الشركات الزراعية الفلسطينية، ويعلّق عامر على هذا الواقع بقوله “إن وجود قطاع صناعي قوي في فلسطين، يساعد على خلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها لدينا، لنستطيع في نهاية المطاف كسر حلقة التبعية”.
وإذا أضفنا إلى السياسات السابقة سياسات العولمة والسوق الحرة، التي تعول عليها السلطة الفلسطينية في بعض الأحيان بشكل منفتح للغاية، فلن نستغرب حينها من معرفة أن المنتِج الفلسطيني يتجابه بسوق تصريف محلية منكمشة للغاية على أرض الواقع، ووسط هذا المناخ، تبدو السلع الصينية الرخيصة، التي فاضت بها أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة، المجرم الأكبر، وهنا أصبحت الكوفية ضحية لشهرتها العالمية، حيث فاضت السوق المحلية بالكوفية الفلسطينية رخيصة الثمن المصنعة في الصين.
ويقول الحرباوي معلقاً “عندما بدأت الكوفية المصنوعة في الصين بالوصول إلى الأسواق الفلسطينية، توقفت أنوالنا العمل”، حيث انكمش الطلب على الكوفية الفلسطينية الصنع، ولذات السبب تقلص الإنتاج، واستغرق الأمر 15 عاماً حتى يسترد الطلب عافيته مرة أخرى؛ ومؤخراً فقط، في عام 2013، قامت السلطة الفلسطينية، تحت ضغط من الصناعيين المحليين الفلسطينيين، بالحد من بعض سياساتها الاقتصادية الليبرالية الجديدة، وذلك من خلال إضافة تعرفة بنسبة 35% على الواردات الصينية المنشأ وغيرها من البضائع الأجنبية.
النجاة من العولمة
بشكل عام، تظهر هذه الديناميكية في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل على تحريض التجار العالميين على خوض معركة مع الحركة المتنامية التي تحث الأفراد على شراء المنتجات المحلية، ودعم الشركات الوطنية، ولكن في فلسطين، الشركات المحلية تكافح أيضاً ضد عدد لا يحصى من القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وبذات الإبداع والمرونة اللتان تعتبران جزءاً لا يتجزأ من الحياة في ظل الاحتلال، استطاعت عائلة الحرباوي اكتساب الانتشار العالمي لأعمالها في ظل العولمة.
داخل المصنع يعمل ثلاثة عمال على التنقل المستمر بين الأنوال الصاخبة إما لإضافة بكرات الخيط، أو لإصلاح التوقفات الكثيرة في نسج الخيوط على الآلات، وفوق المصنع تم بناء ورشة عمل هادئة عن ضجيج الآلات، يعمل بها جودا حرباوي ونجله على قص الأوشحة الفردية من لفافات النسيج الكبيرة المكدسة في زاوية الغرفة، في ذات الوقت التي تعمل فيه خمس نساء على آلات الخياطة، لإضافة اللمسات الأخيرة والشرّابات على الكوفية، “في هذه الأيام، نقوم وسطياً بانتاج ما بين 300 إلى 400 كوفية يوماً”، أوضح حرباوي، وعلى الرغم من أن هذا الرقم بعيد كل البعد عن الأرقام الهائلة التي كان المصنع ينتجها في السبعينيات والثمانينيات، بيد أنه لا يزال يشكل تحسناً كبيراً عن مقدار الانتاج في أوائل القرن الحالي.
وبغية بقائها منفتحة ومنافسة في السوق، تراهن صناعة الحرباوي على النوعية الحرفية، وأصالة، وتفرد منتجاتها؛ فالكوفية الحرباوية هي بضاعة أصبحت تلقى استسحساناً وتقديراً من المشترين المهتمين في كل مكان، كما أن التجارة الإلكترونية وحملة إنقاذ مصنع الكوفية الوحيد المتبقي في فلسطين، أثبتا أنهما من المبادرات الناجحة لاستمرار عمل المصنع.
هناك عدد من المواقع الإلكترونية المخصصة التي تسهّل على العملاء في جميع أنحاء العالم لشراء كوفية الحرباوي الأصلية، “نحن الآن نصنع الكوفيات بالعديد من الأنماط والألوان المختلفة”، يوضح حرباوي، ويضيف “ولكن هذه المنتجات مخصصة للسياح، لأن الفلسطينيين ما يزالون يفضلون الأنماط التقليدية”.
الكوفية خارج العالم العربي
بالتوازي مع تاريخها العريق في فلسطين، وجدت الكوفية حياتها الخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ ففي الستينيات، ارتبط مفهوم الكوفية بالأقليات المحاربة التي ترتديها والذين يمثلون مبادئ مناهضة الحرب أو يخضون معاركاً لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبعد ذلك، وفي السبعينيات تقريباً، بدأت الجماهير الواعية سياسياً في جميع أنحاء العالم تربط الكوفية مع القضية الفلسطينية.
ولكن ابتداءاً من التسعينيات وحتى بداية القرن الحالي، وهي الفترة التي شهدت الانتفاضة الثانية وحروب الخليج المتعاقبة، والحرب على الإرهاب، باشر المعلقون اليمينيون، الذين كانوا أمريكيين في أغلب الأحيان، بذم مرتدي الكوفية وربطهم بتأييد الإرهاب بشكل عام.
هذه الموجة من الذم استثارها، على وجه الخصوص، واقع انتقال الكوفية من أكشاك الشوارع إلى واجهات محلات الأزياء الراقية، حيث ندد البعض بهذه الحركة معتبرين إياها محاولة لتجميل الإرهاب، ورأى آخرون أنها في نهاية المطاف محاولة لتجريد هذا الرمز من معناه السياسي، أما البعض الآخر فظل يعتبر أن ما حصل هو فرصة لزيادة الوعي حول محنة فلسطين وسياسات الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمرة، ولكن كما يقول سويدنبورغ، ربما ليس من الضروري تصنيف الكوفية باعتبارها إما رمز سياسي أو عنصر أزياء مستقل، حيث يمكن أن تكون الكوفية معبّراً عن كلا الحالتين على حد سواء.
على الرغم من التوترات التي تصاحب تفسيرات هذا الرمز، بيد أنه بالنسبة لأنجليس رودناس، وهي سائحة إسبانية في مدينة الخليل، الكوفية السوداء والبيضاء هي تعبير واضح لا يخامره الشك عن فلسطين، حيث تقول “أرى بأنها ملابس تقليدية أصبح لها الآن دلالات سياسية باعتبارها رمزاً للمقاومة، بالنسبة لي، فإنني أقوم بربطها مع صور عرفات، والاضطرابات السياسية في المنطقة”.
ساعدت الإستراتيجية التي انتهجها مصنع الحرباوي المتمثلة بإضافة الألوان إلى أشكال الكوفيات، بتخفيف الرمزية السياسية للكوفية، حيث خففت من الاستقطاب السياسي لمرتديها، حتى من قِبل المرتدين المثقفين سياسياً، “لقد اشتريت واحدة ملونة كهدية، لأنها أعجبتني كموضة أزياء” تقول رودناس.
استطاعت عائلة الحرباوي ربما إيجاد التوزان التجاري الصحيح من خلال إدخالها للألوان في صناعة الكوفية، ولكن بالتأكيد، الكوفية في الخليل ستبقى بالنسبة للأجيال الشابة تقليداً يستحق المحافظة عليه، حيث يقول محمد الحرباوي نجل جودا الحرباوي البالغ 14 عاماً، “أنا ارتدي الكوفية حول عنقي، وعندما أكبر بالسن، سأضعها فوق رأسي مع العقال”، وأضاف “أنا أحب أن أرى كبار الفلسطينيين وهم يرتدون الكوفية، بالنسبة لي، فإن ذلك يعني أنهم يحبون فلسطين”.
المصدر: ميدل إيست آي