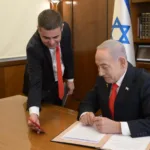في زيارة إلى سوق قروي ببني سويف عام 1832، وصف رحالة إنجليزي مشهد الفلاحين وهم يجلسون القرفصاء ويبيعون منتجاتهم، بينما دخل عليهم ضباط الجيش المصري المؤسس حديثًا آنذاك:
“لاحظنا عددًا من ضباط الفرسان وكأنما يريدون أن يُشعروا الفلاحين بحقارة ملابسهم المتواضعة، ظهروا في بِدَلِهم الفاخرة المبرقشة على ظهور خيول مطهمة، يعدون بها فوق الأكوام العالية، ويهبطون ثانية وهم يكبحون جماح خيولهم المندفعة بحيوية في منتصف القفزة، ويرتدي قائدهم عباءة قرمزية ورداءً مطرزًا وشالًا ثمينًا، مع حصان رائع وسيف معقوف، فبدا بشواربه المنمقة الشقراء المحمرة كما لو كان فارسًا جرمانيًا.”
***
على العكس مما تشير الروايات الوطنية الكلاسيكية، وكما تقول هذه الكلمات المذكورة في كتاب المؤرخ خالد فهمي، كل رجال الباشا، لم تكن العلاقة على ما يُرام بين الجيش الجديد الذي شرع محمد علي في تأسيسه ليبدأ مشروعه الإقليمي منطلقًا من القاهرة، وبين العوام من المصريين، وإن كان المصريون قد كرهوا المماليك لأسباب كثيرة، فإن كراهيتهم لجيش محمد علي كانت لسبب مختلف، وهو تطبيقه لفكرة التجنيد الإجباري التي فرضت على الفلاحين أن يتركوا قراهم وأراضيهم لثلاث سنوات لأداء الخدمة العسكرية.
على الرُغم من ذلك، لم تتطور العداوة إلى مواجهة بعد أن وجد كل من الجيش والشعب علاقة جديدة طفيلية إن جاز القول استفاد فيها كل منهما من الآخر، حيث اكتشف الفلاحون أن الخدمة في الجيش أعطتهم الكثير من المزايا، أبرزها الدفاع عن أراضيهم، وهو ما يعني أن الخدمة العسكرية كانت، وربما لا تزال، طريقًا على مستوى الأفراد لحماية أراضيهم وتعزيز مصالحهم بشكل نفعي، أكثر منها لحماية الأرض بالمعنى الوطني، وأنها متداخلة مع طبيعة توزيع المصالح الاجتماعية الاقتصادية، على عكس الجيوش الحديثة المهنية المنفصلة عن الصراعات الاجتماعية اليومية.
من القلعة إلى الاتحادية
باعتباره مشروعًا ينتمي في أهدافه إلى عصور ما قبل الحداثة أكثر منه إلى العصر الحديث، على الرُغم من محاولات لصق مبادئ الوطنية الحديثة به، ورث مشروع محمد علي كافة السمات السياسية والعسكرية للدولة العثمانية كمشروع تركي بالأساس، واهتم اهتمامًا كبيرًا بالعسكر دون غيرهم، لا سيما وأن دول ما قبل الحداثة كانت تتشكل بالأساس من جيوش ضخمة مقارنة بمؤسسات سياسية ضئيلة غاب عنها مفهوم السيطرة الاجتماعية الذي أتى مع الحداثة، غير أن الوسائل التي دشن بها الباشا جيشه الخاص، على العكس من وسائل العصور القديمة، كانت مواكبة لأحدث ما جادت به الأنظمة الأوروبية.
تباعًا، وفي أدواته ووسائله، كان المشروع حداثيًا بامتياز، ولم يكن ذلك فقط في اعتماده على التجنيد كمفهوم حديث، ولكن في حاجته إلى مؤسسات أخرى لخدمة طبيعته الحداثية تلك، فهو بحاجة لأزياء موحدة تُصنّع في القاهرة، ومطبعة وأرشيف لحفظ سجلات جنوده، ومؤسسات طبية لمداواة الجنود، إما لإصابتهم في الحرب أو لاحتمالية تناقل الأمراض بينهم نظرًا لاختلاطهم لفترات طويلة وفي ظروف ليست جيدة بالضرورة، وهي مؤسسات لم تكن موجودة من الأصل، فإن كانت بلدان أوروبا قد مرت بأطوار الحداثة بطريقة طبيعية جرى فيها تحديث وعلمنة المؤسسات المدنية والعسكرية الموجودة بالتوازي، فإن وجود مصر خارج السياق الأوروبي كان يعني أن الجيش المسترزع على النمط الحديث سيحتاج كذلك إلى استزراع كل هذه المؤسسات الحديثة من حوله.
نتيجة لذلك، كانت الدولة المصرية بنت الجيش، كما أن معظم مؤسساتها منذ نشأتها تدور حول الجيش بطريقة أو أخرى، ولم يكن غريبًا إذن مع دخول الإنجليز وهزيمة الجيش عام 1840 أن يكون مشروع الدولة قاب قوسين أو أدني من السقوط، وهو ما دفع أسرة محمد منذ تلك الهزيمة إلى الاهتمام بالسيطرة على الداخل كإعادة تعريف لمشروعها السياسي، كما حدث حين طلب محمد علي أن تكون مصر والسودان له ولأسرته مقابل تخليه عن طموحاته، ولعل ذلك هو ما أدى فيما بعد، ومع ظهور الاستعمار، إلى اهتمام الدولة بتدشين مؤسسات تُحكِم بها قبضتها على الداخل، بينما هيمن الإنجليز على وجود مصر ككيان على الساحة الدولية، وكانت النتيجة، وللمفارقة، هي ما يُسمى بالمرحلة الليبرالية في التاريخ المصري، والتي تسبب بها كبح سلطان الجيش نتيجة دخول الإنجليز في المعادلة، وخلقهم لنظام ملكي برلماني على غرار النظام في بلادهم.
على مدار ذلك القرن، بين منتصف القرن التاسع عشر وحتى انقلاب يوليو، وبينما اتجهت أسرة محمد علي للداخل، بدأ تدشين المؤسسات الأكثر حداثة في الدولة المصرية، والتي أعطتها سلطة داخل المجتمع أكثر من الجيش، وأبرزها بالطبع وزارة الداخلية، كما يشير الباحث علي الرجال في مقاله هنا، وهي للمفارقة الخطوات التي أدت إلى خلق مسافة بين أسرة محمد علي والجيش، ومع حتمية انحسار الدور الاستعماري للإنجليز والتوجه نحو عصر ما بعد الاستعمار، كانت مصر على موعد مع عودة الجيش لملئ فراغ “الكيان” المصري على المستوى الإقليمي والدولي، وهي المرحلة التي شهدت بالطبع سقوط أسرة محمد علي التي تقوقعت في مؤسسات الدولة الداخلية، واستيلاء الجيش، القديم في طبيعته وبنيته، الجديد في مشروعه السياسي المنفصل الآن عن الأسرة الحاكمة، على السلطة في البلاد.
يمكن القول بشكل أو آخر أن دورة الحياة التي مرت بها أسرة محمد علي، بدءًا من مشروعها الإقليمي ثم هزيمته واقتصاره على السيطرة في الداخل، مرت بها أيضًا منظومة يوليو كسُنّة لنفس الدولة التي ورثتها، فبينما عادت هيمنة الجيش تحت لواء القومية والاشتراكية، ارتكزت شرعية النظام الجديد في الأساس للمشروع الإقليمي الذي كان يقوده عبد الناصر، ومع هزيمة 1967، والتي تعادل هزيمة 1840 بالنسبة لجيش محمد علي، تراجع الطموح الإقليمي إلى غير رجعة، في حين بدأت حسابات مشروع يوليو السياسي تتجه نحو الحفاظ على المكتسبات في الداخل، وهو ما دفع بالقيادة الموجودة آنذاك إلى اتخاذ السياسات التي اتخذتها منذ حرب أكتوبر وما بعدها.
في تلك الفترة، وعلى العكس من بدايات القرن العشرين، لم تكن هناك قوة استعمارية صِرفة مثل إنجلترا تتغلغل في الداخل المصري، وتفرض رؤاها السياسية والاقتصادية بشكل يتيح هامشًا ليبراليًا كالذي تشكل في العشرينيات، فقد كانت القوة الأمريكية الحاضرة بشكل غير مباشر تتيح للدولة نفسها مساحة أوسع للتحكم في كيفية تحقيق مصالحها مع الاحتفاظ بالأوضاع كما هي، بل واستغلال علاقاتها الجديدة بواشنطن لتوسيع نفوذها، وهو ما أدى على مدار السنوات الأربعين الماضية إلى توسّع دور المؤسسة العسكرية داخليًا في مجالات مدنية بحتة، بدءًا من المحافظات وشركات البناء وحتى الأندية ومشاريع الأطعمة وقاعات الأفراح، وهي المرحلة التي انتقل فيها موقع السلطة جغرافيًا مرة أخرى، وهذه المرة إلى محيط مصر الجديدة ومدينة نصر.
بين التحرير ورابعة
على مدار القرنين اللذين ترسخ فيهما سلطان المؤسسة العسكرية المصرية بالدولة التي تمخّض عنها مشروعه، كان الاعتبار الأول لوجوده، ولا يزال، هو الحفاظ على مكتسباته كمشروع سياسي، وهي المكتسبات التي بدأ يراكمها بمذبحة القلعة حين تخلص من النخبة القديمة وحل محلها، ثم بدأ يتوسع فيها مع تبلور مؤسساته الحديثة الجديدة، وإن كان قد تراجع مع هيمنة الإنجليز وتحول أسرة محمد علي لمؤسسات الدولة الأخرى، فإنه قد عاد بقوة متشحًا بمشروع الجمهورية في الخمسينيات والستينيات، بل وخلق تناسقًا ربما غير مسبوق بينه وبين مؤسسات الدولة الأحدث كالداخلية.
تجلى ذلك أثناء سنوات الثورة الأربعة، بمحاولات الجيش وضع نفسه بعيدًا عن بقية مؤسسات الدولة حين قامت الثورة، حيث نأى بنفسه عن طرف يبدو خاسرًا لكيلا يخسر معه معنويًا أمام جموع الشعب في الميدان، وهي محاولات اتضح زيفها لاحقًا نظرًا للتقارب الشديد بين مصالحهما، والتي نُسجت معًا على مدار الأعوام الأربعين أو الستين الماضية، وبشكل وصل لذروته في مذبحة رابعة العدوية، وإن كان الاتجاه في البداية نحو التحرير هو اتجاه متوقع من صفوف الثورة، نظرًا لتمركز قوى الدولة الكلاسيكية في محيطه، فإنها لحظة كان يسهل على الجيش أن يقف موقف المحايد فيها نظرًا لوقوع مراكز قوته بعيدًا، أما وصولًا إلى رابعة، وبينما اقتربت الجموع، بغض النظر عن اختلافها أو اتفاقها مع مطالب الثورة وعلاقتها بها، من معاقل السلطة العسكرية، فإن الصراع أصبح صفريًا.
في النهاية، يجدر القول أن هناك فرقًا بين مذبحتي القلعة ورابعة، فالقتلى في الأولى كانوا نخبة عسكرية ليس إلا، في حين كانوا في الثانية مواطنين من المفترض أن تدافع عنهم الدولة -نظريًا- لا أن تقتلهم، وهو ما يجعل الثانية أشد سوءًا، بيد أن هناك سمات متماثلة بين المذبحتين، فهما على المستوى السياسي لحظة صفرية قررت فيها الدولة تصفية غريمها، وإن كانت الدولة قد تجحت على مدار قرنين كاملَين أن تغسل أي جريمة ارتكبتها بشيطنة الآخر، إما باعتباره مملوكيًا استعبد المصريين طويلًا وخلصتنا منه، أو عميلًا لطرف خارجي شنقته، أو إرهابيًا اقتصت منه، فإنها منذ الخامس والعشرين من يناير، وحين أصبحت وجهًا لوجه مع المصريين أنفسهم، لم تتوانى عن استخدام العنف بدرجات متفاوتة، وصولًا لمذبحة قتلت فيها ألفين منهم.
في كل الأحوال، وبمنطق الجيوش، لم يكن ما فعلته الدولة غريبًا، فكما يحدث حين يصل التوتر مع عدو خارجي إلى ذروته، ويبدأ إطلاق النار مباشرة بين الطرفين، فإن المنطق نفسه ينطبق على أي نظام أو دولية يهيمن عليها الفكر العسكري بشكل كبير، ولعل المذابح التي قامت به نظم عسكرية شتى حول العالم تشي لنا بذلك والأمثلة هنا لا حصر لها، وكل ما يقع على عاتق الدولة بعد أن تنفذ مذبحتها أن تخلق رواية تبرر بها ذلك، فإن كانت الوطنية التي صاغتها الدولة المصرية بنُخبتها قد بررت مذبحة المماليك، فإن الروايات التي تبرر بها الدولة حاليًا مذبحة رابعة لن يُكتَب لها تاريخيًا ان تستمر طويلًا، وهي تعتمد بالأساس على قواعد شعبية مغيّبة ليست بالضرورة باقية، في حين أن الآلاف من الصور والحكايات المأخوذة عن قُرب للحدث ستظل حية لعقود، لا سيما في عصر الصورة واللقطة الذي لا تفوته تفصيلة واحدة، وسيؤثر ذلك لا شك على أي لحظة تعود فيها الثورة للهجوم والدولة للدفاع.