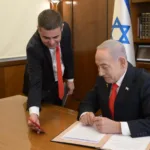يمتاز النظام الحاكم في لبنان بالبراعة والديناميكية. فهو يملك أكثر من عقلٍ مفكّر، يتواطؤ الواحدُ منها على الآخر أحياناً، ويُنجده إن كان في ذلك مصلحة مشتركة.
خلال أربع وعشرين ساعة، تراجعت السلطة عن إجراءين فضائحيين بسرعة قياسية. أوّلهما الجدار الأخرق الذي شُيّد في وسط بيروت، والذي عزل مبنى الحكومة عن سائر البشر في العاصمة، وأعاد تسليط الضوء على قضية الوسط التجاري الميت ومعه أزمة مدينة تختنق بين طبقات من الاسمنت والمشاريع العقارية، ويتآكل فيها الفضاء العام بحسب ما تقتضيه بورصات المال. وثانيهما المناقصة الخاصة بموضوع النفايات، والتي كرّست المحاصصةَ بين أركان الطبقة الحاكمة وثبّتت منطقها، بفجورٍ يليق بوصفِه موضوعُ المناقصة المذكورة.
ليس النظام التوافقي بدعة لبنانية من حيث المبدأ. وحين نظّر له عالم السياسة الهولندي أريندت ليبهارد، رأى فيه وصفة تتيح التعايش بين مكوّنات بلد تفصل بينها هوّة عميقة من الاختلاف، بحيث يسمح التشارك في السلطة بين ممثلي المكوّنات الطائفية أو الإثنية أو الثقافية لمسارٍ ديموقراطي سلس، ويأخذ في الاعتبار هواجس الجميع وخصوصياتهم.
على أن النظام في لبنان شكّل المثال الأبرز الذي يستخدمه نقّاد ليبهارد لتبيان الخلل في نظريته. فكان النظام اللبناني، بهذا المعنى، مثالاً لا يُحتذى في علم السياسة. وهذا ليس بسرٍ بأي حالٍ من الأحوال. فهو يمثّل خيبة عبّر عنها آلاف المحتجين في بيروت وغيرها من المدن اللبنانية على مدار أيام.
على أن رغبة المحتجين الجارفة بتغيير واقع الحال لم تتبلور على شاكلة تصوّر واضح. فوقعَ الحراك في جملة من الإشكاليات التي أملاها نجاحه الكبير في استقطاب آلاف المشاركين وعشرات آلاف المتضامنين معهم، ممّن قرروا عدم إدارة خدّهم الأيسر بعد الآن.
ويواجه الحراك اليوم تحديات عديدة. من بينها الحاجة إلى عدم استبعاد أي مكوّن أو فردٍ يجد في المطالب المرفوعة ما يحاكي هواجسه اليومية أو قضاياه البعيدة، بمعزل عن مدى تأييده لرموز النظام إياه أم لا. إذ إن هذه فرصة للتعامل مع المسائل المطروحة كقضايا، بدلاً من السماح باستثمارها لتوجيه لكماتٍ من هذا الطرف السياسي لذاك.
ومن بين هذه التحديات، بل أبرزها، ذاك الخاص بوضع أهدافٍ واضحة. وبرغم أن بعض هذه الأهداف بدأ يتبلور بشكلٍ جنيني، على شاكلة رفض إقرار المناقصات ورمي الكرة في ملعب البلديات لسحب القضية من بازار الطبقة السياسية، إلا أن الأهداف الموضوعة تلك ما زالت أقلّ بكثير مما يمكن للنظام هضمه.
يمكن أن ينجح الحراك في دفع السلطة إلى التراجع في بعض الأمور. وإن تمكّن من فرض مبدأ الرقابة الشعبية وطلبِ المحاسبة في قضايا الهدر والفساد، كالنفايات والكهرباء، ولاحقاً الأملاك البحرية والتنقيب عن الغاز مثلاً، فذاك يُعدّ مكسباً عظيماً. على أن مطلب «إسقاط النظام» وجد له مكاناً على ألسنة كثير من المحتجين. وهو، برغم رومنسيته أو شعبويته، عبّر عن نفسه بشكل مجتزأ، إذ طالب باستقالة الحكومة وبإجراء انتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن. علماً أن أياً من الإجراءين لا يُسقط النظام، بل يعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها. وهذا ما يطرح تحدياً من نوع آخر: أي نظام نريد؟
للنظام اللبناني رؤوسٌ عديدة، ولكلٍ منها شبكة واسعة من الارتباطات الزبائنية المُستفيدة. وهذه الشبكات تعوم على تناقضات الطوائف المتّصلة بمعظمها برُعاةٍ في الخارج. كما أن بنية النظام تقوم على أحزابٍ لها جماهير عريضة، إما بحكم المصالح أو بموجب العقيدة. وهذه معطياتٌ لا يمكن إغفالها لمن يريد أن يدعو إلى تغيير جذري، ويحصّل نتائج ويتدارك مطباتٍ و «مؤامرات».
هذا النظام لا يسقط بالضربة القاضية حتماً. إنه أقوى من ذلك بكثير. وأرجله ثابتة في أراضي الجماعات الطائفية جميعاً. على أن وصوله إلى أعلى مراحل زبائنيته، وترهّل قدراته الخدمية إلى حدودٍ مزرية، وتجاوزُ أعمال المحاصصة فيه لما تتيحه موارد البلاد الطبيعية وجغرافيتها الضيقة، يسمح بالتطلع إلى تغيير بنيوي على جرعات.
خرقُ النظام اليوم مُتاح بعدما طفح عفنُه وبانت قمامته عند كل قارعة طريق. إلا أن رسم خريطة جدّية توصل إلى نهاية النفق أو تقرّبنا منها، يستوجب ما يتجاوز الدعوة إلى انتخابات مستعجلة أو المطالبة باستقالات حكومية.
الحاجة ملحّة اليوم إلى الدفع باتجاه إقرار قانون انتخابي على أساس النسبية – دائرة واحدة أو متوسّطة. فذاك يسمح بتمثيل فئات واسعة همّشها النظام أو أخضعها لآلياته الفوقية، ويتيح عبورها إلى داخل هيئاته التمثيلية من دون الحاجة إلى نيل رضى «الزعيم» والاندراج في منظومة فساده.
تلك ثغرة بالغة الأهمية يحتاج إليها كل من لا يزال يؤمن بهذا البلد، وبإمكانية العمل من داخل مؤسساته لتوسيع الهوامش المُتاحة والتأسيس لتراكمٍ يحفّز المواطن – الفرد، ولا يُخيف الجماعات.
لا يبدو المورفين كافياً اليوم لتسكين الجموع المحتجة، وعمليّات التجميل ما عادت تخفي ترهل النظام. لكن التحايل على احتمالات التغيير الجذري، ولو بعد حين، جارية على قدمٍ وساق. وخلف التحايل قدراتٌ مالية ضخمة وشبكات مصالح.
يمكن للفرصة أن تُفوَّت، وذاك لا يؤدي إلى نهاية البلد. لكنه يعني العودة إلى حظائر الطوائف مجدداً والمكوث فيها ردحاً من الزمن، ريثما تكتمل دورةٌ أخرى من استنفاد الموارد وابتلاع ما تيسّر من نفطٍ وغاز واستثماراتٍ في سبيل التنقيب عنه.. وتطفحُ رائحة النظام مجدداً بعد سنوات، نفّاذة أكثر من الآن.
نُشر هذا المقال لأول مرة في صحيفة السفير اللبنانية