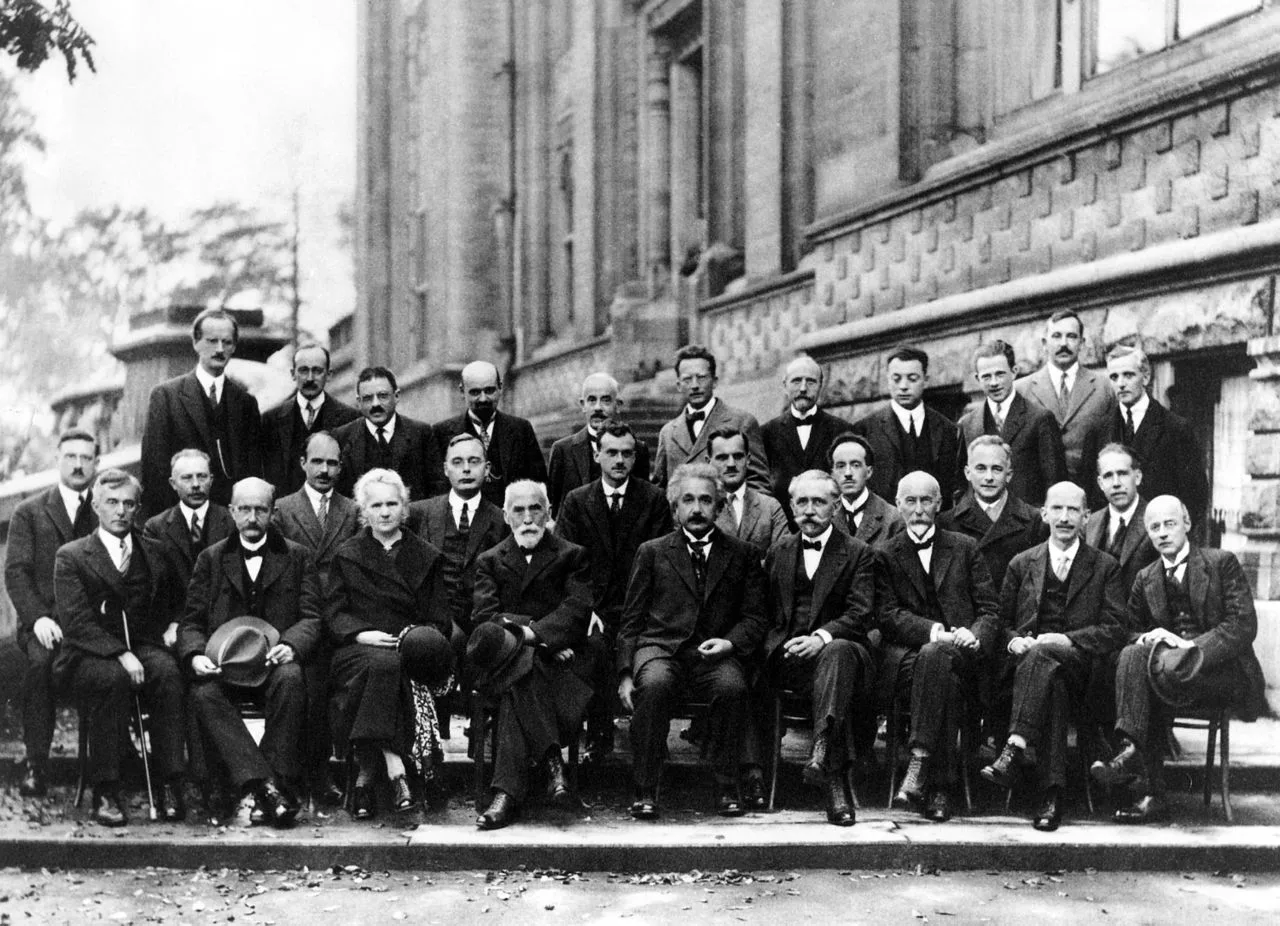حاولنا على طول ملف التعليم أن نلقي نظرة على النظم والتجارب التعليمية المختلفة في كل مكان، لكن ما يتضح من نوعية التقارير والتحليلات المنشورة عن المنطقة العربية هو أزمة كبيرة، تتمظهر هذه الأزمة في كافة المراحل التعليمية، وتتجسد على المستويين الأدائي والمفاهيمي.
ومع الشك الذريع في قدرة (أو رغبة) الأنظمة السياسية العربية على مجابهة الأزمة في الأداء، ربما يكون من المناسب هنا أن نلتفت للأزمة المفاهيمية والتي يمكن دراستها ومجابهتها واقعيًا، يتطلب الحديث عن التعليم نظرة متمعنة على عنصري العملية التعليمية الأساسيين؛ العلم وأهل العلم، وهنا نحاول أن نفهم كل منهما على حدة، وعلاقتهما ببعضهما البعض، وعلاقتهما بالواقع العربي.
مازالت ماهية العلم كمفهوم فلسفي غامضة حتى اليوم، فبالرغم من وجود فرعين كاملين من الفلسفة والتاريخ يعنيان فقط بدراسة العلم كمفهوم في أغلب الجامعات الكبرى؛ إلا أنه يبقى محل خلاف كبير بين دارسيه.
ربما يعود السبب في هذا إلى محوريته في تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمعات المختلفة، ربما يصح لنا البدء بتعريف لغوي لكلمة العلم من المعجم؛ وهو إدراك وجود شيء ما ومعرفته، بهذا الشكل يصبح العلم عملية من التعرف على أشياء لم نكن نعلم وجودها، ومع تطور القدرة البشرية على الإحساس بكافة أشكاله، يزداد الإدراك لما لم يعلم بوجوده في الحياة.
وتتحرك عملية الاستكشاف والإدراك تلك على كافة مستويات الوجود، بداية من الموجودات المادية الملموسة، ومرورًا بالحقائق الاجتماعية المجردة، وليس نهاية بالمشاعر داخل النفس.
أما إذا أردنا الحديث عن العلم كممارسة، فإننا نتحدث عن جهد منهجي ومرتب، جهد يحاول وضع الحقائق والمدركات السابق ذكرها بشكل مرتب ومصنف، ويحاول أن يكشف علاقاتها ببعضها البعض والتي تأخذ صورًا كالظواهر، ويتضح من السابق أن مثل هذا الجهد إذ يطبق على مختلف المستويات الإدراكية، وعلى مستوى الكون كله بما يحويه من بشر وأفلاك وجمادات وأحياء؛ يتضح أن هذا الجهد أكبر بكثير من أن يقوم به إنسان واحد في عمر واحد، وإنما هو جهد متراكم لأعمار أجيال لا تنتهي، ومجموع محاولات فهم تصيب وتخطئ ثم يأتي أحد ليعدل عليها.
وهنا يصح التساؤل عن الهدف من كل هذا الجهد، وتصح أيضًا الإجابة على وجهين لا يمكن معرفة فضل أيهما على الآخر، الأول هو التوق البشري الطبيعي للمعرفة والفضول، ويظهر هذا بشكل واضح مثلًا في الأطفال وفضولهم الشديد في معرفة العالم من حولهم، والوجه الثاني هو الحاجة الإنسانية لتطويع وتسخير الطبيعة لتسهيل وتيسير حياة الإنسان، إذ يفتح التعرف على الطبيعة والنفس والمجتمع عددًا لا نهاية له من الإمكانيات؛ إمكانيات لاستخدام ما تم التعرف عليه بشكل أفضل من خصائص للموجودات في حياة أسهل وأيسر، ولا يمكن تحديد أي من هذين الوجهين سبق الآخر، إلا أن كلاهما على قدر شبه متساوي من الأهمية في تطور الحضارة البشرية وسموها.
هنا يمكن لنا الانتقال للحديث عن أهل العلم؛ أو بشكل أدق: الجماعة العلمية.
الواقع أن تراكمية العلم وزيادة استهلاكه للموارد المالية والبشرية تحتم تواجد تقسيم للعمل العلمي بما يتناسب مع قدرات الأفراد، كما أن الحاجة إلى زيادة التخصص والدقة في العمل أضافت لذلك، وكان هذا يعني بالضرورة حتمية اعتماد الأفراد العاملين في المجالات العلمية على جهود أقرانهم ومساعدتهم.
مع بداية الثورة العلمية مع القرن الـ18 في أوروبا، بدأت الصورة الحالية لما يصطلح عليه بالمجتمع العلمي في التشكل لتصل لما هي عليه، تحتم تواجد مواثيق علمية مكتوبة وغير مكتوبة لضمان استمرار الجهد العلمي من عالم إلى آخر، وبالتدريج بدأت التصنيفات العلمية كوحدات القياس المترية وما يشابهها في الثبات والانتشار بين العاملين بالمجال، كما ظهرت الجمعيات العلمية لجلب العلماء للنقاش والإنتاج سويًا، أدى هذا إلى ضرورة الاهتمام بالجامعات كمساحة للبحث العلمي، والدراسة، وتجهيز الأجيال القادمة من العلماء.
وفقًا للسابق يمكن أن نقول إن الجماعة العلمية هي كلية تجمع كل الدارسين والعاملين بمجال علمي محدد، وكجماعة، هي ليست صلبة واضحة الانتماء إليها كالجنسية أو العرق، وإنما هي اتفاق ضمني يعرف أهله بعضهم البعض بدرجاتهم العلمية والجماعات التي ينتمون إليها، وغالبًا ما يكون أعضاء هذه الجماعة من المسؤولين عن وظيفة صناعة الحقيقة في مجتمعاتهم، وحدهم هم من يحددون ما هو العلم الجاد وما هو ليس بعلم أصلًا، وهم يحددون الخرافة من الحقيقة العلمية.
فلنجمع عند هذه المرحلة ما قمنا بتعريفه سابقًا ونحاول وضعه في سياقاتنا الخاصة؛ كيف ترى مجتمعاتنا العربية العلم؟ وما هي الجماعات العلمية البارزة؟
بالنظر إلى واقع الإنتاج والإعداد العلمي في البلدان العربية، يمكننا الزعم أن الجامعات تمثل القلب من المنظومة التعليمية، قد يبدو هذا مريبًا خصيصًا وأن الأكثرية من السكان في البلدان العربية لا تتلقى تعليمًا جامعيًا، إلا أن طبيعة دور الجامعة كمؤسسة علمية تتخطى دراسة الناس فيها بشكل مباشر.
تمثل الجامعة معبد العلم الحديث بمعنى يكاد يصبح حرفيًا، وفي البلدان العربية تحديدًا يختلط هذا الدور بحالة من الفشل المؤسسي كفيلة بإنتاج منتجًا علميًا شديد الخطورة، إذ يصبح دور الأستاذ الجامعي كسادن من سدنة معبد العلم شديد التأثير على تكوين الكوادر العاملة في المجتمع لاحقًا، إلا أن الفشل المؤسسي يظهر في هذه الحالة بانعدام الإبداع وغياب المصداقية لصالح السلطة، وبهذا الشكل تصبح ولاءات الجماعات العلمية مشوشة بوباء نفوذ السلطة السياسية عليها، وعندما يغيب دور الرقابة العلمية والمجتمعية للجماعة العلمية يتحول العلم إلى مجرد أداة يسهل التلاعب بها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، ومع غياب المعيار العادل والرقابة المخلصة للعلم كغاية أسمى، يظهر أنين الشعوب تحت غطاء من الالتباس والتخبط، بينما تستطيع السلطة امتصاص كل ما يتبقى من موارد لصالح فساد طبقي.
ربما يمكن الحديث هنا عن أضحوكة جهاز علاج الفيروسات الكبدية والمناعية الذي ادعى الجيش المصري تطويره، فهذه الحالة تمتاز بالوضوح والنموذجية.
فرد – وهو اللواء إبراهيم عبدالعاطي – غير معلوم بشكل واضح مؤهلاته يدعي الانتماء إلى الجماعة العلمية، ويطلق جهازًا غير مسموح بمعاينته ولا نشر ورقة بحثية واحدة عنه، والأغرب في الأمر من كل هذا مجموعة من الأطباء الجامعيين ينطلقون مدحًا في الاختراع وشكرًا للسلطة عليه.
وفي هذه الحالة نرى جيشًا يقوم بإطلاق الأجهزة العلمية، وأساتذة جامعيين يقومون بالدفاع عن جيش الوطن، وشعب هو الأعلى في العالم في انتشار الفيروسات الكبدية لا يجد محاولة جادة لتقديم علاجات لآلامه، فكيف يمكن الحديث عن تعليم في مثل هذا السياق بينما العلم وحيوات الناس المرتبطة به تذوي بهذا الشكل.