الإخوان والثورة بين العمل السياسي والحزبي.. قراءة في كتاب “الرؤية البديلة”
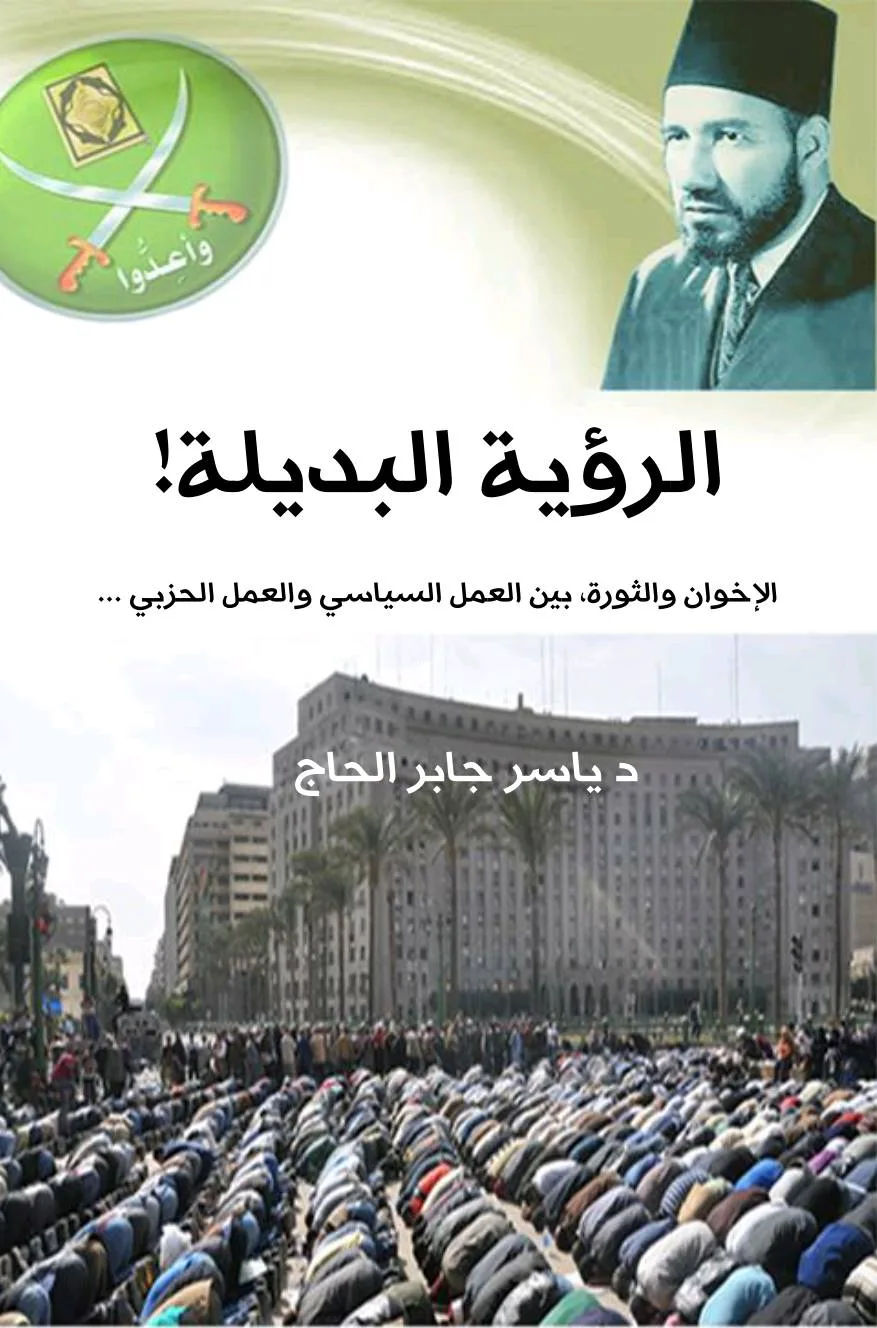
على ما يبدو أن الأحداث الراهنة في مصر تُجبر الجميع على إجراء المراجعات وتقييم المواقف السابقة وبناء رؤية جديدة للمستقبل، كما أن الظرف الحالي التي تعيشه الدولة المصرية عقب انقلاب عسكري أجهض تجربتها الديمقراطية الأولى صنع حراكًا داخليًا في كافة التيارات السياسية التي كان لها نصيب من المشاركة في الحياة السياسية المصرية قبل الانقلاب، لا سيما تلك التيارات ذات القاعدة الجماهيرية العريضة.
لا يمكن إغفال هذا الحراك النقدي داخل التيارات الإسلامية بالتحديد، حتى ولو لم تظهر آثاره إلى العلن في هذه اللحظة، ولو لم يأخذ مسارًا رسميًا، لكن ما يمكن أن نؤكده أنه انطلق على أقل التقديرات بشكل فردي بين أبناء الحركات الإسلامية بفعل العديد من العوامل التي لا مجال لسردها هنا، بل نُفسح المجال لإحدى المبادرات النقدية التي ظهرت لأداء كبرى تيارات الإسلام السياسي وهي جماعة “الإخوان المسلمين”.
هذه التجربة خرجت إلى النور في صورة كتاب يحمل اسم “الرؤية البديلة” .. الإخوان والثورة بين العمل السياسي والعمل الحزبي لمؤلفه الدكتور ياسر جابر الحاج أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذي أصر على تحدي الظروف وإصدار هذا الكتاب في هذا الوقت الحساس الذي تمر به جماعة الإخوان المسلمين على الصعيد الداخلي من تصدعات إدارية وعلى الصعيد العام بعد مرور أكثر من عامين على الصدام مع نظام الانقلاب العسكري في مصر.
في مقدمة الكتاب يؤكد الكاتب أن “هذا الكتاب يستهدف مراجعة وضعية جماعة الإخوان المسلمين السياسية وعلاقتها بالحياة الحزبية وأثر ذلك على الحالة الثورية الحالية في (مصر ما بعد الانقلاب) والتي بدأت تأخذ حالة ثبات ولا حسم”.
استهل كتاب الرؤية البديلة فصوله بتأصيل ومراجعة عرض فيها الكتاب رؤية جماعة الإخوان المسلمين لشؤون الحكم، حيث فسر الكاتب دعوة حسن البنا – مؤسس الجماعة – في مجال السياسة على أنها دعوة لإصلاح الحكم بالأساس وليس من الضرورة أن تتولى الجماعة هذا الحكم، كما يوضح الكتاب من وجهة نظر كاتبه لماذا رفض البنا الأحزاب في وقت تأسيسه للجماعة.
استكمل هذا الفصل مناقشة هذه القضية من منظور تاريخي في الطور الأول من تأسيس الجماعة، حيث أوضح دور الجماعة السياسي حينها كما حدده حسن البنا، في الوقت الذي رفض فيه ممارسة السياسة من خلال التحزب، وقد آثر الكتاب أن يُجيب على تساؤل عن الدور السياسي للجماعة إذا كانت لن تحكم وفي نفس الوقت لن تكتفي بالوعظ والإرشاد.
فدور جماعة الإخوان المسلمين السياسي وفقًا لقراءة الكاتب لأدبيات الجماعة التي كتبها البنا يندرج تحته عملية النضال الدستوري وهو دور الجماعة السياسي العام لإصلاح الحكومة في وجهة نظره، إذ يرى الكاتب هذا المصطلح أقرب في هذا العصر إلى مصطلح “جماعات الضغط” في العلوم السياسية وهو الذي يراه الكاتب مناسبًا للجماعة في وضعها الحالي، وذلك من خلال إعادة قراءة كلام البنا بشكل مختلف.
كذلك ويرى الكاتب أن الجماعة لا يجب أن تمانع في خروج كوادر منها للمشاركة في العمل السياسي الحزبي بصفتهم الشخصية لا بصفة المؤسسة التي ينأى بها عن ممارسة الحزبية، وبهذا يرى الكاتب أن تكتفي الجماعة بدور “جماعة الضغط” مع عدم السعي إلى تصدر السلطة مع دعم من تراه مناسبًا من السياسيين على الساحة لتحقيق أهدافها الإصلاحية، بحيث لا تتحول المؤسسة الدعوية إلى خصم سياسي، كما أكد كتاب الرؤية البديلة أن هذا الضابط لدور الجماعة نابع من تأصيل حركي وليس تأصيل شرعي.
وبعد هذه الجولة في كتابات البنا التي أراد الدكتور ياسر الحاج أن يُعيد بها تعريف دور الجماعة السياسي كما أراد لها مؤسسها الأول، يقفز بنا الكاتب إلى الوضع الحالي للجماعة من بعد ثورة يناير، حيث يرى مخالفة الجماعة لهذه الأدبيات التي تحدد دور الجماعة السياسي بعد أن دخلت في معترك السياسة من باب التنافس الحزبي ما أدى إلى نزيف في شعبية الجماعة.
وذلك بعد تأسيس حزب الحرية والعدالة بدون مراجعة لمبادئ البنا داخل الصف، كما يقول: “وربطت هذا الحزب بالجماعة بعلاقة تبعية أصبحت معها الجماعة حزبًا سياسيًا بشكل عملي فقط ودخلت بصفتها وبكل جسدها بدون لافتة الجماعة فقط في صراع الأحزاب السياسية لتنافس على السلطة بالمخالفة لصريح فكر الإمام المؤسس كما تقدم، من هنا بدأ الخلل ومن هنا بدأت الجماعة تعاني نزولا حادًا في شعبيتها بعد بدء المنافسة على السلطة”.
ثم يستعرض الكتاب وكاتبه تبعات هذا القرار، حين منعت الجماعة أي من أعضائها ممارسة السياسية إلا من خلال هذا الحزب، وهو ما انعكس على العلاقة التي تربط بين إدارة الحزب والجماعة التي بدأت بحسب الكاتب نقلًا عن تصريحات قادة الجماعة بمقولة الحزب منفصل عن الجماعة ثم تحولت إلى الحزب سينفصل عن الجماعة بعد أن يشتد عوده وما لبث الأمر إلى تحول الحزب إلى الذراع السياسي للجماعة بشكل واضح.
حينها طرح الكاتب تساؤلًا واضحًا بعد استعراض قرارات الجماعة فيما يخص العلاقة بينها وبين الحزب يقول فيه “هل تحولت الجماعة إلى حزب سياسي؟”، وقد خلص الكتاب إلى أن إجراءات الجماعة في التعامل مع حزبها وأعضائه تؤكد أن الجماعة أصبحت بهذه الصورة حزبًا سياسيًا.
وقد يُلاحظ في هذا الكتاب أن منهج كاتبه هو طرح الأسئلة على القارئ لإثارة ذهنه ومن ثم الإجابة عليها، هذا الفصل يطرح التساؤل ويقول “هل يمكن جمع المنهج الإسلامي في حزب واحد؟”، وقد كانت إجابته في كتابه أنه من المستحيل أن تجمع الفكرة الإسلامية في حزب كحزب الحرية والعدالة لأن الحزب يتعامل مع تفاصيل العمل السياسي والإداري للدولة بإجراءات تفصيلية، بينما تعمل الجماعة على دعوة أعم وأشمل من هذه الجزئية، كما أن خطأ الحزب في العمل السياسي لا يجب أن ينسحب على منهج الجماعة الإسلامي.
فيقول: “فكما لا يمكن جمع المسلمين في الفقه على مذهب فقهي واحد فلا يمكن أيضًا جمع منهج الإسلام بما له من مرونة في التطبيق وسعة في الاختيار ونضع هذا المنهج كله في أسلوب وسلوك هذا المحافظ أو ذاك الوزير أو هذا النائب ونزعم أن ما يقوم به هو منهج الإسلام ونفترض أن ما عداه لن يكون إسلاميًا، وننافس الآخرين باسم الإسلام في الانتخابات!”.
ينتقد الكاتب بعد ذلك أداء جماعة الإخوان بعد الثورة فيقول: “وكانت الفاجعة أن النشاط الدعوي للجماعة كان متواضعًا جدًا إذا قورن بما ينبغي أن يكون بعد جو الثورة والانفتاح وزوال القبضة الأمنية! ولم تستشعر القيادة الخطر لتقوم بالمراجعة والانتباه لهذا الضعف في الأداء”.
ويرى الأمر أنه انسحب على شعبية الجماعة في الشارع بعدما طغى الجانب الحزبي عليها، حيث ظهرت الجماعة في أعين البعض كـ”المهرولة إلى السلطة”، بعد أن رأى الكاتب أن الجماعة سلكت طريق السلطة أثناء هذا الانفتاح بدلًا من العمل مع المجتمع رغم أن الفرصة كانت مواتية، فيقول: “ولكن ظهرت الجماعة كدعاة يمدون أيديهم للمجتمع ليأخذوا أصوات الناس في الانتخابات ليصعدوا إلى كرسي السلطة، كانت هذه الصورة هي ما أصابت الجماعة بوصمة السلطة وشبهة النفع”.
انتقل الكاتب بعد ذلك للرد على شبهات يعلم أنها ستثار حول طرحه هذا، حيث انتقد الكاتب مقولات شبيهة بأن هذا المصير حتمي، وأن الانقلاب كان نهاية مكتوبة، فيقول الكاتب: “من العبث إلقاء اللوم على الخصم فماذا تتوقع منه، لو كان الصراع محسومًا بالهزيمة من أول يوم لكان من الأمانة عدم إعطاء وعود بالنجاح والنهضة، ولكان البقاء على كرسي الحكم دليلاً على إما أنه كانت هناك فرصة للنجاح أو أن هناك فشلاً في إدارك الواقع”.
ويستكمل الكاتب دفاعه عن فكرته قائلًا: “هكذا لم يكن الانقلاب ونجاحه حتميًا، ولم يكن الخونة ينقصهم دبابات أو أسلحة أو ضباط خونة فاسدين ليقوموا بانقلابهم، ولكنهم سعوا لإيجاد حاضنة شعبية واسعة لتسوغ انقلابهم، ونحن ساعدناهم في حملتهم هذه بصعودنا للسلطة (الصورية) ليتمكنوا من رقابنا بعد انحسار شعبيتنا جراء ما أسميه وصمة السلطة”.
يرد الدكتور ياسر الحاج على شبهة أخرى تقول إن هذا الطرح ربما كان يُناسب وقت البنا إبان تأسيسه للجماعة ولكنه غير مناسب لهذا العصر، إذ يرد قائلًا: “وهذا الكلام غير صحيح، فقد راجعت الجماعة بالفعل موقفها من الأحزاب ولكن فقط من الناحية الفقهية فيما يتصل بجواز وجود الأحزاب شرعًا، ولم تتطرق أي دارسة أو مراجعة لعلاقة الجماعة بالعمل الحزبي مطلقًا”، حيث يرى الكاتب أن الجماعة لم تتطرق في مراجعتها لإمكانية انخراط الجماعة في العمل الحزبي أو التحول إلى حزب سياسي، إنما كانت المراجعة تخص جواز وجود الأحزاب من الناحية الشرعية.
ويستطرد الكاتب في رؤيته ويدفع الشبهات عن طرحه مستشهدًا بالسجالات الفكرية التي تحدث داخل الجماعة ومتنبئًا بالاعتراضات التي ستنطلق على هذا الرأي حول علاقة الحزب بالجماعة، مؤكدًا أن دوافع الإخوان من العمل السياسي قد تغيرت بعد الثورة عكس ما كانت عليه قبلها، وهو ما يراه تخطيًا لمفاهيم العملي السياسي كما حددها البنا أدت إلى تحول أفراد الجماعة إلى مجموعة من الحزبيين لمجرد وجود فرصة سانحة لتولي الحكم كما ذكر الكاتب.
وذكر الكتاب أن من أكثر عوامل بث الفرقة في الجماعة هي العمل الحزبي بصورته الحالية قائلًا: “إن من أكثر عوامل تقسيم الجماعة هو الإصرار على جمع الجماعة على تفصيلات العمل الحزبي التي ستكون عامل انقسام، وحسبنا بالقياس ابتعاد البنا عن جمع الجماعة على مذهب فقهي واحد، فكان البعد عن الفرعيات سببًا في توحد الجماعة، هذا في الفقه، فما بالنا في قرارات السياسة داخلية والمجاري والقروض ونصوص القوانين و و و”.
كذلك رد على الكاتب على من يدعي أن الشورى هي التي أنتجت هذا السلوك قائلًا: “إن كانت هذه من الشورى ليست هذه كل الشورى، فالشورى لها مستويات حسب أهمية القرار، وفيها أيضًا مراجعة القرارات الخاطئة وتقديم الاستقالة حال الفشل وسحب الثقة من القيادة ومحاسبتها؛ فالشورى عملية تفاعلية تستوجب تحمل المسؤولية والمحاسبة وليست صكًأ مفتوحًا لأخذ مسار للأبد بدون توقف ومراجعة وتصحيح ومحاسبة بل ومحاكمة في بعض الحالات”.
انتقل الكاتب بين جنبات كتابه إلى رؤية الوضع الراهن وضرورة اتخاذ خطوات جدية من قِبل الجماعة لمواجهة الانقلاب العسكري، حيث يرى أن من أهم هذه الخطوات هي إعطاء ما يُطلق عليها الكاتب “الثورة” لون شعبي بحيث لا تصبغ بلون التيار الإسلامي فقط، كما يؤكد أن قطاعات من الشعب لا تشارك جماعة الإخوان المسلمين في مسارها الحالي بسبب تفسيرهم أن ما يحدث في مصر الآن هو صراع على السلطة بين الحكم العسكري وجماعة الإخوان، كما يفسرون كلمة “عودة الشرعية “ما مرادفه عودة الإخوان للحكم مجددًا.
ويقول الكاتب في هذا الصدد: “إن الوضع السابق للانقلاب كان وضعًا معيبًا وليس من الحكمة استدعائه من جديد برغم كل إيجابياته وكان مصيره الفشل لو استمر، وحتى لو لم يحدث الانقلاب لأسباب عديدة أهمها غياب القوة التي كانت تتمثل في الظهير الشعبي الواسع، وهكذا سيبقى مؤيدو الشرعية وحدهم في الطرقات تحت وابل من رصاص الغدر والخيانة ويبقى الصراع في حالة، لا حسم”.
ويؤكد الكاتب في تحليل مطول مستشهدا بتصنيف البنا للمجتمع أن الثورة مازالت حية في نفوس الكثير ومازال لها جمهورها ورصيدها الشعبي الواسع فيمن أسماهم بكتلة “المراقبين” الذين يرفضون المشاركة في الحراك الحالي، وانتقل الكتاب بعد ذلك إلى فصل “كيف تنجح الثورة” من وجهة نظر الكاتب حيث يقول الكاتب: “لا يوجد سيناريو مرشح لنجاح الثورة إلا القوة الشعبية الهادرة باتساع الاحتجاجات عدديًا وتحول لونها إلى اللون الشعبي العام وليس التيار الإسلامي فقط تحت شعار “نجاح الثورة” وإسقاط هذا النظام لبناء نظام العدل والحرية، ولن يحدث هذا إلا بتجمع كتلة “المراقبين” أو “الكتلة الوسط” وأنصار الشرعية”، وأن هذا لن يحدث مادامت الجماعة تطالب بالعودة من جديد لسدة الحكم وتطرح نفسها كحزب سياسي.
كما يؤكد الكاتب أيضًا في هذا الفصل أنه لا نجاح للثورة بدون بدون ذراع سياسي لأن في النهاية لن يكون الحل في مصر إلا سياسيًا، فيقول: “لابد من ذراع أو أذرع سياسية قوية تحصد نتائج المسار الثوري لتدير الدولة حال سقوط النظام، وإلا للأسف ستذهب هذه التضحيات سدى، وللأسف لا توجد هذه الذارع السياسية القوية التي تملأ هذا الفارغ الخطير حتى الآن”، ويرى أن الجماعة يجب أن تترك هذه المساحة لتتشكل داخلها حركات سياسية منافسة للنظام من اللامعين السياسيين داخل المجتمع سواء من داخل الجماعة أو من خارجها.
ويلخص الكاتب رؤيته الإجمالية تحت عنوان:
(“المطلوب من جماعة الإخوان المسلمين” أن تتخلي عن المطالبة بالعودة للحكم من جديد لحالة “ما قبل الانقلاب” والقبول بأن تكتفي بأن ترجع “جماعة ضغط” في المجال السياسي وأن يكون دورها الحارس للمنهج الذي تدعو إليه لا حاكمًا مباشرًا لمصر.
لماذا؟
لـ “إعادة الانتشار” داخل المجتمع وإتاحة توسع المد الثوري وإتاحة الفرصة لنمو أذرع سياسية تعبر عن الثورة، من أفراد الإخوان ومن غير الإخوان”)، إذ يُجمل الكاتب رؤيته بأن الفصل بين العمل السياسي والعمل الحزبي سيكون بمثابة “إعادة انتشار” لجماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع بشكل جديد يسمح بعودة موجة ثورية شعبية جديدة ولو بعد حين.
الجدير بالذكر أن هذا الطرح في كتاب الرؤية البديلة لم يتنازل عن عودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى الحكم، لكن أشار الكتاب إلى ضرورة نزع الصفة الحزبية عن الجماعة، كما ضرورة عودتها إلى ممارسة الدعوة والسياسة من منطلق قيمي وليس تنافسي.
كما ذكر أيضًا مؤلف الكتاب الدكتور ياسر الحاج في مرفقات كتابه أنه قدم لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر مذكرة تحمل نفس مضمون الكتاب في شهر أبريل من العام 2011، أي قبل إنشاء حزب الحرية والعدالة رسميًا، ولكنها بحسب تعبيره: “لم تناقش ولم تعرض ولم يرد عليها”، أي أن هذه الرؤية قديمة من عمر الثورة وليست ردًا للفعل على الأزمة الحالية أومحاولة للهروب منها، بل ويوضح المرفق إن تلك المذكرة توقعت الأزمة والإخفاق وأن الأيام أثبتت صحتها وأن هذه الرؤية كانت بين يدي قيادة الجماعة منذ ذلك التاريخ.
وإذا أردنا أن نضيف إلى هذا الاستعراض الخاص بكتاب الرؤية البديلة خاتمة نقدية، فإننا سنركز أن الكتاب انطلق من خلفية أيديولجية بحتة ربما جعلته يجانب الصواب في توزيعه للأوزان النسبية للقوى المجتمعية على الأرض حيث صنفهم من وجهة نظر الجماعة، ووقع في شراك التعميم بألفاظ “العلمانية” وغيرها،وكذلك أفكار الكتاب بشكل إجمالي منغلقة تمامًا على الجماعة، بل يبدو الكتاب وكأنه مذكرة مطولة تخاطب الجماعة وأفرادها فقط ومنغلق تمامًا على الحالة المصرية بالتحديد رغم أنه ينظر للجماعة التي تمتد لعشرات الدول ولها تجارب سياسية متنوعة ومتباينة.
ولكن قد يكون هذا الانطلاق مقبولًا لدى الكاتب الذي وجه الكتاب بالأساس إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، كما يمكن القول إن الكاتب تغافل في حله عن الوضع الإقليمي المحيط وتأثيره على الجماعة وعلى قدرتها على حسم الملف المصري، كذلك أنهك الكاتب نفسه في تفاصيل دقيقة للغاية لا يجب أن تناقش في رؤية نقدية عامة كهذه.
لكن في النهاية وبلا شك أنها بادرة طيبة أن تخرج مراجعات فكرية إلى العلن من قلب جماعة الإخوان المسلمين التي تصدرت المشهد السياسي من بعد ثورة يناير حتى وقوع الانقلاب العسكري، وهو ما سيسهم بلا شك في إنضاج أي تجربة سياسية قادمة للجماعة إذا ما أخذت الأصوات النقدية مكانًا مسموعًا داخل الجماعة، في ظل انحسار للمساحة الفكرية والإثراء الفكري داخل الجماعة.
لتحميل كتاب الرؤية البديلة من هنا