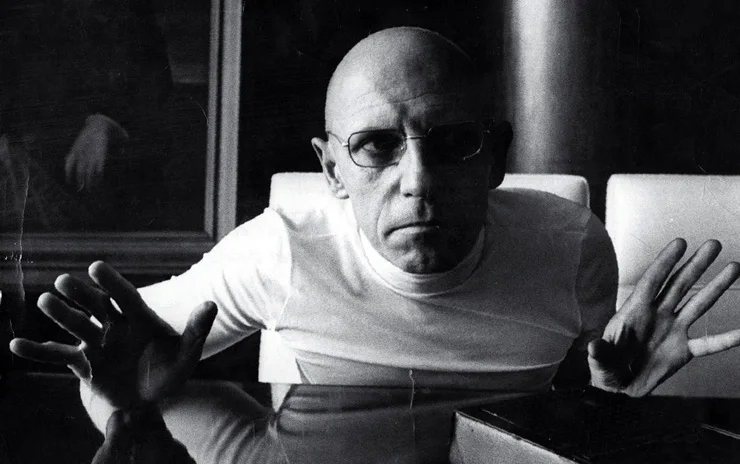في بداية كتابه “المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن” حاول الفيلسوف الفرنسي فوكو أن يقارن بين مشهدين، الأول يتعلق بإعدام شاب يدعى داميان اتهم بقتل والده سنة 1757، حيث «”رت قيادته عبر عربة، عاريًا إلا من قميص يستره، حاملاً مشعلاً من الشمع الملتهب، وفي العربة نفسها، يجري قرصه بالقارصة في حلمتيه، وذراعيه وركبتيه وشحمات فخديه، على أن يحمل في يده اليمنى السكين التي بها ارتكب الجريمة المذكورة، جريمة قتل أبيه، ثم تحرق يده بنار الكبريت، وبعدها يحرق جسده بواسطة الشمع ويقطع بواسطة أربعة أحصنة، ثم تتلف أوصاله وجسده بالنار حتى يتحول إلى رماد يذرى في الهواء”.
أما المشهد الثاني فهو يجري بعد ثلاثة أرباع القرن، وقد سطره ليون فوشي لسجن الأحداث في باريس، بدا فيه تقسيم الحياة اليومية للسجين بأدق التفاصيل، بدءًا من ساعة الاستيقاظ، إلى الصلاة، والعمل، الغداء والنوم، وشكل ملبسه وعلاقته مع نفسه ومع الآخرين.
وأمام هذه المقارنة أخذ يتساءل فوكو في ما إذا كان التطور في اختفاء الاحتفال العقابي، والتحول إلى عقوبة السجن داخل فرنسا وأوروبا بشكل عام، كانت تعبر عن حقبة جديدة من المشاريع الإصلاحية، بحكم انتشار أفكار التنوير، أم أن انسحاب العقوبات الوحشية للظل، يتعلق بمسألة أخرى تتعلق بعلانية مشهد التعذيب، كما برز في حالة داميان، الذي كان يتم في ساحات عامة وأمام جموع غفيرة، كطقس سياسي يهدف في الأساس إلى أن يوضح للجموع النفوذ المطلق للسلطان، ولذلك كان السجن بآلياته الانضباطية الجديدة يمثل ولادة جديدة له موضوعها الأساسي هو الجسد (كما في سجن أحداث فرنسا): “حيث يغدو جسد المجرم موضوعًا للمعرفة، وبمثابة الحيز الذي تظهر فيه تقنيات السلطة ليس بالطريقة التعسفية السابقة ولكن بطريقة أكثر خبثًا ودهاءً، عبر التحكم به وتطويعه وإصلاحه”.
ومن هنا بدت السلطة الحديثة عند فوكو قبل كل شيء منتجة، بمعنى أنها مكونة، تعمل على إنتاج أنواع خاصة من الأجسام والعقول، عبر ممارسات انضباطية غير مرئية ليس في مؤسسة السجن فحسب، بل في مختلف ميادين المجتمع: المستشفيات، المؤسسات العسكرية، المدارس… إلخ، كما أن هذه السلطة تعددية: فهي تمارس من نقاط لا حصر لها، لا من مركز سياسي مفرد، كأن تحوزها النخبة أو منطق المؤسسات البيروقراطية، وهي ليست محكومة بمشروع رئيس وحيد، بل هي منتجة لعلاقات وهويات منظمة وتأديبية تجب مقاومتها، ورغم أن تحليلات فوكو السابقة تركزت على فرنسا وأوروبا الشمالية، إلا أن أهمية الطرح الفوكودي كان يكمن في شرح طبيعة السلطة الحديثة ذاتها والتشكيك في أفكار التنويريين، ليس في تلك الدول فحسب، بل في أماكن عديدة من العالم، مثل الهند وأمريكا الجنوبية والعالم العربي، وهو ما تنبه لأهميته إدوارد سعيد، الذي برزت عبقريته في فترة السبعينات كونه استطاع إدخال مفاهيم فوكو داخل العالم الأكاديمي الأمريكي، ما ساهم في تأسيس حقل “ما بعد الكولونيالية” الذي أخذ يهتم بالماضي الكولونيالي وعلاقته بحاضر الدولة والمجتمعات ما بعد الكولونيالية، وقد عبر سعيد عن ذلك بقوله “إن الموقف المعيب الذي يقفه فوكو يظهر من كونه لا يعير اهتمامه للحقيقة التي مفادها أن التاريخ ليس إقليمًا ناطقًا بالفرنسية، بل هو تفاعل معقد فيما بين اقتصادات ومجتمعات وأيديولوجيات متفاوتة، لذلك فقد كان فوكو غافلاً عن أن عمله ينطوي على أعمق المعاني، لا كنموذج متقوقع عرقيًا عن كيفية ممارسة السلطة في المجتمع الحديث، بل كجزء من صورة أشمل تتضمن مثلاً العلاقة بين أوروبا وبقية أرجاء العالم، وكيف أن فكرتي الخطاب والانضباط (أو رسم الإطار كما سنرى عند تيموثي ميتشل) لدراسة وإعادة بناء كل العالم غير الأوروبي تقريبًا؛ لذلك فالتماثل بين نظام السجن لدى فوكو والاستشراق تماثل مذهل”.
الدراسات ما بعد الكولونيالية في مصر
وفيما يتعلق بالعالم العربي، يمكن القول إن دراسة الباحث البريطاني تيموثي ميتشل، كانت السباقة في دراسة مفاهيم السلطة والخطاب في تاريخ مصر الحديث، من داخل المفهوم الثوري الذي نحته فوكو عن السلطة الانضباطية الحديثة، وقد أظهر من خلالها كيف أن العملية الاستعمارية سعت إلى النظر لمصر كعالم مؤطر للسلطة، شبيهة بصورة مقروءة، من خلال ترويج تقنيات جديدة للسيطرة العسكرية والنظام المعماري والتعليم المدرسي… إلخ، بهدف استخدامها للسيطرة والحد من نطاق أي حركات أو تجمعات واسعة، قد يكون من الصعب اختراقها أو مراقبتها، كما في حالة كبت الموالد الشعبية التي كانت تميز الحياة الاجتماعية والاقتصادية المصرية بدعاوى تتعلق بانتشار الأمراض والهواء الفاسد، بيد أن الجدية في دراسة ميتشل لم تتعلق بهذا الجانب فقط، وإنما في تنبهه لمفارقة تتعلق برؤية الأصلاني (النخب المحلية) لهذه السياسات، الذي رغم رفضه للمظاهر السياسية للفكر الكولونيالي، ظل رهينة لمقولات الفكر المركزي الغربي، حتى حين تطلع إلى أن يستعيد لغته المحلية، وهي حالة وصفها إدوارد سعيد بعبارة رائعة “أن الإمبريالية رغم كل شيء هي مشروع تعاوني”، بمعنى أن المستعمَر بقي رهينة للفضاء الإبستمولوجي والأخلاقي، حتى عندما تطلع إلى الدفاع عن التحديث والتنوير، بل والدفاع عن هويته، الأمر الذي يشير إلى نتيجة مغايرة لبعض السرديات السائدة حيال تواطؤ بعض رموز الإصلاحية العربية في القرن التاسع عشر، التي ما يزال يبجلها البعض ويتباكى على أيامها، في الترويج لفكرة السلطة الانضباطية.
وفي هذا السياق يشير ميتشل إلى ملاحظتين ذكيتين: الأولى تتعلق بـ “موقع النظر”، بالنسبة للزائر الغربي لمصر، الذي لم يكن مجرد موقع منفصل، خارج العالم أو فوقه، لقد كان على المستوى المثالي موقعًا يمكن للمرء أن يرى من دون أن يُرى، شأنه في ذلك شأن السلطات في البانوتبيكون (سجن فوكو النموذجي الشهير)؛ فالسائح الأوروبي العادي، الذي كان يلبس وفقًا للنصيحة الواردة في دليل فوري للمسافرين إلى مصر السفلى والعليا، إما قبعة من اللباد العادي أو اللباد الناعم، مع نظارة من الزجاج الملون ذات ذراعين حاجبين للعينين، يملك النظر غير المرئي نفسه، والقدرة نفسها على الرؤية من دون أن يرى، وبحلول ستينيات القرن التاسع عشر كان الخديوي نفسه يسافر في البلد وهو يلبس نظارة ملونة، وعندما ظهرت في مصر عام 1877 أول صحيفة سياسية ساخرة مهاجمة سلطة الأوروبيين في البلاد وساخرة من المتعاونيين الأتراك معهم، قامت الحكومة بإغلاقها على الفور تقريبًا، ونفت رئيس تحريرها، وكانت قد سمت نفسها “أبو نضارة”، وبذلك تقاسم الكاتب مع السلطة هذه الرغبة في أن يرى دون أن يُرى.
أما الملاحظة الثانية فهي تتعلق بتعريف التنويري المصري رفاعة الطهطاوي للسياسة، التي تبدو مطابقة – بحسب ميتشل – إلى حد كبير للصور التي انتقدها فوكو حيال السياسة الحديثة، وفرض انضباطها على حياة الأفراد اليومية، فطبقًا لما يقوله ميتشل “تنقسم السياسة عند الطهطاوي إلى خمسة أجزاء، الأولان: السياسة النبوية والسياسة الملوكية ينقلان المعنى الشائع والأقدم لكلمة سياسة بوصفها القيادة أو الحكم، أما في القسمين الثالث والرابع، السياسة العامة والسياسة الخاصة: فيظهر المعنى الجديد للمارسة السياسية، فالسياسة العامة تعرف بأنها هي الرياسة على الجماعات كرئاسة الأخرى على البلدان وعلى الجيوش وترتيب أحوال ما يجب من إصلاح الأمور، حيث يجري توسيع مفهوم القيادة الضيق ليشمل ترتيب وإدارة والأشراف على شؤون الأمة، وتم توسيع دلالة مصطلح السياسة الخاصة إلى مدى أبعد، وهي التي تعرف أيضًا بأنها سياسة المنزل، في النوع الخامس، السياسة الذاتية التي جرى فيها التعبير عن السياسة بعبارات الصحة والتربية والانضباط، وبذلك توسع معنى السياسة من القيادة أو الحكم التي كانت قائمة في مصر بالتجمعات لصالح الممارسات السياسية القائمة حفز وتفقد وجسم وعقل والأخلاق الذات الفردية.
حكاية الناس العاديين مع جيش محمد علي
أما المحاولة الرائدة الثانية التي سعت إلى الاعتماد على الحفريات الفوكودية، فهي تعود لكتاب المؤرخ المصري خالد فهمي “كل رجال الباشا”، الذي سعى من خلاله إلى إعادة تفسير تجربة بناء جيش محمد علي في النصف الأول من القرن التاسع، بوصفها تعد أساس السلطة الانضباطية الحديثة في مصر، ما ساهم في هدم سرديات شائعة في الكتابة التاريخية المصرية حيال المصلح العظيم محمد علي بعد عقود من الفترة العثمانية التي كانت تتسم في المخيال القومي بحالة من الحكم الاستبدادي والقهر، غير أن الأهم في مشروع فهمي لم يتعلق فقط بتقديم سردية بديلة على المستوى التاريخي، وإنما في قدرة طرحه الابستمولوجي على تجاوز ما وقع فيه ميتشل، وما كان محط نقد واسع لدراسات فوكو، وأعني بذلك تلك الرؤية الميتافيزيقية للسلطة بوصفها منتجة لجميع القدرات، وما ينتج عنه من نتيجة ترى الأفراد ليس سوى “مالئي أمكنة” وليست لديهم مصادر للمقاومة، لكن بدلاً من السير في هذا الفهم القاصر لمقاربة فوكو للسلطة، اعتمد فهمي على ما أشار إليه فوكو في المحاضرات الأخيرة التي ألقاها قبل وفاته، والتي تطورت بطرق تواجه هذه الاعتراضات، وأهم التطورات من هذه الناحية، أفكاره عن السيطرة والسلطة والمقاومة، ففي مقالة لفوكو حول “الذات والسلطة” ناقش فوكو قائلاً “إنه حيث توجد سلطة لا بد من وجود مقاومة”، وهذا يعني وبشكل جلي، تعارضًا مع تأكيداته السابقة التي تقول “إن السلطة في كل مكان”.
وهي المسألة التي بينها فهمي بالعبارة التالية أنه يجب التأكيد وكما سبقت الإشارة إلى أن هذا الكتاب “كل رجال الباشا” ليس معنيًا فقط بإثبات إمكانية استخدام أفكار فوكو في فهم طبيعة جيش محمد علي، فهو يرمي إلى ما هو أبعد من تحليل وممارسات السلطة الحديثة في هذا الجيش، إلى تتبع ممارسة الجنود وحياتهم اليومية وكيفية تعاملهم مع ممارسات وخطابات هذه السلطة، فهمهم لخطابات السلطة واستخدامهم لها، ولذلك إذا سلمنا أن السلطة الحديثة لا مركزية وموزعة في الجسد الاجتماعي، فيمكن بناء على ذلك استنتاج أن المقاومة أيضًا لا مركزية وموزعة بالمثل في الجسد الاجتماعي، ولذلك تغدو دراسة جيش كجيش الباشا قادرة على أن تميط اللثام لا عن تقنيات السلطة الحديثة في مصر وممارستها الخبيثة اللامركزية فقط، بل أيضًا على تتبع أساليب مقاومة هذه السلطة.
نُشر المقال لأول مرة في صحيفة القدس العربي