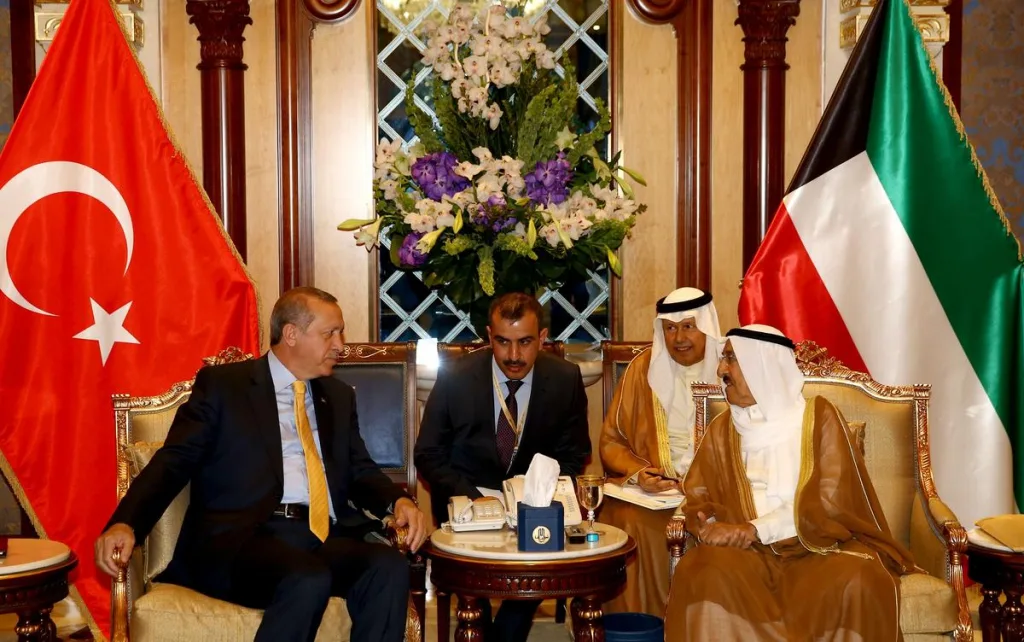على بعد خطوات من متحف اللوفر في قلب باريس تقع كنيسة سانت جيرمان، والتي دق جرسها في إحدى أيام أغسطس 1572 ليعلن بدء مذبحة القديس بارثولوميو ضد المسيحيين البروتستانت، لتشهد شوارع المدينة صرخات مدوية جراء ذبح الكاثوليك للآلاف منهم في واحدة من أسوا المذابح الدينية في تاريخ أوروبا، وهي حرب دينية استمرت حين انتفضت العُصبة المقدسة كما عُرفَت أنذاك في باريس الكاثوليكية ضد الملك هنري الثالث المتسامح دينيًا، والذي قتل على يد أحدهم قبل أن يتولي الملك هنري الرابع البروتستانتي في الأصل، ويتحول للكاثوليكية ليضع نهاية لتلك الحروب.
في موقع آخر بباريس لا يبعد كثيرًا عن هجمات الجمعة الماضية، يقف عامود يوليو كما يعرف في قلب ميدان الباستيل، والذي استضاف المعركة الدموية الشهيرة التي وقعت بعد حوالي قرنين في نفس المكان، حيث قام الفرنسيون بأول ثورة شعبية في تاريخهم، واقتحموا سجن الباستيل، وهي أحداث تبعها “عهد الإرهاب” كما يُعرَف والذي قام فيه الثوار بحملة عنيفة ضد أعداء الثورة.
بعد ثلاث سنوات، عادت الدماء مجددًا بالقرب من اللوفر حين واجهت مجموعة سان كولوت (أي بدون ملابس في إشارة إليهم كفقراء) حرس الملك لويس السادس عشر في معركة سقط فيها أكثر من ألف قتيل، انتهت بالقبض على الملك وإلغاء الملكية لوقت قصير، وهي معركة تبعتها بأسابيع حادثة دموية جديدة، حيث قامت نفس المجموعة باقتحام السجون وتصفية 1300 من أعداء الثورة تخوفًا من تعاونهم مع هجوم ألماني (بوروسي) محتمل.
حتى عام 1871 كانت ساحة اللوفر محجوبة بقصر توليري، والذي احترق أنذاك بعد أن قامت القوات الجمهورية المحافظة بقمع حكومة “كوميون باريس” الشيوعية الراديكالية التي استمرت لشهرين، والتي شيدت كنيسة ساكريكور الكاثوليكية “تكفيرًا” عن ذنوبها كما تقول النقوش الموجودة عليها، وبالتحديد إعدام الراديكاليين لرئيس الأساقفة بالمدينة، في إشارة واضحة على رسوخ السلطة الرجعية الكاثوليكية حتى ذلك الوقت.
جغرافيا باريس دموية نوعًا ما إذن، ففي كل ميدان أو مكان شهير تخفي المباني التاريخية الجميلة الآن معركة عنيفة، وهو عنف انصب كله ولا يزال على مواضيع بعينها أسرت ذهن الباريسيين، كالعلمنة والدين من ناحية، والراديكالية والمؤامرات والأيديولوجية من ناحية أخرى، أو كل ما يتعلق بالاعتقاد بشكل عام، فالفرنسيون اليوم معروفون بكونهم الشعب الأكثر اهتمامًا بالأيديولوجيا في خياراته السياسية، كما شهد في الماضي أشد المعارك الدينية بينما حاول البعض التحول من مذهب لآخر.
العقائد بكافة أنواعها إذن أمر حساس في باريس، من الإيمان المسيحي وحتى الاعتقادات الثورية، وهي عقائد فتحت بسهولة باب الدماء كما فعلت على مدار القرون السالفة، وإن كانت باريس قد حاولت دومًا أن تخفي أثار العنف من طرقاتها، وأن تقصرها على كتب التاريخ والمتاحف، لتقدم نفسها كمدينة سلام وأناقة وحضارة في نهاية المطاف، يظل العنف الكامن في ثقافتها يطل برأسه بين الحين والآخر، لينفجر كالبركان بصور مختلفة.
***
نظر إيميل هنري إلى المقهى باعتباره تجسيدًا للمجتمع البرجوازي، وكان يهدف إلى قتل أكبر عدد ممكن من الناس حين وضع قنبلة في مقهى ترمينو عام 1894، وعندما سُئل في المحكمة عن سبب إيقاع الضرر بمجموعة كبيرة من الأبرياء، قال ببساطة أنه لا يعتقد بأن هناك أي أبرياء بين البرجوازيين، لتقرر المحكمة إعدامه خلال أشهر، وهو إعدام أطلق فيه هنري آخر كلماته، “تعيش الأناركية!”
لم تكن تلك أول مرة يقوم فيها هنري بعملية إرهابية في باريس، كما لم يكن أول إرهابي تعرفه المدينة، فقد سبقه أوغوست فايان بوضع قنبلة عام 1893 عند مجلس النواب الفرنسي، ورُغم ضعف قنبلته التي صنعها بالمنزل ولم تُحدث سوى جروحًا طفيفة لعشرين نائبًا، إلا أن الحادث أنذاك كان كالقشة التي قصمت ظهر البعير، ودفع الحكومة الفرنسية بعد حوادث مشابهة قام بها أناركيون لتمرير مجموعة قوانين عُرفت بالقوانين الخسيسة، تضمنت تقييد حرية الصحافة، ومنع أي شخص أو جريدة من استخدام الدعايا الأناركية.
كانت تلك الفترة تحديدًا هي التي انتشر فيها مصطلح الإرهاب بمعناه السلبي، حيث كان الإرهاب قبل ذلك مسألة خلافية بين من رأى بجدواها على غرار ثوريي القرن الثامن عشر، ومن نبذها تمامًا من المحافظين، غير أن المؤسسات الفرنسية التي ازدادت رسوخًا منذ تلك الفترة وصاعدًا خلقت سردية تنظر بشكل سلبي للعنف لتعزيز شرعية الجمهورية، بل واتخاذ الحوادث الإرهابية ذريعة لتمديد سلطاتها، ليقتصر العنف على سرديات ثورية لم تحظى بقبول واسع كالشيوعية والفاشية والأناركية وغيرها من المعتقدات.
كان آخر عهد باريس بالعنف الموسّع أثناء الحرب العالمية الثانية كما نعرف، قبل أن تؤسس الجمهورية الخامسة ويتولى شارل ديغول، غير أن العنف استمر على نطاق حوادث ضيقة، كما حدث أثناء حرب الاستقلال الجزائرية، والتي قتلت فيها الشرطة الفرنسية عام 1961 مائتين من المتظاهرين السلميين من الجزائريين في باريس وألقت جثثهم في نهر السين، وكذلك في الاضطرابات التي شهدتها المدينة عام 1968، وفر أثناءها ديغول لقاعدة عسكرية في ألمانيا، وأخيرًا في تسعينيات القرن الماضي حين شهدت الجزائر انقلاب السلطة على الإسلاميين، والذي وصلت أصداؤه لباريس عن طريق “إرهابيي” جزائريين.
***
بشكل أو آخر تُعد هجمات الجمعة، والتي قام بها فرنسيون مسلمون بالأساس، منتمية للسياق الفرنسي بقدر ما تتقاطع مع السياق الإسلامي الأوسع، ففرنسا دون غيرها لها نصيب وافر من تلك العمليات على العكس من بلدان أخرى في أوروبا كدول إسكندنافيا وألمانيا ذات الثقافات المحافظة والهادئة، بل ويمكن القول أن الثقافة الفرنسية نفسها بتاريخها وأفكارها طالما نظرت لذلك النوع من “الإرهاب” المُربِك للمجال العام بمشاعر مختلطة، فالجمهورية نفسها ترى فيه اضطرابًا بالطبع، غير أن الكثيرين يرون فيه راديكالية نوعًا ما، وهُم معظم الثوريين في الحقيقة على مدار تاريخها إن لم يكن كلها.
هناك شيء ما في راديكاليي فرنسا دومًا يوحي بأنهم يريدون قتلها لا إنقاذها، فمن الصعب تخيّل أن مجموعات السان كولوت كانت تمتلك رؤية لبناء فرنسا مختلفة بقدر ما كانت عازمة على استئصال كل ما يمثل فرنسا القديمة، كذلك معظم الأناركيين ممن قاموا بهجماتهم في تسعينيات القرن التاسع عشر، فإلقاء القنبلة أو إطلاق الرصاص والجري بعيدًا هو نشوة بذاتها كما يبدو من حوادث عدة شهدتها باريس وفرنسا كلها اتسمت بها حركات فلسفية وثورية عديدة دون أن تطرح ما ينبني عليها بالضرورة، وبالتبعية فإن جهاديي أو إرهابيي فرنسا (سمهم كما شئت) لم يأتو بجديد سوى على مستوى الأفكار ولكن ليس التكتيكات.
بقدر ما اتسمت الراديكالية الفرنسية بالعنف وطبيعته العدمية في آن، بقدر ما انعكس عُنفها على المنظومة القائمة، أو لربما كان الأمر بالعكس؛ فالمنظومة الكاثوليكية العنيفة ومذبحة بارثولوميو لعلها هي التي أرست بذور العنف والإرهاب في الثقافة الفرنسية ورسخت الإيمان بأنه ليس ثمة إصلاح ممكن في فرنسا، فالإصلاحيون يُقتَلون كما رأينا، وكل ما يمكن أن تفعله في فرنسا هو أن تمتلك آليات العنف بنفسك لفرض ما تريد بالقوة، أما الإصلاح فهو متروك للإنجليز الذي انتزعوا حقوقهم من الملكية بهدوء على مدار قرون أو الألمان الذين أعادوا النظر في تاريخهم بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الفرنسيين لا قبل لهم بتلك الأعصاب الهادئة، ولا هم متواضعون كفاية كالألمان ليعيدوا النظر في تاريخهم.
كثيرون هم من أرادوا قتل “فرنسا” وأغلبهم فرنسيون في الحقيقة، وهناك تيارات فلسفية كثيرة كما ذكرنا تعتبر ذلك القتل مسألة إيجابية جدًا، منها الثوري ومنها العدمي وغيرها، وليس غريبًا إذن أن تكون العدمية كمعتقد بحد ذاته قد ولدت في فرنسا، وأن يكون الفرنسيون مهووسين بعملية الانتحار الفرنسي تلك، والتي تعود بجذورها ربما لقرون طويل وليس للأعوام السابقة فقط كما يتصور البعض، فالكتب التي تتكلم عن موت فرنسا أو انتحار فرنسا أو إسلامها بمعنى استسلامها على غرار رواية ميشيل ويلبك الأخيرة رائجة بين الملايين هناك (بغض النظر عن جودتها الأدبية).
كل ما هنالك أن الفرنسيين واعتزازهم بذاتهم ربما لا يسمح لهم بأن يتحملوا أن يقوم بتلك المهمة أحد غير فلاسفتهم وأدبائهم وإرهابييهم أيضًا، ولربما كان تعرض باريس لنيران الأجنبي هوالمسألة الوحيدة التي وحّدت الفرنسيين نسبيًا، كما فعلت نيران الألمان في الحرب العالمية الثانية، وكما تفعل الآن تفجيرات الجهاديين، وهي لحظات مناسبة بالطبع للجمهورية لتعيد توحيد صفوفها وإنقاذ نفسها من هلاك داخلي تجلبه بعض شرائح الفرنسيين على فرنسا.
هل تكفي هجمات باريس إذن لإنقاذ الجمهورية، أم أن الانحدار الشديد الذي يشعر به الفرنسيون سيدفعهم للانتحار كما يتنبأ بعض الفرنسيين؟ وكيف ستنتحر فرنسا؟ بالاستسلام للإسلام كما يقول ويلبك؟ أم بالقفز إلى مركبة اليمين المتطرف وانتخاب مارين لو بِن في 2017؟ وهل سيكون ذلك انتحارًا أصلًا؟ أم أنه انتحار فقط من منظور الجمهورية؟ فاليمينيون بالطبع سيرون دخول مارين لو بِن للسلطة باعتبارها إعادة إحياء لفرنسا الميتة في نظرهم بسبب جمهوريتها المنبطحة لأوروبا، والإسلاميون أيضًا سيرون “غزوهم” المستقبلي لفرنسا فتح الفتوح في قلب أوروبا، والتي وقفت يومًا ما جيوش المسلمين دون أن تدركها.
على أي حال، وبغض النظر عن أي الضفتين تمتلك سلطة تعريف الانتحار والإحياء من عدمه، لا يبدو أن فرنسا ستستمر على نفس شكلها، فهي أكثر بلد أوروبي مضطرب منذ سنوات ثقافيًا وفكريًا، وقد تكون هجمات باريس مجرد عامل مسرّع للتحول الذي كانت لتشهده في كل الأحوال نحو “فرنسا من نوع آخر.”