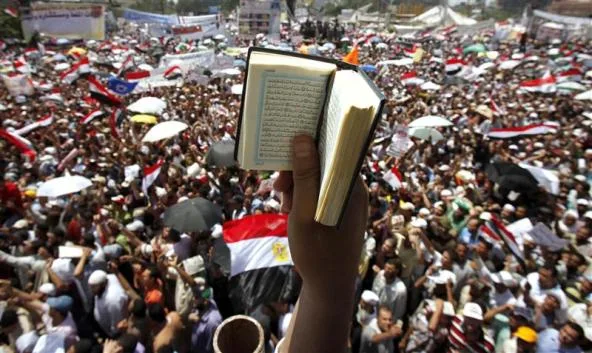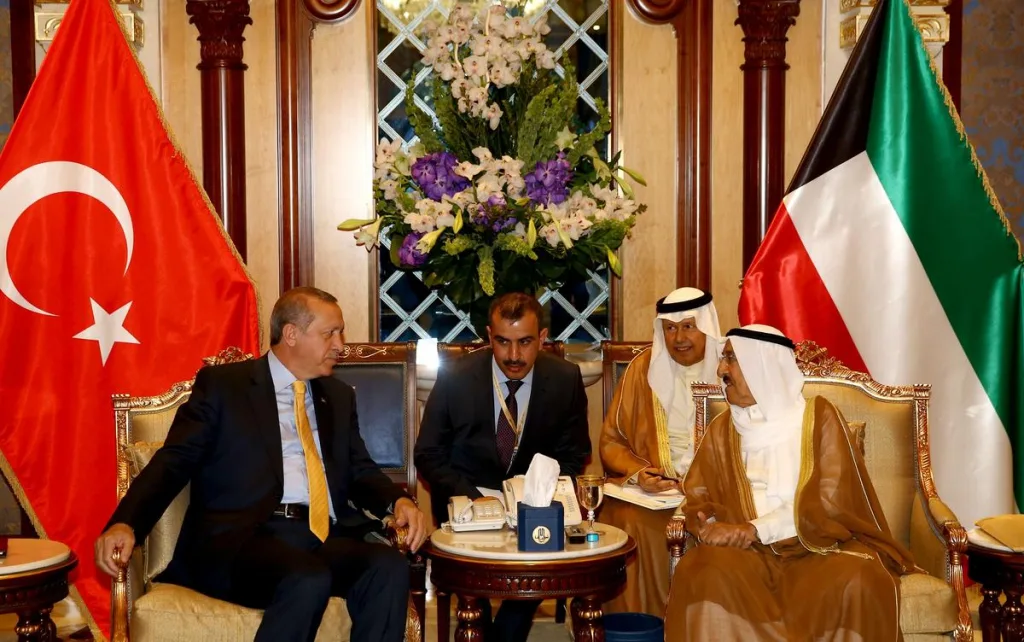في كتابه الواسع الانتشار والمثير للجدل”الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي”، أشار وائل حلاق إلى التناقضات بين مفهوم ومنطق الدولة الحديثة من جهة وفلسفة الحكم الإسلامي من جهة أخرى، فهو يرفض افتراض الإسلاميين أن الدولة الحديثة هي أداة محايدة يمكن أن تستخدم لتأدية بعض الوظائف وفقًا لخيارات قيادتها وانحيازاتهم الأيديولوجية، ويرى أن الدولة الحديثة لديها قيمها وفلسفتها العليا، والتي تنتج أثرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والنفسي.
فقد وصف حلاق الشريعة الإسلامية باعتبارها نظامًا أخلاقيًا يهدف إلى التأسيس لحياة نموذجية، وباعتبارها باراديم أو نطاق مركزي تخضع له كافة النطاقات الاجتماعية الملحقة (السياسة والاقتصاد والتعليم …إلخ) وتتحاكم إليه، ولهذا فإن الدولة الإسلامية لها دور تربوي خالص: بناء إنسان فاضل.
وعلى النقيض، فإن الواجب الأخلاقي في الدولة الحديثة يُنحَّى لمرتبة ثانوية، لأنها تشكلت وفق برادايم فلسفة التنوير، البرادايم الذي يستهدف التقدم الاقتصادي والتقني، ويؤكد على المنهجية العلمية والرشادة، ولذلك فإنه إذا كانت الدولة الإسلامية تسترشد ببارادايم أخلاقي له مرجعية مقدسة (الوحي)، فإن الدولة الحديثة موجهة بالبارادايم الوضعي العلماني، وإذا كانت مهمة الدولة الإسلامية هي تنشئة الفرد المسلم الأخلاقي فإن مهمة الدولة الحديثة هو إنتاج المواطن المنتج والمنضبط بقوانينها.
وبدون الخوض في معنى هذه الفرضية ودلالاتها – إذ ليس هذا هو موضوع المقال – أظن أنه من الممكن أن يبنى عليها فرضية أخرى تخص الأيديولوجيا السياسية الدينية ذاتها، فبشيء من المناظرة، يمكن الزعم بأن “الأيديولوجيا السياسية الدينية” هي نسق فكري مستحيل أيضًا، بل ويمكن أن نبرر هذه الفرضية بالمنطق ذاته، أن الأيديولوجيا السياسية – كونها نسق فكري علماني بالضرورة – فهي تستوجب علمانية الأفكار والمعتقدات التي تصاغ وفق هذا القالب، وأن تحميل الأفكار الدينية على القالب الأيديولوجي ينتج تشوهات واضطرابات عديدة في هذا النسق الهجين.
ولتوضيح هذا المعنى، نحتاج أن نعرّف ما هي الأيديولوجيا، وأن نستعرض الفرق بين قالب الأيديولوجيا وقالب الدين كنسقين مختلفين من الأفكار والمعتقدات، لنصل في النهاية إلى كيف أن النسق الأيديولوجي من حيث محتواه الفكري والعقدي ومن حيث مصدره المنطقي هو علماني بالضرورة.
فيما يخص الأيديولوجيا، فإن هناك عدة تعريفات متباينة للغاية حاولت توصيف هذه الظاهرة، وتختلف هذه التعريفات باختلاف التوجه الأيديولوجي (محافظ أم ماركسي أم ليبرالي)، ولكن وفقًا لأحد التعريفات الأكاديمية – الشبه محايدة – عرّف أندرو هيوود الأيديولوجيا أنها “مجموعة متماسكة بدرجة تزيد أو تنقص من الأفكار التي توضع أساسًا للنشاط السياسي المنظم، سواء بقصد الحفاظ على نظام القوة القائم أو تعديله أو الإطاحة به”، ومن ثم تتضمن الأيديولوجيا عناصرًا ثلاثة: نقد النظام القائم، رؤية مستقبلية للمجتمع، نظرية للتغيير السياسي.
وهنا تبرز أول ملامح علمانية القالب الأيديولوجي، فهو معني أساسًا بتنظيم النشاط السياسي، أو (بشكل أعم) معنيّ بتنظيم النشاط البشري المرتبط ببعض الجوانب الاجتماعية في هذا العالم، بعكس الدين الذي يقدم قالبًا أوسع من المعتقدات (تشمل الدنيوي والأخروي)، وبأولوية مختلفة (تقدم الأخروي على الدنيوي)، فالمعتقدات الدينية تعبر عن رؤية كونية للوجود وغايته، وتربط الدنيوي والمادي بالأخروي والغيبي، وهي تعطي أولوية للغيبي على الدنيوي، فمثلا يُبنى الانتماء أو عدم الانتماء للدين على الإيمان بالمعتقدات الغيبية التي ينص عليها هذا الدين بالأساس وليس على الاقتناع بالخيارات السياسية أو تبني النظم الاجتماعية التي قد تفهم من نصوصه، كما أن التعاليم الدينية تكون توقيفية تفصيلية في مجال العقائد والشعائر، ثم تصبح أكثر عمومية ومقاصدية فيما يخص الشرائع الحياتية، بل حتى في الأيديولوجيات الشمولية التي تقدم نفسها “كرؤية كونية” كالنازية على سبيل المثال فإنها كثيرًا ما توصف في الأدبيات السياسية بأنها “أشباه أديان” أو “أديان كاذبة” أو”أديان سياسية” نظرًا لتوسع مجالها ومدى دوجماتيتها عن ما يفترض أن يكون عليه الحال في الأيديولوجيا السياسية التقليدية.
ومن جهة أخرى، نرى ملمحًا آخر لعدم ملاءمة القالب الأيديولوجي للمحتوى الديني متمثلاً في الأيديولوجيات الإسلاموية، فهي تعنى بالأساس في برامجها الحزبية ورؤاها الإصلاحية بتقديم الأفكار والبرامج السياسية (المتعلقة بنمط توزيع السلطة، وشكل الشرعية السياسية، وعلاقة الدولة بالمجتمع، ونحو ذلك)، وكذلك تقديم البرامج الاقتصادية (أنماط التنمية التي تتبناها، شكل توزيع الثروة، وظائف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، إلخ)، لكنها بطبيعة الحال لا تقدم من قريب أو بعيد أي إسهامات في مجال المسائل العقائدية أو تؤسس لمذاهب أو مدارس فقهية جديدة بعكس الجماعات والمذاهب الدينية التقليدية، فطبيعة القالب الأيديولوجي – بعكس القالب الديني – لا يولي هذه المسائل الغيبية والأخروية والشعائرية أي أولوية.
وهنا يبرز الجانب الآخر من علمانية القالب الأيديولوجي، والمتمثل في مصدره العقلاني/ البشري، فالأيديولوجيا هي بنت البرادايم العلماني، بل أنها ظهرت في سياق محاولة فلسفة التنوير إنشاء نسق معرفي يحل محل الدين ويقوم بوظائفه في المجتمع، ولكن على أسس علمية عقلانية، “وليست غيبية أو خرافية هذه المرة!!”، بعدما ضاقت بالدور السلبي للدين في مجتمعاتها الغربية من ترسيخ الاستبداد وشرعنة النظم الفاسدة وتقسيم المجتمعات طائفيًا وتفجير الصراعات الدامية وغيرها، ولهذا فإن الحركات الإصلاحية الإسلامية حينما حاولت أن تواجه خطر العلمنة (الذي حمله لمجتمعاتنا الاستعمار ومن ورائه دولة الاستقلال) بالتأكيد على مرجعية الإسلام في تنظيم شؤون المجتمعات المسلمة كان عليها أن تتطور “نسقًا سياسيًا منطقيًا عقلانيًا” من المبادئ السياسية والاقتصادية الإسلامية شديدة العمومية ومن بعض أحكامه في هذا المجال المحدودة للغاية.
ومن هنا ارتبطت عملية أدلجة الإسلام بإشكالية هامة، وهي بما أن الإسلام جاء في مجال الشرائع عامًا وكليًا وأن الأحكام التفصيلية فيه محدودة لكي يفسح المجال أمام الاجتهاد البشري لمواكبة المستجدات التي تطرأ على حياة الناس ومعايشهم، ولأن القالب الأيديولوجي كما ذكرنا أيضًا معنيٌّ أكثر بتفاصيل النظم المعيشية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لهذا صادف عملية الأدلجة سؤال محوري: كيف سنملأ هذه التفاصيل؟! ولإجابة هذا السؤال كان هناك اتجاهان بشكل عام:
الاتجاه الأول هو الاتجاه التقليدي (التيار السلفي إجمالاً) وهو الذي حاول ملء هذه التفاصيل واستكمال هذه البرامج بالخبرة التاريخية للأمة الإسلامية، وبالعودة إلى اجتهاد فقهاء السلف وأئمتهم. فنجد أطروحات الاتجاه السلفي السياسية تتبنى نفس الممارسات التاريخية والاجتهادات السابقة مثل شكل دولة الخلافة المركزية التقليدية (شبه الإمبراطورية)، الخليفة ومواصفاته وصلاحياته، أهل الحل والعقد، بيت المال،.. إلخ. فنجد مثلاً من يتحدث عن الإمام الذي ينتخب مرة واحدة مدى الحياة، ويجمع صلاحيات تنفيذية وتشريعية (بتعيين أهل الحل والعقد والذين لهم رأي استشاري فقط غير ملزم) ويقصر مفهوم الشورى على أهل الاجتهاد والرأي دون مجلس شورى منتظم أو أحزاب ونحو ذلك، ويصوغ هذا الطرح على أنه النظام الإسلامي في الحكم! والمشكلة في هذا الطرح – كما هو ظاهر – هو الجمود عن إدراك الواقع والتغيرات التي طرأت على النظم الحياتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاولة استخدام معادلات تاريخية منتهية الصلاحية، والتي وإن حققت نجاحًا في وقتها وظروفها فبالتأكيد لن تحقق نفس النجاح في إطار ظروف وتوقيت مختلف، والمشكلة الأهم في هذا الطرح هي “تديين” الممارسات البشرية والخبرات التاريخية للأمة بحيث صارت آليات مثل بيت المال (لتنظيم توزيع الثروة في المجتمع) أو أهل الحل والعقد (كمؤسسة تقوم بتنظيم ممارسة الشورى) من الدين الذي يجب أن نسعى لإقامته في الأرض.
أما الاتجاه الآخر فهو الاتجاه التحديثي (الإخوان المسلمون إجمالاً) وهو الذي مال إلى المزاوجة بين مقاصد الشريعة وأهدافها بل وبعض أحكامها وآلياتها مع الآليات الحداثية، فنجد مثلاً أن برامج بعض الأحزاب الإسلامية “مثل حزب الحرية والعدالة بمصر” ينطلق من قاعدة العدل والشورى الإسلاميتين ثم يزاوجهما بآليات ليبرالية ديمقراطية مثل تداول السلطة، الفصل بين السلطات، الحياة الحزبية الصحية، تعظيم دور منظمات المجتمع المدني، حرية الصحافة والإعلام، ونحو ذلك، وهذا الاتجاه وإن كان يمثل شكلاً أكثر ملاءمة وفاعلية لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة الإسلامية إلا أنه وقع في مشكلة أساسية وهي أنه صبغ الاجتهاد البشري والفكر الإنساني بصبغة شبه دينية وشبه مقدسة، فهذاهو برنامج الحزب الإسلامي وهذا هو نظام الحكم الإسلامي، وأيضًا إذا انتقلنا إلى البرنامج الاقتصادي للحزب ذاته نجده – بعد الانطلاق أيضًا من مبادئ إسلامية كأهمية الكسب الحلال والتضامن والتكافل بين المسلمين ونحوه – يطبق آليات الرأسمالية “الأخلاقية”، والسوق المفتوحة ويعتمد نمط الإصلاح الاقتصادي النيوليبرالي من تحرير التجارة والخصخصة وضغط الانفاق الحكومي وما شابه، وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا حول هذه السياسات، فإنها تعكس تقديرًا بشريًا للمصلحة وانحيازًا أيديولوجيًا علمانيًا، وليس تقديرًا شرعيًا فضلاً عن كونه وحيًا إلهيًا، فما الذي يجعل من هذه السياسات سياسات إسلامية؟ وما الذي يجعل رؤية تنموية أخرى (على نمط دولة الرفاه مثلاً) رؤية غير إسلامية؟!
وبهذا فإن القالب الأيديولوجي سواء بمجال اهتمامه أو بمصدر ومنطق معتقداته وأفكاره لا يتلاءم مع القالب الديني بشكل جلي، وينتج عن التداخل بينهما في ظاهرة “الأيديولوجيات السياسية الإسلامية” العديد من الإشكاليات سالفة الذكر، لكن في الختام، يجب التأكيد على أن هذه الفرضية لا تتبنى فكرة أن الدين لا علاقة له بالمجال السياسي أو بمجال النشاط البشري عامة، أو أنها تنتقد أو تنقض مرجعية الشريعة الإسلامية، لكنها فقط تبحث عن إعادة تنظيم وموضعة الإسلام في هذا المجال، فالإسلام لا يمثل أيديولوجيا سياسية تتبنى نظاما سياسيًا واقتصاديًا محددًا، بل يمكن أن يستنبط في ضوئه نظمًا عديدة متباينة، تختلف باختلاف طبيعة المجتمعات وأشكال الدول، وأنماط النشاط الاقتصادي السائد بها، كما تختلف كذلك باختلاف الأفهام والطبائع البشرية المجتهدة، والإشكاليات المرتبطة بأدلجة الإسلام تعود – من وجهة نظري – إلى الفهم الخاطئ لحقيقة شمولية الإسلام، وكونه منهج حياة، والخلط في هذا الفهم بين المرجعية وبين النظام، فمرجعية الإسلام تعني أنه إطار مرجعي، يمدنا بالقيم الحاكمة والمقاصد العليا، بل وبمنهجيات استدلال ولغة خطاب نتجادل من خلالها حول هذه القضايا، كدائرة كبيرة تتنوع داخلها الأيديولوجيات والنظم، وهو فقط يحدها جميعًا برؤيته العقائدية للخلق والحياة، وبمنظومته القيمية والمقاصدية لهذه الأنشطة الاجتماعية والبشرية.