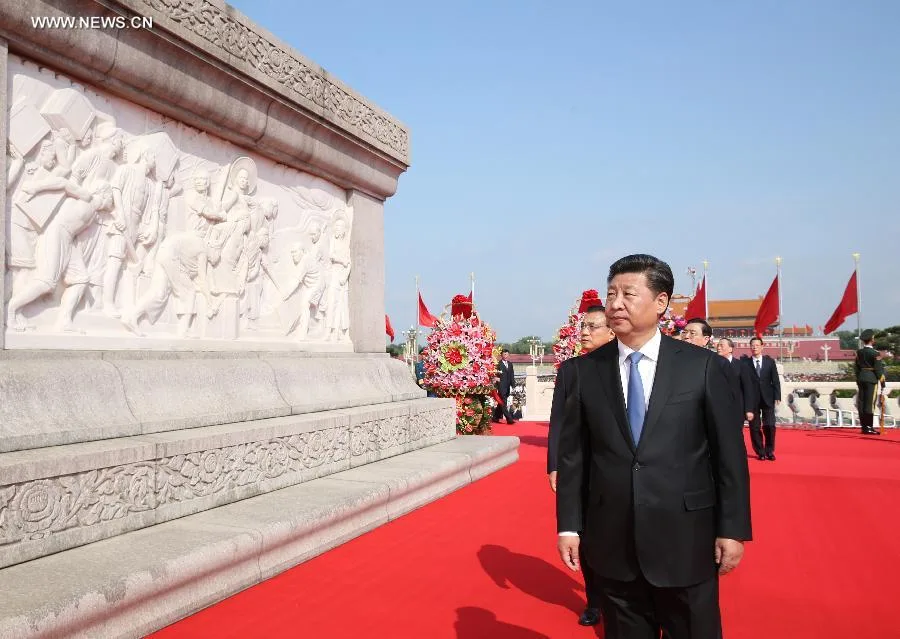كنت قد ذكرت في مرات سابقة بأن العالم العربي المتقلب بين الأزمات السياسية والحروب الأهلية أمامه خياران لا ثالث لهما: فإما خيار التوافق والتسويات السياسية السلمية أو التمادي في طريق الحرب الأهلية المهلكة للأرواح والأبدان على النحو الذي تعاني منه أقطار عربية كثيرة، من الجارة ليبيا إلى مصر وسوريا واليمن والعراق وغيرها، وقد أثار هذا التصريح وقتها قدرًا من الجدل والتعليق في بعض وسائل الإعلام بزعم التهويل من المخاطر في بلدنا، إلا أنني كنت ومازلت مقتنعًا بأن تونس كانت معرضةً لمخاطر جمة، ولنذر فتنةً حقيقية وقاها الله شرها، بل نحن لم نكن بمنأى عن الكارثة المحقة التي وقعت فيها أقطار عربية أخرى، لولا ارتفاع صوت العقل والحكمة بين نخبتها السياسية والاجتماعية للخروج من المساحات الخطرة ووضع القاطرة التونسية في الوجهة الصحية والسليمة.
صحيح أن طبيعة هذه الصراعات وملامح هذه الأزمات المستفحلة التي نراها اليوم تختلف من بلد عربي إلى آخر، والكثير من هذه الصراعات التي تشق العالم العربي، تختلط فيها عوامل السياسة والصراع على النفوذ والحكم، بعوامل الدين أو الطائفة أو المكون العرقي، فضلاً عن التدخلات الخارجية، ورغم أن من المسلم به أن النسيج المجتمعي التونسي يظل أكثر تماسكًا من الكثير من البلدان العربية الأخرى بحكم التجانس الديني واللغوي الذي تتمتع به تونس، ولكننا في نهاية المطاف لسنا بمنأى عن تأثير الجغرافيا وخصوصًا تأثير الجوار من حولنا، ومن ثم لا يمكن الاطمئنان هنا إلى مقولة الفرادة أو الخصوصية التونسية، وإذا كان ثمة من نجاح يذكر في تونس، فهو يتمثل في القدرة على الحد من تأثيرات المحيط السلبية وتقوية المناعة الذاتية في الجسم السياسي التونسي.
ولوضع الأمور في سياقها العام بما يساعدنا على تقريب الصورة وفهم معطيات الواقع التونسي المتشعبة، يحسّن بنا في هذا الصدد العودة قليلاً إلى الوراء، وتحديدًا إلى السنوات الأولى التي أعقبت الثورة.
لقد تمخضت انتخابات 23 أكتوبر 2011 عن انتصار واضح للترويكا مع رجحان واضح لكفة النهضة، وكان ذلك في إطار موجة تغيير واسعة غمرت المنطقة في إطار ما سمي بالربيع العربي، بيد أن بقية القوى سواء تلك التي اختارت مقاطعة الانتخابات بصمت كما هو شان المكون الدستوري والتجميعي أو تلك التي شاركت في الانتخابات ولم يحالفها الحظ كما هو شأن المكونات اليسارية التي تشكلت فيما بعد في إطار الجبهة الشعبية، فقد خرجت من تجربة الانتخابات بمرارة شديدة ولم تحتمل التحول المفاجئ الذي حصل في المشهد السياسي العام، خاصة وأن بعضها كان يتغذى من مناخات الصراع مع الإسلاميين تحت عنوان الدفاع عن مكتسبات الحداثة تحت خيمة النظام السابق.
تعامل كل طرف بطريقته الخاصة مع هذه المعطيات الجديدة التي أفرزتها انتخابات 2011، إذ عملت الترويكا على تثبيت مواقعها استنادًا إلى الشرعية الانتخابية، مثلما حاول الطرف الآخر الاستقواء بالشارع والضغط الإعلامي لزعزعة مواقع نخب الحكم الجديدة، خصوصًا بعد كارثة الاغتيال السياسي ثم التحولات الدرامية التي جرت في المحيط الإقليمي.
وهكذا انتهى الأمر إلى نوع من العطالة السياسية الخطيرة نتيجة تعادل موازين القوى تقريبًا بين الطرفين، أي الحكم والمعارضة، فلا نحن كنّا قادرين على أن نحكم بأريحية، ولا المعارضة كانت قادرة على إزاحتنا والحلول محلنا، ومثل هذا الوضع كان ينبئ بالسير نحو تمديد الأزمة، ومفتوح على احتمالين: إما عقد تسوية سياسية تاريخية بين الطرفين تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الجديدة الآخذة في التشكل في الداخل والخارج، ومن مقتضياتها القبول بإعادة بناء المشهد السياسي على نحو جديد، أو التمادي في خط التصعيد المتبادل ودفع الاستقطاب السياسي والأيديولوجي إلى حده الأقصى، مع ما يحمله ذاك من نذر الانهيار السياسي والاقتصادي المحقين، بما في ذلك خطر انهيار الدولة في مرحلة انتقال قاسية وصعبة وجوار مدجج بالسلاح سيساهم قطعًا في تغذية هذا الصراع إلى أمد بعيد.
من المؤكد أن هناك متغيرات جرت في الإقليم لم تكن لصالح أطراف الحكم، ومن ذلك الانقلاب الذي حصل في مصر تحت عنوان ثورة 30 يونيو 2013، ثم الأخطر من ذلك تشكل جبهة إقليمية مناهضة للربيع العربي تقودها بعض دول الخليج المرعوبة من التغيير بعد أن نزلت بثقلها المالي والإعلامي، ثم دخول ظاهرة الاغتيال السياسي على الخط، فضلا عن تحمل أعباء الحكم في مرحلة بالغة التعقيد والصعوبة من دون امتلاك أدوات الحكم الحقيقية أو سابق خبرة في إدارة شؤون الدولة.
كل هذه المعطيات بمكوناتها المحلية والإقليمية انعكست على نحو أو آخر في انتخابات 2014 التي كانت في محصلتها النهائية لصالح نداء تونس، ولكن من دون رجحان كامل، مثلما كانت انتخابات 2011 لصالح النهضة، بيد أنه يتوجب الانتباه إلى أن هذه المعادلة في المحيط الإقليمي وحتى الدولي كما هو الأمر في الداخل ليست مستقرة، بل هي تظل متحركة وبالغة السيولة، بما يعنيه ذلك أنها لا تسمح لأي طرف بالانتصار الكامل وإلغاء الجهة المقابلة، فلا النهضة كانت قادرة على إلغاء نداء تونس بحجة أنه وريث النظام القديم، ولا نداء تونس قدر على إلغاء النهضويين بزعم أنهم دخلاء على الدولة، ولعل هذا الأمر لم يفهمه جماعة حزب المؤتمر ووريثه اليوم في الحراك، مثلما لم تفهمه جماعةً محسن مرزوق التي تريد أن تمتطي مجددًا مركب الاستقطاب السياسي والأيديولوجي بدوافع يسروية طفولية.
وهنا دخلت إكراهًا السياسة وضروراتها لتفعل فعلها في الطرفين، باتجاه قبول إعادة هندسة المشهد السياسي على نحو لا يلبي بالضرورة رغبات وحسابات الجهتين، وخصوصًا قواعد الحزبين المشحونة بمخلفات التجاذب والحملات الانتخابية، وقد تطلب ذلك التحرك باتجاه الموقع الوسط، بما في ذلك الإقدام على تنازلات قاسية ومؤلمة لكل منهما، ويحسب للشيخين الغنوشي والسبسي برجماتيتهما وقدرتهما على التقاط اللحظة التاريخية قبل فوات الأوان، مع ما يقتضيه ذلك من مرونة ومساومات سياسية متبادلة، وقد ساعد على ذلك وجود خيمة الرباعي الراعي للحوار الذي سهل على مختلف الأطراف مغادرة المربع الأول في المفاوضات.
بدأت رحلة الوعي هذه – إن جاز القول – بلقاء باريس التاريخي ثم سلسلة المفاوضات الأخرى التي كانت تجري وراء ستار وخلف أبواب موصدة، ما بين سكرة (بيت الباحي) والنحلي (بيت الغنوشي) والتي كنت طرفًا مباشرًا فيها، ولم أكن مجرد متابع أو مراقب لها.
فرضت إكراهات السياسة في بداية الأمر على النهضة الخروج من الحكم وتسليم مقاليد السلطة لحكومة كفاءات وطنية بعد انتزاع المصادقة على الدستور وتحديد تاريخ للانتخابات، ولكن إكراهات السياسة المُرة أيضًا، فرضت بدورها على الطرف الآخر، أي نداء تونس بعد الانتصار النسبي الذي سجله في انتخابات أكتوبر 2014، وبعد سقوط الحكومة الأولى قبل أن يكتمل تشكيلها، أن يقبل بالشراكة مع النهضة وتجاوز تلك الثنائية المانوية بين نحن وهم، التي قاد على أساسها حملته الانتخابية وجلبت له بعض الأنصار.
صحيح أن هذا الخيار له كلفته السياسية على الجهتين، بما في ذلك قبول نوع من إعادة تموقع رجالات العهد القديم من جهة النهضة، ثم قبول التعايش ومن ثم الشراكة السياسية مع من كان يصنف في موقع العدو من جهة النداء، ولكن هذا الخيار ومهما كانت بعض تبعاته، إلا أَنَّه تغلب فيه مقادير الحسنات على السلبيات، والسياسة في نهاية المطاف بخواتمها ونتائجها، وهذا ما لا يفهمه الأيديولوجيون المتصلون من اليمين واليسار على السواء.
بدأنا نحن هذه الرحلة الجديدة في حركة النهضة تحت عنوان التوافق وبدأها منافسنا على الجهة الأُخرى، أي نداء تونس، تحت عنوان التعايش الذي استخدمه الرئيس الباجي، واليوم يكتشف كل منا فضيلة هذا التوافق الذي خطى خطوة أكثر وأبعد من مجرد التعايش، بديلاً عن ثقافة المغالبة والاستحواذ، قد تكون هذه خطوة تكتيكية أملتها ضرورات المرحلة وإكراهات السياسة للطرفين، ولكن تتجه هذه الخطوات إلى أن تكتسب طابع رؤية شاملة ومكتملة الأركان تتعلق بنظرية في الانتقال الديمقراطي في بلد صغير ومحاط بعواصف هوجاء من كل جانب، في إطار ما اصطلح على تسميته اليوم بالنموذج التونسي أو الاستثناء الديمقراطي التونسي.
وإذا قدر لأشقائنا في ليبيا، الممتحنين بحرب أهلية طاحنة الالتزام بأسس الاتفاق الذي وقعوه في الصخيرات المغربية أخيرًا، فمعنى ذلك أن النموذج التوافقي التونسي يعزز رصيده ويكتسب مساحات جديدة على حساب نماذج الحروب الأهلية وحكم العساكر الغليظ التي يراد تسويقها مجددًا في العالم العربي.
المصدر: جريدة الصريح التونسية