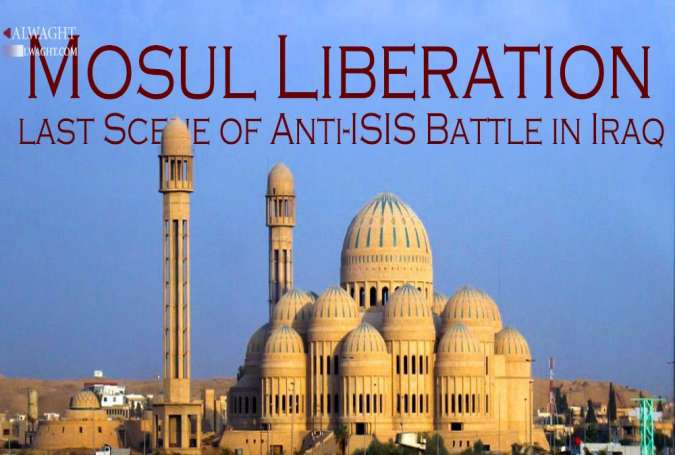تمر علينا في هذه الأيام، الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل أحد أهم أعمدة ما يُعرف في عصرنا الحالي، بالإسلام الحركي، وهو الإمام أبو الأعلى المودودي (25 سبتمبر 1903م – 22 سبتمبر 1979م]، والذي يصنفه البعض بأنه أحد مجددي القرن الرابع عشر الهجري.
وفي حياة الشخصيات أمثال الإمام المودودي، تكون هناك الكثير من نقاط الدرس والعبرة الموضوعية، التي تخرج عن نطاق الانبهار التقليدي بالشخصية العاطفي الطابع، من جانب أبناء الحركة الإسلامية، إلى مستوىً أكبر وأعمق يتعلق بما تحمله صيرورات حياته ومواقفه خلالها، بشأن الحركة الإسلامية، بمختلف أطيافها.
وفي النقطة الزمنية الحالية، فلعله أهم القضايا التي تطرحها حياة الإمام المودودي، هي قضية علاقته مع مؤسسي الحركات الإسلامية الأخرى الذين تزامنوا معه في عملية الإحياء والبعث للخلافة الإسلامية، من خلال منظومة تربوية وسياسية إسلامية انتظمت في برامج عمل وتنظيمات ذات ظهير مجتمعي وسياسي.
وتعود هذه الأهمية إلى ما تخوضه الكثير من الحركات الإسلامية، حتى بعض الأجنحة الموصوفة بالصحوية منها، من صراعات بينية وصلت إلى مستويَيْن لا يوجد ما يليهما من السوء، الأول، هو التكفير والافتراق عند حدود العقيدة، والثاني، هو الاقتتال الصريح، واستخدام السلاح، على أساس “اختلاف” العقيدة نتيجة التكفير، وتباين المصالح السياسية ومنطلقات كل جماعة من هذه الجماعات.
وهذه الصراعات هي المعوق الأساسي لانطلاق أي مشروع إسلامي موحد يعمل على تحقيق ما طرحه الآباء المؤسسين للحركات والجماعات الإسلامية الحركية المختلفة ذات الطابع السياسي، بدءًا من بديع الزمان النورسي وحتى المودوي، مع وجود إرهاصات سابقة ممثلة في شخصيات لم تعمل على تأسيس جماعات، مثل جمال الدين الأفغاني، ورشيد الرضا.
ومن بين أهم الشخصيات التي نعنيها، والتي ارتبطت بالمودودي عبر تاريخه الحركي الطويل، هو شخصية الإمام حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، الذي كان أكثر الشخصيات التي ظهرت في المرحلة التي تلت تفكك الدولة الإسلامية الجامعة، في عشرينيات القرن الماضي، سعيًا إلى الالتقاء بنظرائه، سواء حركيين أو مفكرين إسلاميين لهم حضورهم وتأثيرهم.
وكان البنا وفق ما كان يعلنه في كل مكان يذهب فيه من العالم الإسلامي الواسع، يتحرك من منطلق ضرورة أن تجتمع كل أصول الأمة بمختلف مذاهبها وحركاتها وتياراتها الفكرية والسياسية، وأنه من دون ذلك؛ لن يمكن تحقيق الأهداف التي ظهرت لأجلها كل دعوات الإصلاح والصحوة الإسلامية، منذ القرن التاسع عشر وحتى انهيار الدولة العثمانية وتفككها.
وهي – أي هذه الأهداف – يتعلق بالأساس بتخليص الأمة من رواسب الاستعمار وقرون التخلف التي دخلت فيها، وتفكيك منظومة الاستبداد والفساد التي حكمت بعد ضعف سلطة الخلافة المركزية، وسيطرة المماليك وعوانهم، وأصحاب نفوذ محليين، مثل شيوخ قبائل وسلاطين محليين، على السلطة في الولايات العثمانية المختلفة، ثم العمل على إقامة نظام إسلامي في الدول التي خرجت من رحم الدولة العثمانية المختلفة، بحيث يمكن بعد ذلك إعادة توحيد هذه الأقطار في كيان واحد مركزي.
هذه الفقرة السابقة، مثلت “مانيفستو” إسلامي غير مكتوب، اتفق عليه الآباء الأوائل المؤسسين لحركات الصحوة والإصلاح الإسلامية، وكان هناك اتفاق حقيقي على ضرورة توحيد الصف الإسلامي، سواء على مستوى الصفوة أو النخبة الحركية، أو المستوى الشعبي، من خلال الوسائل التربوية والاجتماعية والسياسية المختلفة.
ولذلك يمكن فهم اهتمام البنا بالمودودي، عندما أسس هذا الأخير، الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية، في لاهور، عام 1941م.
كان اهتمام البنا بالمودودي متصلاً بتحركات البنا في طول العالم الإسلامي وعرضه من أجل البدء في توحيد الحركة، وكان من بين ذلك أيضًا، مشاركته في تأسيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، في القاهرة، عام 1947م، والذي ضم علماء من مذاهب شيعية مختلفة، وعلماء من مختلف مذاهب أهل السُّنَّة والجماعة.
وهناك في أدبيات البنا ما يدعم ذلك في خطابه، ومن بين ذلك ما جاء في “رسالة المؤتمر الخامس”؛ حيث ذكر أن الإخوان “يعتقدون أن الخلافة رمز للوحدة الإسلامية، ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام، وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها، والاهتمام بشأنها”.
ويضيف في ذلك أن الإخوان المسلمين “لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس مناهجهم، وهم مع ذلك يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات، التي لا بد منها، وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن تسبقها خطوات”.
ولقد لخص البنا هذه الخطوات في “زيادة التعاون بين أمم الإسلام، وعقد الأحلاف والمعاهدات والمجامع والمؤتمرات بينها، ثم تكوين عصبة الأمم الإسلامية”.
وكما تقدَّم؛ فقد كان هناك شبه إجماع على الأفكار والسياسات في هذا “المانيفستو” غير المكتوب، ومن بين ما كان بين المودودي والبنا من التقاء يصل إلى حد التطابق، قضية استعادة إحساس الأمة بهويتها الإسلامية، كانتماء قومي لها، لو صحَّ التعبير، باعتبار أن ذلك الضمانة الوحيدة لإتمام مشروع الوحدة الإسلامية مجددًا.
وكان ذلك أوضح لدى المودودي بحكم خصوصية الحالة، وهي انتماؤه إلى شبه القارة الهندية؛ حيث رفض بالإطلاق فكرة اندماج مسلمي شبه القارة الهندية في إطار مشروع القومية الهندية الواحدة كبديل عن “القومية الإسلامية”.
وألف في تلك المرحلة كتابه الشهير “الدولة الإسلامية”، الذي كان أساسًا مهمًّا فيما بعد للكثير من الحركات الإسلامية، وعمل على دعم استقلال باكستان عن الهند، بحيث تكون وطنًا قوميًّا لمسلمي القارة الهندية.
إلا أن أهم ما كان في أفكار المودودي والبنا من اتفاق ويخص المحور الذي نتناوله يعنينا في هذا الموضع من الحديث، هو اتفاقهما على رفض فكرة التكفير، فكان المودودي يعتبرها “خطيئة فردية واجتماعية” كما ذكر في كتابه “المسلمون والصراع السياسي الراهن”، والذي ترجمه سمير عبد الحميد إبراهيم، إلى العربية عام 1981م.
ومن بين ما جاء في الطبعة العربية للكتاب، مقولة للمودودي خلال فتنة التكفير التي ظهرت بين مسلمي الهند بين عامَيْ 1934م و1935م، عندما قال: “إن مَن يلعن مؤمنًا كان وكأنه قتله، وإن من يكفر مؤمنًا كان وكأنه قتله، إن التكفير ليس حقًّا لكل فرد، والتكفير جرم اجتماعي أيضًا، إنه ضد المجتمع الإسلامي كله، ويضر كثيرًا بالمسلمين ككل”.
أما البنا، فقد اعتمد المحاذير الشرعية في هذا الصدد؛ حيث قال إن الإخوان المسلمين لا يكفرون مسلمًا أقر بالشهادتين، وعمل بمقتضاهما، وأدى الفروض “سواء برأي أو معصية، إلا إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، أو كذَّب صريح القرآن، أو فسَّره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر”.
ما الذي حدث؟!
لم تستمر علاقة البنا والمودودي طويلاً بسبب الوفاة المبكرة للبنا، عام 1949م، بعد اغتياله على يد النظام الملكي المصري في ذلك الحين.
وبعد وفاة البنا الذي كان يحوز سطوة فكرية وتنظيمية على أتباعه، بحكم كونه المؤسس والكاريزما والتأثير اللذَيْن كان يتمتع بهما، وأقر بهما له خصومه قبل أعدائه، انفكت مركزية أفكار البنا داخل الإخوان، وتداخلت معهم العديد من التيارات الفكرية، وظهرت رموز أخرى تملأ الفراغ الذي تركه رحيل البنا مبكرًا.
كان من بين أهم الرموز التي ظهرت في تلك الفترة، الأستاذ سيد قطب، الذي كان أكثر ميلاً لأفكار المودودي، التي كانت أكثر ميلاً إلى الصِّدَامية من البنا، الذي اعتمد مشروعًا طويل المدى للتغيير، يعتمد أكثر ما يعتمد على التربية، قبل السياسة، بينما كانت السياسة ذات مركزية واضحة في أفكار وكتابات المودودي، حتى أنه بدأ مسيرته الحركية بطرح مشروع الدولة الإسلامية، التي كانت في المرحلة الخامسة في مشروع البنا، بعد الفرد المسلم ثم الأسرة المسلمة ثم المجتمع المسلم، فالحكومة الإسلامية.
وفي ظل الحرب الشرسة التي شنها النظام الناصري في مصر ضد الإخوان المسلمين، فقد كان لها نتيجتان أساسيتان على الصف الإخواني والإسلامي الحركي بشكل عام، الأولى أنَّ مركزية أفكار البنا قد خفُتَتْ لصالح أفكار قطب والمودودي، واللذان كانا يريان أنه لا أمل في استقرار عملية التربية الإسلامية وأسلمة المجتمع من دون حكومة ودولة إسلاميتَيْن تحافظان على وتيرة عملية تربية الفرد والأسرة والمجتمع على الأصول الإسلامية الأخلاقية والعقيدية.
النتيجة الثانية، كانت راجعة لضعف الرابط التنظيمي لقيادة الجماعة على الكثير من الشباب في تلك المرحلة، بسبب تغييب للقيادات إما بالإعدامات أو الزج بهم في غيابات السجون.
مثلت أفكار قطب والمودودي بديلاً لبعض أفكار البنا لدى جيل الشباب التالي في الإخوان المسلمين
ومن ثَمَّ؛ أخذت أفكار قطب والمودودي حيزها، وكان لها القبول الأوفر حظًّا من أفكار البنا نفسها في كثير من المناطق، عند الجيل التالي من الإخوان المسلمين، وأبناء الحركات الإسلامية الأخرى، التي ظهرت نتيجة التحلل النسبي أو على الأقل الضعف الذي شهدته جماعة الإخوان المسلمين على المستوى التنظيمي والحركي، خلال ما يقرب من عقدَيْن من الزمان.
تصادمت هذه الحالة، مع الواقع التنظيمي للإخوان المسلمين أنفسهم؛ حيث حاكمية المنهج الذي وضعه البنا، هو أحد مقدسات الجماعة وثوابتها، ولا مجال للانحراف عنها، وكان ذلك قد وقر في عقول ونفوس القائمين على الجماعة، بأنه الضمانة الوحيدة لبقائها على قيد الحياة وموحدة كذلك.
وحتى وإن كان المودودي شريكًا أساسيًّا للبنا في الحركة الإسلامية العالمية في مرحلة حساسة من تاريخ الأمة، وحتى وإن كان قطب هو ابن الإخوان المسلمين نفسها؛ إلا أن هذا الوضع لم يقبل به القائمون على شؤون الجماعة تنظيميًّا.
وهنا، وأمام هذه الحالة من “الجمود” بحسب توصيف الفئة الأصغر سنًّا من الإخوان، والتي عانت الأمرَّيْن في سجون عبد الناصر؛ بدأت مرحلة من الخروج من الإخوان، تبلورت بعد ذلك في تنظيمات أخرى كانت نواة للتنظيمات المعروفة حاليًا بالسلفية الجهادية، والتي بدأت من رحم الجماعة الإسلامية المصرية، وتنظيم الجهاد، حتى وصلت في تلاوينها المختلفة إلى تنظيم “القاعدة”، بأذرعه المختلفة، وتنظيم “داعش” الذي يجسد الصورة الأكثر تطرفًا لتطبيقات المودودي والبنا في مجال حاكمية فكرة الدولة في المشروع الإسلامي، وأنه لا مناص من تحقيقها أولاً إذا ما أراد المسلمون تطبيق الشريعة الإسلامية، واستعادة خيرية الأمة.
ولما كانت الحركات الإسلامية المختلفة في وقت الآباء المؤسسين على اتفاق على المبادئ العامة والأهداف المرحلية لتحقيق الغايات المشروعة للأمة المسلمة؛ فقد كانت الخلافات غالبًا ما تأخذ الصورة الفكرية والسياسية، ويتم محاصرتها من خلال اللقاءات والمؤتمرات، ولاسيما خلال موسم الحج؛ حيث شهد أكثر من موسم حج لقاءات بين البنا والمودودي ورموز إسلامية أخرى، كانت قضايا المسلمين السياسية والحركية غالبًا ما تكون مطروحة على مائدة النقاش خلالها.
إلا أنه، وفي المرحلة التالية، بعد تغييب هذه القيادات التاريخية، بدأت الخلافات تأخذ صورة الافتراق والخصومة المباشرة، بحيث قام المخالفون بتشكيل “تنظيماتهم” الخاصة بعيدًا حتى الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية، التي أسسها المودودي، والتي كانت على صلة قربى بالإخوان المسلمين تنظيميًّا في مراحل تالية من تاريخها.
هذه التنظيمات آمنت – تحت وطأة تجارب حكم أنظمة عسكرية قومية في مصر وسوريا والعراق – بأن إقامة دولة إسلامية، وتحقيق المشروع الإسلامي، لن يتم من دون “تضحيات”، ولن يتم من دون التخلص من الأنظمة الحاكمة التي أعطت بالعنف الذي استخدمته ضد الحركات الإسلامية، وخصوصًا بعد تجربة جريمة نظام الأسد الأب في حُماة في سوريا، المبرر المنطقي لحمل السلاح ضد الأنظمة.
مجزرة “حُماة” مثلت نقطة تحول كبرى في تفكير ومواقف الجيل الثالث من أبناء الحركة الإسلامية الصحوية نحو المزيد من العنف في دعاوى التغيير
وكان ذلك في فترة مبكرة حتى قبل ظاهرة “العائدون من أفغانستان” التي عرفتها الدول التي كانت صاحبة النصيب الأوفر في مشاركة أبنائها في صفوف المجاهدين في أفغانستان، ضد الاحتلال السوفييتي، مثل مصر والجزائر.
وهنا نشير إلى حالة شديدة الأهمية تؤكد ما نقول، وتثبته، وهي حالة أبي مصعب السوري، أحد أهم منظِّري تنظيم “داعش”، وغيره من تنظيمات السلفية الجهادية، فهو في فترة أزمة حُماة، في فبراير ومارس عام 1982م؛ حيث كان أبو مصعب السوري من الطليعة الإخوانية المقاتلة في المدينة، وانفصل عن إخوان سوريا، بسبب رفضه لمبدأ خفض فوهة البندقية، بعد المقتلة العظيمة التي قام بها نظام الأسد ضدهم، ودمَّر خلالها المدينة عن بكرة أبيها.
وتدريجيًّا، اختفى الإخوان المسلمون الذين خرجوا من رحم تجربة الصراع مع الدولة في العالم العربي، ولاسيما في مصر وسوريا، وانضموا إلى التنظيمات التي آمنت بالعمل المسلح، وحل محلهم جيلٌ جديد “نقي” في انتمائه لهذه الجماعات، أي أنه نشأ وترعرع فيها، ولم يدخلها من باب تنظيمات وجماعات أخرى سابقة الظهور عليها، مثل الإخوان المسلمين.
ولذلك تحولت الخصومات السياسية من خصومات فكرية، وأزمات تخارج أعداد من هذا التنظيم أو ذاك، إلى صراعات مسلحة أخذت مجالها الأكبر والأوضح في الوقت الراهن، بسبب حالة الفوضى التي قادت إليها الارتكاسات التي قامت بها الأنظمة العربية الحاكمة على ثورات الربيع العربي، مدعومة في ذلك بقوى دولية من مصلحتها استمرار حالة الاحتراب والأزمة الراهنة في العالم العربي.
تلكم باختصار غير مخلٍّ الرحلة التي مرت بها الحركات الإسلامية منذ جيل المؤسسين المؤتلِف، وحتى جيل الأحفاد المختَلِف، ولئن كانت هناك دروس مستفادة منها؛ فلعل أهمها هو أن إصلاح هذه الحالة، ينبغي أن يكون على رأس اهتمامات أي عامل في مجال الإسلام السياسي وحركاته، وإلا فإن “المانيفستو” السابق؛ سوف يبقى أبدًا حبيس أدراج وأفكار المؤمنين به فحسب، ولن تقوم للأمة قائمة ما دامت بذور الصراع والاقتتال قائمة بين ظهرانيي طليعها الحركية.