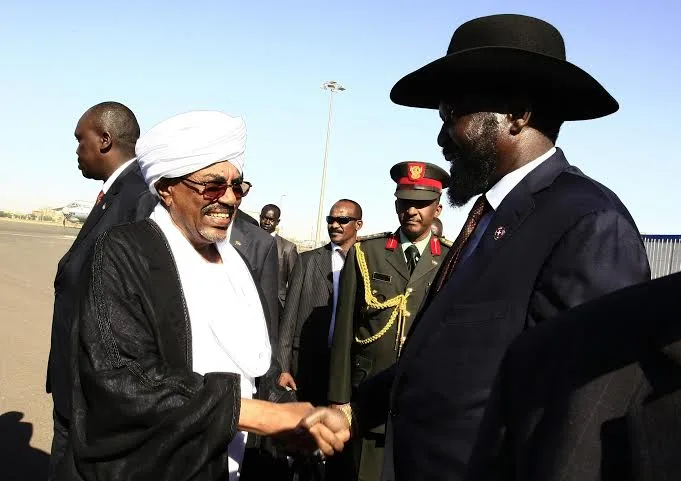لا ريب أن التاريخ أوسع من مجرد التاريخ السياسي، كما لا ريب أن التاريخ السياسي أوسع من تاريخ الحروب، ولكن الحقيقة التي لا فكاك منها أن تاريخ الحروب هو خلاصة التاريخ السياسي، وأن التاريخ السياسي هو خلاصة التاريخ كله، ولا يسع أحد يريد دراسة العلاقة بين أمتين إلا أن يبدأ بتاريخ الحروب هذا، فإن شاء اكتفى فيخرج حينئذ بحصيلة نافعة وصادقة وكافية أيضًا، وإن شاء استزاد فكان أحسن وأنفع. [راجع: موجز تاريخ الصدام بين الإسلام والغرب ج1، ج2، ج3، ج4]
في الحروب يضع كل فريق خلاصة نفسه، العلوم والفنون والأفكار والاختراعات وتدابير السياسة ونتائج البحوث، والحروب ليست اشتباك السلاح وحده بل قبلها وبعدها وحولها اصطراع العقائد والفلسفات والأساطير والقيم والأخلاق، حتى العلاقات السياسية هي في التحليل الأخير صيغة حربية تعبر عن موازين القوى ومساحات النفوذ وآفاق الرغائب والمطامح والمطامع، وحتى العلوم – بشقيها الإنساني والتطبيقي- ما لم يكن لها إسهام ملموس في رفعة ومجد الأمة لم يكن لها فائدة عملية، بل ربما كانت وبالاً على الأمة ذاتها إذا اتجهت للترف والتفاهات دون الغايات والمهمات.
إذن، فقد أثمر هذا التاريخ الطويل بين المسلمين والغرب حروبًا لا تنقطع، ومع ذلك فقد أثمر مساحات أخرى من التعارف والتأثير والتأثر، وبمثل ما كانت الحروب دافعًا لمعرفة المزيد عن هذا الخصم، بمثل ما كان تطور العلوم نافعًا في إدارة هذه العلاقات والحروب، سواء على مستوى الملوك والساسة أو على مستوى العلماء وطلبة العلم أو حتى على مستوى العامة.
ومع هذا فقد كانت مساحة التعارف الإسلامي على الغرب أوسع بكثير من مساحة الحروب وما أثمرته، فالإسلام من حيث هو رسالة عالمية يحفز أهله على العلم وعلى الدعوة، وقد وضع القرآن الكريم والسنة النبوية أصول التعارف على الآخر ومعلومات غزيرة عن بعضه -كاليهود والنصارى- فكان هذا أساسًا انطلق منه المسلمون في اتجاهات شتى.
ونحن حين نسعى في التأصيل الإسلامي لعلم الاستغراب فيجب علينا أن نقلب في هذه المعرفة القديمة بالغرب، والتي تمثل بذورًا وجذورًا للاستغراب الذي نريده، وحينئذ سنجد لدينا تراثًا ضخمًا ومتشعبًا ومهمًا، وهو تراث نافع على الجهتين: جهة علمنا بأصولنا ومدى ما بلغه أجدادنا من المعرفة وقيمة ما حصلوه ومقدار ما فاتهم وما أخطأوا فيه، وجهة علمنا بأصول الغرب وجذوره، فمما لا شك فيه أن الغرب الحديث عرف نفسه من خلال تراثنا نحن، ويشهد بهذا كثير منهم [1]، حتى إن أسوأهم حالاً – وهو من يعتبر المسلمين مجرد سعاة بريد احتفظوا بعلوم اليونان والأقدمين ولم يضيفوا شيئًا – إنما يشهد بقيمة التراث الإسلامي في معرفة جذور الغرب ذاته.
وكمحاولة لضبط الموضوع ومنع أنفسنا من الغرق في دروبه، نجعل الحديث فيه في أربعة مواضيع:
- الحروب، وما نبت على ضفافها من معرفة وتواصل.
- السفارات والعلاقات السياسية، وما جرى فيها من تبادل العلوم والمعارف.
- الرحلات التي اطلع بها القوم على ما لدى الآخر.
- حركة البحث العلمي.
أولاً: الحروب
لقد نشبت بين المسلمين والروم آلاف المعارك ما بين صغيرة وكبيرة، وكل معركة منها كانت تسفر عن مزيد علم لدى كل طرف بالآخر، لاسيما ما تسفر عنه من الاستيلاء على مدن تحتوي على نُظُم إدارية وترتيبات معاشية وإمكانيات اقتصادية وعلمية فضلاً عن الشعوب وأحوالها وعاداتها وتقاليدها، كذلك تسفر الحروب عن أسرى لدى كل طرف يقضي الواحد منهم أزمانًا قد تطول في بلاد العدو فيتعرف فيها على أحوالهم وعوائدهم ونظمهم وقد يجيد لغتهم في بعض الأحيان.
وتبدو هذه الخبرة مبكرًا في قول المحارب الفاتح الكبير عمرو بن العاص – رضي الله عنه – حين بلغه ما يرويه المستورد القرشي – رضي الله عنه – عن النبي r أنه قال: “تقوم الساعة والروم أكثر الناس”، فقال له عمرو: أبصر ما تقول، قال: أقول ما سمعت من رسول الله r، قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصال أربع: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة وجميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك” [2]. وفيما نعلم فإنه ليس ثمة ما يمكن أن يشكل هذه الخبرة لدى عمرو إلا معارك الشام ومصر.
ثم تظهر هذه الخبرة في اتخاذ إجراءات جديدة مؤثرة، فقد انزعج عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -حين علم أن معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه -، وهو الوالي على الشام، يركب في موكب وله حاجب على بابه، غير أن معاوية اعتذر له قائلاً: “يا أمير المؤمنين، إنا بأرض عدونا قريب منها، وله علينا عيون ذاكية، فأردتُّ أن يروا للإسلام عزًا”؛ فهنا أدرك معاوية أن بساطة العرب وتبسطهم لا تصلح في أرض كانت حتى وقت قريب تحت حكم الروم، بل لا بد أن يكون للوالي مشهد عز كالموكب والحاجب، فإن الرعية قد اعتادت أن يكون ملوكها في مواكب وحراسات ودون الوصول إليهم أبواب وحُجَّاب وإلا سقط من نظرهم هيبة الوالي؛ وهو الأمر الذي لم يكن بالوسع تجاهله فقال عمر: “إن هذا لكيد رجل لبيب أو خدعة رجل أريب” [3].
لقد اقتضت الحروب معرفة الكثير عن العدو، وقد احتاج المعتصم في إحدى غزواته معرفة إيرادات الدولة البيزنطية، فأمده بها بسيل الخرشني مسؤول الخزانة [4] إذ بلغت نحو ثلاثة ملايين دينار، فكتب المعتصم إلى الإمبراطور البيزنطي: “سألت صاحبك عن خراج أرضك فذكر أنه كذا وكذا، وأخسُّ ناحية في مملكتي خراجها أكثر من خراج أرضك، فكيف تنابذني؟” [5].
ومن أمثلة ما استفادت به الدولة الإسلامية في حروبها التحالف مع أتباع المذهب البوليصي الذين يسكنون جنوب الأناضول، والذين يعانون من الاضطهاد الديني للدولة البيزنطية، ويطلق عليهم أحيانًا في مصادرنا “البيالقة” وأحيانًا “الصقالبة”، وكان لهؤلاء جهد مهم في الحجز بين القوات البيزنطية والإسلامية زمن الخلافة العباسية لفترة من الوقت، بل لقد قاموا أحيانًا بتهديد القسطنطينية ذاتها، وكانت الخلافة قد تعهدت بالإنفاق عليهم وضمان رواتبهم في مقابل حماية بعض الثغور في منطقة الحدود، وظلوا يمثلون فائدة حربية كبرى حتى دب الضعف في جسد الخلافة وخسرت -بسبب سوء صنيع بعض الولاة- هذا التحالف المهم، ودفعت ثمنًا باهظًا [6].
كما اقتضت الحروب كذلك ترتيب أوضاع التعامل مع الغربيين الذين يتّاجرون في بلاد المسلمين، فهذا صلاح الدين -كما يبدو من رسالته للخليفة- يعد من إنجازاته ترتيب أوضاع التجار الأوروبيين “البنادقة والبياشنة والجنوية” في المشرق، بحيث لا يتحول نشاطهم التجاري إلى ما يضر بالمسلمين اقتصاديًا أو عسكريًا [7].
——————————————–
[1] يقول لويس سيديو بأن المعلومات التي قدمها العرب عن العصور الوسطى “لا تُقَدَّر بثمن”. لويس سيديو: تاريخ العرب العام، ص425.
[2] مسلم (2898).
[3] البلاذري: أنساب الأشراف 5/147، والطبري: تاريخ الطبري 3/265.
[4] أغلب الظن أنه انتهز فرصة وجود الجيش الإسلامي فأسلم وانحاز إليهم، أو هو على الأقل سالمهم وخرج ليعقد صلحا يتجنب به حرب المسلمين على مدينته “خرشنة”.
[5] ابن الفقيه: البلدان ص392.
[6] محمد إلهامي: رحلة الخلافة العباسية 2/103، 109. وانظر أطراف قصتهم ببعض تفصيل في: قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة ص187، الطبري: تاريخ الطبري 5/ 513، المسعودي: مروج الذهب 2/583، المسعودي: التنبيه والإشراف ص130، 155، وابن الأثير: الكامل في التاريخ 6/ 272، فتحي عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية 2/221، 222، 3/318، د. فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسية 2/71، د. سهيل زكار في الموسوعة الشاملة للحروب الصليبية 3/215.
[7] ابن أبي شامة: عيون الروضتين 2/364.